علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (2)

لنا في ما يأتي أن نبدي باقتضاب طائفة من نظائر “المبدأ / المثنَّى” كما وردت مسمَّياته في مدوَّنات الفلسفة الأولى ومذاهبها:
المسمَّى الأول: “المائيَّة” أو المبدأ الذي هو أصل كلّ الأشياء
يوجز طاليس (Thales 624-546 ق.م) وهو أوَّل الحكماء السبعة، نظامه الفلسفيَّ بالاعتقاد أنَّ الماء أصل الأشياء جميعًا، وأنَّ الكون مليءٌ بالآلهة، وأنَّ الاختلافات بين الموجودات ليست إلَّا نتائج استحالات عرضت للماء فغيَّرت مظاهره الخارجيَّة التي كانت ترافقه وهو ماء، وأحلَّت معها خاصّيَّات أخرى تتلاءم مع المصدر الجديد الذي استحال إليه الماء؛ فكلُّ شيء راجع إلى الماء، ومن الماء وُجِدَ كلُّ شيء.
قول طاليس «إنَّ الماء أصل كلِّ الأشياء» أوَّلهُ بعضهم بأنَّه يشي بما لم يعلن، رائيًا إلى الماء الإله الموجِد لكلِّ شيء، لأنَّه المبثوث في ثنايا كلِّ شيء. في المقابل رأى آخرون أنَّ قولًا كهذا قد يفيد اعتقاده بالتوحيد، عبر الإقرار بإله متجلٍّ بالماء. حيث هو الموجود في كلِّ شيء، وموجِد كلَّ شيء. إلَّا أنَّ كثيرين وجدوا أنَّ هذه الأقوال ليست سوى تأويلات أُلبِسَت طاليس إلباسًا ولا تعكس مقصده البتَّة.
المسمَّى الثاني: “الأبيرون” أو الَّلامتناهي الكونيّ
أحد أبرز فلاسفة ملطية أنكسميندر (Anaximander 611-547 ق.م)، ينكر فكرة معلِّمه طاليس أنَّ «الماء أصل الأشياء جميعًا»؛ ودليله أنَّ الماء جزءٌ كغيره من الأجزاء، والجزء لا يكون أصلًا للكلِّ المركَّب من أجزاء يخالف بعضها البعض في خواصِّه، وبالتالي في جوهره. لكنَّ المفارقة أنَّه سيوافقه الرأي حيال فكرة المادَّة الواحدة التي سمَّاها (الَّلامتناهي) أو الأبيرون Apeiron. و”الأبيرون” مزيجٌ من الأضداد كالحارِّ والبارد واليابس والرَّطب، لكنه – في الأصل – كلٌّ متجانسٌ لا يوصف بكمٍّ نهائيٍّ ولا بكيف محدَّد، ويمتاز بالسرمديَّة، وهو جامع لخواصِّ وصفاتِ كلِّ شيء، وعنه تكون الأشياء فترتدُّ إلى العنصر الذي نشأت منه، كما جرى بذلك القضاء والقدر. فأشياء الكون تنشأ من هذا «الَّلامتناهي» بعمليَّة الانفصال. وبحركة المادَّة تنفصل الأشياء بعضها عن بعض وتجتمع بعضها إلى بعض. ثمَّ تظهر لنا صور الانفصال؛ وبفضل هذه الحركة الانفصاليَّة الخالدة تحدث الكائنات.[جعفر آل ياسين، فلاسفة يونانيون- العصر الأول، بغداد، مطبعة الإرشاد، 1971، ص 30.].
المسمَّى الثالث: الألوهيَّة الملتبسة بالوثنيَّة
بين القرنين السادس والخامس قبل الميلاد، سنجد انعطافًا قليلًا في الَّلاهوت والكوزمولوجيا اليونانيَّة نحو ضربٍ ملتبس من التوحيد. سوف يرفض إكسينوفان (Xenophones 570-480 ق.م) وتلميذه بارمنيدس (Parrmenides515-440 ق.م) الطابع الخرافيَّ للديانة اليونانيَّة، فأنكرا التعدُّديَّة وعقيدة التناسخ الفيثاغوريَّة، وقالا بإله واحد، غير أنَّ هذه الوحدانيَّة ظلَّت مشوبة بالتباسات وثنيَّة بيِّنة.
حسب أكسينوفان أنَّ ما هو إلهيٌّ لا يمكن إلَّا أن يكون واحدًا، ولا يمكن إلَّا أنَّ يوجد واحد هو أفضلها، لهذا رأى أنَّ الإله يجب تصوُّره على أنَّه واحد، وهذا الإله لا يشبه البشر الفانين، فهو كلَّه بصرٌ وكلَّه سمعٌ وكلَّه فكر. وهو الذي يحكم الأشياء جميعًا من دون مشقَّة. ومع أنَّ توحيد إكسينوفان لم يكن كتوحيد الأديان الوحيانيَّة، لكنَّه آمن بإله أعظم يتفوَّق على باقي الآلهة والبشر. الدربة نفسها سيأخذ بها بارمنيدس Parmenides الذي آمن مثل أستاذه إكسينوفان بوحدة الوجود، وجعل الوجود أساس الَّلاوجود، فالوجود موجود ولا يمكن إلَّا أن يكون موجودًا. والوجود والواحد متكافئان، ملاء لا خلاء، ثابت لا حركة فيه. ثم أيَّده تلميذه زينون الإيلي (zenon 490 -430 ق.م) مثبتًا الوحدة، منكرًا الكثرة، مؤيِّدًا الثبات ضدَّ الحركة، وله في ذلك حجج مشهورة في تاريخ الفلسفة. [حسن حنفي، تطوُّر الفكر الدينيِّ الغربيِّ (الإنسان والله)، مجلَّة الجمعيَّة الفلسفيَّة المصريَّة، السنة السابعة- العدد السابع، 1998، ص 131].
المسمَّى الرَّابع: الواحد عند هيراقليطس
على الوجهة إيَّاها – وإن بصياغة أخرى – سيمضي هيراقليطس (Heraclitus 540- 475 ق.م) ليرفض فكرة تجسيد الإله مع قبوله فكرة التشبيه. لكنَّ فكرته في تنزيه الإله كانت هي الإضافة الحقيقيَّة له؛ حيث أعلن أنَّ الإله واحد، وأنَّ عالم الآلهة المزعوم وهمٌ وخرافة، وأنَّ الأسرار الشائعة بين الناس ليست سوى حكايات مائعة لا قدسيَّة فيها. ربما يكون هيراقليطس قد تأثَّر بأورفيوس والديانة الهندوسيَّة، خصوصًا لجهة اعتقاده بخلود الروح وتناسخها وخضوعها لقانون الكارما. وبذلك اختلف المؤرِّخون حول صفات الإله الواحد عند الفلاسفة الموحِّدين وحول صلته بالعالم وأزليَّته، لكنهم لم يتوصَّلوا إلى فكرة الإله الواحد الذي ليس كمثله شيء، وهذا ما دعاهم إلى النأي عن عقيدة التوحيد على نهج ما هو معروف في الديانات الوحيانيَّة.
المسمَّى الخامس: العقل كمبدأ يعادل الإله الأرضيّ
العقل هو الموجود الأوَّل أو الشيء في ذاته لدى أناكسجوراس. وإذا كانت جميع الأشياء فيها جزءٌ من كلِّ شيء، فإنَّ العقل لا نهائيٌّ، ويحكم نفسه بنفسه، ولا يمتزج بشيء، ولكنه يوجد ككيان قائم بذاته… “ذلك أنَّ العقل هو ألطف الأشياء جميعًا وأنقاها، عالم بكلِّ شيء، عظيم القدرة، يحكم جميع الكائنات الحيَّة كبيرها وصغيرها، والعقل هو الذي حرَّك الحركة الكليَّة فتحرَّكت، وهو الذي يدرك جميع الأشياء التي امتزجت وانفصلت وانقسمت، وهو الذي بثَّ النظام في جميع الأشياء التي كانت، والتي توجد الآن والتي سوف تكون”. هذا يعني أنَّ أنكساجوراس قد ألَّه العقل وجعل منه المحرِّك الأوَّل، إلَّا أنَّه لم يتحدَّث عن أيِّ تدابير إلهيَّة في فلسفته عن الوجود.
المسمَّى السَّادس: المبدأ الأفلاطونيّ أو عالم المُثُل
في طورٍ تالٍ من التفلسُف سنشهد على انعطافات كبرى في ميتافيزيقا الوجود شكل التجريد العقليِّ سمة بيِّنة لها. سيعلن أفلاطون أنَّ الطريق إلى معرفة المبدأ لا بدَّ من أن يمرَّ عبر الفلسفة بما هي العلم بالحقائق المطلقة المستترة وراء ظواهر الأشياء”. وكان بهذا يصدق النيَّة في الدعوة إلى تأسيس فلسفة ما ورائيّة تتغيّا الكشف عن حقيقة الوجود. ولمَّا جاء أرسطو ليعرِّف الفلسفة بأنّها “العلم بالأسباب القصوى للموجودات، أو هي علم الموجود بما هو موجود”، كان توَّاقًا إلى الانعطاف بمهمَّتها من أجل أن يجاوز التعالي الميتافيزيقيَّ للمُثُل الأفلاطونيّة ويحسم الجدل حول تعريفاتها. كانت هندسة العقل بالمقولات العشر ثمرة هذا الانعطاف. وهو لم ينفِ ما أعلنه القدماء من أنَّ الفلسفة تبقى العلم الأشرف من المعرفة العلميَّة، وأنَّ إدراك الحقيقة ومعرفة جوهر الأشياء يحتاجان إلى إلهام وحدسٍ عقليٍّ يمضي إلى ما وراء طور العقل. إلَّا أنّه – مع ذلك – سيبقى أوَّل من افتتح باب السؤال المتشكِّك عمّا إذا كان بمستطاع العقل البشريِّ إدراك الحقائق الجوهريَّة للأشياء.
المسمَّى السَّابع: المحرِّك الذي لا يتحرَّك
سيبدو أرسطو في مدوَّناته “ما بعد الطبيعة” كما لو أنَّه يعلن الميقات الذي نضج فيه العقل البشريُّ ليسأل عمَّا يتعدَّى فيزياء العالم ومظاهره. لكنَّ السؤال الأرسطيَّ – على سموِّ شأنه في ترتيب بيت العقل – سيتحوَّل بعد برهة من زمن، إلى علّةٍ سالبة لفعاليَّات العقل وقابليَّته للامتداد. وما هذا إلَّا لحَيْرة حلّت على صاحبه ثمَّ صارت من بعده قلقًا مريبًا. والذي فعله ليخرج من قلقه المريب، أنَّه أمسك عن مواصلة السؤال الذي تعذَّر الجواب عليه في حساب المنطق، ثمَّ مضى شوطًا أبعد ليُعرِضَ عن مصادقة السؤال الأصل الذي أطلَّ منه الموجود على ساحة الوجود. والحاصل أنَّ الفيلسوف الطموح “ما بعد الطبيعة” مكث في الطبيعة وآَنَسَ لها فكانت له سلواه العظمى. رضي بما تحت مرمى النظر ليؤدّي وظيفته كمعلِّم أوَّل لحركة العقل. ومع أنَّه أقرَّ بالمحرِّك الأول، لكنَّ شَغَفَه بعالم الإمكان أبقاه سجين المقولات العشر. ثمَّ لمَّا تأمَّل مقولة الجوهر، وسأل عمَّن أصدرها، عاد إلى حَيْرته الأولى. لكنَّ استيطانه في عالم الممكنات سيفضي به إلى الجحود بما لم يستطع نَيْلًه بركوب دابَّة العقل.
حَيْرتُه الزائدة عن حدِّها أثقلت عليه فلم يجد معها مخرجًا. حتى لقد بدت أحواله وقتئذٍ كمن دخل المتاهة ولن يبرحها أبدًا. مثل هذا التوصيف يصل إلى مرتبة الضرورة المنهجيَّة ونحن نعاين الحادث الأرسطيّ. لو مضينا في استقراء مآلاته لظهر لنا بوضوح كيف اختُزلت الميتافيزيقا إلى علم أرضيٍّ محض. من أبرز معطيات هذا السياق الاختزاليِّ في جانبه الأنطولوجيِّ أنَّ أرسطو لم يولِ معرفة الله عناية خاصَّة، ولم يعتبرها غرضًا رئيسيًّا لفلسفته، ولم يدخلها بالتالي في قوانينه الأخلاقيَّة ولا في نظمه السياسيَّة. الأولويَّة عنده كانت النظر إلى العالم الحسّيِّ وبيان أسبابه وعلله من دون أن يفكِّر في قوَّة خفيَّة تدبِّره. مؤدَّى منهجه أنَّ الطبيعة، بعدما استكملت وسائلها وانتظمت الأفلاك في سيرها، انتهى بها المطاف إلى محرِّك أوَّل أخصُّ خصائصه أنَّه يحرِّك غيره ولا يتحرَّك هو. هذا المحرِّك الساكن أو المحرِّك الصُوَريُّ هو عنده الإله الذي لا يذكر من صفاته إلَّا أنَّه عقل دائم التفكير، وتفكيره منصبٌّ على ذاته. يتحرَّج أرسطو عن الكلام في المسائل الدينيَّة، ويعدُّها فوق مقدور البشر، ويصرِّح بأنَّ الكائنات الأزليَّة الباقية، وإن تكن رفيعة مقدَّسة، فهي ليست معروفة إلَّا بقدرٍ ضئيل. لكنَّ هذا الفيلسوف الذي لم يفكِّر مبدئيًّا إلَّا في الطبيعة وعللها والأفلاك ومحرِّكاتها سيق في آخر الأمر إلى إثبات محرِّك أكبر تتَّجه نحوه القوى وتشتاق إليه. [إبراهيم مدكور- فلاسفة الإسلام والتوفيق بين الفلسفة والدين – في إطار كتاب “قضيّة الفلسفة” تحرير وتقديم: محمّد كامل الخطيب – دار الطليعة الجديدة – دمشق – 1998- ص: 165].
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (نسف) في القرآن الكريم
معنى (نسف) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 أكبر مسؤوليات التربية... منع تسلّط الوهم على الفطرة
أكبر مسؤوليات التربية... منع تسلّط الوهم على الفطرة
السيد عباس نور الدين
-
 حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (2)
حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (2)
محمود حيدر
-
 التحلّي بذهنيّة قويّة وإيجابيّة يلعب دورًا فعّالًا في التّأقلم مع الألم المزمن وإدارته
التحلّي بذهنيّة قويّة وإيجابيّة يلعب دورًا فعّالًا في التّأقلم مع الألم المزمن وإدارته
عدنان الحاجي
-
 الحرص على تأمين الحرية والأمن في القرآن الكريم
الحرص على تأمين الحرية والأمن في القرآن الكريم
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 نوازع وميول الأخلاقيات
نوازع وميول الأخلاقيات
الشيخ شفيق جرادي
-
 المذهب التربوي الإنساني
المذهب التربوي الإنساني
الشهيد مرتضى مطهري
-
 الحق والباطل: ماء راسخ وزبد يزول
الحق والباطل: ماء راسخ وزبد يزول
الشيخ جعفر السبحاني
-
 {حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ..} كيف يُنسب اليأس للرسُل؟
{حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ..} كيف يُنسب اليأس للرسُل؟
الشيخ محمد صنقور
-
 أَمَرْنا مُتْرَفِيها!
أَمَرْنا مُتْرَفِيها!
الشيخ محمد جواد مغنية
الشعراء
-
 اطمئنان
اطمئنان
حبيب المعاتيق
-
 الحوراء زينب: قبلة أرواح المشتاقين
الحوراء زينب: قبلة أرواح المشتاقين
حسين حسن آل جامع
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-

فوائد الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر
-
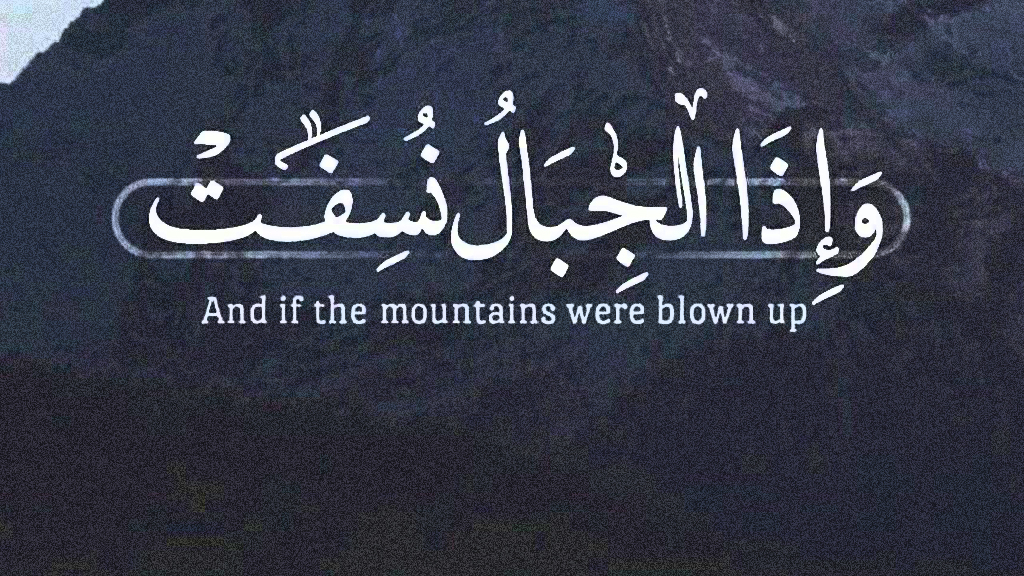
معنى (نسف) في القرآن الكريم
-

أكبر مسؤوليات التربية... منع تسلّط الوهم على الفطرة
-

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (2)
-

التحلّي بذهنيّة قويّة وإيجابيّة يلعب دورًا فعّالًا في التّأقلم مع الألم المزمن وإدارته
-

جمعيّة سيهات للخدمات الاجتماعيّة تختتم الهاكثون الإبداعيّ بثلاثة فائزين
-

(أسرار ملقاة على الرّصيف) أمسية شعريّة بديعة للعبادي والهميلي
-

اختتام النّسخة الثّامنة عشرة من حملة التّبرّع بالدّم (نعم الجود)
-

الحرص على تأمين الحرية والأمن في القرآن الكريم
-

معنى (رعد) في القرآن الكريم









