علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".الإسلام في نظر الاستشراق المستحدَث

محمود حيدر
لمّا وضع المؤرّخ وعالم الاجتماع الفرنسي مكسيم رودنسون كتابه المعروف (جاذبيّة الإسلام) في ستينيّات القرن الفائت وجد كثير من الباحثين في العالم الإسلامي أنّ هذا الآتي من مدارج اليسار الماركسي، شاء أن يحفر سبيلاً معاكِساً لما هو مألوفٌ لدى علماء الاستشراق. وذهب آخرون إلى أنّ الرجل أخذته أبحاثه المفرطة نحو توقّعات «غير معقولة» حول موقعيّة الإسلام الحاسمة في تحديد مستقبل العالم.
يومها لم يُسفر النقاش حول أفكار رودنسون عن نظر جديد للإسلام يعيد رسم خريطة معرفية تغاير الثوابت الإيديولوجية التي ترسّخت في الثقافة الغربية بفعل ما كتبه المستشرقون. لقد لاحظ رودنسون ما لم يلحظُه السواد الأعظم من أهل الاستشراق، أن الحملات الصليبية ليست هي التي أنشأت الصورة الثقافية السلبية عن الإسلام، وإنما كانت الصليبية نفسها هي النتيجة لتلك الصورة. فالإرهاصات الثقافية التي سبقت الحملات الصليبية كانت – حسب رودنسون- وليدة الوحدة الإيديولوجية للعالم المسيحي اللّاتيني التي أدّت بدورها إلى بلورة صورة «العدوّ المسلم»، وإلى توجيه الطاقات نحو الصليبية في الوقت نفسه.
السياق الإجمالي للرؤية الثقافية الغربية لم يتبدّل. فالتحوّلات التي وقعت على امتداد النصف الثاني من القرن العشرين حتّى يومنا هذا، جاءت لتؤكّد اتّساق الرؤية وتواصلها.
ولَئِن جاءت الأطروحة التي بسطها رودنسون، على نصاب الدهشة المعرفية الإيجابية، فإن ما نجده في الخطاب الثقافي الغربي اليوم حيال الإسلام يتبدَّى على نصاب مقلوب. وليست أطروحة «الإسلاموفوبيا» التي شقّت سبيلها بلا هوادة في ثقافة الغرب الأخيرة، إلاّ واحدة من التجلّيات المستأنفة للأيدولوجيا الاستشراقية.
سيرورة لقاء الغرب بالإسلام
مع صرف النظر عن طبيعة هذا التجلّي المستأنف، فإن لنا هنا أن نرى إلى الإسلام كما هو الآن في ميزان الغرب، باعتباره حاضراً وبجاذبية استثنائية في تشكيل خرائط المعرفة العالمية في بدايات القرن الحادي والعشرين.
ولو عدنا إلى أصل القضية، لرأينا الوضعية التالية:
كلّما انعقد الكلام حول ثنائيّة الإسلام والغرب، عاد ما بينهما من اتّصال وانفصال إلى سيرته الأولى. ما من شيء للإسلام على الغرب، أو للغرب على الإسلام، إلاّ رُدَّ إلى مستهلّ الإشكال. أي إلى تلك اللحظة التي أدرك فيها الغرب، بما هو غرب، أن استئناف التاريخ، وإعادة ترتيبه، لا يتحصَّلَ إلاّ بآخر يواجهه، ليحاوره أو يجادله، أو ليهيمن عليه. إنها أيضاً اللحظة نفسها، التي يدرك فيها المسلمون أنهم، على وجه القصد، هم ذلك الآخر. ما كان الأمر يحتاج إلى كثير مشقّة لاختبار مثل هذا الإدراك. الحافظة الجمعية للمسلمين مكتظّة بما لا حصرَ له من الحوادث والوقائع والأخبار. أما أرشيف الغرب فهو مشحونٌ بتيّارات، واستراتيجيّات، وأفكار، لا تنفكّ ترى إلى عالم الإسلام كفضاء مفتوح على تمرينات الاحتلال والسيطرة....
منذ الإرهاصات الأولى لنهضة الغرب، قبل نحو أربعة قرون، أخذت تنمو سيرورة اللقاء بالإسلام. غير أنّ هذه السيرورة طُبعت على غائيّة سالبة من أوَّلها. ولقد رأينا كيف ستؤول إلى ضربٍ من لقاء، تَبيّن أنه لن يؤدَّى على النحو المرسوم له إلا على أرض الزّيغ، والكمون، ومضمرات الشكّ. كان على الغرب الذي حمل حداثته الفتية لينشرها على الملأ، أن يتّصل بإسلام الشرق اتّصال الغالب بأمره. كأنما قدَر الغرب في حداثته الأولى، ألاّ يرى إلى جغرافيات الإسلام، إلاّ كمتّسعٍ مديدٍ، يزخر بقابليّات التلقّي، والتمثّل، والإخضاع.
في هذه الحقبة يعود الكلام على أطروحة «الإسلام والغرب» إلى نشأته الأولى. وعلى الرغم من تقادم الزمان على تلك الأطروحة، فهي لا تزال حيّةً في ساحات الجدل الفكري والحضاري. تفعل وتنفعل، وترسم وجهَ العالم وحدوده. إنّها أكثر أطروحات الزمن الجديد مثاراً للجدل. لا يعود السببُ في ذلك كلّه إلى سوء الفهم المتبادَل بين طرفَي الأطروحة وحسب، بل إن سوء الفهم هو شقيقُ ضديّة حضارية وثقافية، وجدتْ بدايتها الفعلية مع صعود الدولة القومية في الغرب، واستشراء غريزة التوسّع....
لم يكن لجغرافية الإسلام الماثلة في عين الغرب كأَمداء مترامية للغزو والانتهاب، إلاّ أن تردَّ الفعل بفعلٍ معاكس. وهو – ردٌّ غالباً ما كان – بحكم ميزان القوّة، وتقنيات السيطرة الجائرة، جواباً ارتدادياً فظيع الأثر. فلسوف يترتّب على الفعل وجوابه الارتدادي أفهام، ومعارف، وثقافات، لا تستوي إلا على حدّ الرفض والاختصام.
مع ذلك، لم يكن في سيرورة «اللقاء اللدود» بين الإسلام والغرب من انقطاع. ظلّت هذه السيرورة، على الرغم من الحروب الضَّروس، والهُدن المتواترة، والتسويات الموقوفة، على نحوٍ ما من التواصل. غير أن هذا التواصل ما كان ليأتي على أجنحة المصادفة. إنه تواصُل ينهض على مفارقة بيَّنة: وجهها الأول، الغزو، والسيطرة. وأما وجهها الثاني فهو التحقّق، والفهم، والتعرَّف، وإعادة صوغ ثنائية الشرق والغرب على صورة أخرى. ولئن كان الوجه الأول هو من طبائع الإمبراطوريات الطامحة، فالوجه الثاني هو ناتجُ عقل الاستشراق وطبائعه.
ما فعلته الإمبراطوريات الطامحة، كان فعلاً مشهوداً في نسيج الزمن العربي الإسلامي كلّه، فلقد كان لأرض الإسلام من كوارثه ما لا يُحصى. أما ما فعله الاستشراق فإنه أنجز من القراءات، وابتنى من الأحكام، ما جعل صورة الإسلام والمسلمين مكسوّة بضبابٍ كثيف. فلو رأينا إلى المشهد الإجمالي لتبيَّن أن من المستشرقين مَن أقبل على حسن الظّن، فكتب في الإسلام وحوله، ما لا شائبةَ فيه. في حين سيمضى بعض آخر منه إلى الحدّ الذي وظِّفت فيه أعماله وأبحاثه وقراءاته ضمن أوعية الإمبراطوريات المهيمنة.
الآن... هل ثمّة منطقة وسطى يمكن أن نعثر فيها على استشراق معرفيّ ينظر إلى المجال الإسلامي الفسيح بعين الواقع وشروطه؟... ربّما، نجد ذلك على النحو الذي وجدناه في تجربة رودنسون ومَن يوازيه في النظر إلى الإسلام والشرق من علماء الغرب. لكنّ داء الغَلَبَة لا يلبث أن يعود ليلقي بظلّه على أكثر تلك الإضاءات في مسار الاستشراق العقلاني. ولو عايّنا قليلاً لوجدنا هذا الداء هو نفسه داء الحداثة بامتداداته المعاصرة، ذلك الذي ساد، وشاع، واستبدّ سلطانه سحابةَ القرنَين المنصرمَين.
هذا هو السياق الأكثر حضوراً في جدالية الغرب / الإسلام. سياقٌ لا ينفكّ يحكم عقل الغرب المعاصر، من «الحرب العادلة»، إلى «صِدام الحضارات»، إلى مقولة «الإسلاموفوبيا».
ومهما يكن من تفاوت في مدارج تفكير الغرب حيال الإسلام، فإنّ حاضريّة الإسلام - على ما يقرّر جمعٌ من فلاسفة الغرب المعاصرين - هي السِّمة التي ستؤسّس للعالم صورتَه الآتية. فالإسلام حاضرٌ حضورَ العين في فضاء الغرب اللّامُتناهي. لقد صار جزءاً منه من دون أن يذوي فيه، وقيمةً من قِيَمه من دون أن يضمحلّ فيها. فضلاً عن أنه سيبقى لوناً مائزاً من ألوانه الكبرى.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 المدينة الفاضلة المهدويّة
المدينة الفاضلة المهدويّة
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
-
 معـاني الحرّيّة (2)
معـاني الحرّيّة (2)
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ!
يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ!
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 إلقاء موسى موسى (ع) الألواح، ومشاجرته أخاه هارون (ع)
إلقاء موسى موسى (ع) الألواح، ومشاجرته أخاه هارون (ع)
الشيخ جعفر السبحاني
-
 النسيان من منظور الفلسفة الدينية (1)
النسيان من منظور الفلسفة الدينية (1)
الشيخ شفيق جرادي
-
 الشمبانزي متمكن من التفكير أيضًا!
الشمبانزي متمكن من التفكير أيضًا!
عدنان الحاجي
-
 أدر مواقفك بحكمة
أدر مواقفك بحكمة
عبدالعزيز آل زايد
-
 معنى (نعج) في القرآن الكريم
معنى (نعج) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقا بَعدية (5)
ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقا بَعدية (5)
محمود حيدر
-
 ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ الضمير في: ﴿عَلَى حُبِّهِ﴾!
﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ الضمير في: ﴿عَلَى حُبِّهِ﴾!
الشيخ محمد صنقور
الشعراء
-
 السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات
السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات
حسين حسن آل جامع
-
 اطمئنان
اطمئنان
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-

المدينة الفاضلة المهدويّة
-

معـاني الحرّيّة (2)
-

إيران: إطلاق موقع المحادثة مع تفاسیر القرآن الكريم بالذّكاء الاصطناعيّ
-

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ!
-
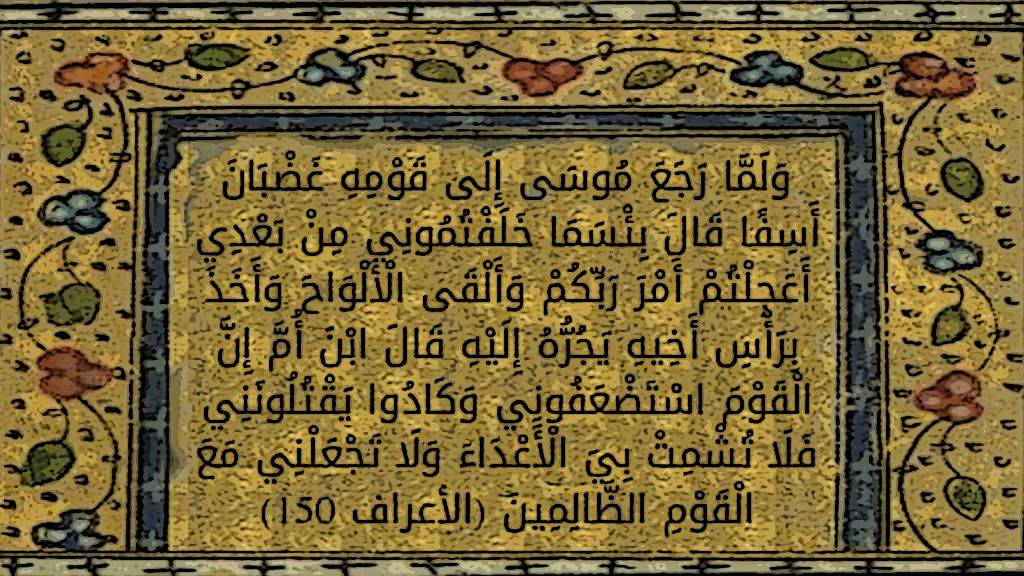
إلقاء موسى موسى (ع) الألواح، ومشاجرته أخاه هارون (ع)
-

النسيان من منظور الفلسفة الدينية (1)
-

الشمبانزي متمكن من التفكير أيضًا!
-

معـاني الحرّيّة (1)
-

أدر مواقفك بحكمة
-

علماء يبتكرون كلية (عالمية) تناسب جميع فصائل الدم









