قرآنيات
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ محمد مصباح يزديعن الكاتب :
فيلسوف إسلامي شيعي، ولد في مدينة يزد في إيران عام 1935 م، كان عضو مجلس خبراء القيادة، وهو مؤسس مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث العلمي، له مؤلفات و كتب عدیدة فی الفلسفة الإسلامیة والإلهیات والأخلاق والعقیدة الإسلامیة، توفي في الأول من شهر يناير عام 2021 م.الرؤية القرآنية عن الحرب في ضوء النظام التكويني (1)

البيان الفلسفيّ لاندلاع الحرب
لماذا تقع الحرب في العالم أساساً؟ لماذا خلق الله تعالى البشر على نحو يبادر إلى الحرب وسفك الدماء؟ ولماذا أصبح كل هذا القتل والفساد والدمار والخسائر التي تحيق بالإنسان وتلحق به؟ هل وقوع كل هذا الدمار وإراقة هذه الدماء الغزيرة بسبب تلك الحروب أمر مقصود في نظام الخلقة، ومطلوب ضمن الإرادة التكوينية لخالق العالم؟
الله تعالى هو الذي يرغب في أن يقتل الإنسان أخاه الإنسان؟ أم أنه غير راض عما يحصل، وأن المخلوقات هي التي يقتل بعضها بعضاً، وهي كائنات تعيش التمرد والخصام، وتثير الصراع والحرب؟ ماذا سيقول الإسلام عن هذه المسألة المعقدة؟ وفي ضوء تعاليمه كيف يرى الهدف الذي كان وراء خلق الإنسان وابتداعه؟ ولم خلق الله الإنسان مجرماً شريراً سفاكاً للدماء يسعى وراء الحرب والاقتتال؟ وكيف تكون كل المفاسد الإنسانية، وإراقة الدماء، وإثارة الحروب والصراعات من وجهة نظر الإسلام ضمن النظام الأحسن، والخلق الأصلح؟
حل هذا الموضوع إذاً، وفك عقدته مهم ورئيسي جداً للوصول إلى الأبعاد القانونية والحقوقية والقيمية للحرب والخوض فيها.
يقول تعالى في الإنسان الذي يهوى الحرب والمخلوق المتعطش لسفك الدماء: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)[١].
يتضح من خلال هذه الآية أن الملائكة حتى قبل خلق الإنسان كانوا يعلمون هويته وحقيقته وأنه سيقتل وسيسفك الدماء من هنا طرحوا سؤالاً مؤدباً معترضين فيه على جعل خليفة من هذا النوع، فقد سألوا الله تعالى: لماذا تجعل الإنسان المخلوق السفاك والمخرب خليفتك في الأرض رغم أننا بمنزلتنا هذه أرفع وأسمى منه؟
فأجابهم الله تعالى جواباً مجملاً: (قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)، وهذه الجواب على إجماله فيه إشارة إلى هذه الحقيقة، وهي أن من بين هؤلاء البشر الذين عدهم الملائكة ظالمين عاصين من ستكون منزلته ومقامه أسمى وأرفع من الملائكة وهو أحق بالخلافة منهم في الأرض.
وعند النظر إلى هذه الآية يمكن القول ومن دون شك: إن القرآن الكريم يرى أن القتال وسفك الدماء إحدى اللوازم البينة لوجود الإنسان الأرضي، وهو أمر ضروري لا ينفك عن حياته الاجتماعية، وأن الله تعالى وملائكته كانوا يعلمون قبل خلق هذا الكائن المعقد بهذه الخصوصية الذاتية اللازمة له، وعليه لا يمكن القول إطلاقاً: إن الله تعالى لا يدرك حقيقة هذا المخلوق، ولا يجوز التفوه بأنه لا يعلم ظاهرة الحرب المغروسة فيه وسفكه للدماء، ولا يصح الحديث أساساً عن أنه لا يدري بأن هذا الأمر سيتفق وقوعه في حياته ومسيرته الاجتماعية، وبعد خلقته أدرك حقيقة الموقف فندم على تكوينه وإبداعه!
اتضح الآن أن الله والملائكة كانوا يعلمون بصفة الإفساد وإراقة الدم وخصوصيتهما لدى الإنسان، وهنا يطرح سؤال فلسفي مهم وهو: لماذا خلق الله تعالى الإنسان بهذه الصفات الذميمة، فجعله يحمل كل هذا الشر والدمار؟ وعلى صعيد أوسع وأعم لماذا خلق الله تعالى العالم ليكون مسرحاً لكل هذا الفساد والفقر والسلب والنهب؟ ولماذا جعل كل هذه الكوارث تحيط بالإنسان؟ وما هي الغاية والقصد من جعل هذا الكون يشهد كل هذه الحوادث الطبيعية المرة والمؤلمة كالزلازل، والسيل، والقحط، والمرض؟
وقد أجاب الفلاسفة والمتكلمون عن هذه التساؤل كل بحسب منهجه ورؤيته، وينبغي البحث والتقصي عن الإجابة المفصلة بخصوص هذا الموضوع في مظانها. وما يمكن ذكره هنا إجمالاً هو: أن وجود شرور كهذه، ومفاسد بشرية وطبيعية إنما هي في الواقع من لوازم وجود عالم الطبيعة وعالم الإمكان وضرورياتهما وتزاحم العالم المادي، وعلى أساس الحكمة الربانية خلق الله سبحانه عالم الطبيعة مرافقاً لمثل هذه الشرور والمفاسد شئنا أم أبينا، مثل الحرب والفقر والمرض والسيل والزلازل والطوفان ونحوها.
ولا يمكن وجود عالم الطبيعة والخلق المادي هذا من دون هذه الشرور والمفاسد، لذا إن ترك فطر هذا العالم وخلقه من قبله تعالى وهو صاحب الفيض المطلق لا ينسجم مع إرادته تعالى، فخلق الطبيعة على هذا النحو وهو يعلم عندما أراد ذلك – أنها ستحتوي على جملة من الشرور والمفاسد طوعاً أو كرهاً، والتصاق هذه الكوارث والشرور ومرافقتها لهذا العالم لا يمنع من تعلق الإرادة الإلهية الحكيمة بخلقته وإبداعه.
ذلك لأن – ورغم وجود هذه الشرور والمفاسد – هناك خيراً وجمالاً وحسناً يحتويه هذا العالم هو أكثر وأوسع بالتأكيد من تلك الشرور والمفاسد، هذا هو الجواب الإجمالي، وبالنتيجة يمكن تبرير الحرب وسفك الدماء والقتل زاد أو نقص، وعليه يمكن أن يتفق وقوع مثل ذلك في المجتمع الإنساني.
الحرب والإرادة التكوينية للباري تعالى
أن الآيات القرآنية تدل بوضوح على أن وقوع الحرب أمر معلوم، وبينه الله تعالى في نظام الخلق الرباني، ولم يكن خارجاً عن علمه وإرادته وتدبيره، ومن جملة الآيات التي يمكن أن تكون دليلاً على ذلك هي قوله سبحانه وتعالى: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ البَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ القُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ)[٢].
وهذه الآية فيها دلالة على أن الله تعالى لو أراد فإنه يمكنه أن يخلق الإنسان ويجعل تفاصيل حياته بعيدة عن كل ألوان الحرب والقتال وسفك الدماء، ولكنه لم يرد أن يكون الإنسان مجبوراً على ترك القتال، ويكون مرغماً على أن يسود حياته الهدوء والراحة فقط.
إن الله تعالى لا يريد أن يسلك بنو آدم طريق الخير على سبيل الجبر والإكراه، فلو أراد ذلك سيكون الأمر كما قال سبحانه: (لَّوْ يَشَاء اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا)[٣]، ولأصبحت الحياة الاجتماعية كما ذكر في آخر الآية التي نحن بصدد البحث فيها الآن أيضاً، وهي التي تتحدث عن القتال، إذ قال الله تعالى: (وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُواْ)[٤].
هذه الآيات الكريمة تدل بوضوح على أن الله سبحانه خلق الإنسان أولاً وبالخصوص حراً كامل الإرادة، ولم يصده ويمنعه عن الحرب والصراع والإرهاب بنحو جبري وقهري، وسينجز أعماله أحياناً في ضوء الميول والرغبات المودعة فيه مع شيء من التضاد والتناقض والصدام.
بعبارة أوضح: إن الله تعالى خلق الإنسان حتى يكون خليفته في الأرض، وحيث إن خلافته سبحانه هي منزلة ومقام غاية في الرفعة والسمو، يلزم الوصول إليه وبلوغه كفاءة وجدارة عاليتين، ومقومات كثيرة يجب أن تتوافر في المرء بسعيه ونشاطه الحر وفعله الإرادي، ولكي يحصل الإنسان على هذه الفضائل والكمالات يجب أن يخلق مختاراً، مريداً، قاصداً لما يفعل، فلو لم تكن في أعماقه مجموعة من الميول والرغبات المتناقضة والمختلفة وبواعث متغايرة، وخلا باطنه من الميل والرغبة بالمعصية وفعل الشر، كان ما يفعله من أعمال حسنة وسلوك ممدوح دون قيمة أو فخر.
وعليه يكون الوصول إلى مرتبة الكمال الإنساني القصوى غير مقدور، فعلى الرغم من عدم ارتكاب الملائكة للمعصية ولم يخطر بخلدهم التفكير بالخطيئة والذنب حتى لم يكونوا جديرين إطلاقاً بمقام الخلافة ومنزلتها؛ ذلك لعلة واحدة فقط وهي أنهم لا يتمتعون بصفة الاختيار والإرادة والحرية.
من هنا إن منزلة أولياء الله ومقامهم أسمى وأعلى من درجة الملائكة ومقامهم، ولا تقاس طاعتهم وعبادتهم بأعمال الصلحاء الإلهيين وعبادتهم، فإن الرجال الذين صدقوا مع الله مختارون بخلاف الملائكة، ورغم وجود الباعث للمعصية والحافز للذنب لديهم لم يرتكبوا أي شيء منها، والتزموا بكل الأحكام الربانية ونفذوها.
ولو نال الإنسان مقام الخلافة الإلهية ودرجتهم سيكف نفسه عن المعصية، ويطهر جوارحه من الذنوب، ولا يقدم إلا على ما يرضي الله من الأفعال، والإرادة الإلهية تعلقت أيضاً بذلك وهو أن الناس هم الذين يختارون طريقة حياتهم ونوعها بملء إرادتهم وحريتهم وليس أنهم مجبرون على لون من ألوان الحياة، وملزمون بحركات مفروضة في مسيرة تكوينية قد عينت وحددت من قبل.
ثم إن هذا الاختيار والحرية والإرادة تزيد الإنسان وتسمو به في مضمار التكامل والرقي المعنوي. وعليه إن الحركة التكاملية للبشر رهن ذلك الاختيار بحيث يمكنه بحرية تامة أن يصنع ما يشاء.
من جهة أخرى أيضاً: إن حرية الإنسان في الوقت الذي تسير به في مضمار الكمال والمراتب المعنوية، فإنها يمكن أن تأخذه إلى الظلم وتجاوز العدل وسلب حقوق الآخرين أيضاً، لذا إن حرية الإنسان من جهة هي متعلق الإرادة التكوينية للحق تعالى ولازمها الكمال، ومن جهة أخرى فهي تستلزم غياب العدل، وسيادة الظلم والجور، وسفك الدماء، وإشعال فتائل الحروب والقتل والقتال أيضاً.
هناك العديد من الحيوانات تعيش بعيدة عن كل ألوان الظلم والحرب والصراع، وتقضي أوقاتها هادئة مطمئنة، ولكن الأمر يختلف في ما يخص الإنسان؛ لأن الله لو خلقه على نحو يسلب منه قهراً القدرة على التجاوز والصراع والظلم، وهو بذلك – وهو على هذه الشاكلة – خال من قلق الحرب واضطرابها، وبعيد عن هوس القتال، وتكون حياته وقتئذ أكثر راحة وأوفر اطمئناناً، ولكن لا يمكنه أن يبلغ الكمال المطلوب ولا يصل إلى الدرجة المعنوية المطلوبة.
وينبغى الالتفات إلى أن هذه الحرب والصراع ما دام موجباً لخير الإنسان وصلاحه فهو متعلق بالأصالة لإرادة الله تعالى، ولكن حينما يكون مستلزماً للشر والفساد فسيكون متعلقاً بالتبع لإرادته سبحانه، وعموماً إن الإرادة الإلهية الحكيمة في جميع قضايا الخلقة متعلقة أولاً وبالذات بالخير والكمال، ولكن لو توقفت بعض الخيرات والمصالح على ظهور بعض الشرور والمفاسد، ستكون الأخيرة متعلقة بالإرادة التكوينية لله بالتبع واللحوق، وقد بين هذا الموضوع بنحو مميز ولغة خاصة في الروايات الشريفة، مثلاً تجدنا نقرأ في بعض الأدعية الواردة: يا من سبقت رحمته غضبه[٥].
من هذه العبارة يمكن أن نفهم أن هدف المولى تعالى ومراده ومقصده الأول قد تعلق ببلوغ الناس رحمته ووصولهم للخير والكمال، ولكن من أجل الوصول إلى ذلك الهدف تحتم الضرورة في بعض الأحيان ويقتضي الأمر أن يظهر الغضب الإلهي، ويبدو انتقام الله في الأرض.
واللغز في هذه القضية هو ما أشرنا إليه من أن الخير والكمال الإنساني يجب أن يرافق الجهد والسلوك الاختياري الحر للإنسان، ولازم الوصول إلى الكمال الإنساني هو أن يكون ابن آدم مختاراً، كامل الإرادة والتصرف، هذا من جهة ومن جهة أخرى إن الإنسان الحر أيضاً عندما يكون متعسفاً في اختياره وحريته ويجعل اختياره في غير موضعه فإن ذلك سيعقبه الغضب والعقاب الإلهي أيضاً.
وعليه إن حرية الإنسان واختياره عين كونها سبيلاً لرقيه وكماله فهي في الوقت نفسه يمكن أن تُسخّر لممارسة مجموعة من الشرور والجرائم، وكما أن لاختياره الدور الكبير في بلوغه منزلة الخلافة الربانية، فهو أيضاً يمكن أن يساعده على الهبوط إلى أسفل درجة من الانحطاط والخزي.
من جانب آخر إن عالم الطبيعة على العموم هو عالم التضاد والتزاحم، فإلى جانب النعم والخير الموجود فيه هناك أيضاً محن وآلام، ونقم ومشقة جمة، وكان لدى الله العلم الكامل بكل النتائج الفرعية والخصائص الجزئية عندما خلق ذلك العالم. من هنا يمكن القول: إن الشرور والمفاسد أمر لازم لعالم الطبيعة وقد كانت مقصودة بالتبع واللحوق لخالق هذا العالم، وعلى العموم إن الخلق والعالم مقصود بالذات له تعالى، والهدف من الإرادة التبعية له سبحانه في ما يخص الحرب وكل الشرور الأخرى، هو أن وجود الخير الكثير والنعم الوفيرة في عالم الطبيعة والمادة اقتضى وجودها، فإن تحققها وإن كان شراً وبؤساً وعناء ولكنه لازم ولاحق لوجود ذلك الخير الأكثر والنعم الأكبر.
وخلاصة الأمر عند طرح السؤال الآتي: هل وقوع الحرب في نظام الخلق والتكوين مقصود له تعالى؟ وهل إرادته تعلقت بذلك أم لا؟ سنجيب بنعم، وهل يمكن أن تقع حادثة في الكون دون إرادة الله تعالى؟! ولكن ينبغي الالتفات إلى أن الآثار والنتائج المفيدة للحرب وخيرها وبركتها مقصودة أولاً وأصالة، والشرور والفساد مطلوبة بالتبع لإرادته تعالى، وهذا الكلام يعني أن الله تعالى ومنذ الوقت الذي ابتدع فيه الخلق كان يعلم بطبيعة الإنسان المتعطشة للدماء ويدرك رغبته في الإفساد والدمار، وكان يعلم بأن هذه الحياة الاجتماعية لهذا الموجود ستكون مسرحاً للحرب والظلم والخراب.
ولكن بمقتضى الحكمة البالغة له تعالى اختاره لينال مقام الخلافة ومنزلة النيابة عنه في الأرض، فأعطاه الحرية المطلقة حتى يستطيع مع اختياره هذا السير في طريق الكمال ويعتلي الدرجات المعنوية السامية، وبذلك يكون أرقى وأسمى من منزلة الملائكة، أو يكون بفساده وظلمه وعصيانه أحقر وأكثر هبوطاً مرتبة من الحيوانات والدواب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] البقرة، ٣٠.
[٢] البقرة، ٢٥٣.
[٣] الرعد، ۳۱.
[٤] البقرة، ٢٥٣.
[٥] الطوسي، مصباح المتهجد، ص٦٩٦.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 آل عمران في آية الاصطفاء
آل عمران في آية الاصطفاء
الشيخ محمد صنقور
-
 معرفة الإنسان في القرآن (9)
معرفة الإنسان في القرآن (9)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (ستر) في القرآن الكريم
معنى (ستر) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 كريم أهل البيت (ع)
كريم أهل البيت (ع)
الشيخ علي الجشي
-
 الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

كريم أهل البيت (ع)
-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
-

آل عمران في آية الاصطفاء
-

الإمام الحسن المجتبى (ع) بين محنتين
-
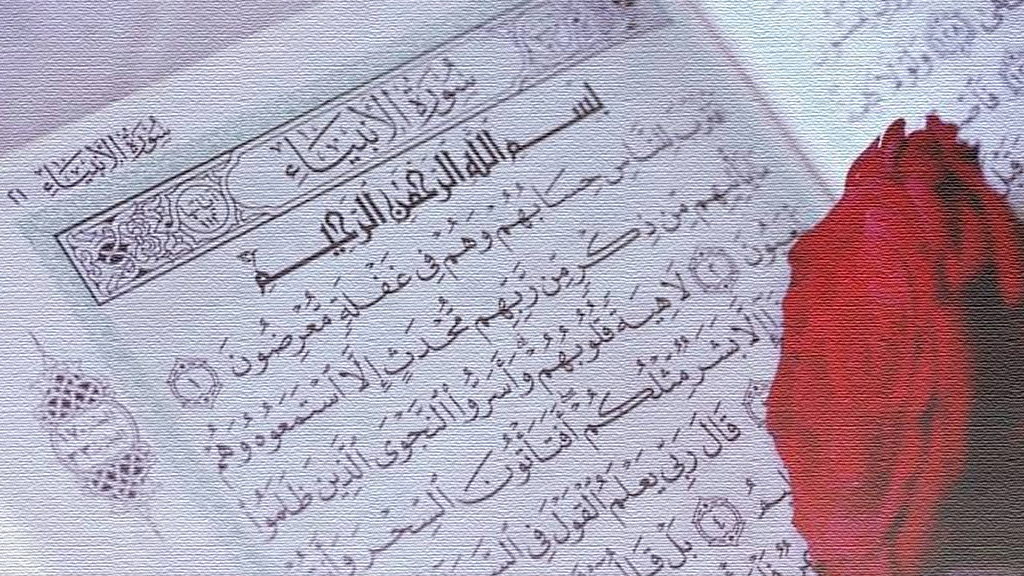
معرفة الإنسان في القرآن (9)
-

شرح دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان
-

إفطار جماعيّ في حلّة محيش، روحانيّة وتكافل وتعاون
-

الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
-

حميتك في شهر رمضان
-

(البلاغة ودورها في رفع الدّلالة النّصيّة) محاضرة للدكتور ناصر النّزر









