علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".الحداثة بوصفها جوهرًا ناقصًا (2)
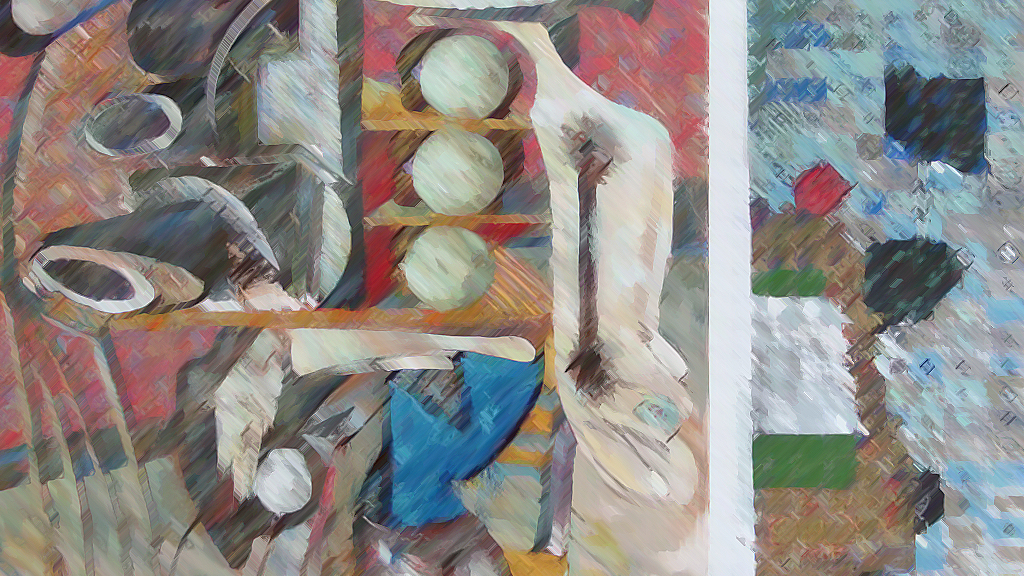
الذهنية الحصرية للحقيقة
المسألة الأكثر استدعاءً للنقاش في هذا الموضع، تتمثّل في التأسيس الميتافيزيقيّ لاستعلاء الفكر الحداثيّ حيال الغير، فقد كان للتنظير الفلسفيّ في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مفعولًا حاسمًا في ترسيخ ثقافة الإقصاء وعدم الاعتراف بما قدّمته الحضارات غير الغربيّة من معارف. وعلى سبيل التبيين، ثمّة من المؤرّخين من يعزو اختفاء أثر فلسفة آسيا وأفريقيا من صرح الفلسفة الغربيّة إلى تضافر عاملين:
العامل الأوّل: الذهنيّة الحصريّة لبعض مدوِّني الفلسفة لـمَّا عمدوا إلى تظهير الفلسفة كخطٍّ ينتهي امتداده عند نقد المثاليّة الكانطيّة للميتافيزيقا.
العامل الثاني: التفكير الاستعلائيّ لدى مفكّري أوروبا وفلاسفتها الذين حصروا الفلسفة بالعرق الأبيض. ومما ينبغي أن يُذكر في هذا المنفسح، ما انبرى إليه إيمانويل كانط حين قارَبَ مسألة الأعراق بتراتبيّةٍ هي أشبه بالطريقة التي قُوربت فيها كائنات الطبيعة، فلقد صنّف كانط المجموعات البشريّة وفق مراتبَ وصفاتٍ يمكن إجمالها كالآتي:
ـ في المرتبة الأولى، يتّصف العرق الأبيض حسب كانط بجميع المواهب والإمكانيّات.
ـ في المرتبة الثانية: يتّصف الهنود بدرجةٍ عاليةٍ من الطمأنينة والقدرة على التفلسف، وهم مفعمون بمشاعر الحبّ والكراهية، ولديهم قابليّةٌ عاليةٌ للتعلم. وأمّا طريقة تفكير الهنديّ والصينيّ، فإنّها تتّسم بحسب كانط بالجمود على الموروث، وتفتقد القدرة على التجديد والتطوير.
ـ في المرتبة الثالثة: يتّصف الزنوج بالحيويّة والقوّة والشغف للحياة والتفاخر، إلّا أّنهم عاجزون عن التعلّم رغم أنّهم يحوزون على قابليّة التدريب والتلقين.
ـ في المرتبة الرابعة والأخيرة: يأتي سكّان أميركا الأصليّون (الهنود الحمر)، وهؤلاء غير قادرين على التعلّم ولا يتّسمون بالشغف، وهم ضعفاء حتى في البيان والكلام.
هذا هو رأي كانط الذي يُعتبر بداهةً من بين أشهر أربعة أو خمسة فلاسفة في تاريخ الغرب الحديث. سوى أنّ الأمر لم يقتصر عليه أو على من وافقوه على مدرسته من بعد، بل ثمّة من يؤيّد هذا الرأي من المعاصرين الذين يجهرون بعدم وجود فلسفةٍ غير غربيّةٍ، وأنّ الموروث الفكريّ لتلك الشعوب إنّما هو محض صدفةٍ تاريخيّة.
لقد شكّلت الذهنيّة الإقصائيّة إحدى أبرز الظواهر التي أنتجها جوهر الغرب الحديث، فلو اتخذنا مسارًا تفكيريًّا مفارقًا للتقليد في النظر إلى الحداثة بأحقابها المختلفة، ربما لَظَهر لنا بيسر ما يمكن أن ننعته بالذهنيّة الإقصائيّة. فلقد شكّلت هذه الذهنيّة علامات فارقة لمجمل أزمنة الحداثة وما بعدها، بل ثمّة من يذهب أبعد من ذلك ليرى أنّ ذهنيّة الإقصاء لم تكن حالة عارضة، وإنّما تجد مرجعيّتها في القاع العميق لفلسفة التنوير. ولو كان من استدلالٍ أوّليٍّ على هذا المدّعى لتيسّر لنا ذلك في ما درج عليه عدد من الروّاد المؤسِّسين.
فقد انبرى جمعٌ من فلاسفة وعلماء الطبيعة في القرن الثامن عشر من كارل فون لينيه (kARL VON LINNE) إلى هيغل (HEGEL)، وإلى من تلاهما من فلاسفة ومفكِّري الحداثة الفائضة، ليضعوا تصنيفًا هَرَميًّا للجماعات البشريّة، على مبدأ الأرقى والأدنى وجدليّة السيّد والعبد، الشيء الذي كان له عظيم الأثر في تحويل نظريّة النشوء والارتقاء الداروينيّة -على سبيل المثال- إلى فلسفةٍ سياسيّةٍ عنصريّةٍ في الأزمنة المعاصرة. أمّا أحد أكثر التصنيفات حدّةً للمجتمعات غير الغربيّة، فهي تلك التي تزامنت مع نموّ الإمبرياليّات العابرة للحدود وتمدُّدها نحو الشرق، وتحديدًا باتجاه الجغرافيّات العربيّة والإسلاميّة.
من تمظهرات هذا التمدّد على وجه الخصوص، ملحمة الاستشراق التي سرت كترجمةٍ صارخةٍ لغيريّةٍ إنكاريّة لم تشأ أن ترى إلى كلّ آخرَ حضاريٍّ إلّا بوصفه كائنًا مشوبًا بالنقص؛ لهذا ليس غريبًا أن تتحوّل هذه الغيريّة الإنكاريّة إلى عقدة “نفسٍ حضاريّةٍ” صار شفاؤها أدنى إلى مستحيل. وما جعل الحال على هذه الدرجة من الاستعصاء أنّ العقل الذي أنتج معارف الغرب ومفاهيمه، كان يعمل في أكثر وقته على خطٍّ موازٍ مع السلطة الكولونياليّة، ليعيدا معًا إنتاج أيديولوجيا كونيّة تنفي الآخر وتستعلي عليه.
فلقد تكوَّنت رؤية الغرب للغير على النظر إلى كلّ تنوّعٍ حضاريٍّ باعتباره اختلافًا جوهريًّا مع ذاته الحضاريّة، ولم تكن التجربة الاستعماريّة المديدة في الجغرافيا العربيّة والإسلاميّة سوى حاصل رؤيةٍ فلسفيّةٍ تمجّد ذاتها وتحتقر ذات الغير. من أجل ذلك سنلاحظ كيف أنشأ فلاسفة الحداثة وعلماؤها أساسًا علميًّا معرفيًّا لشرعنة الهيمنة على الغير، بذريعة تمدينه وتحديثه.
من هذا المحلّ بالذات ستساهم غيريّة الحداثة في توطيد الأساس المعرفيّ والثقافيّ لفلسفة الإنكار التي توغّلت عميقًا في الحقلين الأنطولوجيّ والتاريخيّ لثقافة الحداثة، الأمر الذي أفضى إلى تحويل الغرب الحديث إلى حضارةٍ إمبرياليّةٍ شديدة الوطأة على العالم كلّه. فلقد عُدَّتِ الحداثة الغربيّة في المخطط الأساسيّ للتاريخ وفي الأيديولوجيّات الحديثة، وحتى في معظم فلسفاتِ التاريخ بوصفها الحضارة الأخيرة والمطلقة، أي تلك التي يجب أن تعمّ العالم كلّه، وأنْ يدخلَ فيها البشر جميعًا.
في فلسفة القرن التاسع عشر يوجد من الشواهد ما يعرب عن الكثير من الشك بحقّانيّة الحداثة ومشروعيّتها الحضاريّة. لكنّ هذه الشواهد ظلّت غير مرئيّةٍ بسبب من حجبها أو احتجابها في أقلّ تقديرٍ؛ ولذلك فهي لم تترك أثرًا في عجلة التاريخ الأوروبيّ، فلقد بدا من صريح الصورة أنّ التساؤلات النقديّة التي أُنجزت في النصف الأوّل من القرن العشرين، وعلى الرغم من أنّها شكّكت في مطلقيّة الحضارة الغربيّة وديمومتها، إلّا أنّها خلَت على الإجمال من أيّ إشارةٍ إلى الحضارات الأخرى المنافسة للحضارة الغربيّة. حتى إنّ توينبي وشبنغلر حين أعلنا عن اقتراب أجلِ التاريخ الغربيّ وموته، لم يتكلّما عن حضارةٍ أو حضاراتٍ في مواجهة الحداثة الغربيّة، ولم يكن بإمكانهما بحث موضوع الموجود الحضاريّ الآخر. ففي نظرهما لا وجود إلّا لحضارةٍ واحدةٍ حيّةٍ ناشطةٍ هي حضارة الغرب، وأمّا الحضارات الأخرى فهي ميتةٌ وخامدةٌ وساكنةٌ…
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (نعج) في القرآن الكريم
معنى (نعج) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 استواء الصراط استقامته
استواء الصراط استقامته
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
-
 السّعادة والشّقاء ذاتيّان أم اكتسابيّان؟
السّعادة والشّقاء ذاتيّان أم اكتسابيّان؟
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 الثقة بوابة النجاح
الثقة بوابة النجاح
عبدالعزيز آل زايد
-
 ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقا بَعدية (5)
ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقا بَعدية (5)
محمود حيدر
-
 الصبر وحسن البلاء
الصبر وحسن البلاء
الشيخ شفيق جرادي
-
 ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ الضمير في: ﴿عَلَى حُبِّهِ﴾!
﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ الضمير في: ﴿عَلَى حُبِّهِ﴾!
الشيخ محمد صنقور
-
 أعظم امتحانات الحياة
أعظم امتحانات الحياة
السيد عباس نور الدين
-
 بين الإنسان والملائكة
بين الإنسان والملائكة
السيد محمد حسين الطبطبائي
-
 لماذا لا يستطيع مرضى الزهايمر التعرف إلى أفراد أسرهم وأصدقائهم؟
لماذا لا يستطيع مرضى الزهايمر التعرف إلى أفراد أسرهم وأصدقائهم؟
عدنان الحاجي
الشعراء
-
 السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات
السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات
حسين حسن آل جامع
-
 اطمئنان
اطمئنان
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-
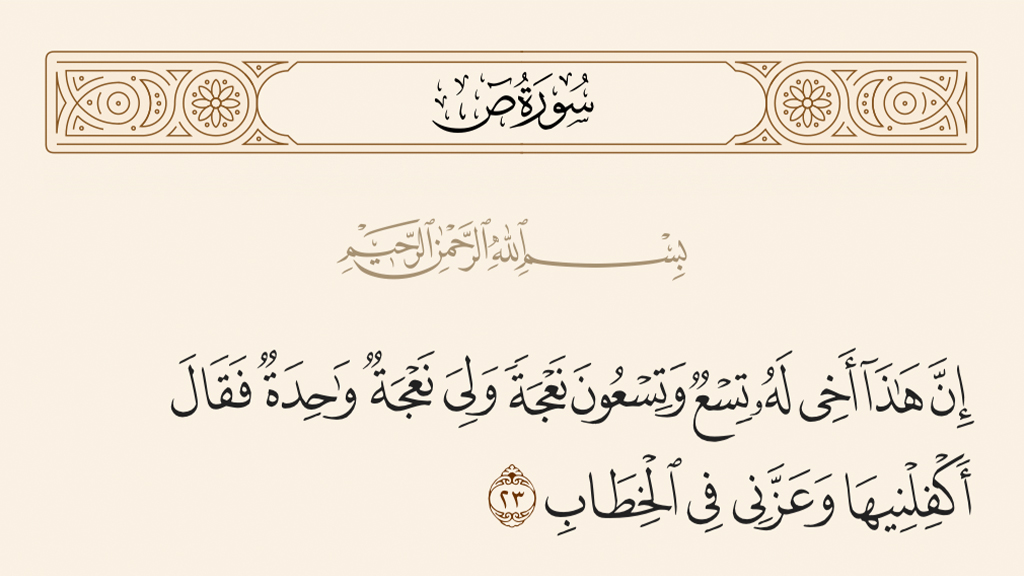
معنى (نعج) في القرآن الكريم
-

استواء الصراط استقامته
-

(متاهة وانعكاس) رواية جديدة للكاتب عماد آل عبيدان
-

(تحديات الأسرة وأدوارها في عصر الذّكاء الاصطناعيّ) محاضرة للدّكتور الخاطر في البيت السعيد
-

السّعادة والشّقاء ذاتيّان أم اكتسابيّان؟
-

علاج جديد قد يشفي من مرض السكري من النوع الأول الحاد
-

الثقة بوابة النجاح
-

محاضرة بعنوان: (العودة للقراءة) للأستاذ يوسف الحسن
-

ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقا بَعدية (5)
-
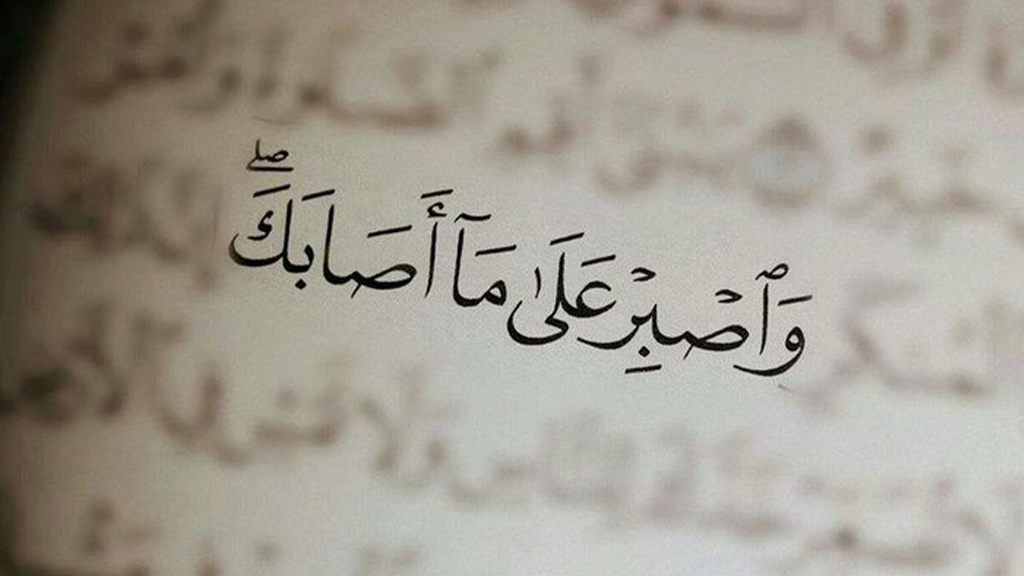
الصبر وحسن البلاء









