علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
إيمان شمس الدينعن الكاتب :
باحثة في الفكر الديني والسياسي وكاتبة في جريدة القبس الكويتيةالتسارع والتباطؤ وإنتاج المعارف (1)
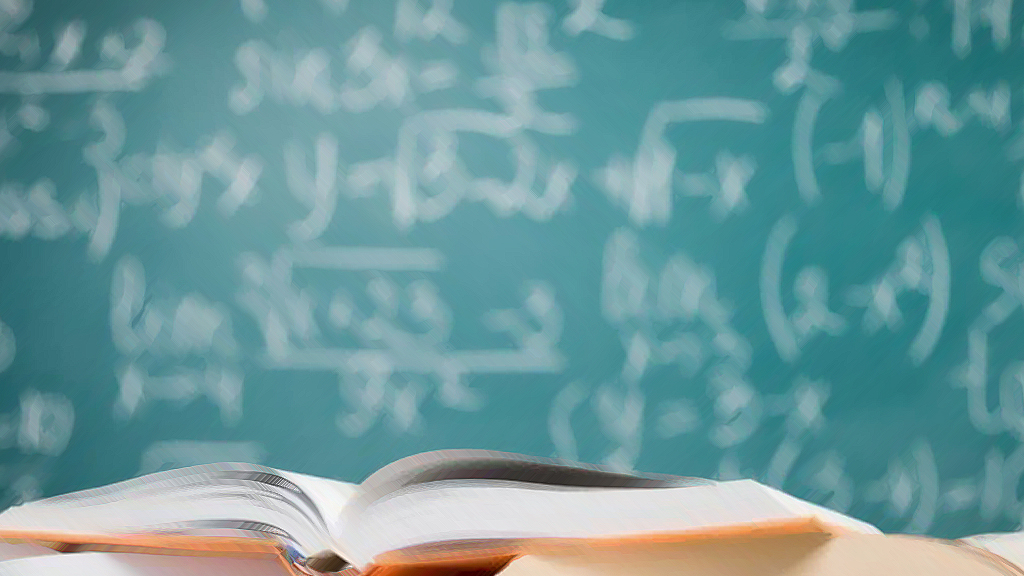
(نحن مستعدون لتخفيف السرعة لاستعادة السيطرة على مسار الأحداث). الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني هارتموت روزا.
تشخيص المقدار في كل حركة يعتمد على دقة الشخص ووعيه، وتشخيصه لأهمية كل حركة ودلالاتها ومآلاتها وتداعياتها، قد يقول البعض أن هذه الدقة والتعاطي الشمولي أمر صعب، وفيه تضييق وتشديد على الإنسان.
فالتباطؤ الذي يطرحه هارتموت روزا ناظر إلى الحركة الديناميكية في النمو وخاصة الاقتصادي منه في الغرب، والتي تعتمد على تسارع الإنسان ضمن نطاق زمني ضيّق ليحقق أكبر حجم من النمو الاقتصادي، وهو ما أفقده لحظة الوعي للذات، وأدخله في دوامة الوقت والعمل والتشييء، قد تصل حالة التسارع إلى اغتراب الإنسان عن ذاته وعن وعي محيطه بشكل واقعي.
لكن سأستغل مفهوم التسارع والتباطؤ في بعده الابستمولوجي (المعرفي)، والذي يعتبر استغلالًا منهجيًّا يشكل قبلية معرفية من الناحية المنهجية في فهم حركة التسارع والتباطؤ في النمو وفي أبعاد أخرى.
وأعني هنا بالذات النخب والمفكرين المعنيين بصناعة المعرفة وإنتاجها، وما يترتب على هذه الصناعة والإنتاج من تداعيات على مستوى السلوك الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. فالمصنع الجيد ينتج بضاعة جيدة وذات جودة عالية، يصبح لها سمعة اقتصادية وسوقية تزيد من نسبة استهلاكها وربح المصنع، والمصنع السيئ ينتج سلع سيئة ذات جودة رديئة، وبالتالي يكون صدى استهلاكها ضعيفًا، أو يكون مستهلكها من بيئات فقيرة، لا يهمه جودة المنتج بقدر ما يهمه سعرها الزهيد، لذلك يكون عرضة للاستغلال والغش بل قد يعرض صحته وحياته للخطر، لعدم جودة السلعة وضمان نسبة أمان صحي عالية من حيث الجودة الصحية وأهليتها للاستهلاك البشري، خاصة في الدول التي لا يوجد عليها رقابة قوية على جودة المنتجات وأهليتها للاستخدام البشري.
وكذلك المعارف، لكن تختلف المعرفة في كونها تشكل بنية الإنسان الفكرية، وهي التي تدعم وعيه وتبني أسسه، وهي التي توجه سلوكه ليدرك ويميز بين السلع الجيدة والرديئة.
المعرفة:
تعتبر المعرفة السلاح الأول في الصفوف الأمامية التي على كل إنسان التسلح بها، لأن الإدراك ووعي الإدراك بالمحيط والذات والوظيفة يحدد سلوك الإنسان في محيطه وعلاقاته، بل يؤسس لمنظومة الحقوق والواجبات، ومنظومة القيم والمعايير والقوانين التي تنظم حياة الفرد والمجتمع في محيطه.
وكما هو معروف أن للمعارف مصادر تستقى منها، هذه المصادر كفيلة بفهم طبيعة هذه المعرفة وقيمتها ومدى مطابقتها للواقع الخارجي، أي صدقها. وتكمن أهمية التركيز على المصادر والتحقق منها وتشخيص قيمتها في أنها القاعدة التي تشكل بنية فكر الإنسان وتحدد مسارات سلوكه وبناه المعرفية، وهذا يدفعنا لسؤال المعرفية وكيفيتها ومنهجها.
التباطؤ والتسارع المعرفي:
إن لكل شيء وزنًا وقيمة وصدى في هذا الكون، خاصة أن الإنسان حسي الطبع، وأغلب معارفه تتحقق بواسطة الحواس، فيكون اللفظ والمعنى والدلالة وما ينشأ عنه من تصورات في الذهن ويخلق دافعية في النفس للعمل، يكون ذا أهمية كبيرة يحتاج إلى إفراد جهد خاص في بنيته ودلالاته، وما ينشأ بالتالي عن نظمه في خطاب من دلالات معنوية وتصورات ذهنية وأفعال واقعية خارجية مترتبة عليه.
فلكل لفظ دلالة ومعنى وبالتالي صورة وفعل، لذلك كان الكلام من أخطر وسائل التواصل وأهمها، تكمن خطورته في صياغته كألفاظ لها دلالات ومعانٍ في جمل، وأهميته فيما ينتج عن هذه الصياغة من تصورات ذهنية تشكل منظومة السلوك والفعل الإنساني في المجتمع.
وماذا يعني ذلك؟
يحتاج الإنسان للبحث ليجيب على مجموعة تساؤلات قد تكون نتاج حراكه في محيطه ونتاج ملابسات واقعه، وهنا يسير الإنسان في عدة مسارات ليجيب على الأسئلة لتتشكل لديه وفق هذه الإجابات معطيات وتصديقات تتحول إلى معارف وأفكار ومعتقدات تحدد سلوكه ومنهجه وما يعتقده، ويحدد مساره في المحيط.
فهو في مسيرته البحثية يذهب من المجهول إلى المعلوم ومن المعلوم إلى المعلوم ومن ثم من المعلوم إلى المجهول ليجيب عن تساؤله.
فالواقع الخارجي يطرح عليه تساؤلات عديدة يجهل إجابتها، بل قد تكون تجاربه المعرفية الخاصة تطرح عليه تساؤلات تتطلب بحثًا للإجابة عنها، هذه الإجابة يسافر خلالها الباحث ويكون سفر الباحثين على عدة أوجه:
يبحث خلال ذاكرته المعرفية المخزونة والمتراكمة عبر خبراته وأبحاثه السابقة، ومعارفه المتنوعة المكتسبة والموروثة، ويحاول خلالها الإجابة عن السؤال، وقد يخضع خلال هذه الرحلة لتحيزاته المعرفية أو لمعتقداته الخاصة، أو لبيئته ومحيطه ومعاداته وتقاليده.
يحاول الباحث الخروج من بيئته الخاصة المعرفية والتوسع في الإجابة خارج نطاق منظومته المعرفية والفكرية الخاصة بعقيدته وبيئته وعاداته وتقاليده، ولكنّ خروجه لا يعني عدم الاستعانة بها، بل هو خروج يراكم هذه الحصيلة، مع حصيلته الجديدة التي يتحصل عليها من البحث في إجابته عن التساؤلات، وأيضًا هنا لا نضمن عدم وقوعنا في التحيزات المعرفية، وتطويع الجديد لحساب القديم.
باحث يحاول الإجابة على تساؤلاته منطلقًا من قيمة صفر معرفيًّا، لأن لكل زمن تساؤلاته وإشكالياته في زمن التسارع المعرفي، القيمة الصفرية هذه لا تعني أبدًا لفظه للثوابت المعرفية، ولا نكرانه لما تحصل عليه من معارف بالدليل القطعي، بل تعني محاولة البحث بأقل قدر من التحيز للوصول إلى أقرب جواب للواقع، والجواب بطريقة القيمة الصفرية أو ما هو أقرب للقيمة الصفرية، قد يعزز قناعات سابقة ومعطيات معرفية لديه، لأنه استند لمناهج جديدة معرفية ومتسلحًا بالخروج من معارفه ومحاولًا ترصد الإجابة وفق معطيات واقعية، وقارئًا الآراء المتنوعة حول التساؤل محل البحث. فتعدد الآراء وتنوعها هو مصداق لجمع العقول إلى عقله الموصى به بالنص الصادر عن المعصوم (عليه السلام).
وهنا لا أنكر أن هناك من الباحثين من يبدأ مساره في الشكل الأول من البحث، لكن يتطور معرفيًّا ومنهجيًّا وتتراكم معارفه وآفاقه المعرفية ليصل إلى الشكل الثالث من الباحثين، ومنهم من يختصر طريقه في البحث ليكون من الشكل الثالث، وهكذا، ولا ننكر أن التجارب كمصدر من مصادر المعرفة تركام المعارف وتثريها، وقد تكون في مرحلة من مراحل الباحث عائقًا معرفيًّا يشكل له تحيزًا بذاته، وجدار صدّ، لذلك يجب أن تكون التجربة ملهمة من جهة، وكاشفة للجهل من جهة أخرى، ولكنها يجب أن لا تشكل قطعًا بذاتها إلا إذا رفدت بمصادر معرفية أخرى قطعية الدليل، فكثير من الباحثين من يجعل من تجربته المعرفية الخاصة، قطعًا ويقينًا معرفيًّا، يقطع به طريقه البحثي والمنهجي نحو الحقيقة، وهو ما يترتب عليه تبعات معرفية وبالتالي منهجية وسلوكية من قبل من سيخلفه ويأتي بعده وبالتالي من قبل من سيتبنى رأيه ويحوله لمنهج عملي تطبيقي على مستوى الفرد أو المجتمع أو حتى الدولة والعالم كما سنرى لاحقًا.
ويأتي كلامنا هنا في هذه الرحلة التي يسلكها الإنسان في مسيرته البحثية للإجابة عما يجهله، وهل كل الناس تسلك هذا المسار؟ أما هنا من يذهب من المجهول مباشرة دون المرحلة الوسيطة ليجيب عن تساؤله بشكل متسارع؟ وهل الذي يجيب عن تساؤلاته ضمن هذا المسار البحثي عن الإجابات يمتلك الأدوات المنهجية السليمة؟ وهل يخلو بحثه من التحيزات المعرفية؟ وحينما يجيب عن التساؤل هل يجيب عنه كمسلّمة يقينية خاضعة لاعتبارات الإجماع والمشهور بحيث تتحول إلى دائرة معرفية مغلقة أمام النقد والتقييم وإعادة النظر؟
وهل النقد والتقييم لا يخضع للتحيزات المعرفية ولاعتبارات ذاتية؟
فعلى سبيل المثال لا الحصر، خاض الغرب معركة طويلة من العصور الوسطى مع الكنيسة، وكان لفهم الكنيسة ومعارفها دور بارز في تشكيل البنية المعرفية للمجتمعات الغربية على مدار قرون، وترتب على هذه البنية صناعة أحداث ورؤى سلبت الكثيرين حيواتهم لمجرد الخروج عن مألوف ومشهور الكنيسة وفهمها للكتاب المقدس، حتى في مجال العلوم والطب والمنطق والفلسفة، كانت الكنيسة هي الناطق الرسمي لها، فالأرض محور الكواكب فهي ثابته ويدور حولها الشمس والقمر، وحينما اكتشف القس برونو أمرًا خلاف ذلك تم سجنه وتعذيبه ومن ثم حرقه بحجة الكفر، وهنا لي وقفة في التسارع والتباطؤ المعرفي، فمن جهة كان تسارع الكنيسة المعرفي في تبني قطعيات ويقينيات مغلقة غير قابلة للنقد والتبديل حتى مع وجود أدلة، سببًا في مسار تسافلي معرفيًّا واجتماعيًّا، بل وحتى على مستوى الحريات وكرامات الناس وحيواتهم، هذا التسارع الذي رسم مسارًا للأحداث أدى في نهاية المطاف لانقلاب كبير على الكنيسة وتدريجيًّا على الدين المسيحي برمته، بل على الدين ككل، ومن جهة أخرى هل يعتبر تسارع برونو في الإفصاح عن رأيه دون امتلاكه دليلًا على هذه الآراء ومع ثبوت حقيقة ما تبناه لاحقًا، هل يعتبر هذا التسارع محمودًا؟ نحتاج هنا أن نتأمل قليلًا قبل إطلاق الأحكام.
فالكنيسة في تسارعها المعرفي دمرت كل السبل بين الناس والدين غالبًا، وبرونو في تسارعه المعرفي فتح كوة في جدار الصمت لمن خلفه للتفكير خارج الصندوق، ولكن ومع ذلك هل إطلاق العنان لأفكاره وتأملاته دون إحرازه دليلًا عليها، سواء كان دليلًا تجريبيًّا أو عقليًّا منطقيًّ، هل يعتبر تسارعًا في غير محله، وكان يمكن أن يمارس التباطؤ المعرفي حىي تكون حجته أتم، وبدل مرور سنوات طويلة عليها بعد موته لاكتشاف صحة ما طرحه، كان يمكن أن تختصر هذه السنوات من خلال تعميق تأملاته وتفكيره وإحراز أدلة تجعل للحقيقة مكانًا في عقول وقلوب المحيطين؟
هنا لا يمكننا الجزم في موضوع برونو، ولكن في موضوع الكنيسة كان التسارع المعرفي سببًا في تدمير علاقة الناس مع الدين، وفي تأخر كثير من العلوم أزمنة طويلة فوتت على البشرية فرصًا للازدهار والنمو، وتأخرت عجلة التطور والنهضة قرونًا نتيجة التسارع المعرفي الذي حدد مسار الأحداث قبل التأمل في التداعيات والمآلات. الفرق بين تسارع برونو وتسارع الكنيسة، هو في نوعية المعارف، فبرونو امتلك حقيقة ثبتت بعد قتله بسنوات لكنها حقيقة لم يمتلك عليها دليلًا فهو سلك منهجًا معرفيًّا خارج صندوق معتقداته وعاداته وتقاليد الكنيسة، وخارج المسلمات الاجتماعية والمعرفية العامة، لكنه في ذات الوقت تسرع في إعلان ما لديه قبل إتمام الدليل عليه، وقبل إخضاعه لمزيد من التعميق، ورغم ثبوت صحته بعد مدة زمنية طويلة، إلا أن إثبات هذه الصحة جاء من خلال التدليل عليه بأدلة أخضعت هذه المعرفة للتجربة، وأرفدتها بأدلة كشفت الزيف بشكل قطعي، فلمجرد مخالفتها للإنجيل ”الكتاب المقدس”، ومجرد أن يعبر الإنسان عن فكرة خارج الإطار المألوف، فهو حق له في التفكير الحر دون أن يعتبرها مسلّمة مغلقة خارجة عن النقد. وقس على ذلك كثيرًا من العلوم والمعارف التي تسارع أصحابها في تحويلها لقناعات ويقينيات مغلقة أخرت مسار البشرية أو حرفت مسارها، وتسبب ذلك في تقويض العدالة وهدر كرامة الإنسان.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 شتّان بين المؤمن والكافر
شتّان بين المؤمن والكافر
الشيخ جعفر السبحاني
-
 معنى (عول) في القرآن الكريم
معنى (عول) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 فاطمة الزهراء (ع) تجلٍّ للرحمة الإلهيّة المحمّديّة
فاطمة الزهراء (ع) تجلٍّ للرحمة الإلهيّة المحمّديّة
الشيخ شفيق جرادي
-
 المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (2)
المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (2)
إيمان شمس الدين
-
 (التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها
(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها
عدنان الحاجي
-
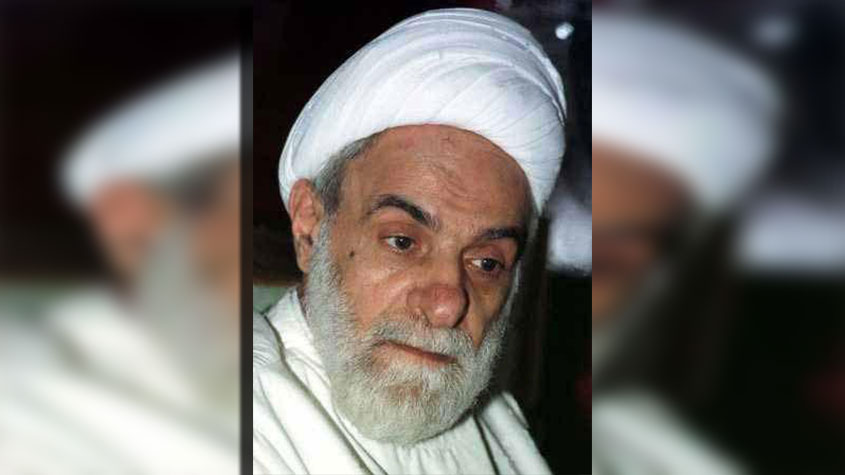 الموعظة بالتاريخ
الموعظة بالتاريخ
الشيخ محمد مهدي شمس الدين
-
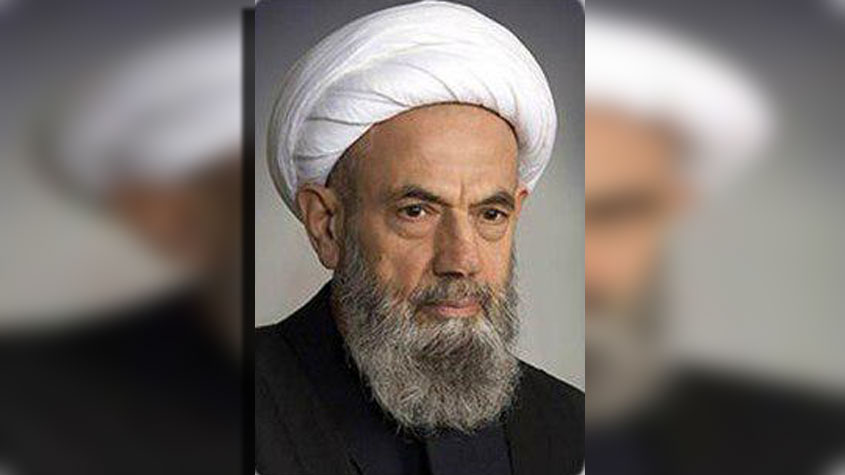 كلام عن إصابة العين (1)
كلام عن إصابة العين (1)
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)
الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)
الدكتور محمد حسين علي الصغير
-
 صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)
صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)
محمود حيدر
-
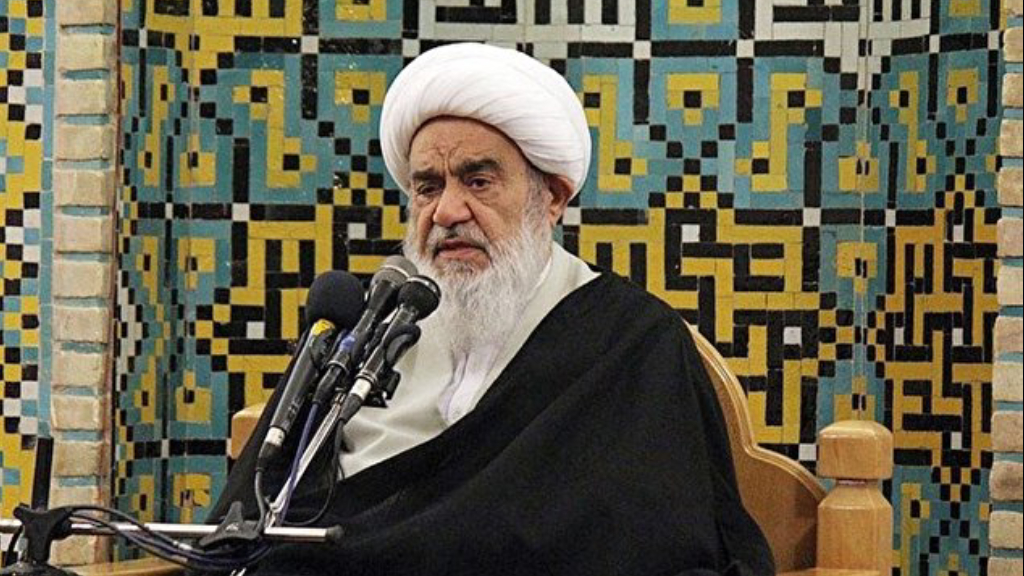 مجلس أخلاق
مجلس أخلاق
الشيخ حسين مظاهري
الشعراء
-
 السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى
السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى
حسين حسن آل جامع
-
 الصّاعدون كثيرًا
الصّاعدون كثيرًا
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-

لـمّا استراح النّدى
-

شتّان بين المؤمن والكافر
-
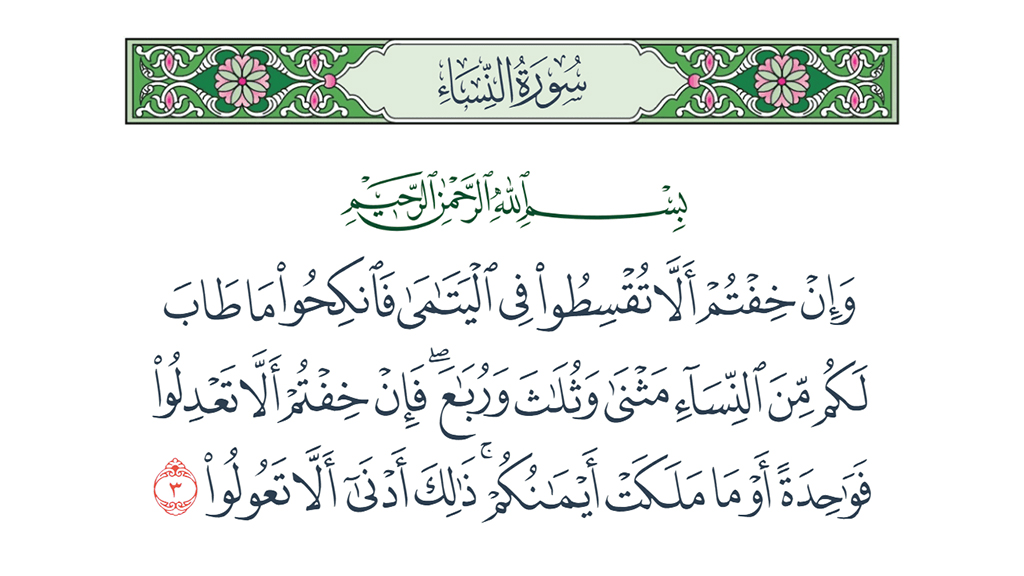
معنى (عول) في القرآن الكريم
-
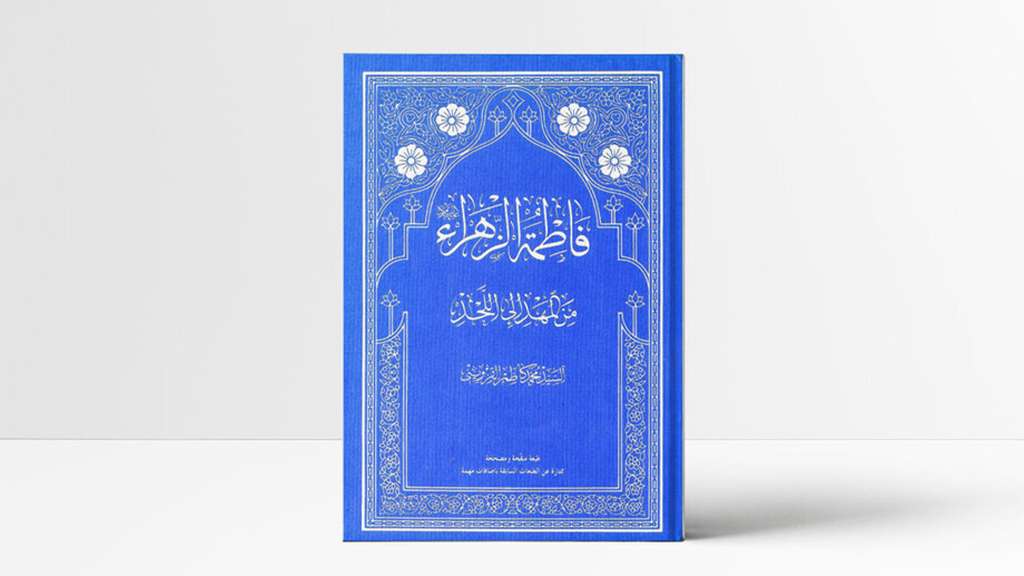
فاطمة الزهراء عليها السلام من المهد إلى اللّحد
-

السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى
-

فاطمة الزهراء (ع) تجلٍّ للرحمة الإلهيّة المحمّديّة
-

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (2)
-

من كنوز الغيب
-

(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها
-
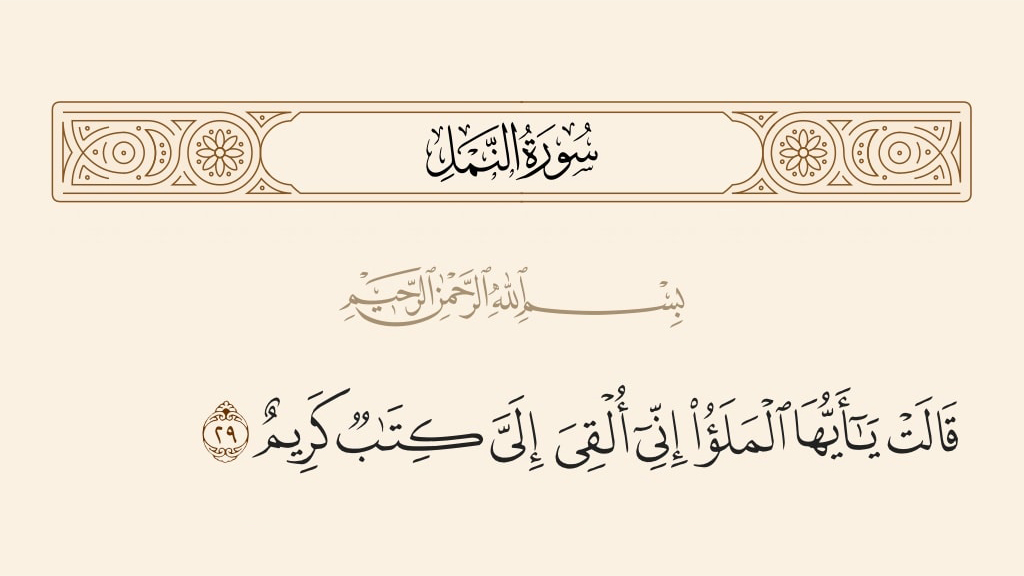
معنى (ملأ) في القرآن الكريم









