علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
إيمان شمس الدينعن الكاتب :
باحثة في الفكر الديني والسياسي وكاتبة في جريدة القبس الكويتيةالتسارع والتباطؤ وإنتاج المعارف (2)
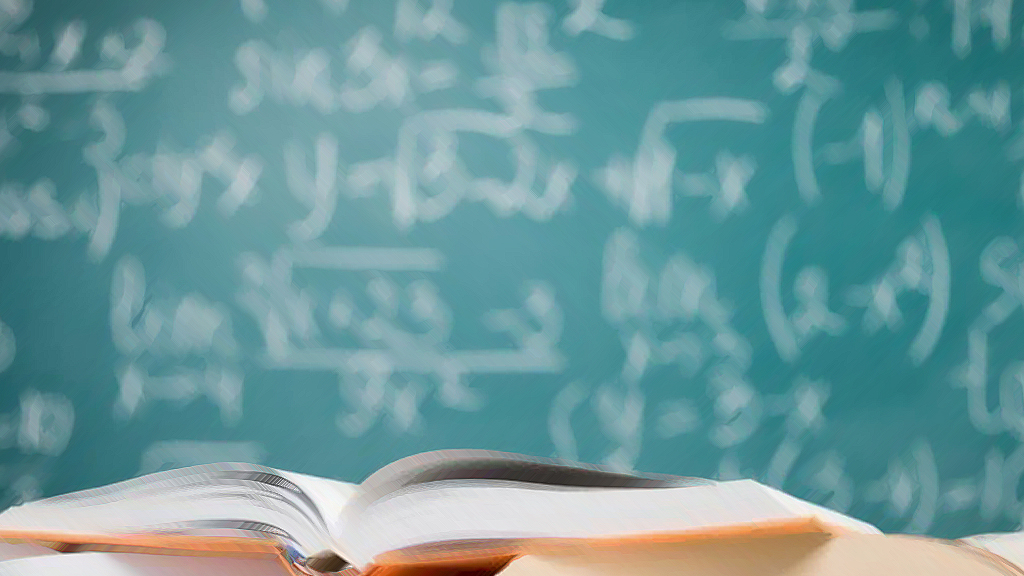
فمسيرة الغرب المعرفية والتي كانت كردّ فعل على العصر الكنسي في القرون الوسطى، وتحولاتها في عصر التنوير، وما طرح من قبل كثير من الفلاسفة أثّر لاحقًا على بنية الدول المعرفية وعلاقتها مع الدين والطبيعة والإنسان، أي في الرؤية الكونية، وفي تشخيص مصادر المعرفة التي تدريجيًّا أخّرت الدين والغيب والعقل من هذه المصادر، وصلت بالغرب اليوم إلى التشيئ، تشييئ كل شيئ حتى الإنسان، وأخضعت نظمها الأخلاقية للنسبية والنفعية، والتي تجلت في أمّة كورونا بشكل واضح، حينما تركت كبار السن ليواجهوا الموت دون أدنى مساعدة.
وهنا لا أعني أن كل نتاج الغرب نتاج سلبي، ولكنّ البنية الفلسفية قامت على أسس مادية جاءت نتيجة التسارع المعرفي الذي تولّد كردّ فعل على كل ما هو ديني، وأقصت نتيجة ممارسات الكنيسة السلبية غالبًا، الدين كمصدر معرفي هامّ يمكن الاستفادة منه، ومن ثم تسارعت بشكل يتمثل فيه طغيان الإنسان وإعجابه بنفسه وإنجازاته حتى في نتائجها البحثية المعرفية والفلسفية حول الوجود والكون والله، هذا التسارع الشديد حتى في نمط الحياة، أفقدهم نقطة ارتكازية في المعارف، وهي وعي الذات، ومحاولة الخروج من هذه التجربة بالاستفادة الإيجابية منها دون تحيز، ووعي الذات نقطة ارتكازية في الانطلاق لوعي المحيط، وفقدان هذا الوعي على ضوء التجربة المحيطة، ومحاولة فهم أسباب التجربة وتداعياتها وتمحيص نقاط ضعفها وقوتها، قد يفقد الباحث اتزانه المعرفي ويوقعه في التحيزات العميقة معرفيًا.
والتسارع أيضا يتمثل في من تأثر بالتجربة الغربية وانبهر بها، ولم يمارس التباطؤ المعرفي قبل أن يتبنى منتوجها المعرفي، منطلقًا من عقدة نفسية تمثّلت في استبداد أنظمته السياسية، وتراجع المؤسسات الدينية غالبًا في أداء دورها كما يجب، وفي تشابك الفقر مع الجهل مع الاستعمار، مما دفعه دفعًا تحت ضغط الكولونيالية المعرفيّة إلى التسارع المعرفي نحو الغرب، والمعارف لا يمكن أن تتحصل بالانبهار ولا بردود الفعل، ولا بالضغوط الخارجية، لأنّ أصل المعرفة الحقيقية يكمن في التباطؤ والتأمل والتفكر والتعقل الطويل، ورصد الأدلة من مصادر المعرفة كافة، دون إقصاء مصدر حتى لو كان باعتقادي مصدرًا ضعيفًا.
ويعتبر يورغن هابرماس على سبيل المثال من العلمانيين الذين نادوا بشكل عنيف لتحييد الدين عن الدولة في القرن الماضي، إلا أنه مؤخرًا بعد نقد وتقييم الحداثة، أي ما بعد الحداثة، وجد أن الكنيسة والمتدينين يمكنهم أن يقدموا رؤى تساعد في تقنين قوانين تخدم الإنسان والمجتمع، وكونهم مكونًا مهمًّا من مكونات المجتمع فلهم الحق في هذه المشاركة، وقد طرح “هابرماس” تساؤلًا مهما حول ذلك قائلا: هل السلطة السياسية ممكنة بعد استكمال القانون الوضعي، هذه السلطة التي لا تستند مشروعيتها لا من الدين ولا من أية ما بعد ميتافيزيقيا؟ ويكمل قائلا: حتى وإن أقرّ المرء بهذه المشروعية، فإن الشك يبقى على المستوى الانفعالي ويكمن هذا الشك في التساؤل ما إذا كان في الإمكان تعزيز أسس الحياة المجتمعية المتعددة عن طريق خضوعها إلى خلفية معيارية متفق عليها شكليًّا في أحسن الأحوال، يعين خضوعها إلى نمط عيش معين. ويمكن القول حتى وإن تفهم اللائكية[1] الثقافية والمجتمعية كصيرورة تعلم مزدوجة، يكون في حاجة لها أتباع تقاليد الأنوار والتعاليم الدينية على حد سواء للتفكير في حدود تخصصهما[2].
هذه المراجعة المهمة التي قام بها “يورغن هابرماس”، حول دور الدين والمتدينين في الحياة السياسية، وفي التضامن الاجتماعي وسن الدولة لقوانين خادمة لكل مكوّنات الدولة، هي مراجعة منهجية لتجربة طويلة في ظل دولة علمانيّة شاملة، وصل فيها إلى قناعة مهمة مؤخرًا أقرّ فيها عن ضرورة الاستفادة من الدين والمتدينين في الدولة. فبعد التسارع في اتخاذ مسارع معرفي محدد في رؤيته الكونية التي أقصت الدين كمصدر معرفي هام للتقنين، عاد التباطؤ مجددًا يطل برأسه بعد مراجعات وتجربة ميدانية طويلة كشفت عن قصور وخلل في ذلك التسارع المعرفي، أدت لتراجع وإن بشكل بسيط، لتضم مجددًا الدين كفكرة يمكن الاتكاء عليها في التقنين وخدمة المجتمع، ولكن هذا التسارع كم دفعت البشرية المتعاقبة ثمنًا له من ذاتها ووجودها وحيواتها، خاصة من شخصية تعتبر من المدرسة الفرانكفونية التي تؤثر في قرارات الدولة وترسم لها فلسفتها؟
وهذا لا يعني أيضًا عدم وجود تسارع في المؤسسات الدينية وفي المدارس الدينية والإسلامية والعربية الشرقية، فهذه سمة إنسانية لا تخص إنسانًا دون غيره، وكثيرة هي الشواهد على التسارع المعرفي وأهمها رفض كثير من الإسلاميين والعلماء لكل منتج الغرب المعرفي رفضًا مطلقًا حتى قبل الاطلاع عليه وفحصه والتنقيب في عمقه، بل تسارع الكثيرون في رفض نظيرة داروين دون حتى محاولة دراسة للعلوم ونشأتها وتطور هذه النظرية وملابساتها ونقاط ضعفها وقوتها، وكان لهذا أثر كبير في تراجع جيل من الشباب عن الدين، وفي ترك الكثيرين إيمانهم بالله، بسبب سلوك الكثيرين المعرفيّ السلبي اتجاه العلم واتجاه الغرب، بغض النظر عن ملابسات وأسباب هذا الرفض، لأننا بالأصل نتحدث عن المعارف التي يجب أن لا تكون خاضعة لردود الأفعال ولا للتجارب السلبية أو المحيط البيئي الخاص والعام.
وأيضًا التسارع يتمثل في التكفير وفتاوى التضليل التي يطلقها كثير من علماء الدين على من يخالف المشهور والمألوف، حتى لو كانت مخالفاته المعرفية تمتلك الدليل والبرهان، وعلى من يختلف معهم في المنهج والنتيجة، بل هناك حرب معرفية بين العلماء والمثقفين يتراشق أغلبهم فيما بينهم تراشقًا إقصائيًّا، فكثير من العلماء يسفّهون المثقف ومنتجه المعرفي، وكثير من الثقفين يستهزؤون بالدين والعلماء ويقصون معارفهم كمصدر، وهذا التّسارع تذهب ضحيته الحقيقة والناس الذين يجب أن يشكّل كل باحث لهم منطقة الأمان وطوق النجاة من الجهل، لا أن يكون بتسارعه المعرفي سببًا لمزيد من الجهل والتضليل والانتكاس القيمي، والتراجع في مستوى العدالة والكرامة الإنسانية.
فنحن أمام مسارات عديدة تتطلب تشخيصًا دقيقًا وتأملًا وتفكرًا وتدبرًا في تحديد متى يتم التسارع المعرفي، ومتى يكون التباطؤ. ويخضع كل من التسارع والتباطؤ لعدة عوامل بعضها ذاتي وبعضها خارجي في مسار عملية التفكير والكسب المعرفي.
ومن أهم وأبرز العوامل التي تؤثر في مسار المعارف هو التحيزات المعرفية، والتي تؤثر في كل من التسارع والتباطؤ، ولكن تأثيرها يكون بدرجات متفاوتة، وباتجاهات قد تكون أحيانًا متعاكسة.
إن المشكلة التي يعاني منها الإنسان اليوم هي التسارع، خاصة التسارع المعرفي، والذي يؤثر في صناعة الحدث ومساره، حيث فقد الإنسان قدرته على ضبط توقيت هذا التسارع، وفهم متى يمكنه أن يتسارع في نشاطه، ومتى يحتاج إلى التباطؤ، نحن نحتاج للتسارع في النهضة والتنمية، لكن يسبقها تباطؤ في المعرفة وفهم الذات والمحيط، لأن الفهم والإدراك والمعارف هي التي تحدد شكل التنمية والنهضة وآلياتها والأهداف المرجوة منها، أي تحدد مسار الأحداث ومآلاتها، لذلك التباطؤ في المعرفة وفهم قريب للواقع يحقق لنا فهم موقع الإنسان وقيمته في كل حركة ومسار حدث.
التباطؤ المعرفي يحدد لنا من هو الإنسان، وما هي وظيفته، وكيف يمكنه أن يعرف وماذا عليه أن يعرف، وكيف يحقق معارفه في الخارج في دائرة تتحكم بها العدالة والكرامة، إنه باختصار التأمل الفريد والتحكم في المعرفة وإتقانها، فالتأمل والتفكر أدوات معرفية تحقق نوعًا من التباطؤ للتدقيق والتعميق البحثي للوصول إلى نتيجة محكمة في مبانيها، تحدد الأحداث ومسارها وفق معطيات أقرب للواقع منها للخيال والوهم.
هذا التباطؤ يعطي مساحة كبيرة للعقل للتأمل، والخروج من تحيزاته المعرفية سعيًا لفهم الواقع خارج حدود ذاته ومحيطه، ومدركاته القبلية، ومن خبراته المتراكمة نتيجة تجاربه التي أكسبته ألوانَ معرفة دفعته للتعميم وخلقت لديه حواجز نفسية من معارف أخرى، فالتجربة على سبيل المثال من مصادر المعرفة المهمة، وتجربة الإنسان الاجتماعية وفي علاقاته مع المحيط والمعرفة، تعطيه خبرات مهمة، لكنها أيضًا تخلق لديه حواجز نفسية تمنعه من التمرد على تلك التجربة ومحاولة خوضها بطرق أخرى، ودراسة أبعادها، فقد تكون بعض التجارب هي نتاج تسارع معرفي، فتكون مخرجاتها غير متقنة، وتحتاج إلى نوع من التباطؤ حتى يتحصل للإنسان معرفة أقرب للواقع، تمنع خلق حواجز نفسية تمنعه من تشكيل مدركات تؤثر في مساره العلمي والمعرفي ونموه الفكري والعلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] اللائكية أو العلمانية الفرنسية، بالفرنسية laïcité (تنطق [la.isiˈte])، هي مفهوم يُعَبِّرْ عن فصل الدين عن شؤون الحكومة والدولة وكذلك عدم تدخل الحكومة في الشؤون الدينية. تواجدت العلمانية في فترة مُبَكِّرَة من التاريخ الفرنسي المعاصر استناداً إلى القانون الفرنسي لفصل الكنيسة عن الدولة عام 1905م، وامتد تفسير العلمانية الفرنسية ليشمل المساواة في التعامل مع جميع الأديان، وأصبح التفسير أكثر تحديداً في عام 2004م.
فاللائكية – كصياغة عربية – مُشتقة من الفظ الاتيني “laicus” وهو بدوره مأخوذ من اللفظ اليوناني ”laós – λαός” ومعناه “الشعب”. غير أنَّ استعماله اللاتيني قد تخصص في قسم من “الشعب”، وذلك في مقابل “الكاهن” clerc، وهو رجل المعرفة “العالِم” (من اللفظ اليوناني clêros بمعنى الحظ الموروث)، والمقصود رجل الدين (المسيحي) المنتظم في سلك الكهنوت الكنسي.
ويبدو أن ترجمة Laïcité إلى اللائكية في اللغة العربية، هو نوع من التعريب لا الترجمة، إذ أنَّ لللائكية معنى خاص في تجربة مجتمع المجتمع الفرنسي دون غيره.
https://political-encyclopedia.org/dictionary/اللائكية
[2] جدلية العلمنة ـ العقل والدين / يورغن هابرماس وجوزيف راتسنغر”البابا بندكتس xvI” /تعريب وتقديم حميد لشهب / دار جداول/ ص 46
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 شتّان بين المؤمن والكافر
شتّان بين المؤمن والكافر
الشيخ جعفر السبحاني
-
 معنى (عول) في القرآن الكريم
معنى (عول) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 فاطمة الزهراء (ع) تجلٍّ للرحمة الإلهيّة المحمّديّة
فاطمة الزهراء (ع) تجلٍّ للرحمة الإلهيّة المحمّديّة
الشيخ شفيق جرادي
-
 المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (2)
المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (2)
إيمان شمس الدين
-
 (التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها
(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها
عدنان الحاجي
-
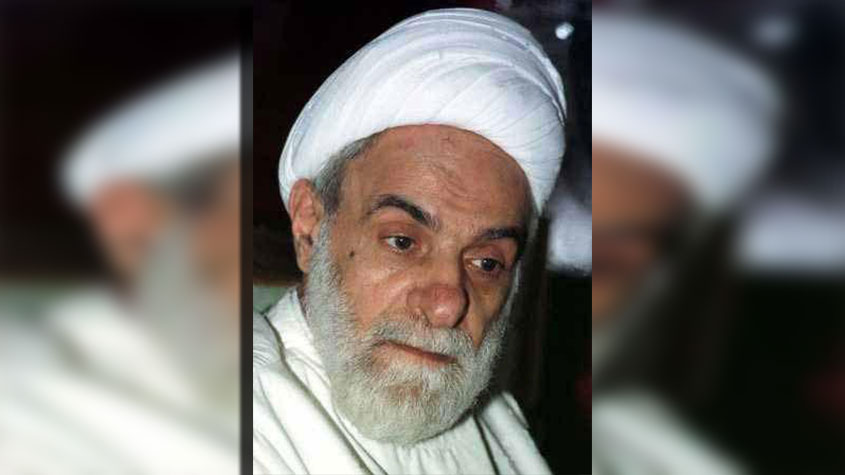 الموعظة بالتاريخ
الموعظة بالتاريخ
الشيخ محمد مهدي شمس الدين
-
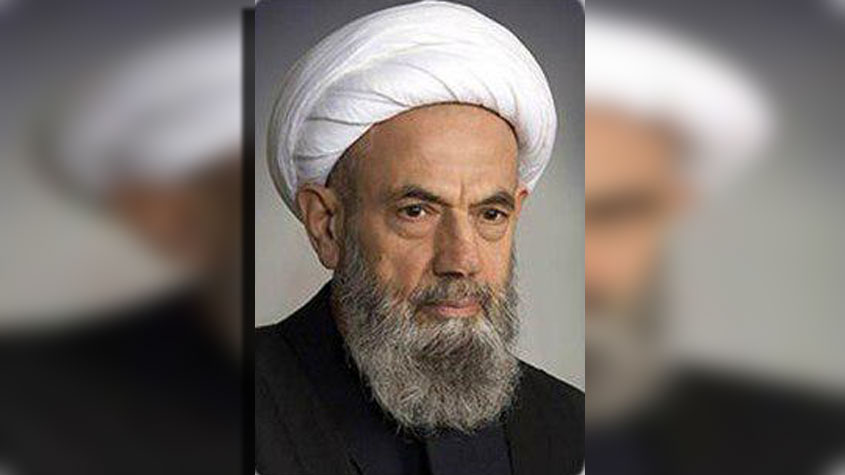 كلام عن إصابة العين (1)
كلام عن إصابة العين (1)
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)
الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)
الدكتور محمد حسين علي الصغير
-
 صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)
صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)
محمود حيدر
-
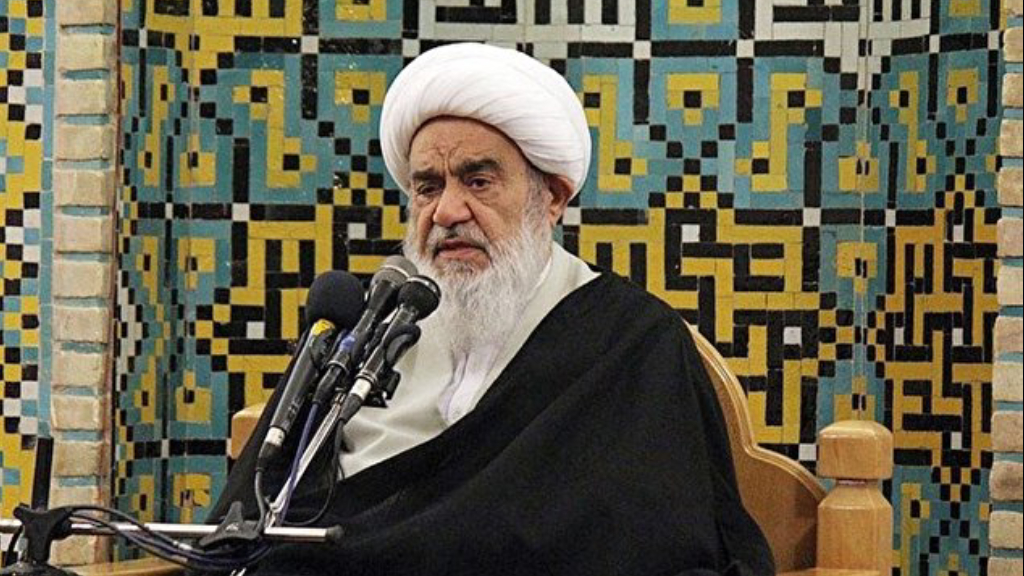 مجلس أخلاق
مجلس أخلاق
الشيخ حسين مظاهري
الشعراء
-
 السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى
السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى
حسين حسن آل جامع
-
 الصّاعدون كثيرًا
الصّاعدون كثيرًا
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-

لـمّا استراح النّدى
-

شتّان بين المؤمن والكافر
-
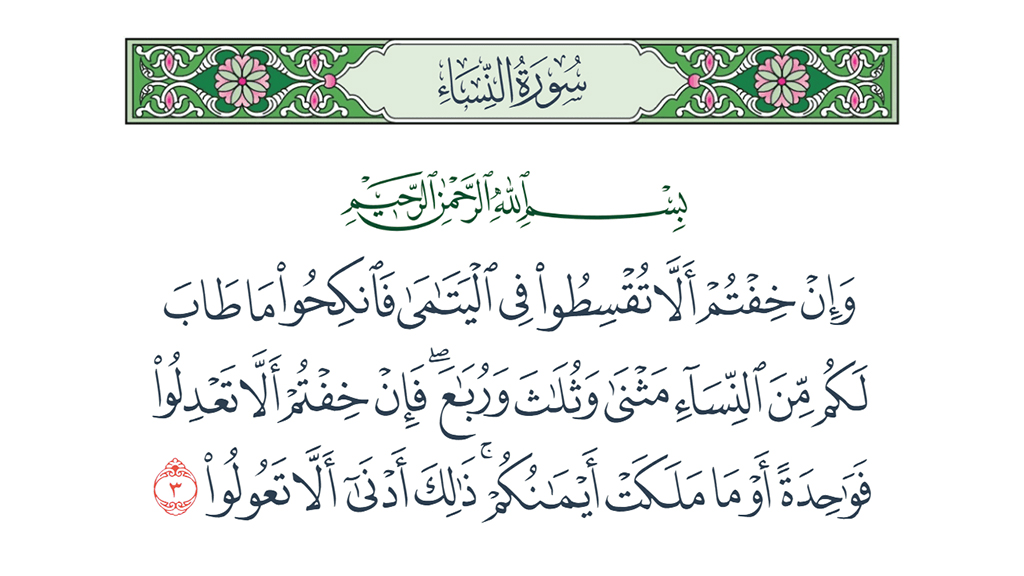
معنى (عول) في القرآن الكريم
-
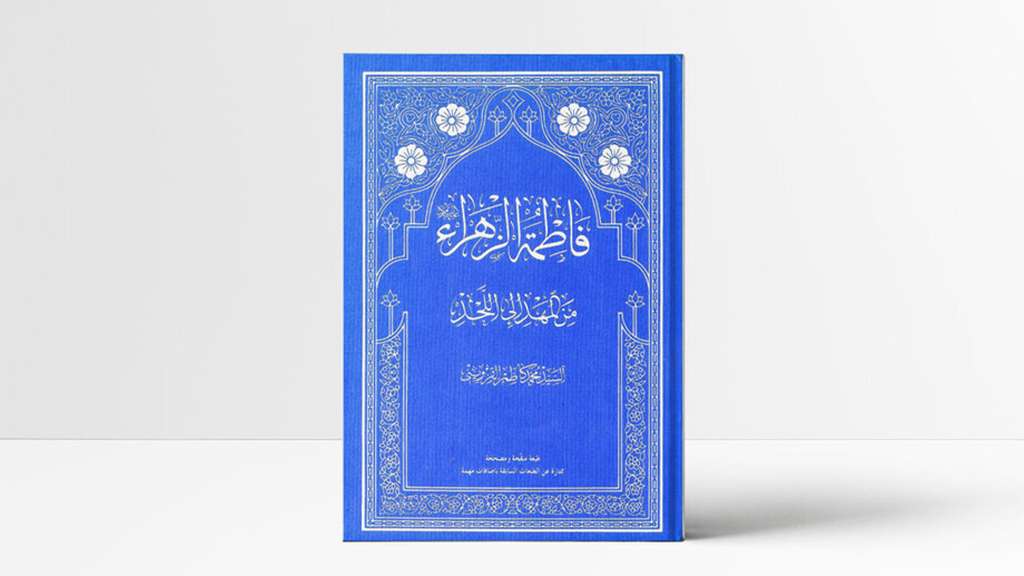
فاطمة الزهراء عليها السلام من المهد إلى اللّحد
-

السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى
-

فاطمة الزهراء (ع) تجلٍّ للرحمة الإلهيّة المحمّديّة
-

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (2)
-

من كنوز الغيب
-

(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها
-
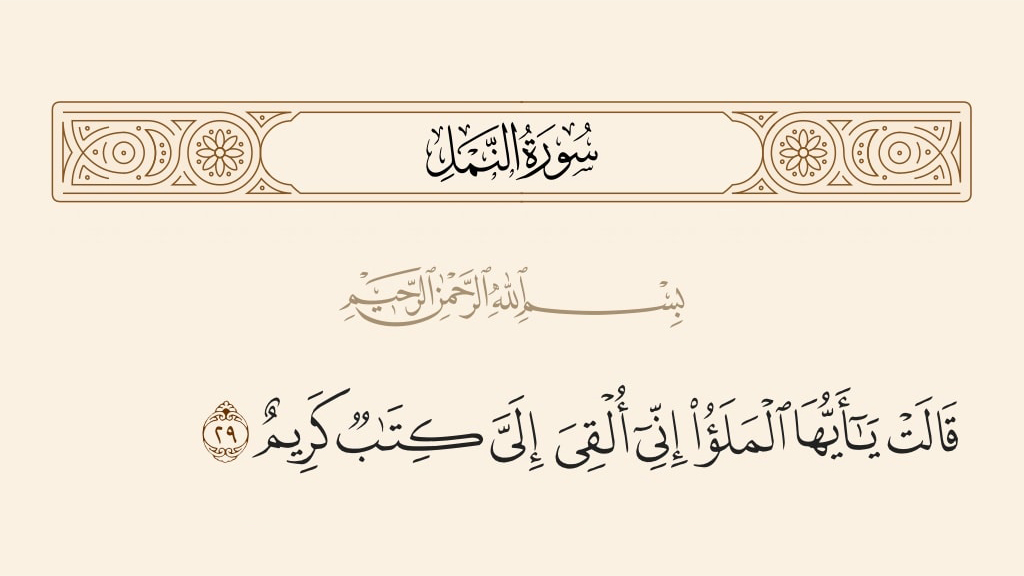
معنى (ملأ) في القرآن الكريم









