قرآنيات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد محمد حسين الطبطبائيعن الكاتب :
مفسر للقرآن،علامة، فيلسوف عارف، مفكر عظيمالمفاضلة بين البَشَر والملائكة

السّيّد محمّد حسين الطّباطبائيّ
اختلَف المسلمون في الإنسان والملَك أيّهما أفضل، فالمعروف المنسوب إلى الأشاعرة أنّ الإنسان أفضل، والمراد به أفضليّة المؤمنين منهم، إذ لا يختلف اثنان في أنّ مِن الإنسان من هو أضلّ من الأنعام، وهم أهل الجحود منهم. فكيف يُمكن أن يفضَّل على الملائكة المقرّبين؟ وقد استُدلّ عليه بالآية الكريمة: ﴿..وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ الإسراء:70، على أن يكون «الكثير» بمعنى الجميع.
وهو المعروف أيضاً من مذهب الشّيعة، وربّما استدلّوا عليه بأنّ الملَك مطبوعٌ على الطّاعة من غير أن تَتأتّى منه المعصية، لكنّ الإنسان من جهة اختياره تتساوى نسبته إلى الطّاعة والمعصية، وقد رُكِّب من قوًى رحمانيّة وشيطانيّة، وتألّفَ من عقلٍ وشهوةٍ وغضبٍ. فالإنسانُ المؤمنُ المطيعُ يُطيعه [تعالى] وهو غير ممنوع من المعصية بخلاف الملَك، فهو أفضل من الملَك.
ومع ذلك، فالقول بأفضليّة الإنسان بالمعنى الّذي تقدّم ليس باتفاقيٍّ بينهم، فمِن الأشاعرة مَن قال بأفضليّة الملَك مطلقاً كالزّجّاج، ونُسب إلى ابن عبّاس. ومنهم مَن قال بأفضليّة الرُّسُل من البشر مطلقاً، ثمّ الرُّسُل من الملائكة على مَن سواهم من البشر والملائكة، ثمّ عامّة الملائكة على عامّة البشر. ومنهم مَن قال بأفضليّة الكرّوبيّين من الملائكة مطلقاً، ثمّ الرُّسُل من البشر، ثم الكُمّل منهم، ثمّ عموم الملائكة على عموم البشر، كما يقول به الرّازيّ، ونُسب إلى الغزّاليّ.
وذهبتْ المعتزلة إلى أفضليّة الملائكة على البشر، واستدلّوا على ذلك بظاهر قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ الإسراء:70. وقد مرّ تقرير حجّتهم في تفسير الآية. [قالوا: إنّ ها هنا من لم يفَضَّل بنو آدم عليهم، وليس هؤلاء إلّا الملائكة، لأنّ بني آدم أفضل من كلّ حيوان سوى الملائكة بالاتّفاق].
وقد بالغ الزّمَخشريّ في التّشنيع على القائلين بأفضليّة الإنسان على الملَك، ممّن فسّر «الكثير» في الآية بالجميع، فقال في (الكشّاف) في ذيل قوله تعالى: ﴿..وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا..﴾: «هو ما سوى الملائكة، وحسْبُ بني آدم تفضيلاً أن تُرفع عليهم الملائكة وهمْ هم، ومنزلتُهم عند الله منزلتُهم، والعجَب من المجبّرة كيف عكسوا في كلّ شيء وكابروا، حتّى جسّرتهم عادةُ المكابرة على العظيمة، التّي هي تفضيل الإنسان على الملَك، وذلك بعد ما سمعوا تفخيمَ الله أمرَهم وتكثيرَه مع التّعظيم لذكرهم، وعلموا أين أَسكنَهم، وأنّى قرَّبَهم، وكيف نزّلَهم من أنبيائه منزلةَ أنبيائه من أممِهم. ثمّ جرّهم فرطُ التّعصّب عليهم إلى أن لفّقوا أقوالاً وأخباراً، منها: قالت الملائكة ربّنا إنّك أعطيتَ بني آدم الدّنيا يأكلون منها ويتمتّعون ولم تُعطنا ذلك، فأَعطِناه في الآخرة. فقال: وعزّتي وجلالي لا أجعل ذرّيّة من خلقتُ بيدي كمَن قلتُ له: كُن فكان. وروَوا عن أبي هريرة أنّه قال: المؤمن أكرم على الله من الملائكة الّذين عنده..».
وما أشار إليه [الزّمخشريّ] من رواية سؤال الملائكة أن يجعل لهم الآخرةَ كما جعل لبني آدم الدّنيا، رُويت عن ابن عمر، وأنَس بن مالك، وزيد بن أسلم، وجابر بن عبد الله الأنصاريّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله، ولفظُ الأخير [حديث جابر]: «لمّا خلقَ اللهُ آدمَ وذرّيّته قالتْ الملائكة: يا ربّ خلقتَهم يأكلون، ويشربون، وينكحون، ويركبون الخيل، فاجعلْ لهم الدّنيا ولنا الآخرة. فقال الله تعالى: لا أجعلُ مَن خلقتُه بيدي كمن قلتُ له: كُن فكان».
ومتن الرّواية لا يخلو عن شيءٍ، فإنّ الأكل، والشّرب، والنّكاح ونحوها في الإنسان استكمالاتٌ مادّية، إنّما يلتذّ الإنسان بها لِما أنّه يعالج البقاءَ لشخصه أو لنوعه، بما جهّز اللهُ به بُنيَته المادّية، والملائكةُ واجدون في أصل وجودهم كمالَ ما يَتوسّل إلى بعضه الإنسانُ بقواه المادّيّة، وأعمالِه المملّة المتعبة، منزّهونَ عن مطاوعة النّظام المادّيّ الجاري في الكون، فمن المحال أن يسألوا ذلك، فليسوا بمحرومين حتّى يحرصوا على ذلك، فيرجوه أو يتمنّوه.
ونظير هذا [الجواب] وارد على ما تقدّم من استدلالهم [الأشاعرة وغيرهم] على أفضليّة الإنسان على الملَك، بأنّ وجود الإنسان مركَّبٌ من القوى الدّاعية إلى الطّاعة والقوى الدّاعية إلى المعصية، فإذا اختار الطّاعة على المعصية، وانتزعَ إلى الإسلام والعبوديّة، كانت طاعتُه أفضل من طاعة الملائكة المفطورين على الطّاعة، المجبولين على ترك المعصية، فهو أكثرُ قرباً وزُلفى، وأعظم ثواباً وأجراً.
وهذا مبنيّ على أصلٍ عقلائيٍّ معتَبرٍ في المجتمع الإنسانيّ، وهو أنّ الطّاعة الّتي هي امتثالُ الخطاب المولويّ مِن أمرٍ ونهي، ولها الفضلُ والشّرفُ على المعصية، وبها يُستحقّ الأجر والثّوابُ لو استُحِقّ، إنّما يترتّب عليها أثرُها إذا كان الإنسانُ المتوجَّه إليه الخطابُ في موقفٍ يجوزُ [يُتاحُ] له فيه الفعل والتّرك، متساوي النّسبة إلى الجانبَين، وكلّما كان أقرب إلى المعصية منه إلى الطّاعة قويَ الأثرُ والعكس بالعكس، فليس يستوي في امتثال النّهي عن الزّنا –مثلاً- العِنِّين والشّيخُ الهَرم ومَن يصعب عليه تحصيلُ مقدّماته، [مع] الشّابّ القويّ البنية الّذي ارتفع عنه غالبُ موانعه، [ومع] مَن لا مانع له عنه أصلاً إلّا تقوى الله، فبعضُ هذه التّروك لا يعَدّ طاعةً، وبعضُها طاعة، وبعضُها أفضل الطّاعة على هذا القياس.
ولمّا كانت الملائكة لا سبيلَ لهم إلى المعصية لفقدِهم غرائزَ الشّهوة والغضب، ونزاهتِهم عن هوى النّفس، كان امتثالُهم للخطابات المولويّة الإلهيّة أشبهَ بامتثال العنّين والشّيخ الهرم لنهي الزّنا، وكان الفضلُ للإنسان في طاعته عليهم.
وفيه [هذا القول]، أنّه لو تمّ ذلك لم يكُن لطاعة الملائكة فضلٌ أصلاً، إذ لا سبيلَ لهم إلى المعصية ولا لهم مقام استواء النّسبة، ولم يكن لهم شرفٌ ذاتيّ وقيمةٌ جوهريّة، إذ لا شرفَ على هذا إلّا بالطّاعة الّتي تقابلها معصية، وتسميةُ المطاوعة الذّاتية، الّتي لا تتخلّف عن الذّات، طاعةً مجازٌ، ولو كان كذلك لم يكن لقربهم من ربّهم مُوجب، ولا لأعمالهم منزلة.
لكنّ الله سبحانه أقامَهم مقامَ القرب والزّلفى، وأسكنَهم حظائرَ القُدس ومنازل الأُنس، وجعلهم خُزّان سرِّه وحملَة أمرِه، ووسائطَ بينه وبين خَلقه، وهل هذا كلّه لإرادةٍ منه جزافيّة من غير صلاحيّةٍ منهم، واستحقاقٍ من ذواتهم؟
وقد أثنى الله عليهم أجزلَ الثّناء إذ قال فيهم: ﴿..بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ* لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ الأنبياء:26-27. وقال: ﴿..لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾التحريم:6. فوصَف ذواتهم بالإكرام من غير تقييدِه بقَيد، ومدَح طاعتَهم واستنكافَهم عن المعصية.
وقال مادحاً لعبادتهم وتذلّلهم لربّهم: ﴿..وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ الأنبياء:28. وقال: ﴿فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ حم السّجدة:38. وقال:﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ * إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾الأعراف:205-206. فأَمَر نبيَّه صلّى الله عليه وآله أن يَذكرَه كذكرهم، ويَعبدَه كعبادتهم.
وحقّ الأمر: أنّ كون العمل جائزُ الفعل والتّرك، ووقوف الإنسان في موقف استواء النّسبة، ليس في نفسه ملاكَ أفضليّة طاعته، بل بما يكشف ذلك عن صفاء طينتِه وحُسن سريرته، والدّليل على ذلك: أنْ لا قيمة للطّاعة مع العلم بخباثة نفسِ المُطيع وقُبْحِ سريرته، وإنْ بلغَ في تصفية العمل وبذْل المجهود فيه ما بلغ، كطاعة المنافق ومريض القلب الحابط عملُه عند الله، الممحوّة حسنتُه عن ديوان الأعمال. فصفاءُ نفس المطيع، وجمال ذاته، وخلوصه في عبوديّته، الّذي يكشف عنه انتزاعه من المعصية إلى الطّاعة، وتحمُّله المشاقّ في ذلك، هو الموجب لنفاسة عمله وفضل طاعته.
وعلى هذا، فذوات الملائكة -ولا قوام لها إلّا الطّهارة والكرامة، ولا يَحكم في أعمالهم إلّا ذلُّ العبوديّة وخلوص النّيّة- أفضلُ من ذات الإنسان المتكدّرة بالهوى، المَشوبة بالغضب والشّهوة، وبأعماله الّتي قلّما تخلو عن خفايا الشّرك، و[تأثيرات] النّفس، ودَخَل الطّبْع.
فالقوامُ الملَكيّ أفضل من القوام الإنسانيّ، والأعمال الملَكيّة الخالصة لوجه الله تعالى أفضل من أعمال الإنسان، وفيها لونُ قِوامِه وشَوبٌ من ذاته، والكمال الّذي يتوخّاه الإنسان لِذاته في طاعته وهو الثّواب، أُوتيَه الملَك في أوّل وجوده..
نعم، لمّا كان الإنسان إنّما ينالُ الكمالَ الذاتيّ تدريجاً بما يحصل لِذاته من الاستعداد سريعاً أو بطيئاً، كان من المحتمل أن ينالَ عن استعداده مقاماً من القُرب، وموطناً من الكمال، فوقَ ما قد ناله الملَك ببهاء ذاته في أوّل وجوده، وظاهرُ كلامه تعالى يحقّقُ هذا الاحتمال.
كيف وهو سبحانه يذكر في قصّة جعْل الإنسان خليفةً في الأرض فضْلَ الإنسان واحتمالَه لما لا يحتملُه الملائكة من العلم بالأسماء كلّها، وأنّه مقامٌ من الكمال لا يتداركُه تسبيحُهم بحمده وتقديسُهم له، ويطهّره ممّا سيظهر منه من الفسادِ في الأرض وسفكِ الدّماء، كما قال سبحانه: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ* وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آَدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ البقرة:30– 33.
ثمّ ذَكر سبحانه أمرَ الملائكة بالسّجود لآدم، ثمّ سجودَهم له جميعاً، فقال: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ الحجر:30. وقد أوضحنا في تفسير الآيات في القصّة في سورة الأعراف أنّ السّجدة إنّما كانت خضوعاً منهم لمقام الكمال الإنسانيّ، ولم يكن آدم عليه السلام إلّا قبلةً لهم ممثِّلاً للإنسانيّة قبال الملائكة.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 آل عمران في آية الاصطفاء
آل عمران في آية الاصطفاء
الشيخ محمد صنقور
-
 معرفة الإنسان في القرآن (9)
معرفة الإنسان في القرآن (9)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (ستر) في القرآن الكريم
معنى (ستر) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 كريم أهل البيت (ع)
كريم أهل البيت (ع)
الشيخ علي الجشي
-
 الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

كريم أهل البيت (ع)
-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
-

آل عمران في آية الاصطفاء
-

الإمام الحسن المجتبى (ع) بين محنتين
-
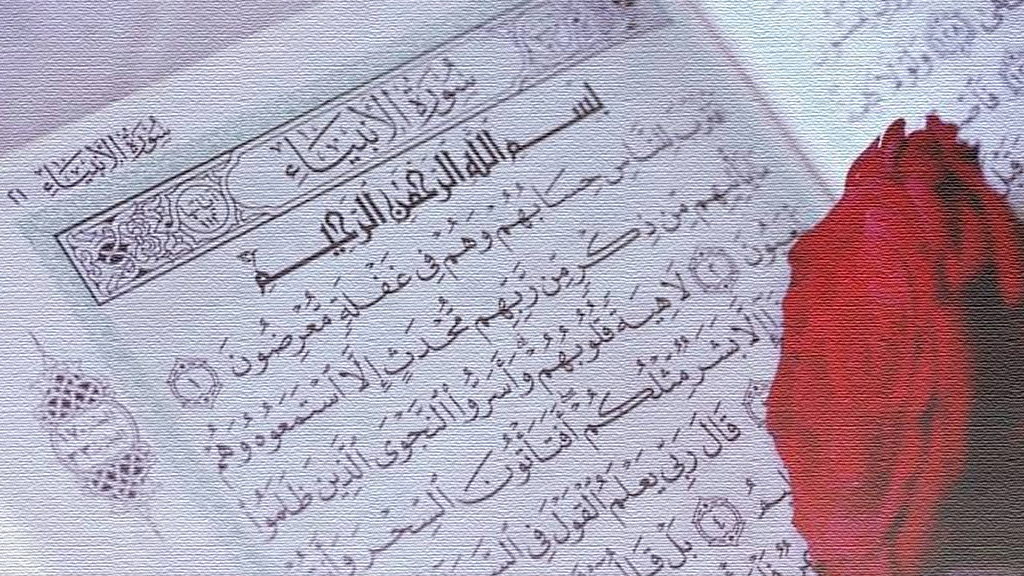
معرفة الإنسان في القرآن (9)
-

شرح دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان
-

إفطار جماعيّ في حلّة محيش، روحانيّة وتكافل وتعاون
-

الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
-

حميتك في شهر رمضان
-

(البلاغة ودورها في رفع الدّلالة النّصيّة) محاضرة للدكتور ناصر النّزر










