مقالات
معلومات الكاتب :
الاسم :
إيمان شمس الدينعن الكاتب :
باحثة في الفكر الديني والسياسي وكاتبة في جريدة القبس الكويتيةالحسين (ع) والمعارضة السّياسية (1)

للإنسان قدرتان: الأولى حيوية متمثلة بالتفاعلات السلوكية، والثانية فكرية، والقدرة الحيوية تتأثر بعدة مؤثرات أهمها المؤثرات الفكرية والمؤثرات الخارجية والداخلية خاصة النفسية، وهذا التأثر يخلق العديد من الانفعالات التي تتحرك في كثير من الأحيان نحو محاولات إشباع تتم عن طريق الأشياء والأفعال، وتتدخل الطاقة الفكرية هنا بدورها الوظيفي في التحكم بنوع الإشباع وصفته، وبالتالي يتحقق الاشباع بناء على البنية المفاهيمية ونظم المعلومات والأفكار التي يتبناها الإنسان.
وتختلف بذلك الأفكار والأفعال والانفعالات وفق اختلاف المفاهيم والرؤى الفكرية، وحيث إن القوى الفكرية والسياسية تتشكل بناء على انجذاب المتشابهين فكريًّا، وبالتالي هذا الانجذاب يخلق بيئة تفاعلية متشابهة مع القضايا الخارجية ضمن التيار الفكري والسياسي، بالتالي تصبح المفاهيم التي تعتنقها القوى والتيارات الفكرية والسياسية متناقضة ومختلفة أو تتشابه في مشتركات، فإن مواقفها أيضًا تجاه الأحداث والقضايا السياسية والفكرية ستكون مختلفة.
"فالمعارضة في الواقع: اختلاف بين المفاهيم نتج بسبب تناقضها أو بسبب تناقض فهمها، ويتفرع عنه اختلاف في المواقف بين البشر.
والمعارضة السياسية: هي خلاف بين المفاهيم السياسية يتفرع عنه خلاف في المواقف السياسية بين القوى السياسية"[1].
المعارضة السياسية من زاوية فكريا – كما يرى عبد الحكيم عبد الله – تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: معارضة مبدئية: وهي الاختلاف السياسي والفكري على أسس مبدئية، كالاختلاف بين الإسلام والكفر، فمفاهيم الإسلام لا يمكن أن تلتقي مع مفاهيم الكفر، والصراع بين مفاهيم الإسلام ومفاهيم الكفر هو صراع دائم.. والمعارضة المبدئية تحتم تبنّي سياسة المواجهة بشكل دائم ضد مفاهيم الكفر التي تصوغ المصالح، ومنها الأهداف للقوى السياسية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
الثاني: معارضة استراتيجية: وهي الاختلاف السياسي على أسس استراتيجية. ولما كان بناء الاستراتيجيات يستند إلى قواعد صلبة وأسس مبدئية، وهي خادمة لمصالح وأهداف المبدأ، لذلك قد يكون الاختلاف الاستراتيجي في بعض الأحيان راجعًا إلى اختلاف مبدئي، وفي هذه الحالة، أي كون المفاهيم الاستراتيجية تتعارض مع المبدأ، يجب محاربتها وتبني سياسة المواجهة ضدها، ولكن ذلك لا يمنع من العمل على احتواء هذه الأفكار أو المفاهيم، والعمل على تغيير جوهرها لكي لا تتعارض مع المبدأ، بل تكون مسخرة لخدمة المبدأ ومصالحه.
الثالث: معارضة عرضية: وهي الاختلاف السياسي على أمور إدارية أو مبدئية فرعية لا تمس أصول المبدأ، والاختلاف الإداري، قد يتعارض مع المبدأ فيعامل مثل المعارضة المبدئية، وقد لا يتعارض معه فيعامل مثل المعارضة الاستراتيجية[2].
وعادة قد تشكل المعارضة أكثرية أو أقلية، إلا أن الميزان في تشخيص شرعيتها يعتمد على مدى ما تطرحه في أسباب معارضتها من حق، ومن مبادئ كبرى ولا تعتمد الشرعية على الأكثرية أو الأقلية العددية. فالغرب يرى أن المعارضة السياسية هي رأي الأقلية المخالف لرأي الأكثرية، حيث تتمثل الديموقراطية في وصول الأكثرية إلى الحكم، بالتالي تنبثق المعارضات من الأقليات المختلفة مع الحكم، حيث يتجسد رأي الأقليات في القوى السياسية المعارضة، ورأي الأكثرية في الحزب الحاكم ومناصريه، ولذلك ووفق مبادئ النظام الديموقراطي، فإن رأي الأكثرية هو الرأي الشرعي النافذ، وهو رأي أغلبية الشعب، أما الرأي الآخر فهو رأي الأقلية التي تقر بشرعية هذه السلطة، لاتفاقها في أمور مبدئية معها، واختلافها في أمور فرعية، ويتم استغلال هذه الاختلافات الفرعية في محاولات تشكيل معارضات وأحزاب معارضة سياسية تهدف للوصول إلى السلطة وتطبيق المنهج الذي تؤمن به هذه الأقليات.
تأخذ المعارضة في الفكر السياسي أشكالًا متعددة، إلا أن وجودها دليل مهم لتمتع المجتمع بنسب حرية كبيرة، إذ إن التاريخ يثبت أن الحرية دائمًا تموت عندما يموت النقد في المجتمع. وبغياب المعارضة لا توجد بالأصل عملية سياسية، بل توجد عملية قهر وابتزاز، وبدلًا من حكم محدد بضوابط سيكون الحكم مطلقًا.
فأهمّ أشكال المعارضة:
- المعارضة السلمية، من خلال تقديم العرائض والشكاوى للحاكم لنصحه وتقويم مساره، وهذا أدنى مستوى من مستوياتها، ويعدّ الخطوة الأولى في مسيرة المعارضة التصاعدية.
- الاحتجاج والرفض لأوامر الحاكم في حال خالفت أسس العدالة، وعدم تطبيقها ومحاولة تقويمه بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة، ومنها الاحتجاجات السلمية، وهذه خطوة متقدمة في حال نصح الحاكم ولم يلتفت للعرائض.
- العصيان المدني من خلال تعطيل مؤسسات الدولة، وتعطيل روافد الاقتصاد. وهي مرحلة تصاعدية في سلم المعارضة السلمية، لتقويم مسار الحاكم، شريطة أن تكون المطالب محقة وفي مسار تحقيق العدل.
- المعارضة المسلحة، وهي أقصى مرحلة يلجأ إليها المعارضون، في حال لجأ الحاكم للعنف والقتل والتهديد لحيوات المعارضين، أي واجه مطالبهم السلمية بالعنف والعسكر، فهنا يصبح من حقهم الدفاع عن أنفسهم، وممارسة الاعتراض وتمكين الناس من حقهم السياسي في المشاركة، وفي تحقيق الحق والعدل.
وأهم أنواع المعارضة كما يرى عبد الحكيم عبد الله:
معارضة حقيقية: وهي الموقف السياسي العملي الذي يتجسد في القوى السياسية إزاء المفاهيم التي تناقض مفاهيمها السياسية، فتعارضها وفق ما تتطلبه هذه المفاهيم.
معارضة خادعة: وهي التلبس بالموقف السياسي العملي من قبل القوى السياسية، تجاه المفاهيم السياسية التي تناقض مفاهيمها في الأسس والقواعد.
معارضة خاطئة:و هي عدم التلبس بالموقف السياسي العلمي من قبل القوي السياسية تجاه المفاهيم السياسية التي تختلف عن مفاهيمها في الأمور الفرعية أو الاستراتيجية أو الإدارية.[3]
وعادة ما تنشأ المعارضة لأسباب التوترات والقلق والاستفزاز الاجتماعي والسياسي، بحيث ينطوي فيها شعور الإنسان بالغبن والقهر والتذمر في درجاته الدنيا، والتمرد في درجاته العليا، وهذا يحدث بسبب التناقض الذي يظهر بين السلطة والشعب، أو السلطة والقوى السياسية عادة، هذا القلق يؤدي لتكتلات تتفق فيما بينها على عدة أمور أهمها:
- الاختلاف مع السلطة
- الشعور بالظلم وعدم العدالة
- ضرورة مواجهة السلطة وتحقيق التغيير والإصلاح
هذه التكتلات السياسية قد تأخذ شكل قوى سياسية وأحزاب لديها برنامج ترغب في تطبيقه، يختلف مع برنامج السلطة، فتسعى هذه المعارضة للوصول إلى السلطة وتحقيق ما تصبو إليه وتراه في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وما تراه محققًا للعدالة، ولكن قد تتشكل المعارضة على هيئة تجمعات ومؤسسات أهلية مدنية، تمارس دور (المراقب ثم الناقد ثم الضاغط) على السلطة، ولكن هذه المؤسسات لا تسعى للوصول إلى السلطة، بل إن سعيها هو تحقيق وعي ذاتي اجتماعي، يحقق مستوى وعي سياسي شعبي، بحيث تبقى عين الشعب هي الرقيب والناقد والضاغط على طول مسار العمل السياسي للسلطة في الدولة ومؤسساتها.
وتقوم المعارضة على قاعدة وركيزة مهمة ورئيسية هي الاختلاف، وكما أشرنا سابقا فقد يكون اختلاف في المبادئ والمفاهيم الكبرى المؤثرة في تحقيق العدالة، وقد تكون اختلافات في المبادئ الفرعية، أي اختلاف في قراءة وتطبيقات المفاهيم الكبرى على الواقع وآليات التطبيق والممارسة السياسية. إلا أن هذا الاختلاف له أشكال متعددة:
- اختلاف في المبادئ والمفاهيم الكبرى التي تمس هوية المجتمع، وأسس تحقيق العدالة، بالتالي تختلف أيضًا في الأهداف.
- اختلاف في المبادئ والمفاهيم الفرعية، التي تختلف فيها المناهج والأدوات لكنها تؤدي إلى الأهداف نفسها.
ويختلف أداء المعارضة وفقا لطبيعة الاختلاف، فقد تتعايش المعارضة مع هذا الاختلاف بالحد الأدنى، ولكنها تسعى لتحقيق مفاهيمها الكبرى ومبادئها وتقليل مساحات الاختلاف وتوسيع مساحات الاشتراك فهي تختلف مع الحكومة لا مع النظام، وقد لا تتعايش المعارضة مع هذه الاختلافات كونها جوهرية، وتمس روح العدالة الاجتماعية، بالتالي تسعى للتغيير بشتى الطرق، لانعدام المساحات المشتركة بشكل لا يسمح للتعايش مع هذه الاختلافات الجوهرية، وهنا يكون الاختلاف مع النظام وبالتالي مع الحكومة.
وكان المسلمون في عهد كل من الخلفاء أبو بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب عليهم السّلام لهم الحق في مراقبة الحكم ونقده ومحاسبته، انطلاقًا من واجب الأمة في ممارسة الخلافة التي أو كلها الله لعباده....
والإمام علي (ع) خاطب الناس بأنه: "وربَّمَا اِسْتَحْلَى اَلنَّاسُ اَلثَّنَاءَ بَعْدَ اَلْبَلاَءِ فَلاَ تُثْنُوا عَلَيَّ بِجَمِيلِ ثَنَاءٍ لِإِخْرَاجِي نَفْسِي إِلَى اَللَّهِ سُبْحَانَهُ وَإِلَيْكُمْ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ اَلْبَقِيَّةِ فِي حُقُوقٍ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ أَدَائِهَا وَفَرَائِضَ لاَبُدَّ مِنْ إِمْضَائِهَا فَلاَ تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ اَلْجَبَابِرَةُ وَلاَ تَتَحَفَّظُوا بِمَا يُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ اَلْبَادِرَةِ وَلاَ تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ وَلاَ تَظُنُّوا بِي اِسْتِثْقَالاً فِي حَقٍّ قِيلَ لِي وَلاَ اِلْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِي فَإِنَّهُ مَنِ فَلاَ تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَلاَ آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي، فَإِنّي لَسْتُ في نَفسي بِفَوقِ أَنْ أُخْطِئْ، وَلا آمَنُ مِنْ ذلِكَ من فِعْيى إِلّا أَنْ يَكْفي اللّه من نفسي ما هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنّي. فَإِنمّا أَنا وأَنتم عَبيدٌ ممْلوكون لِرَبّ لا رَبّ غَيْرَه". [4]
وبذلك حدّد الإمام علي (ع) مجموعة ضوابط:
- النقد بحق، أي النقد ليس لأجل النقد، والمواجهة ليست مجرد انفعالات نفسية، بل النقد والمواجهة عليهما أن يكونا بالحق، ومن أوجه الحق، الالتزام بالضوابط الأخلاقية والمبادئ القرآنية في النزاع والخصومة.
- المشورة بعدل، وهنا يؤكد على مشاورة الناس في آليات تحقيق العدل في حال اعترض أحدهم على ذلك. فيفعّل دور الناس في المشاركة السياسية ومراقبة أداء الحاكم.
- تأكيده على مساواته كحاكم بالناس، كونهم جميعًا عبيد مالكهم الله تعالى، وهذا التأكيد يحثهم على أداء دورهم السياسي في المشاركة والنقد والتقييم، والهدف تحقيق العدل.
وبالنظر إلى مسار الإمام الحسين (ع) الرافض لبيعة يزيد غير الشرعية، لأنه انحرف عن المسار في ضرورة أن تتوفر شروط الحكم الذي يعدّ حقًّا، والحق كما أسلفنا عليه أن تتوفر فيه شرط المشروعية والمقبولية، نجده تدرج في مواجهة خروج يزيد على إجماع المسلمين في رفضه كحاكم، وفي عدم شرعية حكمه بالأصل.
فهو أعلن في بدء الأمر رفضه للبيعة موضحا أسبابه، ومن ثم خرج من المدينة تجنًبا لهذه البيعة وإصرارًا على إعلام الناس بأنه خرج من أرضه وموطنه رفضًا للبيعة، ثم بعد أن توالت عليه الكتب من أهل الكوفة تطلب منه المجيء ومواجهة يزيد ومنع استلامه للسلطة، فتوجه إلى الكوفة لا بقصد المواجهة العسكرية، ولكن بقصد التحشيد لرفض البيعة وإعلان موقف إجماعي على ذلك كنوع من الاحتجاج، ثم العصيان العام للبيعة كتعطيل لتمريرها، ومن ثم إكمال المسيرة التي ابتدأها والده علي (ع) في إسقاط حكومة الشام غير الشرعية، فقد كان الإمام علي (ع) قد خرج في مواجهة حكومة معاوية الذي رفض بيعة الإمام علي (ع) الذي بايعته جموع المسلمين، فخرجت الشام ومعاوية كإقليم تابع لولاية علي الخليفة الشرعي، عن بيعة الإمام علي (ع)، هذا التناقض شق المجتمع الإسلامي في الدولة الإسلامية إلى شقين، ووجد في كل منهما جهازًا إداريًّا وسياسيًّا لا يعترف بالآخر، فالشام تعرفت على الإسلام من خلال ولاية يزيد أخي معاوية، ثم بعد ذلك بولاية معاوية بن أبي سفيان، ولم يسمع إقليم الشام عن علي (ع) وجهاده ومكانته، فعاش الإسلام من منظار معاوية بن أبي سفيان، وبالتالي خرج عن هذا الإجماع، وأراد شق صف المسلمين بإقامة دولة هو حاكم عليها في الشام، فكانت واقعة صفين الشهيرة في مواجهة انحراف معاوية، ولأن الإمام عليًّا (ع) هو الحاكم الشرعي والمسؤول عن الأمة الإسلامية وهويتها ووعيها ووحدتها، فكان يريد أن يقضي على هذا الانشقاق الذي وجد في جسد الأمة الإسلامية وذلك بشخصية هؤلاء المنحرفين، وإجبارهم بالقوة للانضمام لما أجمع عليه المسلمون من بيعة للإمام علي (ع)، وذهاب الإمام علي (ع) لحرب مباشرة لأنه كان يريد تصحيح الاعوجاج في مسار الأمة، وكان أجلى مصداق لهذا الاعوجاج هو منهج معاوية وما طرحه من إسلام بعيد عن إسلام النبي (ص)، هذا فضلًا عن عدم شرعيته، بالتالي لا يمكن لأنصاف الحلول أن تطرح في مسار التصحيح وإعادة البناء، لأن إعادة البناء السياسي يجب أن تصاغ وفق الرؤية النبوية التي يمثلها علي (ع) ويدركها ويفهم أبعادها ومفاصلها.
لكن ما قام به معاوية ومناصروه من خدعة التحكيم والتي رفعت خلالها المصاحف تحت شعار “لا حكم إلا لله”، وأجمع من في جيش علي (ع) على التحكيم، بالتالي رضي الإمام علي (ع) بما أجمع عليه المسلمون في التحكيم، بالرغم من معرفته أنها خدعة يريد من خلالها معاوية أن يهرب من هزيمته العسكرية المحتمة، لكي يلتف على وعي المسلمين بخداعه ويحملهم على التحكيم، فيبقى هو في حكم الشام، ويعيد رص صفوفه ليحقق مراده فيما بعد من أخذ الخلافة.
ثم بعد استشهاد الإمام علي (ع)، بايع المسلمون ابنه الحسن (ع)، الذي باشر بتجهيز الجيش لإكمال مسيرة والده في أسقاط حكومة الشام لعدم شرعيتها، ولكن جرى خداع سياسي أيضًا، من خلال شراء ذمة قائد جيش الإمام الحسن (ع) عبيد الله بن عباس، كما تنقل بعض المصادر، وانهزام الجيش ثم الترويج لمعاهدة الصلح التي لم يكن الحسن (ع) طرفًا فيها، وإنما روج لها معاوية من خلاله جهازه الإعلامي ونشرها كإشاعة، لتتحول بعد ذلك لواقع تحت الضغط الجماهيري الذي أجهدته كثرة الحروب، والتبست عليه قضية القتال الداخلي مع المسلمين.
ولم يكن الإمام الحسين (ع) ليشذ عن هدف والده وأخيه في إسقاط حكومة الشام لعدم شرعيتها بالأصل، لكن العهد الذي كان بينه وبين معاوية جعله يؤجل المواجهة إلى حين موته، فَعَلّه بعد ذلك يتمكن من استعادة حقه في الحكم، ومن ثم ممارسة عمليات إصلاح كبرى، إلا أن نقض معاوية للعهد، وتوريثه الحكم لابنه يزيد الذي اشتهر بفسقه بين المسلمين، دفع الإمام الحسين (ع) أن يعلنها بشكل صريح من المدينة ردًّا على طلب بيعته ليزيد: “مثلي لا يباع مثله” وهو رفض صريح ونهائي للبيعة ورفض الحسين (ع) صاحب الحق الشرعي في الحكم هو تصريح واضح بعدم شرعية هذا الحكم ولا حكامه، بالتالي هو مواجهة صريحة مع يزيد ونظامه الحاكم.
وقد حاول الإمام الحسين (ع) أن يمارس دور المعارضة السلمية، سواء برفضه البيعة كحق، أو خروجه من المدينة، أو حتى ذهابه إلى الكوفة بعد توالي الرسائل إليه ليؤسس جبهة معارضة، تؤدي فيما بعد لمواجهة نظام يزيد وتغييره، لأن اختلاف المسلمين والإمام الحسين هنا مع يزيد هو اختلاف جوهري على النظام والمفاهيم والمبادئ الكبرى التي لا يمكن التعايش معها، لعدم تحقيقها للعدالة، ولانحرافها في نظامها السياسي عن المنهج الذي كان على عهد الخلفاء وكان يحفظ حق المسلمين في البيعة والرفض والنقد والمعارضة دون مساس بهم، وكان يخضع خلاله الخليفة للنقد والتقييم والاعتراض، إلا أن إصرار يزيد على مواجهة الحسين (ع) وقتله، دفع الحسين (ع) لمواجهة هذا الإصرار على القتل، إضافة لابتداء جيش يزيد للحرب، بمواصلة معارضته بالمواجهة العسكرية للدفاع عن نفسه ومن معه، ولتأكيد ثورته ومعارضته ضد يزيد ومحاولات اغتصابه للخلافة، حتى آخر رمق من روحه.
ــــــــــــــــــ
[1] المعارضة السياسية، عبد الحكيم عبد الله، مجلة الوعي، العدد ١٢٦، السنة الحادية عشرة – رجب ١٤١٨ – تشرين الثاني ١٩٩٧م
[2] المصدر السابق بتصرف
[3] المعارضة السياسية، عبد الحكيم عبد الله، مجلة الوعي، العدد ١٢٦، السنة الحادية عشرة – رجب ١٤١٨ – تشرين الثاني ١٩٩٧م
[4] شرح نهج البلاغة، ابن أبي حديد المعتزلي، ج ١١، ص ١٠٢ ،١٠٣
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 ﴿غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ هل هو تكرار؟
﴿غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ هل هو تكرار؟
الشيخ محمد صنقور
-
 (وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ)؟!
(وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ)؟!
الشيخ مرتضى الباشا
-
 ما هي ليلة القدر
ما هي ليلة القدر
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 لماذا يصاب المسافر بالأرق ويعاني من صعوبة في للنوم؟
لماذا يصاب المسافر بالأرق ويعاني من صعوبة في للنوم؟
عدنان الحاجي
-
 معنى سلام ليلة القدر
معنى سلام ليلة القدر
السيد محمد حسين الطهراني
-
 لأجل ليلة القدر، الأخلاق الفاضلة وقوة النفس
لأجل ليلة القدر، الأخلاق الفاضلة وقوة النفس
السيد عباس نور الدين
-
 معنى (نكل) في القرآن الكريم
معنى (نكل) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 مميّزات الصّيام
مميّزات الصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
الشعراء
-
 عرجت روح عليّ وا أمير المؤمنين
عرجت روح عليّ وا أمير المؤمنين
حسين حسن آل جامع
-
 جرح في عيون الفجر
جرح في عيون الفجر
فريد عبد الله النمر
-
 من لركن الدين بغيًا هدما
من لركن الدين بغيًا هدما
الشيخ علي الجشي
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

الصوم رائض وواعظ
-

علماء يطورون أدمغة مصغرة، ثم يدربونها على حل مشكلة هندسية
-

العدد الحادي والأربعون من مجلّة الاستغراب
-

إحياء ليلة القدر الكبرى في المنطقة
-

المساواة في شهر العدالة
-
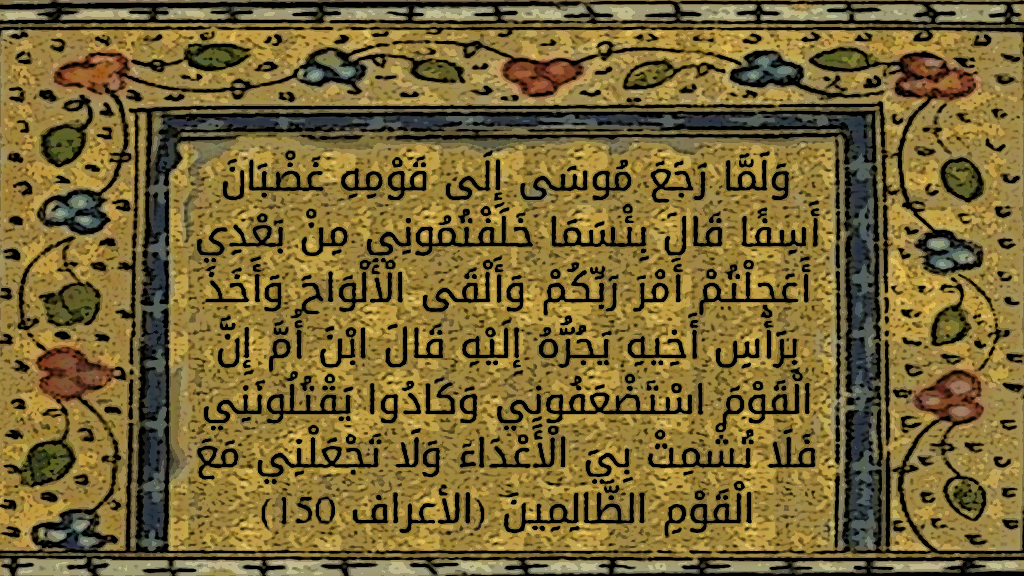
﴿غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ هل هو تكرار؟
-
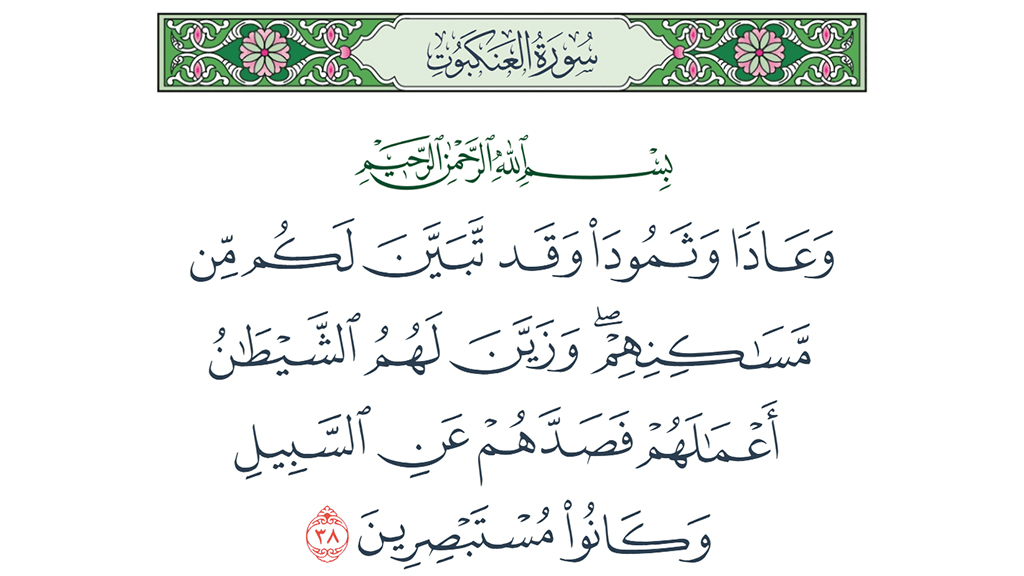
(وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ)؟!
-

شرح دعاء اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان
-

ما هي ليلة القدر
-

لماذا يصاب المسافر بالأرق ويعاني من صعوبة في للنوم؟










