علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشهيد مرتضى مطهريعن الكاتب :
مرتضى مطهّري (1919 - 1979) عالم دين وفيلسوف إسلامي ومفكر وكاتب شيعي إيراني، هوأحد أبرز تلامذة المفسر والفيلسوف الإسلامي محمد حسين الطباطبائي و روح الله الخميني، في 1 مايو عام 1979، بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتصار الثورة الإسلامية، اغتيل مرتضى مطهري في طهران إثر إصابته بطلق ناري.النفس الإنسانية (6)

روح المجتمع
حاول بعضهم تفسير هذه الميول المعنويّة تفسيراً آخر شبيهاً بتفسير المفكّر «موريس ماترلينك»، وهو أنّ الدافع والملهِم هو روح المجتمع؛ فمَن يخدم الأمّة ويفنى من أجلها، فهو مُلهَمٌ مِن قِبَل تلك الروح، ولا شيء وراء ذلك.
هذا أيضاً توجيهٌ غير دقيق؛ لأنّنا لا نعقل هذه «الروح»، ولا نعرف لها معنى؛ ذلك أنّ «المجتمع» ليس له وجود مستقلّ عن وجود أفراده، بل هو مجموع الأفراد؛ فالوجود الحقيقيّ هو للأفراد، وأمّا المجتمع فهو موجودٌ اعتباريّ لا روح له. ولو سلَّمنا بما قالوا، فهذه «الروح» من أين اكتسبَت ذلك؟ ومَن هو مُلهِم هذه الروح المزعومة؟ ثمّ إنّه إذا لم نؤمن بشيء وراء «روح المجتمع» هذه، من جنّة ونار ومجازاة، فستكون هذه الروح روحاً خادعة للإنسان، مغرِّرةً به؛ لأنّه لا معنى لأنْ يضحّي المرء بسعادته وراحته في سبيل المجتمع بلا عوض، لا دنيويّ ولا أخرويّ، فإنّ هذا غاية الحمق.
الإلهيّون
قد أضاء الصبح لذي عينَين، وتقشّعت السحب الثقال عن عين الشمس، والقول الفصل هو ما عليه «الإلهيّون» من أنّ الله تعالى هو الملهِم والمرشِد، وأنّ تلك الميول الخيِّرة إنّما هي فطرته تعالى في خلقه، هي نداؤه تعالى للإنسان، وهذه التضحيات كلّها لن تذهب هدراً؛ لأنّه ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ﴾، ولأنّه تعالى لا يضيع أجرَ مَن أَحسنَ عملاً، من ذكر أو أنثى.
ومن هذا الإحساس، يتحمّس أصحاب القلوب الرحيمة والنفوس الطيّبة لكلِّ ما فيه خير البشر. ولكنّ الخوف من تلاشي المذهب المادّيّ وإحياء التوجُّه الإلهيّ، هو السبب في بروز مثل هذه الآراء والنظريّات.
القرون الوسطى
لا نعدم أن نرى من يدَّعي بأنّ «التديّن» والعودة إلى «الله» مصادرة للحرّيات والفكر وعودة للقرون الوسطى، قرون الجهل والتعصّب المقيت. وهذه المقولة قد لا تكون عجيبةً وغريبةً إذا تمسّك بها الغربيّون، ولكنّها أغرب ما تكون إذا تشبّث بها أهل الشرق المسلمون. فالناس في إيران أحياناً يتحدّثون ويهاجمون القرون الوسطى! القرون الوسطى تتعلّق بالمجتمعات الغربيّة والحضارة الأوروبّيّة، وهي تُعَدّ مرحلة انحطاط لهم، أمّا عندنا نحن المسلمين، فإنّ تلك المرحلة تُعَدّ مرحلة الحضارة والثقافة والاعتزاز، فكيف نتحدّث عنها نحن هنا في «إيران»، ونعدّها مشكلة وكابوساً مزعجاً، نحذر أن يعود جاثماً على صدورنا؟!
لقد كانت تلك الحقبة بالنسبة لنا حقبة تمدّنٍ وعلمٍ ومجدٍ حضاريّ لا يبارى. أجل، إنّ القرون الوسطى أوروبيّة الجنسيّة ولها ظروفها الخاصّة، ولا تمتُّ لنا ولا لديننا بأيّ صلة قرابة.
إنّ عهد «أبي ريحان البيرونيّ» و«ابن سينا» و«الفارابيّ» و«ابن رشد»، قبل ألف عام، لهو من أسطع عهود الثقافة والتمدّن البشريّ، فلماذا -إذاً- يربط المسلِمُ نفسَه بتاريخ أوروبّا؟! ويا حبّذا لو عادت القرون الوسطى لنشهد مجدنا الغابر وعزّنا الدابر، لو كان «ابن سينا» موجوداً اليوم أو «أبو ريحان البيرونيّ»، لنصبوا للأوّل تمثالاً، وقبّلوا قدمَي الثاني إجلالاً!
كلام «سارتر» حول «النفس الواقعيّة»
يرى «سارتر» أنّ الإنسان يحمل على عاتقه المسؤوليّة الكاملة عن «وجوده»، وأنّه قادر على خلق نفسه بحسب الصورة الّتي يشاؤها، لكنَّه يزعم أنّ افتراض وجود «إله» يؤدّي إلى سلب «حرّيّة» الإنسان، لماذا؟
يقول: لأنَّ إذا كان الإله موجوداً، فمعنى ذلك أنّ له «ذهناً»؛ فيكون قد تصوَّر طبيعةَ الإنسان سلفاً في ذهنه؛ وإذا كان الأمر كذلك، فلا يمكن للإنسان أن يكون حرّاً؛ لكونه لا يقدر أن يكون إلّا كما تصوَّرَه «الإله» سلفاً. وأين هذا من «الحرّيّة»؟ فلأجل الحفاظ على حرّيّة الإنسان، لا بدّ من إنكار وجود أيّ «إله»؛ لأنّ حرّيّة الإنسان ذاتيّة له، فهو عين الحرّيّة، لا أنّه ذو حرّيّة.
إنّ «سارتر» يرى الله بعين واحدة، بل لا يراه أصلاً. ليس لـ«الإله» «ذهنٌ» حتّى ينفعل ويتصوَّر؛ وما فرَضَه «إلهاً» هكذا، إنّما هو مخلوقٌ مثله، لا غير، وإن سمّاه «إلهاً». وأمّا دعواه بأنّ الإنسانَ هو «إرادةٌ حرّةٌ»، فهي مغالطة سافرة؛ لأنّه إن كانت هذه «الإرادة» ناشئة من «طبيعة الإنسان» ومادّيّته، فهي لغوٌ؛ لأنّ المادّة مقصورةٌ على الحركة، وفاقد الشيء لا يعطيه. وبعبارة أخرى، المادّة حصيلة ذرّات، والذرّات لا «إرادةَ» لها في حركتها. وعليه، فنحن نسأل «سارتر»: ما هو منشأ «حرّيّة الإنسان»؟
لا مناص من الاعتراف بوجود قدرة فوق قدرة الطبيعة، وأنّ الإنسان أقدر على تسييس هذه الطبيعة وتذليلها، فلا معنى للقول بأنّه ليس الإنسان «نفسٌ» و«ذات» إلّا «الإرادة». نعم، قول «سارتر» بأنّ الإنسان لا «طبيعة» له، وأنّه هو الّذي يكيِّف «نفسَه» ويصوّرها كما يحلو له، هو قولٌ صحيحٌ إلى حدٍّ ما، وقد صرَّح حكماء الإسلام وفلاسفته بهذا؛ فالإنسان ليس كبقيّة المخلوقات، أسيرَ «الخِلقة الأولى». ولا تحسبنَّ أنّنا بهذا نوافق «سارتر» في أنّ الإنسان لا ماهيّة له ولا طبيعة؛ كلّا، ما هذا أردنا، بل أردنا القول بأنّ الإنسان «ماهيّة» ذات استعداد واقتضاء لأنْ تكون كما يريد الإنسان، وهذا الموضوع بحثه علماؤنا بحثاً مستوفياً، وأفضلَ ممّا ذكره «سارتر»، ولا سيّما «صدر المتألّهين»، حيث له القدح المعلى. وهي فكرة لها جذور قرآنيّة، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾.
فمِن الناس من يُحشَر «إنساناً»، ومنهم من يُحشَر ذئباً أو كلباً أو خنزيراً أو أقبح، وهذا يدور مدار الـمَلَكات المكتَسَبة وأطوار النفس حين موتها. وما ألطف قول الشاعر «مولوي»:
أيّها الأخ، أنت لست إلّا فكراً،
لست عظماً ولا شعراً
فإن كان فكرك خيراً صرت إلى جنّةٍ؛
وإن كان شرّاً، صرت حطباً في الآتون
فلو سألنا الشاعر: ما هو الإنسان؟ لأجاب: هو ما يفكّر فيه. فإن كان يُفكر في «الحقيقة»، فهو «حقيقة»، وإن كان يُفكّر في «الله» دائباً في طاعته، فهو مَثَل «الله» وظلّه، وإن كان يفكّر في «عليّ» ويحذو حذوَه، فهو «عليٌّ»، وإن كان يُفكّر أو يعمل عمل «الكلب»، فهو «كلب»؛ ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾.
باختصار: قل لي بِمَ تُفكّر، أقُل لك مَن أنت.
إذاً، حقيقة الإنسان هو ما يعيشه فكراً وسلوكاً، والنصوص الإسلاميّة صريحةٌ في هذا. فقد جاء أنّ مَن أحبَّ حجراً حشره الله معه ؛ والمعنى أنّ مُحبَّ الحجر يُحشَر حجراً؛ لأنّه لا معنى لحشر الحجر. وذكرَت كتب الأخبار أيضاً، أنّ خراسانيّاً يتموَّج حبّاً لأهل البيت (عليهم السلام)، قطع الطريق إلى المدينة المنوّرة سيراً على قدمَيه، وقد تورَّمَت قدماه وتشقّقتا، فلمّا دخل على أبي جعفر (عليه السلام)، قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ، مَا جَاءَ بِي مِنْ حَيْثُ جِئْتُ إِلَّا حُبُّكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ. فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): «وَاللَّهِ، لَوْ أَحَبَّنَا حَجَرٌ حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَنَا؛ وَهَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ؟».
ولا فُضَّ فوه الشاعر إذ يقول:
إن كنت طالباً جوهرَ التراب، فأنت تراب
وإن كنت طالباً الروح، فأنت روح خالدة
أنا سأُعلن الحقيقة
حقيقتك هو ما تطلبه وتسعى إليه، فاختر لنفسك.
لماذا يحتاج الإنسان للأخلاق؟
لماذا الإصرار على أن يكون للإنسان سلوك خاصّ وتربية خاصّة وطبيعة خاصّة، ونُسمِّيها «خُلُقاً»؟ ما هي ضرورة ذلك؟ ولِمَ صار ذلك ضروريّاً؟
الحقّ إنّ الإجابة عن هذه التساؤلات تتطلّب بحثاً مستقلاً؛ لكون ذلك مرتبطاً بالبناء الخُلقيّ الّذي أُوجِدَ عليه الإنسان؛ إذ إنّه ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾. صحيح أنّ الخالق الحكيم قد خلق كلّ حيوان مزوَّداً بغرائز وقوى تناسب حياته الأرضيّة، لكنّ الإنسان، على الرغم من تمتُّعه بالاستعداد للترقّي والتكامل الروحيّ، إلّا أنّه خُلِق ضعيفاً من حيث الطبائع الأوّليّة والغرائز اللازمة لحياته الأرضيّة. لكن، في المقابل، قد زُوِّدَ بما يمكّنه من أن يختار به الخُلق المناسب، ككائن مكرَّم ومسؤول مكلَّف، وبهذا يسدُّ النقص ويرفع الضعف. ووظيفة المربّين هي مساعدة الإنسان في تكميل نفسه، وتخليصها من ضعفها الطبيعيّ، وهذا ما يرمي إليه قول الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله): «بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق»؛ أي إكمال الخصال الحميدة والصفات الاكتسابيّة المرهون بها سعادة الإنسان. فالإنسان يبدأ مسيرته ضعيفاً، لكن بالتربية الرشيدة المبنيّة على الأخلاق القويمة، وبما أُوتِيَ من إرادة وفكر، يتجاوز هذا الضعف إلى القوّة، وينطلق من النقص إلى الكمال الممكن له.
نوعان من الأخلاق
منظِّرو الأخلاق فريقان:
فريقٌ يقيم أخلاقَه على الأنانيّة وحبّ الذات، آخذاً بما يُقال له «تنازُع البقاء»، وأنّ الأقوى هو الأبقى، فهو يحرص على تقوية ذاته فقط، ومن هؤلاء «نيتشه» (Friedrich Nietzsche)، فإنّه يقول بصراحة: إنّ القوّة وحدها هي أساس الأخلاق. وكذلك هي طبيعة «الأخلاق الشيوعيّة»، فإنّ أساسها المنفعة الشخصيّة.
وفريقٌ يعطي للأخلاق قيمةً ذاتيّة، ويعدّها عدوّاً «للذات» و«الأنا»، ومحاربة لها. فالصدق والأمانة وغيرهما أمور حَسَنة، ولا ينبغي التفريط فيها لحساب «الذات»، بل يجب أن تُداس «الذات» لأجلها.
وبهذا يتّضح لنا أنّ مسألة «النفس» في باب الأخلاق مسألةٌ مهمّة، وهي حدٌّ فاصِلٌ بين اتّجاهَين مختلفَين.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 ﴿غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ هل هو تكرار؟
﴿غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ هل هو تكرار؟
الشيخ محمد صنقور
-
 (وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ)؟!
(وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ)؟!
الشيخ مرتضى الباشا
-
 ما هي ليلة القدر
ما هي ليلة القدر
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 لماذا يصاب المسافر بالأرق ويعاني من صعوبة في للنوم؟
لماذا يصاب المسافر بالأرق ويعاني من صعوبة في للنوم؟
عدنان الحاجي
-
 معنى سلام ليلة القدر
معنى سلام ليلة القدر
السيد محمد حسين الطهراني
-
 لأجل ليلة القدر، الأخلاق الفاضلة وقوة النفس
لأجل ليلة القدر، الأخلاق الفاضلة وقوة النفس
السيد عباس نور الدين
-
 معنى (نكل) في القرآن الكريم
معنى (نكل) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 مميّزات الصّيام
مميّزات الصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
الشعراء
-
 عرجت روح عليّ وا أمير المؤمنين
عرجت روح عليّ وا أمير المؤمنين
حسين حسن آل جامع
-
 جرح في عيون الفجر
جرح في عيون الفجر
فريد عبد الله النمر
-
 من لركن الدين بغيًا هدما
من لركن الدين بغيًا هدما
الشيخ علي الجشي
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

الصوم رائض وواعظ
-

علماء يطورون أدمغة مصغرة، ثم يدربونها على حل مشكلة هندسية
-

العدد الحادي والأربعون من مجلّة الاستغراب
-

إحياء ليلة القدر الكبرى في المنطقة
-

المساواة في شهر العدالة
-
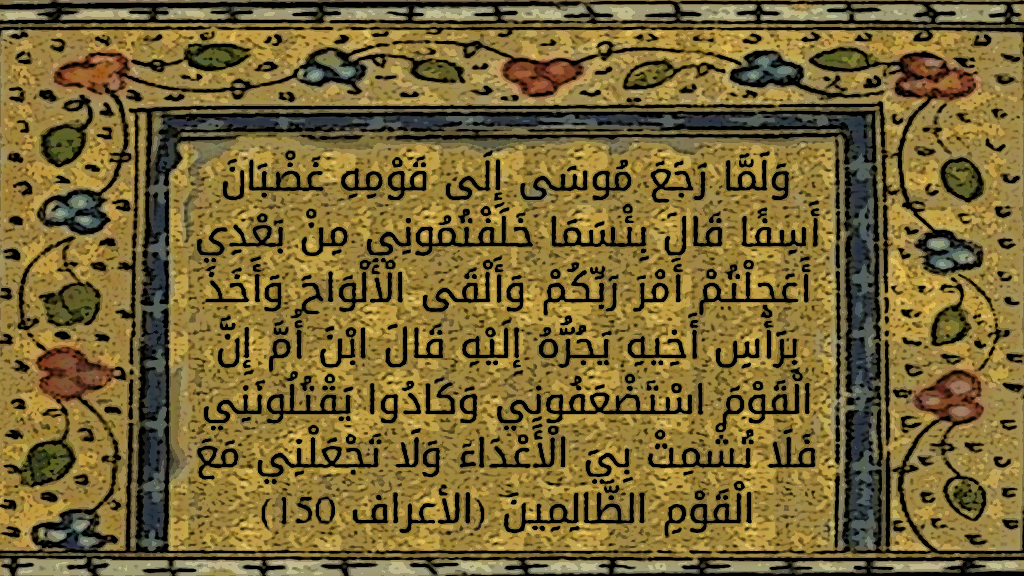
﴿غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ هل هو تكرار؟
-
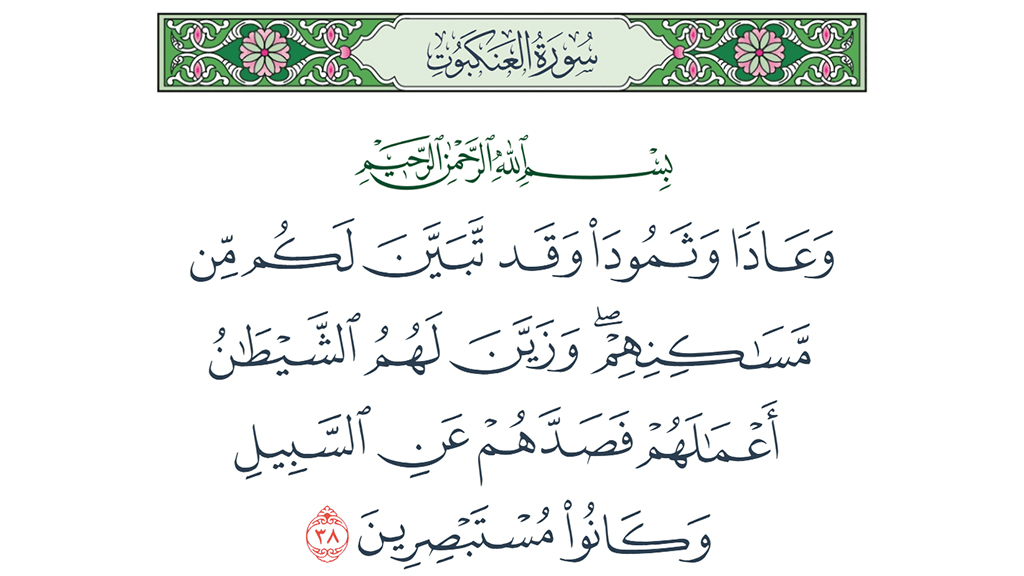
(وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ)؟!
-

شرح دعاء اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان
-

ما هي ليلة القدر
-

لماذا يصاب المسافر بالأرق ويعاني من صعوبة في للنوم؟










