علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".حيث تولد العلمنة من رحم الدّين

لا ينفسح الضباب عن صورة العلمنة، إلا إذا وضعت في مقابل الدين. ولقد دلتنا التجربة التاريخية في الغرب، على أنها ولدت من الرحم الحار للديانتين اليهودية والمسيحية. ولذا فإن العلمنة بهذه الصورة ما كانت لتتخذ ماهيتها وهويتها، إلا ضمن لعبة يحتل الدين فيها مكانة محورية.
المفارقة الجوهرية في ولادة العلمنة، أنها تلازمت وتزامنت وتبلورت مع حركة الإصلاح الديني، ابتداءً من القرن الخامس عشر الميلادي. حتى لجاز القول إنه لولا هذا الاحتدام في فضاء المسيحية، ما كان لنظرية العلمنة أن تجد لها سبيلاً للظهور.
الحادث التاريخي المؤسس لهذه المفارقة، جرى في إسبانيا من خلال ثلاث وقائع سيكون لها أثر هائل في قلب أوروبا وعقلها على مدى ثلاثة قرون لاحقة.
الأولى: حين تمكنت جيوش الملك فرديناند والملكة إيزابيلا، من هزيمة دولة المدينة في غرناطة، وهي المعقل الإسلامي الأخير في العالم المسيحي.
الثانية: حين وقّع فرديناند وإيزابيلا مرسوم الطرد، الذي أصدراه لتخليص إسبانيا من اليهود الذين خُيّروا بين قبول التعميد أو الطرد.
الثالثة: حين أبحر كريستوف كولومبوس في شهر أغسطس من ذلك العام، انطلاقاً من السواحل الإسبانية ليكتشف أرض المسيح في أميركا الشمالية.
في أواخر القرن الخامس عشر لم يكن باستطاعة الأوروبيين بمن فيهم الإسبان، التنبؤ بفداحة التغيّر الذي دشنوه. فما جرى في إسبانيا حيث تأسست أول إمبراطورية مركزية حديثة للعالم المسيحي، سوف لن يتوقف مفعوله على إطلاق ثورة سياسية واقتصادية، بل سينجز ثورة ثقافية معرفية بعيدة الأثر.
وستغدو العقلانية العلمية هي المنظومة التي تحكم مناهج التفكير. كانت المسيحية تتغير رغم كل محاولات الإطاحة بمنظومتها اللاهوتية، ولذا سنرى أن المساهمة الإسبانية الرئيسية في حركة الإصلاح، كانت ذات سمة صوفية. فقد أصبح مستكشفو العالم الروحي هم متصوفو شبه الجزيرة الإيبيرية، تماماً كما كان الملاحون يكتشفون بالتوازي مناطق جديدة من العالم المادي.
كانت العلمنة متضمنة، بوعي أو بغير وعي، في الإصلاح البروتستانتي، وسنجد ذلك على نحو بيِّن من استقراء إجمالي لرحلة الاحتدام المرير مع الكاثوليكية. فقد طور البروتستانت ما أسموه الإنجيل الاجتماعي، لكي يضفوا القداسة على المدن والمصانع التي لا ربَّ لها. وهذا "الإنجيل" هو ما يمكن أن نسميه "لاهوت العلمنة"، كما سنرى بعد قليل...
لنقرأ هذه القصة: في عام 1909 ألقى الاستاذ المتقاعد من جامعة هارفارد، جورج إليوت، خطاباً بعنوان "مستقبل الدين" أوقع اليأس في قلوب من هم أكثر محافظة. فالدين الجديد ـ كما اعتقد إليوت ـ ستكون لديه وصية واحدة هي: حب الله الذي يلقى تعبيراً عنه في خدمة الآخرين عملياً. فلن تكون فيه كنائس أو كتب مقدسة.
ولا لاهوت حول الخطيئة، ولا حاجة للعبادة، فحضور الله سيكون جلياً جداً وغامراً تابعيه، لدرجة أنه لن تكون هناك حاجة إلى طقس القربان المقدس. مع هذا الإنجيل لن يدعي المسيحيون احتكار الحقيقة، لأن أفكار العلماء، والعلمانيين، أو من ينتمون إلى دين مختلف، ستكون سارية فيه تماماً كما هو سريان الحقيقة المسيحية. الدين المستقبلي ـ في اهتمامه بالآخرين ـ لن يكون مختلفاً عن المثل العليا، كالديمقراطية والتعليم والإصلاح الاجتماعي والطب الوقائي.
كان إليوت يحاول ـ عبر هذه المخاطرة ـ العودة إلى ما كان يعتبره حقيقة الإنجيلي الأصلي، وذلك من خلال البحث عن تجاوز المعتقد وتخطيه: حب الله ومحبة الجار.
قامت نظرية الإصلاح الديني على قاعدة لاهوتية، قوامها الجمع بين الإيمان بالله والإيمان بالعالم، مع إسقاط العصمة عن سلطة الكنيسة. وقد تبلورت هذه النظرية مع مارتن لوثر (1483 1556) وجون كالفن (1509-1564) وهولدريش زفينغلي (1484 1531)، الذين عادوا إلى منابع التراث المسيحي.
شدد لوثر على أهمية الإيمان، لكنه رفض العقل بشدة لأنه يؤدي إلى الإلحاد. في مؤلفات لوثر، كان الإله قد بدأ ينسحب من العالم المادي الذي لم يعد له أهمية إطلاقاً، وهذا ما دفعه إلى علمنة السياسة. وحسب تصوره فإن الكنيسة والدولة يجب أن تعملا مستقلتين عن بعضهما، وأن تحترم كل منهما العالم الملائم لنشاطها، وسنرى تبعاً لذلك، كيف أن هذه الرؤية ستجعل لوثر من أوائل الأوروبيين المدافعين عن فصل الكنيسة عن الدولة، فقد جاءت علمنة السياسة عنده بمثابة طريقة جديدة للتدين.
أما كالفن وزفينغلي فذهبا أبعد مما ذهب إليه "المعلم" في التأسيس اللاهوتي للعلمنة. آمنا بضرورة الجمع بين وحيانية الكتاب المقدس، وواقعية الحياة البشرية. لقد وجدا أن على المسيحيين أن يعبّروا عن إيمانهم بالمشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية، بدلاً من الانسحاب إلى داخل الدير. وأن يقدّسوا العمل من خلال تعميد أخلاق رأس المال الصاعد، فالعمل هو سعي مقدس نحو الألوهة، وليس عقاباً إلهياً على الخطيئة الآدمية الأولى. تضيء لنا هذه المقدمات على حقيقة أن العلمنة التي كانت تنمو ببطء في أوروبا، لم يكن نموها خارج سيرورة الإصلاح الديني.
في مثل هذه الحال، بدت الصورة وكأن البروتستانتية المحتجة لاهوتياً على إكراهات الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، هي التي فتحت الباب العالي لنظرية العلمنة ولثورتها الشاملة فيما بعد. وسيأتي من رواد حركة الحداثة من يضفي على هذه الصورة مشروعيتها العلمية.
ففي مستهل الحداثة، شارك العالم الفلكي الهولندي كوبرنيكوس (1473 1543) كالفن رؤيته اللاهوتية المعلمنة، لما قال إن ما أنجزته حول مركزية الشمس، هو أكثر إلهية مما هو بشري. أما غاليلي الذي اختبر فرضية كوبرنيكوس عملياً، فقد كان مقتنعاً بأن ما أنجزه كان نعمة إلهية. كذلك سيحذو إسحق نيوتن (1642 1727) حذو نظيريه. حيث أعرب عن قناعته بأن فكرة الجاذبية كقوة كونية، تجعل الكون كله متماسكاً وتمنع الأجرام السماوية من الاصطدام ببعضهما، وبأن ما توصل إليه يثبت وجود الله العظيم ميكانيكياً. وهكذا سنستمع إلى آينشتاين وهو يعلن في أواخر عمره، أن الله ما كان يلعب النرد وهو يهندس الكون الأعظم.
لكن المفارقة التي نلحظها في التساوق بين الإصلاح الديني وحركة الحداثة، هي: مصالحة الاعتقاد بالله مع العلم، وتناقضه مع الفكر الديني وسلطة الكنيسة في الآن عينه.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 خصائص الصيام (1)
خصائص الصيام (1)
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الشيخ محمد صنقور
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 معرفة الإنسان في القرآن (6)
معرفة الإنسان في القرآن (6)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (فور) في القرآن الكريم
معنى (فور) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

خصائص الصيام (1)
-

الموانع من حضور الضيافة الإلهية
-

البعث والإحياء بعد الموت
-

حديث للاختصاصيّ النّفسيّ أسعد النمر حول توظيف التّقنية في العلاج النّفسيّ
-

التقوى، العطاء، الإيثار في شهر رمضان
-

شرح دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان
-
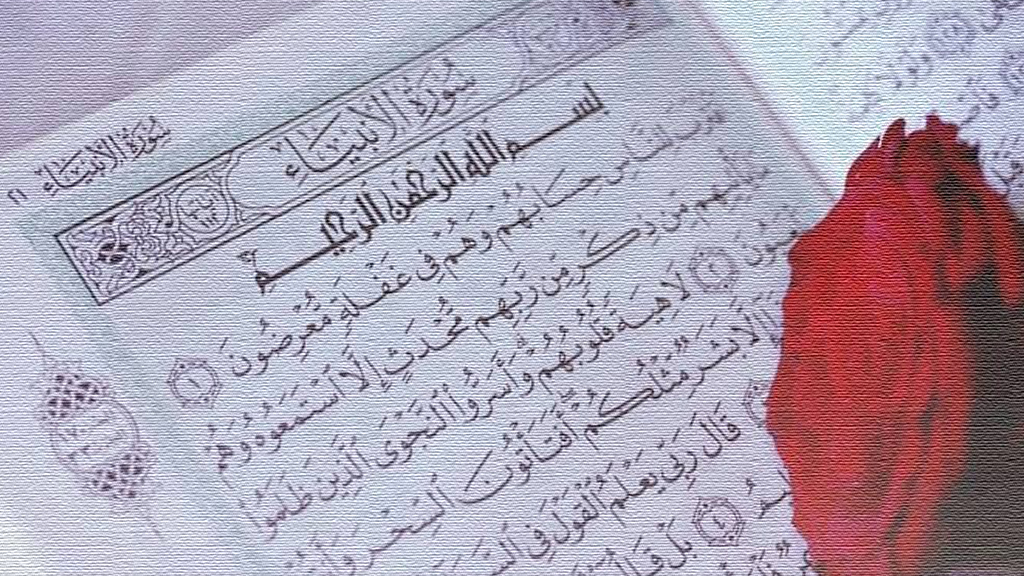
معرفة الإنسان في القرآن (6)
-

شرح دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان
-

لقاء الرحمة والعبادة
-

معنى (فور) في القرآن الكريم










