علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
د. سيد جاسم العلويعن الكاتب :
كاتب ومؤلف في العلوم الفيزيائية والفلسفية، حاصل على البكالوريوس و الماجستير في علم الفيزياء من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن حاصل على الدكتوراه من جامعة درهم (بريطانيا) في الفيزياء الرياضية.النظريَّة الكميَّة في ميزان المذهب الذاتي (٢-٢)

د. جاسم العلوي ..
مِن الثَّابت لدى جميع من يتبنَّى بالكامل نظرية السيِّد الشهيد في الاستقراء ومذهبها الذاتي، أو الذين لا يستطيعون أن يذهبوا معها إلى أقصى ما تصل إليه -أعني بذلك نقل القيمة الاحتمالية العالية للاستقراء إلى يقين- وهو ما عبَّر عنه بالجانب الذاتي من المعرفة، والذي معظم علومنا تتشكل على أساسه، أنَّ الاستقراء ليس له حلًّا قياسيًّا استنباطيًّا.
إنَّ أرسطو أراد للتجربة أن تصل إلى اليقين؛ اعتماداً على تحويل الاستقراء إلى قياس يستمد كبراه مما افترضه المنطق الأرسطي مُسلَّمة عقلية أولية تنفي أن يكون الاتفاق أكثريًّا أو دائميًّا، وتستمد صغراه من التجارب التي تتحرك -مع تكرارها- في الاتجاه الذي ينفي الصدفة النسبية، ويؤكد أو يكشف في الوقت ذاته عن سببية إحدى الظواهر للأخرى. لكنَّ السيد الشهيد قد تنبَّه إلى أنَّ ما يفترضه المنطق الأرسطي مُسلمة عقلية يرتكز عليها في تشكيل كبرى القياس الخفي المبطن في الاستقراء، هو في حقيقته ليس مبدأ عقليًّا قبليًّا. إنَّ القليلَ من التدقيق في هذه الفرضية -وكما أشار السيد الشهيد في كتابه الأسس- يتَّضح لنا أن هذه المسلمة ليست كذلك؛ ذلك لأنَّ المبدأ الأرسطي لا ينفي تكرار الصدفة على مستوى الوقوع؛ أي أنَّ الواقع العملي ومن خلال الممارسة وبالاستقراء نفسه يُمكن لنا أن نتأكد -من هذه الحقيقة- عدم تكرار الصدفة في الواقع. لكن أراد بهذا المبدأ نفي إمكان تكرار الصدفة وإثبات استحالة تكرارها.
وعندما نُقارن بين درجة القوة والإيمان بهذه المسلمة “الاتفاق لا يكون دائميًّا أو أكثريًّا”، وبين درجة القوة والإيمان بالمسلمة العقلية التي تنفي اجتماع النقيضين؛ مثلاً نرى أنَّ العقلَ النظريَّ والعمليَّ للإنسان مجهَّز؛ بحيث يقبل بهذه الحقيقة دون أدنى شك. ولكن عندما نتأمل في المسلمة الأرسطية لا نستطيع أن نلمس ذلك الزخم أو الحضور في النفس التي تجعلها في نفس الدرجة والمساواة مع المسلمة التي تنفي اجتماع النقيضين. إنَّ المسلمة الأرسطية تفتقد ذاتيًّا لعنصر الضرورة في نظام الكون، كما هي الحال في مسلمة نفي اجتماع النقيضين التي هي ضرورة في نظام الكون وحركة الفكر. إننا يُمكن أن نتصوَّر عالماً تقترن فيه الظواهر بالصدف النسبية، ولكننا لا يُمكن أن نتصوَّر عالماً تتعايش فيه الأشياء مع نقائضها في المكان والزمان نفسه.
وعلى ضوء المقالة السابقة، يتبيَّن أنَّ المبدأ الأرسطي يقوم على أساس نفي غير مُحدَّد العدد والنوع والزمان. فنحن لا نستطيع أن نحدِّد طبيعة هذه الصدفة، وأين يمكن أن تحدث، وعدد المرات التي يمكن أن تتكرَّر فيها. وتقوم الاعتراضات الموجهة لهذا المبدأ على هذا النفي غير محدد الهوية والعدد والزمان في إبطال كون المبدأ الأرسطي علماً إجماليًّا قبليًّا قائمًا على أساس التضاد والتمانع، أو على أساس الاشتباه كما بيَّنا في المقالة السابقة.
وسوف نقوم بتسجيل اعتراضات السيد الشهيد عندما نفصل في المعنى المقصود من العلم الإجمالي القائم على أساس التضاد والتمانع أو على أساس الاشتباه.
قد ينشأ العلم الإجمالي من إدراكنا بأنَّ بَيْن الأشياء تضاد وتمانع، فلا يمكن لها أن توجد جميعاً؛ فعند رمي قطعة نقود نعلم مسبقاً إما وجه الكتابة سيظهر أو وجه الصورة، وعلمنا هنا مردِّد بين الوجهين، ولإدراكنا التمانع بين الوجهين نعلم أنه لا يمكن لهما أن يظهرا معًا. هذا العلم الإجمالي يتحوَّل إلى علم تفصيلي محدد إذا أتيح لنا أن نطلع على الوجه الذي سقطت عليه قطعة النقود. عندئذ يُمكن لنا أن نعلم بشكل مفصل ومحدد -غير مردد- أو أن ننفي بصورة محددة الوجه الذي لم يظهر. ولنا هنا أن نتساءل: هل يُوجد بين الصدف المتماثلة تمانع ذاتي لا يجعلها تتكرر في تجربة؟ فلو افترضنا أن (أ) هي سبب (ب)، وأن (ت) ترمز إلى أي شيء ليس له علاقة سببية في وجود (ب)، غير أنه يظهر في التجربة كصدفة نسبية. إن المبدأ الأرسطي يُقرِّر مسبقاً أن (ت) لن تقترن بـ(ب) باستمرار على خط طويل. وإذا افترضنا أن هذا الخط الطويل الذي لم يحدده أرسطو يعبر عن عشر تجارب متتالية، فإنَّ (ت) لن تقترن بـ(ب) على الأقل في تجربة واحدة من هذه التجارب العشرة، بينما ستظهر (أ) في كل التجارب العشرة؛ الأمر الذي يجعلنا نتأكد من سببية (أ) لـ(ب). لكننا ندرك أن عدم ظهور (ت) في التجارب العشرة لا يرجع إلى وجود تمانع ذاتي بين جميع التاءات. فإذا لم تكن على هناك سبيل المثال علاقة بين شرب اللبن وظهور الصداع، واخترنا عشوائياً عشرة أشخاص وأعطيناهم لبناً، فإنَّ ظهور الصداع لن يحدث في واحد من الأشخاص العشرة. لكننا ندرك أنه من الممكن للصداع أن يظهر فيهم جميعاً لعدم وجود تمانع الذاتي في تكرار ظهور الصداع. فالمبدأ الأرسطي إذن ليس علماً إجماليًّا يقوم على أساس التمانع أو التضاد. (الاعتراض الثاني).
وإذا افترضنا أنَّ الصداع قد ظهر بشكل متتابع في تسعة أشخاص من بين العشرة الذين اخترناهم بشكل عشوائي، فهل سيعجز المجرب عن الاختيار العشوائي للشخص العاشر بحيث لا يظهر فيه الصداع حتى لا تتكرَّر الصدفة عشر مرات متتالية؟ إذاً يتبيَّن أنَّ فرضية التضاد أو التمانع إذا طبقناها على الاقتران الذاتي الذي هو الاختيار العشوائي للمجرب وظهور (ت) (ظهور الصداع كما في المثال)؛ فسنجد أنَّها لا تنطبق. وكذلك عندما نقوم بالاختيار الواعي للأشخاص الذين يتوافر فيهم ظهور الصداع، ونعطيهم لبناً، فسنحصل حينئذ على أي عدد من الاقترانات الموضوعية بين شرب اللبن وظهور الصداع دون أن يكون بينها أي تضاد أو تمانع يحول دون حدوثها. (الاعتراض الأول).
إنَّنا نواجه إحدى حالتين بالنسبة لــ(ي) -تعبِّر (ي) عن سبب آخر غير (أ) في وجود (ب)- الأولى أن نكون متأكدين من عدم وجودها؛ ففي هذه الحالة لا نحتاج إلا أن نجري تجربة واحدة حتى نتأكد من سببية (أ) إلى (ب). الثانية أن يكون حدوثها محتملاً. وهنا نلحظ أنه كلما كبر احتمال (ي) كان ميلنا للاعتقاد بسببية (أ) إلى (ب) أبطأ والعكس صحيح. لذلك فإنَّ الميل إلى الاعتقاد بسببية (أ) لـ(ب) يتناسب عكساً مع مقدار احتمالات وجود (ي). ولكن المبدأ الأرسطي لا يستطيع أن يفسر لنا كيفية تأثر الاستقراء باحتمال وجود (ي)؛ لأن الاستدلال الاستقرائي يعبِّر عن علم أولي قبلي بأن الصدفة لا تتكرَّر على المدى الطويل دون أن يكون لمقدار احتمال (ي) أي تأثير. بينما تتأثر سببية (ب) باحتمال وجود (ي)؛ ففي الحالة التي لا نعلم أن لـ(ب) أسبابا أخرى في الطبيعة سوف يكون ميلنا للاعتقاد بسببية (أ) لـ(ب) أكبر منه فيما إذا كنا نعلم أنَّ لها أسبابًا، غير أننا لا نعلم بوجودها في التجارب. (الاعتراض السادس).
إنَّ (ت) يمكن أن تقترن بـ(ب) في تسع تجارب متتابعة، لكنها بحسب المبدأ الأرسطي لن تقترن في التجربة العاشرة من أجل العلم بأنَّ الصدفة النسبية لا تتكرَّر في عشر تجارب متتابعة. لو كانت الصدفة النسبية لا تتكرر في عشر تجارب متتابعة يُشكل علماً عقليًّا سابقًا عن التجربة والاستقراء، لكننا نعتقد على نحو الجزم بالقضية الشرطية القائلة بأنه لو وجدت الصدفة النسبية في تسع تجارب متتابعة، فإنها لن توجد في العاشرة. ونحن رغم ميلنا للاعتقاد بأن (ت) لن توجد في التجربة العاشرة إذا تكررت في تسع تجارب متتابعة، إلا أنَّنا لا نعتقد بتلك القضية الشرطية مما يدل على أنها ليست مبدأً عقلياً قبلياً. (الاعتراض السابع).
إذا كانت (أ) تسبِّب (ب)، فإن (أ) ستظهر في عشر تجارب متتابعة، لكن لو أن أحداً وبدون علمنا قد أدخل في التجربة شيئاً يمنع ظهور (أ) في التجربة العاشرة، فإن إيماننا بأن (أ) هي سبب لـ(ب) سيزول. ورغم أننا قد اكتشفنا بعد ذلك أنَّ أحداً قد تدخل في سير التجربة ومنع (أ) من الظهور، فإن علمنا بالسببية (أ) لـ(ب) سيزول أيضاً؛ لأننا نقف أمام تسع حالات ناجحة فقط. والمنطق الأرسطي لا يمكن له على ضوء طريقته أن يفسر لنا كيف تزعزع علمنا بسببية (أ) لـ(ب) لمجرد علمنا بأن عاملا خارجيا قد أدخل في التجربة. فلو كان المبدأ الأرسطي يعبر عن معرفة أولية تنفي تكرار الصدفة في عشر تجارب متتابعة لما تزلزل إيماننا به لمجرد معرفتنا بأن شيئاً ما قد أثر على سير التجربة. (الاعتراض الخامس).
أمَّا العلم الإجمالي الذي يقوم على أساس الاشتباه، فهو أن نعلم أن شيئاً ما محدداً في الواقع لكنه اشتبه علينا، كأن نعلم أنَّ أحد الطلاب قد رسب إما في المنطق أو الرياضيات، فيكون علمه قد نشأ على أساس الاشتباه؛ لأنه لا يوجد أي تمانع ذاتي بين الاثنين. وعندما يطلع الطالب على المادة التي رسب فيها يتحول علمه الإجمالي إلى تفصيلي. لكننا عندما نفترض الشك في أصل واقعة رسوب الطالب، فإنَّ ذلك يكون سبباً لزوال العلم الإجمالي. ولكن لا يوجد في الواقع صدفة محددة يُمكن أن يُشار إليها بصورة غير محددة تكون الأساس للعلم الإجمالي. (الاعتراض الثالث).
… إنَّ المبدأ الأرسطي الذي يُقرِّر عدم وقوع الصدفة النسبية في عشر تجارب متتابعة، فإنْ كان المبدأ يُقرِّر عدم الوقوع فحسب فهو ليس علماً عقليًّا قبليًّا؛ لأن العلم العقلي القبلي يجب أن يكشف عن ضرورة ثبوت الموضوع للمحمول أو نفيه عنه. أما إذا كان يعني ضرورة عدم الوقوع فالضرورة إما أن تكون ذاتية أو عرضية. فإنْ كانت ذاتية فهي التي يلزم فيها ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه. وإن كان المبدأ الأرسطي يمثل علماً بضرورة عدم الوقوع، فإن هذه الضرورة إما أن تكون ذاتية أو عرضية. فإذا كان لأي صدفة نسبية أن تقع إذا توافر سببها الكافي فلا مجال للقبول بالضرورة الذاتية؛ إذ صار بالإمكان التفكيك بين المحمول والموضوع. إننا لا نجد استحالة في ظهور الصداع في الأشخاص العشرة عند تناولهم للبن رغم عدم وجود علاقة سببية بين الصداع واللبن. وإما أن تكون الضرورة عرضية، ففي هذه الحالة يتوقف ثبوت المحمول للموضوع على سبب (حد أوسط). ويكون إدراكنا للسبب الذي يمنع تكرار الصدفة على المدى الطويل سببًا للإيمان بالمبدأ والتسليم به على أساس أنه علم عقلي من النوع الذي تحتاج فيه القضايا إلى توسط حد يربط بين محمولاتها وموضوعاتها. فإذا كان عدم تكرار وقوع الصدفة ناشئا عن عدم وجود السبب الكافي؛ فهذا يعني أنَّ المبدأ الأرسطي ليس علماً عقلياً؛ لأن العلم بعدم تكرار وقوع الصدفة غير مرتبط بفكرة مسبقة عن السبب، فعلى الرغم من أننا لا نعلم بأسباب الصداع، إلا أننا نعلم بأنه لن يقترن صدفة بشرب اللبن في جميع الحالات التي تجري عليها التجربة. (الاعتراض الرابع).
يُمكن لنا أن نستنتج مما سبق النقاط المهمة التالية:
– أنَّ العلم الإجمالي علم محدد في الواقع، لكنه غير محدد في علمنا.
– الاطلاع على الواقع هو الذي يحول علمنا الإجمالي المردد إلى علم يطابق الواقع ويعكس تفاصيله كاملة.
– إنَّ الشك في أصل الواقعة المحددة والتي قد يشار إليها بطريقة غامضة، مما يخلق لدينا علما إجماليا يقوم على أساس الاشتباه، قد يكون سبباً لزوال العلم الإجمالي كالشك في أصل رسوب الطالب -كما في المثال السابق- يؤدي إلى زوال العلم الإجمالي.
– لا نملك في الواقع صدفة محددة تكون النواة لعلم إجمالي، والشك فيها يؤدي إلى زوال العلم الإجمالي.
– إنَّ الصدف النسبية المتماثلة ليس بينها تمانع ذاتي يُبرر عدم ظهورها في التجارب على المدى الطويل.
– المنطق الأرسطي لا يستطيع أن يفسر على أساس طريقته في تبرير الاستقراء: كيف يتأثر اعتقادنا بسببية (أ) لـ(ب) بدرجة احتمال (ي) -(ي) تمثل أي سبب آخر غير (أ) في وجود (ب).
– المبدأ الأرسطي ليس علماً عقليًّا قبليًّا؛ لأنه لا يعبِّر عن ضرورة ذاتية أو عرضية بين تكرار التجربة وعدم تكرار الصدفة النسبية فيها.
المشكلة الاستقرائية على ضوء المذهب التجريبي
عندما يُحدِّد مذهب ما الإطار المرجعي لنظريته، فإنه يُؤسِّس المفاهيم لتتوافق مع ذلك الإطار المرجعي. لذا؛ فإنَّ المذهب التجريبي باعتماده التجربة والحس أصلاً، فإنه يُؤسِّس مفاهيمه انطلاقاً من ذلك الأصل؛ فإذا كانت السببية في المفهوم العقلي هي علاقة الضرورة والتأثير بحيث تكون (أ) ضرورة وجودية لـ(ب)، فإن فكرة الضرورة تغيب عندما نتناول السببية بمفهومها التجريبي؛ إذ لا أحد يستطيع أن يقيس الضرورة في المختبر. ومن هنا، فإنَّ السببية وفق ذلك الإطار المرجعي التجريبي لا تعني سوى علاقة زمانية ذات طابع استمراري مطرد بين شيئين.
تتباين المواقف من الدليل الاستقرائي ضمن التيار العريض الذي يرى في التجربة الحسية الرافد الأوحد الذي يستقي الإنسان منه كافة معارفه ومعلوماته. وتوجد ضمن التفسيرات الخاصة بالمذهب التجريبي ثلاثة اتجاهات رئيسية:
* اتجاه اليقين: وهو الاتجاه الذي يرى في الدليل الاستقرائي القدرة على الوصول إلى اليقين؛ حيث تبلغ درجة التصديق بالقضية الاستقرائية حد الاعتقاد الجازم بها. بمعنى أن الاستقراء يكشف عن الواقع الخارجي العيني بدرجة لا تقبل الشك، ويتصدر هذا الاتجاه الفيلسوف الإنجليزي “جون ستيوارت مل”.
* اتجاه الترجيح: وهو الذي يرى في الاستقراء سبباً في ترجيح القضية الاستقرائية، ولا يبلغ فيه التصديق بالقضية الاستقرائية درجة الجزم بها، بل يوجد على الدوام هامش من التشكيك بصدقها. صحيح أنَّ هذا الهامش قد يصغر تبعاً لتوسع الاستقراء وشموله لعدد أكبر من الحوادث المستقرأة؛ إذ يرفع هذا التجمع العددي للشواهد من سقف الاحتمال، لكنه لا يلغي على الإطلاق ذلك الكسر الصغير الذي يمثل مصدر الشك بصدقها. ويزداد الاحتمال بهذه القضية رجحاناً كلما توسعنا في الاستقراء.
* اتجاه الشك: وهو الاتجاه الذي يفسر الاستقراء؛ بوصفه عادة ذهنية، وهو بالتالي يُشكِّك في القيمة الموضوعية للقضية الاستقرائية ويتصدر هذا الاتجاه الفيلسوف (دافيد هيوم).
هذه الاتجاهات الثلاثة -وإن اختلفت في تفسير الاستقراء- تعالج المشكلات الاستقرائية الثلاثة التي استعرضناها في المقالات الثلاثة السابقة داخل أسوار التجربة والحس، وهي بذلك تقدم تفسيرها الخاص للمشكلة الاستقرائية وفق ذلك الإطار التفسيري الذي تبنته للمعرفة البشرية. ومن هنا، فإنَّ المشكلتان الأولى والثالثة وهما السببية التي تفترض أنه لا بد لـ(ب) من سبب والاطراد الذي يحتم استمرار العلاقة بين السبب والمسبب في الزمان عندما تتوافر الشروط الموضوعية؛ لذلك قد أرجعهما المنطق العقلي إلى مجموعة المعارف القبلية السابقة على التجربة. بينما قدم التجريبيون تفسيرهم المنسجم مع الإطار المرجعي الذي يستند إلى الحس كمصدر للمعرفة؛ فالسببية بمفهومها التجريبي تمثل علاقة التتابع الزمني المطرد بين أي حادثتين؛ فالحادثة (أ) يعقبها في الزمان الحادثة (ب)؛ بحيث أنه في كل مرة تتحقق الشروط الموضوعية، نجد أنَّ الحادثة (أ) يعقبها -زمانيًّا- ظهور الحادثة (ب)، دون أن نستوحي من هذه المشاهدة فكرة الضرورة أو اللزومية. وينتج عن هذا الفهم للسببية هو النظر للعلاقات السائدة في عالم الطبيعة بشكل منفرد ومعزول؛ فهي علاقات مستقلة قائمة بين أفراد بشكل مطرد وليست بشكل مفاهيم. إنَّ النظر إلى الأشياء بشكل منفرد وليس ضمن مجموعات؛ بحيث تضم كل مجموعة الأفراد المتشابهة لا يؤسس للمفاهيم الكلية التي ينضوي تحتها عدد من الأفراد يتفقون في صفات معينه. فبينما يتحرَّك العقل بهذا الاتجاه التصنيفي للأشياء، والذي يرى في الفرد معبراً عن الكل، وإن فهم مجموعة علاقات التأثر والتأثير للفرد ضمن الشروط الموضوعية التي تحقق تلك العلاقات، يبرِّر لنا الحكم العام على أن جميع أفراد ذلك النوع ستعطي النتائج نفسها إذا وضعت في الظروف الموضوعية نفسها، نجد أن هذا الرؤية -التجريبية- التي لا تتحرَّك إلا في إطار الحس لا تستطيع أن تتجاوز الفرد إلى المفهوم الكلي الذي يجرده من هويته الفردية الضيقة ليضمه للمجموع.
موقف الاتجاهات الثلاثة من المشكلة الأولى والثالثة:
لقد قدمنا التفسير التجريبي للسببية ضمن الإطار المرجعي لهذا المذهب. وبيَّنا أنَّ السببية بمفهومها التجريبي لا تعني سوى العلاقة الزمانية المتتابعة والمطردة بين الحوادث. ولكن السؤال: لماذا تكون (أ) و(ب) مُتعاقبتان زماناً وبشكل مطرد؟ ولماذا لا تكون (ت) أو (ج) مثلاً هي التي تعقب (أ) زماناً واطراداً؟ قد لا يرى هذا المذهب الحاجة للجواب عن هذا السؤال.
لقد آمن الاتجاه الأول -صاحب النزعة اليقينية- بحاجة الاستقراء لمبادئ السببية، لكنه يرى أنَّ هذه المبادئ هي أيضاً نتاج استقراء أوسع في الطبيعة. وبعد أن أصبحت السببية حقيقة يقينية بفضل الاستقراء أصبح بالإمكان استخدامها في تعميمات استقرائية لاحقة.
أمَّا الاتجاه الترجيحي، فقد آمن بأنَّ الاستقراء بحاجة إلى المصادرات السببية، ولكن إثبات هذه المصادرات غير مُمكن. وبما أنَّ هذه المصادرات لا يُمكن البرهان عليها بالكيفية التي اعتمدها المذهب العقلي؛ حيث اعتبرها مبادئ عقلية قبلية، ولا بالكيفية التي استدل بها الاتجاه الأول، والتي اعتبرها نتاج استقراءات أخرى، فإنَّ الاستقراء لا ينتج يقيناً بل رجحاناً في القضية الاستقرائية. وكلما شمل الاستقراء حوادث أكثر زاد الاحتمال برجحان القضية الاستقرائية.
والاتجاه الثالث ذو النزعة السيكولوجية، فقد أمن بالحاجة إلى هذه المصادرات، ولكنه تبنى تفسيرها على اعتبار نفسي؛ فالسببية التي تنتج العلاقة ذاتها بين قضيتين، والتي تجعل الحاضر يُشبه الماضي، وأن نبرِّر أن ما سيحدث في المستقبل سيكون هو أيضاً شبيها بهما ليس مبرِّراً منطقياً، بل هو مبرر سيكولوجي يسميه “دافيد هيوم” رائد هذا الاتجاه بالتداعي. والمقصود من التداعي هو انتقال الذهن من فكرة إلى أخرى نتيجة للتشابه والتجاور في الزمان أو المكان، والعلة والمعلول. إنَّ مشاهدتنا للماء على النار تثير في ذهننا الفكرة الأخرى عن الغليان. وهذا يعني أنَّ العلاقات العلية تقع حدًّا واحدًا، ينتقل بعدها الذهن للتفكير في الحد الآخر. هذا يعني في نهاية المطاف أنَّ علاقات العلية القائمة بين الأشياء هي مجرد أفكار قائمة في أذهاننا، وليس لها حقيقة موضوعية في الخارج.
موقف الاتجاه الأول والثاني من المشكلة الثانية
أما بالنسبة للمشكلة الثانية وهي إذا كان لـ(ب) سبب، فلماذا يكون (أ) هو السبب وليس (ج) أو (هـ)…إلخ؟ فإنَّ الاتجاه الأول -والذي يؤكد قدرة الاستقراء على الوصول إلى اليقين- لم يتمكن -ومن خلال الطرق العديدة التي وضعها- للتأكد من السببية القائمة بين الحادثتين أو (ب) على سبيل المثال، إلا التقليل من احتمال الصدفة النسبية، ولكنها لا تفسر إمكانية القضاء عليه نهائيًّا.
إنَّ الاتجاه الثاني يؤكد أنَّ الاستقراء يؤدي إلى رجحان العلاقة بين (أ) و(ب)، لكنه لا يقود إلى الجزم بهذه العلاقة. ويوجد ضمن هذا الاتجاه من يُؤمن بحاجة الاستقراء إلى مصادرات خارجة عن التجربة حتى يشكل مبرراً منطقيًّا للاستقراء، كالفيلسوف الإنجليزي “رسل وهناك”، والفيلسوف الدكتور زكي نجيب محمود، وهما لا يرون حاجة الاستقراء إلى مبرر منطقي، عقلي حتى يجوز الحكم بصحة الاستدلال من حوادث الماضي على حوادث المستقبل. ويرى هؤلاء أنَّ ما حدث في الماضي يكون بنفسه سبباً كافياً للحكم على المستقبل، ولكن رجحاناً وليس يقيناً. فهناك فارق بين قضايا العلوم والرياضيات؛ فقضايا العلوم كلها قائمة على الترجيح لا اليقين، ويمكننا -ومن خلال نظرية الاحتمالات- الكشف عن احتمال عالٍ للقضية الاستقرائية.
المذهب الذاتي في المعرفة في إطاره العام
هذا هو المذهب الجديد في المعرفة، والذي بشر به السيد محمد باقر الصدر في كتابه “الأسس المنطقية للاستقراء”. وقبل أن نستعرض الأسس التي يقوم عليها هذا المذهب الجديد، سنقوم بالتمييز بين ثلاثة أنواع من اليقين؛ وهي: اليقين المنطقي والموضوعي والذاتي. إنَّ اليقين المنطقي يختصُّ بالاستدلالات الاستنباطية، وأنَّ العلاقات القائمة في هذا النوع من اليقين لا تقبل التفكيك، فإذا قادنا الدليل الاستنباطي إلى العلاقة القائمة بين (أ) و(ب) فإننا نستطيع أن نجزم بأنه من المستحيل ألا تكون العلاقة غير ذلك. أما اليقين الذاتي، فهو مسألة شخصية وليس لها مقياس موضوعي. أما اليقين الموضوعي، فيتعلق بالاستدلالات الاستقرائية، ويمكن تحقيق اليقين بالقضية الاستقرائية عن طريق تنمية الاحتمال إلى درجة عالية جدًّا من التصديق بالقضية الاستقرائية. إنَّ هذا المذهب -الذي أسماه السيد الصدر بالمذهب الذاتي- يؤكد قدرة الاستقراء على الوصول إلى اليقين الموضوعي. وفي هذا الشكل من اليقين نستطيع أن نؤكد العلاقة القائمة بين (أ) و(ب)، ولكننا لا نستطيع أن نجزم أنه من المستحيل أن يكون الأمر غير ذلك كما هي الحال في اليقين المنطقي. إنَّ هدف السيد محمد باقر الصدر من نظريته الجديدة في المعرفة هو: الوصول بالاستقراء إلى اليقين الموضوعي.
لنعد إلى السؤالين المركزيين في نظرية المعرفة؛ وهما: ما مصادر المعرفة؟ وكيف تنمو؟
… إنَّ المذهب الذاتي في المعرفة يتَّفق مع المذهب العقلي بوجود معارف عقلية قبلية مستقلة عن الحس والتجربة، تشكل الأساس أو القاعدة التي يقوم عليها البناء الفوقي للمعرفة.
ولكنَّ المذهب الذاتي يختلف عن المذهب العقلي في تفسيره للكيفية التي تنمو بها المعرفة.
… إنَّ المذهب العقلي يُؤمن بطريقة واحدة لنمو المعرفة؛ وهي: طريقة التوالد الموضوعي، بينما يؤمن السيد محمد باقر الصدر في مذهبه الذاتي بوجود طريقتين لنمو المعرفة؛ هما: طريقة التوالد الموضوعي والذاتي.
والتوالد الموضوعي يعني أنَّ معرفة جديدة تنشأ للتلازم الموضوعي القائم بين الجانب الموضوعي من المعرفة المولدة والجانب الموضوعي من القضية المتولدة. وهذا التوالد الموضوعي هو الأساس الذي يقوم عليه القياس الأرسطي. ومن أمثلة المعارف المتولدة بطريقة التوالد الموضوعي نظريات إقليدس في الهندسة التي تولدت من بديهيات تلك الهندسة.
أمَّا التوالد الذاتي، فيُقصد به أنه بالإمكان أن تتولد معرفة جديدة دون أن يستلزم ذلك تلازماً موضوعيًّا بين القضيتين المولدة والمتولدة. بل إنَّ المبرِّر لنشوء معرفة من معرفة أخرى هو التلازم بين الجانبين الذاتيين للمعرفة. ويُعتبر هذا النوع من التوالد في الاستدلال الأرسطي خطاً؛ لأن الاستدلال الأرسطي يستهدف النتيجة التي تفضي إلى اليقين المنطقي التي تعبر عن شكل من العلاقة لا تقبل التفكيك.
ومن أمثلة المعارف المتولدة بطريقة التوالد الذاتي: جميع القضايا المستنتجة من التعميمات الاستقرائية؛ إذ لا يوجد أي تلازم موضوعي بين مجموعة الأمثلة والشواهد التي تم اختبارها وبين تلك التعميمات. فالعلم بالتعميم ينشأ عن طريق العلم بهذه الأمثلة والشواهد، دون أن يكون هناك تلازم موضوعي بينهما، بل على طريقة التوالد الذاتي. وبالتالي؛ فإنَّ جميع الحقائق العلمية هي حقائق مستنتجة بطريقة التوالد الذاتي، بل إنَّ معظم المعرفة البشرية قد استنتجت بهذه الطريقة.
إنَّ الدليل الاستقرائي -من وجهة نظر هذا المذهب الجديد- يمرُّ بمرحلتين:
– الأولى: مرحلة التوالد الموضوعي؛ وهي المرحلة التي يتم فيها تطبيق نظرية الاحتمالات بالتعريف الجديد الذي تبناه السيد محمد باقر الصدر، وهو تعريف الاحتمال على أنه علم إجمالي، على الأمثلة والشواهد التي تم استقراؤها. وكلما زاد عدد الشواهد زاد الاحتمال بالقضية الاستقرائية. ونستطيع أن نرفع من سقف الاحتمال بالقضية الاستقرائية إلى أقصى حد ممكن، ولكن دون أن نصل في هذه المرحلة إلى اليقين بها. وفي هذه المرحلة من الاستدلال لا نحتاج إلى الإيمان العقلي القبلي بالسببية، بل نحتاج فقط إلى عدم رفضها، ثم يمكن أن نبرهن على السببية القائمة بين قضيتين باستخدام نظرية الاحتمالات. ولا نحتاج في هذه المرحلة إلا إلى التسليم بالمصادرة العقلية وهي عدم اجتماع النقيضين.
– الثانية: مرحلة التوالد الذاتي؛ وفي هذه المرحلة استطاع السيد أن يبرهن على أن هذا الاحتمال العالي يمكن تحويله إلى يقين موضوعي بالقضية الاستقرائية. ولكي يتسنى للدليل الاستقرائي القفز درجة من الجزم والوثوقية بالعلاقة القائمة بين قضيتين يفترض السيد محمد باقر الصدر مسلمة عقلية مفادها أنَّ الذهن البشري مجهَّز على إلغاء أو إهمال هذا الكسر الضئيل من بعد أن وصل الاحتمال بالاستقراء إلى درجة عالية جدًّا. بمعنى أنَّ العقل البشري العملي مُصمَّم بحيث يتعامل مع الحقائق المستنتجة بطريقة الاستقراء على أنها حقائق قطعية. ومن هنا، فإنَّ الجانب الذاتي من المعرفة التي أفادته هذه المسلمة العقلية يلعب دوراً كبيراً في تصديق القضايا والتعامل معها على أساس من الجزم واليقين.
هذا -بشكل مختصر جدًّا- هو الملامح العامة للمذهب الذاتي في المعرفة الذي أسَّسه السيد محمد باقر الصدر، وأنا أعتقد أنَّ العلوم الحديثة مدينه له بهذا الإنجاز؛ لأنه خلَّصها من مشكلة خطيرة للغاية كانت تلازمها من تاريخ البشرية. ومهما اختلفت الآراء حول هذه النظرية، يظل كتاب “الأسس المنطقية للاستقراء” الذي خرج من أزقة النجف الأشرف إنجازًا عظيمًا. وأن مدرسة فقهية ذات تقاليد عريقة كمدرسة النجف الأشرف أثبتت قدرتها على التعاطي مع القضايا الفكرية المعاصرة.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 خصائص الصيام (1)
خصائص الصيام (1)
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الشيخ محمد صنقور
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 معرفة الإنسان في القرآن (6)
معرفة الإنسان في القرآن (6)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (فور) في القرآن الكريم
معنى (فور) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

خصائص الصيام (1)
-

الموانع من حضور الضيافة الإلهية
-

البعث والإحياء بعد الموت
-

حديث للاختصاصيّ النّفسيّ أسعد النمر حول توظيف التّقنية في العلاج النّفسيّ
-

التقوى، العطاء، الإيثار في شهر رمضان
-

شرح دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان
-
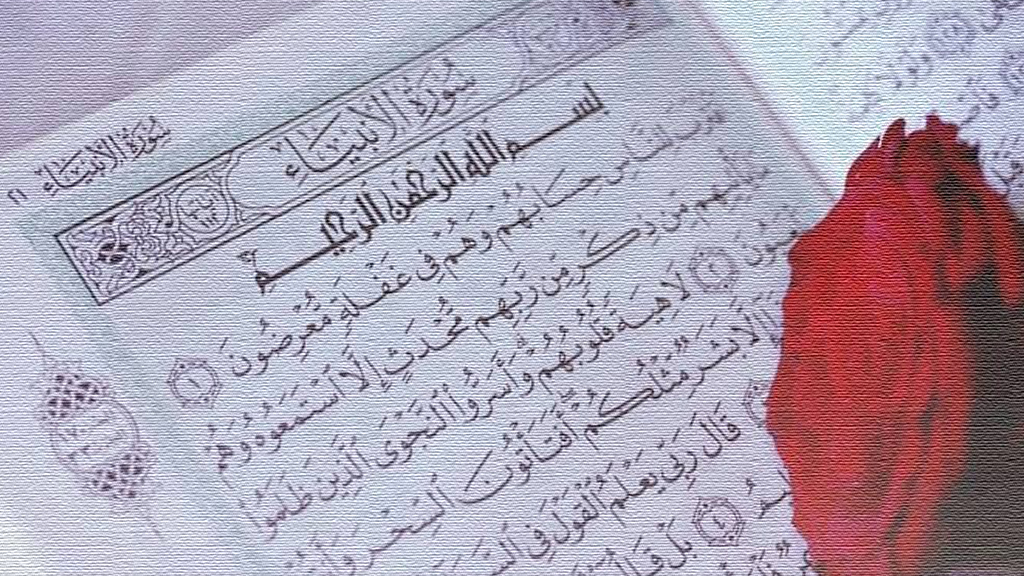
معرفة الإنسان في القرآن (6)
-

شرح دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان
-

لقاء الرحمة والعبادة
-

معنى (فور) في القرآن الكريم










