قرآنيات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد محمد حسين الطهرانيعن الكاتب :
عُرف بين الناس باسم العلامة الطهراني، عارف وفيلسوف، ومؤلف موسوعي، من مؤلفاته: دورة المعارف، ودورة العلوم، توفي عن عمر يناهز الواحد والسبعين من العمر، سنة 1416 هـ.القرآن رحمة للمؤمن ونقمة للكافر

عندما كان النبيّ الأكرم صلّى الله عليه وآله يتلو القرآن كان يشير إلى فضاءٍ لطيفٍ واسعٍ ـ يصل في وُسعه حدود الإنسانيّة والاتّصال بالحقّ تعالى والفناء في ذاته ـ بحيث يصير غارقاً بدوره في ذلك العالم، لكن كيف يُمكن لأولئك الذين لم يتجاوزوا الأُمور الجزئيّة ولم يُعرضوا عن المال والجاه والهوى والشهوة والغرور أن يقتفوا أثره؟! ولذلك فإنّهم سيظلّون قابعين في ذلك المكان الضيّق للمادّة وعبادة المادّة.
لقد كان النبيّ الأكرم يُحلّق في فضاء القدس، تعرُج به آيات القرآن إلى عالم الأسماء والصفات الإلهيّة اللامتناهي، وتحلّق به همّته المتعالية بعيدا ًفي أعلى أجواء المعرفة والصفاء. فكيف سيُمكن لهذا المسكين الحبيس في بئر الهوى والهوس العالق في حبال الأباطيل والشيطنة، أو لتلك الذبابة قصيرة النظر والمـُنهكة أن تحلّق إلى ذلك المكان الفسيح؟! وهذا هو الحجاب الصلد والسدّ الحديديّ الذي سينشأ مائزاً بين العامل بالقرآن وتاركه، شاء المرء أم أبى.
وعليه فالمؤمنون في عروجٍ وارتقاءٍ دائمٍ، وأمّا الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي: الذين لم يتجاوزوا الظاهر الذين {يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وهُمْ عَنِ الأخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ} [1] فحصروا العيش واللذّة في الإطار الضيّق لأسوار الهوى والمادّة وأنفاقها المظلمة، فهم في حالة فقدانٍ دائمٍ لصفاتهم الإيجابيّة، فيستبدلون الثروات التي وهبهم الله إيّاها من عمرٍ وحياةٍ وعقلٍ بلذّاتٍ متغيّرةٍ، وينحدرون على الدوام في دركات النفس وجهنّم. فأيّ حجابٍ أشدّ من هذا؟ وأي سدٍّ أكثر إحكاماً منه؟ إنّهم لا يُريدون من الرسول أن يصف الله بالوحدانيّة! وعندما يُوصف الله في القرآن المجيد بالواحد ويُعدّ متفرّداً في ذاته وصفاته وأفعاله، فإنّهم يولّون على أعقابهم مدبرين، ويُظهرون تنفّرهم من كلمات الحقّ هذه. ولأنّهم اتّخذوا لأنفسهم أرباباً من أبٍ وأُمٍّ وشريكٍ ورفيقٍ وزوجةٍ وابنٍ وحاكمٍ ومحكومٍ وثروةٍ وتجارةٍ وزراعةٍ، صارت هذه آلهتهم وأربابهم، فكيف سُيمكنهم أن يرفعوا أيديهم عنها ويُودعوها في وادي النسيان ليُسلموا قلوبهم وأرواحهم لله الواحد القهّار؟!
ولذلك فلن يرضخوا أبداً لتعاليم القرآن المبتنية على أساس الوحدة؛ لأنّها لا تنسجم مع الحياة الشيطانيّة، ولا تتلاءم مع الصروح التي يقوم بنيانها على عالم الخيال وعشق المجاز. فكتاب الحقّ هذا يدعوهم إلى الحقّ، وهم يُصرّون على الباطل، ويقولون علانيّةً: يا أيّها النبيّ! بدّل قرآناً كهذا، أو ائتنا بقرآنٍ غيره يُوافق أهواءنا، ويُمضي اعتداءاتنا، ويتركنا في استبدادنا أحراراً مطلقي العنان! ائتِ بقرآنٍ يعترف بمكانة وُجهائِنا وكبرائنا ويُقيم لهم وزناً، ولا يضع الغنيّ والفقير في صفٍّ واحدٍ! ائتِ بقرآنٍ يجعل الناس يهوون سجّدا ًعلى أعتاب قصورنا، ويُثبّت سيطرتنا عليهم، ويجعلها مستقرّة! ائتِ بقرآنٍ لا يدعونا إلى الصلاة والتضرّع، ولا يأمرنا بالصوم والجهاد، ولا يحثّنا على الإنفاق والإيثار، بل يدعونا إلى ركوب الشهوات، والتطاول على أعراض الناس، والاعتداء على حقّ ذوي الحقوق، والسطو على أتعاب الضعفاء والمساكين، ومعاقرة الخمر والكذب والقمار! وباختصار فإنّنا نريد أن تأتينا بقرآنٍ يكفل رغباتنا النفسيّة، لا أن يُكبّلنا عند القيام بإشباع رغباتنا النفسانيّة، أو يضع الحواجز الرادعة أمام حرّيّتنا في ممارسة ما يحلو لنا!
{وَإذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الذين لا يَرْجُون َلِقَآئَنَا ائْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أو ْبَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآءِ نَفْسِي إنْ أتَّبِعُ إلاّ مَا يُوحَي إليَّ إنِّي أخَافُ إنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَومٍ عَظِيمٍ * قُلْ لَّوْ شَآءَ اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ ولا أدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِّن قَبْلِهِ (لم أكن فيها مطّلعاً على هذا القرآن وعلى مثل هذه المعارف) أفَلا تَعْقِلُونَ}.[2]
يا أيّها النبيّ العزيز! قل في ردّك على هؤلاء الأشخاص الغافلين المحجوبين: إنّ هذا الكتاب كتاب توحيد جيء به لينقلكم ويعبر بكم إلى أُفق الإنسانيّة، لا أنّه كتاب شركٍ متضمّن لتعاليم البهيميّة. هو كتابٌ جاء من قِبل الله، لم آتِ به من عند نفسي أو أنشئه وفق رغبتي كي أُغيّر فيه وأُبدّله بحسب ما يُمليه عليّ رأيي وذوقي! إنّ قلبي كمرآة في مقابل أنوار الحقّ تعالى، وهو الذي يوحي إليه ما يشاء، ولو ارتكبت في ذلك مخالفة، لمسّني منه العذاب الأليم. قل: إنّ الذي دعاني إلى هذا القرآن هو إرادة الله وأمره، وإلاّ فإنّني قد عشت بينكم قبل ذلك لمدّة أربعين سنة كُنت أُكلّمكم وأتحدّث معكم فيها، فهل سمعتم عنّي طيلتها مثل هذه الكلام؟ لا، لم تسمعوه! فاعلموا إذن أنّ القرآن ليس من كلامي، بل هو وحي الله الذي نزل، وأُمرت بتلاوته عليكم وتفهيمه إيّاكم.
{فَلآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ* ومَا لا تُبْصِرُونَ* إنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ومَا هُوَ بِقَوْل ِشَاعِرٍ قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ (وتعترفون بهذه الحقيقة) * ولا بِقَوْلِ كَاهِنٍ (ومرتبط بالجنّ ونفوس العالم السفلي) قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ * تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالمينَ * ولَوْ تَقَوَّل َعَلَيْنَا (هذا النبي) بَعْضَ الأقَاوِيلِ * لأخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ *ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنكُمْ مِّنْ أحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (لنا أو مخلّصين له من قبضتنا وحائلين دون حصول هذا الأمر) * وإنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِين}.[3]
فالنبي لم يأت بالقرآن من عنده أبداً لكي يُحدث فيه بعض التصرّفات أو يُغيّره ويُبدّله وِفق رغبة أتباعه! وعليه فقد امتنعت مجموعة من الناس عن التخلّي عن الهوى، ولم يكونوا مستعدّين للانقياد والتسليم للقرآن بسبب خضوعهم للغرائز الشيطانيّة والملكات التي ورثوها أو تربّوا عليها. وفي هذه الحالة سيزيدهم عرض القرآن عليهم إنكاراً على إنكارهم وتتمّ الحجّة عليهم وينكشف ـ بسبب إعراضهم وإنكارهم ـ بؤسُهم وتعاستهم، وهذا هو معنى زيادة الخسران. بَيدَ أنّ مجموعة أُخرى منهم ـ وفقاً لما تُمليه عليهم أرواحُهم الطاهرة النزيهة وغرائزهم الرحمانيّة وملكاتهم الحسنة الموروثة وتربيتهم الصالحة ـ سمَوا فوق كلّ إنّيّاتهم وشخصيّاتهم، وضَحَّوا بكلّ شيء في سبيل الحقّ، وسلّموا وانقادوا لأوامر الله في قرآنه المجيد، وكانت الآيات الإلهيّة دائماً ما تترك بصماتها الإيجابيّة في أنفسهم وأرواحهم، فأُولئك سيضحى إيمانهم أقوى وأرواحهم أسعد. وهذا هو معنى الشفاء والرحمة المختصّين بالمؤمنين بالقرآن:{إنَّمَا المؤْمِنُونَ الذين إذَا ذُكِرَ اللهُ وجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وإذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إيَمَانًا وعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}.[4]
وقد ورد أنّه عندما كانت تنزل آية على المؤمنين كانوا يتساءلون فيما بينهم: كم زادت هذه الآية في إيمانكم؟ وما مدى تأثيرها الـمُنعِش على أرواحكم؟ {وَإذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إيمَانًا فَأمَّا الذين ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إيمَانًا وهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وأمَّا الذين في قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلى رِجْسِهِمْ ومَاتُوا وهُمْ كَافِرُونَ}.[5]
إنّ مثل القرآن كمثل الشمس الساطعة المتألّقة التي تُشرق وتنشر أشعّتها وحرارتها في الأجواء ويصل نورها وحرارتها الأرض، فيغترف منهما كلّ موجود ما يقوّي به ذاته وطينته. ففي الليل البهيم، لن تفوح من الورود والأزهار رائحتها الطبيعيّة، كما لن تُبرز النجاسات والأقذار المتعفّنة رائحتها الكريهة الخبيثة. أمّا حين تطلع الشمس من جديد وتلامس بنورها ودفئها الزهور الغافية، فستتفتّح البراعم في البساتين لتشحن الفضاء بعبقها الفوّاح، وستفوح أيضاً في الجانب الآخر رائحة النجاسات في المزابل؛ لتملأ الهواء القذر في المستنقعات والمزابل برائحتها الحادّة العفنة. إذن، لم يكن الذنب ذنب الشمس؛ إذ الإشعاع والتوهّج من لوازمها، بل يكمن الذنب في الذات الخبيثة لهذه الموجودات التي انطوت على الموادّ المتعفّنة، فلو لم تُشرق الشمس ولم تصل الحرارة والدفء، لما كان هناك أثر لأيّ موجودٍ وسيكون الكلّ عندئذٍ بمنزلةٍ سواء، فلا ميزة للورد على الأقذار، ولا فرق بين روضة الأزهار وأُتون الحمّام!
لقد قسّم القرآن ـ حين نزوله ـ البشر إلى صنفين: أصحاب يمين وأصحاب شمال، سعداء وأشقياء، مؤمنين وكفّار، أصحاب الجنّة وأصحاب السعير، موحّدين ومشركين، عدول وفسّاق، مُتّقين ومنحرفين. وهذا هو معنى فصل القرآن وفرقانه الذي لا يُبقي مجالاً لأحد ليدّعي ادّعاءً فارغاً، أو ليضع المنحرفون والمتجاسرون أنفسَهم في مصافّ أولياء الله، ويعدّون أنفسهم نخبة العالم وصفوته. وقد أدرك كفّار قريش هذه الحقيقة بشكلٍ جيّد، ولهذا جرّدوا سيوفهم من أجل إطفاء نور الإسلام، وأشعلوا الحروب في بدرٍ وحنينَ والأحزاب وأُحد؛ لقتل المسلمين واجتثاث القرآن من جذوره، لكنّهم لم يتمكّنوا من ذلك ولم يُفلحوا في تحقيقه، ولم يُطفىء نور الله تعالى: {يُريدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِه ِوَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُون}.[6]
ولمـّا فتح الإسلام مكّة وبلغ الإسلام مِنَ العظمة بحيث لم يجرؤ أحد على معارضته أو الإعراض عن ذلك الدين المبين ـ وإلاّ لعرّض نفسه للخطر ومكانته للاهتزاز ـ أعلن مشركو قريش (أبو سفيان وأعوانه) إيمانهم، لكن لا عن طيب خاطرٍ، بل لأنّهم لو لم يفعلوا ذلك لحكموا على أنفسهم بالفناء والاضمحلال. وبعد رحيل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يعد في إمكانهم معارضة الإسلام في ظاهره؛ إذ إنّ الإسلام صار قويّاً إلى درجة أنّ معارضته كانت تعني طردهم ولعنهم، وبلغ الموقف حدّاً صار معه إظهارهم لمثل هذه الادّعاءات والكلمات يُساوي هلاكهم وإبادتهم الحتميّة. ولهذا تظاهروا بلباس الإسلام، وأمّا في الباطن فقد بقي الكفر والنفاق على حاله، ففي الظاهر صلاة وصوم وحجّ، لكن في الباطن ظلّ الشرك والهوى وإنكار الله والمعاد مهيمناً على نفوسهم.
لقد كانوا في عهد الرسول في خصامٍ دائمٍ مع ظاهر القرآن، وبعد وفاته صلّى الله عليه وآله شمّروا عن سواعدهم للمواجهة مع باطن القرآن وحقيقته؛ إذ إنّ الذي عرضه عليهم الرسول لم يكن منحصراً بظاهر القرآن فقط، بل كان يشمل أيضاً معاني القرآن وحقيقته، ولمـّا أدركوا هذا الأمر لجؤوا للمعارضة. وبعد أن تُوفيّ صلّى الله عليه وآله وكان ظاهر الإسلام قد استوعبهم، قاموا بمعارضة القرآن وتأويله وكانوا يقولون: اقرؤوا القرآن، ولكن لا تُؤوّلوه، ولا تذكروا شأن نزول الآيات، ولا تتحدّثوا عن الخصوصيّات، واتركوا المعاني مبهمةً!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ـ سورة الروم (30)، الآية 7.
[2] ـ سورة يونس (10)، الآيتان 15 و16.
[3] ـ سورة الحاقّة (69)، الآيات 38 إلى 48.
[4] ـ سورة الأنفال (8)، الآية 2.
[5] ـ سورة التوبة (9)، الآيتان 124 و125.
[6] ـ سورة الصفّ (61)، الآية 8.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 آل عمران في آية الاصطفاء
آل عمران في آية الاصطفاء
الشيخ محمد صنقور
-
 معرفة الإنسان في القرآن (9)
معرفة الإنسان في القرآن (9)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (ستر) في القرآن الكريم
معنى (ستر) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 كريم أهل البيت (ع)
كريم أهل البيت (ع)
الشيخ علي الجشي
-
 الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

كريم أهل البيت (ع)
-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
-

آل عمران في آية الاصطفاء
-

الإمام الحسن المجتبى (ع) بين محنتين
-
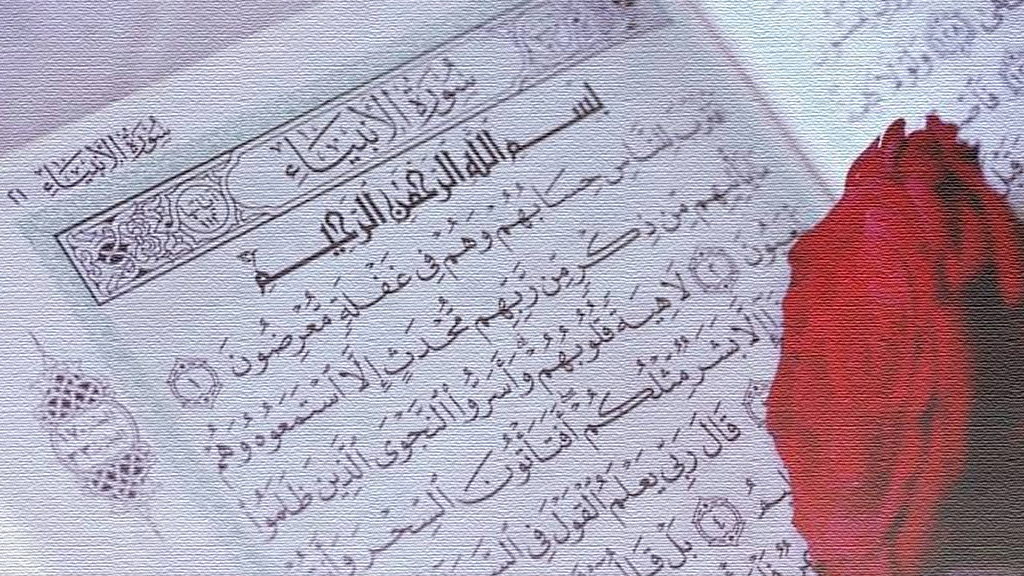
معرفة الإنسان في القرآن (9)
-

شرح دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان
-

إفطار جماعيّ في حلّة محيش، روحانيّة وتكافل وتعاون
-

الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
-

حميتك في شهر رمضان
-

(البلاغة ودورها في رفع الدّلالة النّصيّة) محاضرة للدكتور ناصر النّزر










