علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقا بَعدية (5)

إله فلسفة الدين والله الموحي في الفلسفة الدينيّة
تلحظ الميتافيزيقا البَعدية مائزًا جوهريًّا بين إله الفلسفة والله الموحي كما يعبّر عنه في الدين. من ذلك، سيعكف الآخذ بدربتها على التفريق بعمق بين وثنيَّة “الُّلوغوس” والتوحيد الوحيانيّ. ومن هذه المنزلة بالذات، تبتدئ إرهاصات هجرة عقليَّة مشرَّعة الآفاق ستحمله على الانتقال من ضيق الفلسفة كعقلٍ أدنى إلى سِعة الوحي، كمعرفة عليا.
بعبارة أبيَن: يصبح قادرًا على التمييز بين توحيد الله وتوحيد الوجود المخلوق كنتيجة لتوحيد الله وتنزيهه عن الخلق. وذلك من أخصِّ المسائل التي تواجه الحكم الإلهي في مساعيه لحلِّ أعقد المعضلات الوجوديَّة وأكثرها دقَّة في المعارف الإلهيَّة. نعني بذلك التمييز بين الله الخالق المدبِّر، والمخلوق المعتنىَ به من خالِقِه والخاضع لقوانينه وسُنَنِهِ. فما دام اشتغال الفكر يدور مدار فضاءٍ ميتافيزيقيٍّ مسكونٍ بطغيان المفاهيم، ومحكومٍ لمقتضياتها المنطقيَّة، سيتعذَّر الوصول إلى حقيقة التوحيد.
لهذا، يتنبَّه الحكم بما هو فيلسوف ديني إلى هذه الفاصلة الدقيقة من المعرفة، ليوضح أنَّ الله ليس مقولة من مقولات الفلسفة، ولا مفهومًا كسائر المفاهيم. ثمَّ إنَّ إحاطته بحكاية الفلسفة بيَّنت له حقيقة أنَّ الإغريق استغرقوا بلعبة المفاهيم حتى صار كلُّ قول في الإله مجرَّد تصوُّر محض من تصوُّرات الذِّهن البشريّ.
ومع أنه يقطع مسافات موصوفة في مباحث الاستدلال، ويأخذ بما تمليه مقتضيات العقل النظريِّ ومبادئ المنطق من أجل التعرُّف على الكون، فقد شاء ذلك كوساطة ضروريَّة لفهم الإخبار الإلهيِّ عن سببيَّة وجود الموجودات. لأجل هذا تنأى الميتافيزيقا البَعديَّة، بما هي فلسفة دينيَّة، من التعقيد لتتَّخذ من البساطة دربة لها ومنهجًا.
تلقاءَ ذلك، ثمَّة من العلماء من يجتهد ليقترح بناء شبكة معرفيَّة على أساس العقل الفلسفيِّ قبل الوصول إلى مُسلَّمة الوحي. ويذهب إلى الاعتقاد بأنَّ كلَّ تحليل أو تفسير للوحي يجب أن يقوم على أساسٍ من هذه المنظومة المعرفيَّة بشكل مستقلّ. وخلاصة ما يتوصَّل إليه هؤلاء أنَّ العقل والفسفة متماهيان ومستقلَّان عن الوحي، وهما حاكمان بالمطلق على مطلق الوحي. وأنَّ مساحة الإدراكات العقليَّة ليست محدودة بحدٍّ، فهي تشمل جميع أسُس المعرفة الدينيَّة، وإنَّما تحتاج الرجوع إلى الوحي في تفاصيل الأحكام فحسب، وعلى هذا الأساس، فإنَّ أسُس الدين تكون قابلة للإدراك بوساطة العقل الفلسفيّ. والنتيجة هي أنَّ العقل في ضوء بعض المقدِّمات حاكمٌ على المعرفة الدينيَّة، ومتقدِّمٌ عليها، بل مضى إلى أبعد من ذلك ليقول بنظريَّة بـ “كفاية العقل” باعتبارها الأصل الذي ينبغي أن يعتمدها الرَّاسخون في العلم.
مع ذلك، فإنَّ غاية ما يتطلَّع إليه “المابَعد” في فلسفة الدين، هي تظهير ميتافيزيقا متطلِّعة إلى التعرُّف على حقائق الوجود بالاستناد إلى مبادئ العقل ومسلَّمات الوحي. وليس من ريبٍ في أنَّ ما يُسمَّى أنواع البديهيَّات الستِّ ما خلا الفطريَّات – أي الأوليَّات والمشاهدات والتجريبيَّات والحدسيَّات والمتواترات – كلّها تُبنى على القياس. أمَّا الفطريَّات فهي قضايا قياساتها معها، في حين أنَّ الحدسيَّات والتجريبيَّات تستبطن قياسًا مخفيًّا فيها.
ومع أنَّ جميع هذه القضايا تُعدُّ من البديهيَّات، ويمكن اعتبارها جميعًا أساسًا لمعرفة سائر القضايا، إلَّا أنَّ مجموعتين منها – في الحقيقة – لا تستند إلى دليل آخر؛ وهي الأوليَّات والمشاهدات. فالأوليَّات تنفرد بكونها الأساس الوحيد للفلسفة. وسيكون من البيّن أن بإمكان الفلسفة أن تصل بفضل الشهود إلى فوائد عديدة، خصوصًا أنَّ الفلسفة الأولى تبتني على أساسين هما: العقل والشهود. (يد الله يزدن بناه- تأمُّلات في فلسفة الفلسفة الإسلاميَّة، ترجمة: أحمد وهبة، مراجعة: محمد الربيعي، دار المعارف الحِكْميَّة، بيروت – 2021، ص 135).
ومن خلال مواصلة عمليَّة الاستعانة بالقضايا اليقينيَّة في القياس نستطيع الوصول إلى نتائج يقينيَّة أخرى. وهذا الطريق شائع ومعروف في النشاط الفلسفيِّ العامّ. لكن إلى جانب هذا الطريق يمكن الاستفادة من “الشهود” أيضًا في تجديد وتطوير القول الفلسفيّ. من أجل ذلك يذهب علماء الإلهيَّات المعاصرون إلى أنَّ الشهود لا ينحصر بالشهود الحسيِّ، سواء الحسّ الظاهر أم الحسّ الباطن، بل ثمَّة “الشهود العقليُّ” وفوقه الشهود القلبيُّ أيضًا.
والجدير بالالتفات أنَّ “الشهود القلبيّ”، يُطلق على كلِّ شهودٍ يرتفع فوق حدود العقل. هنا، يمكن الإشارة إلى ثلاثة أنواع من الشهود هي: الحسيّ، والعقليّ، والقلبيّ. وبقبول هذه النقطة ينفتح الباب أمام دخول الشهود إلى عالم الفلسفة وبيان حجِّيَّته وقيمته المعرفيَّة.
وفق هذه السيريَّة الجوهريَّة من الواحديَّة بين العقليِّ والشهوديِّ تنهض المعادلة التالية: “المعرفة الوحيانيَّة” تقع على خطٍّ امتداديٍّ صاعد من “المعرفة العقليَّة”. وإذا اتّفق أنَّ هذه الأخيرة، أي “المعرفة العقليَّة”، تتعامل مع الاستدلال والمفاهيم والتصوُّرات والألفاظ، فإنَّ المعرفة في أفقها “المابعديِّ” مبنيَّة على الكشف والشهود وعلم الفطرة. على هذا الأساس تصبح “الفلسفة”- وهي العلم الذي تتمُّ دراسته بواسطة النظام العقليّ – على أفق مشترك مع الميتافيزيقا البَعديَّة بوصفها فلسفة حاضنة للوحي والعقل معًا.
صحيح أنَّ مهمَّة الفلسفة معرفة الحقائق، لكن الأداة التي تستخدمها لهذا الغرض وتثبت بها مسائلها، هي “العقل” و”المفاهيم الذهنيَّة”. ولهذا يُتوقَّع فقط من العقل والفلسفة إثبات وجود الله تعالى، في حين يستحيل أنَّ نتوقَّع منهما إيصالنا إلى معرفة ذات الله. ذلك أنَّنا بالعقل والفلسفة يمكننا معرفة الله، إلَّا أنَّهما بعد ذلك، لا يوفِّران لنا رؤيته والحضور في ساحته المقدَّسة؛ وهذا طورٌ من التصعيد تصل فيه همَّة التفلسف إلى القبول الرضيِّ بما توفِّره الميتافيزيقا البَعديَّة من طرائق تفضي إلى التحرُّر من أسر المفاهيم، وصولًا إلى ما يمكن أن تكتسبه من نعوت غير معهودة في مقام كونها العلم الذي يُتعرَّفُ فيه على الفائق والمتعالي في الوجود. صحيح أنَّ طريق الفلسفة يختلف عن طريق الميتافيزيقا البَعديَّة وماهيَّتها، إلَّا أنَّهما يستطيعان معًا وبالرضى المشترك أن يملآ منطقة فراغ ميتافيزيقيَّة أخفقت الفلسفة الكلاسيكيَّة في ملئها على مدى أحقاب طويلة.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 السّعادة والشّقاء ذاتيّان أم اكتسابيّان؟
السّعادة والشّقاء ذاتيّان أم اكتسابيّان؟
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 الثقة بوابة النجاح
الثقة بوابة النجاح
عبدالعزيز آل زايد
-
 ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقا بَعدية (5)
ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقا بَعدية (5)
محمود حيدر
-
 الصبر وحسن البلاء
الصبر وحسن البلاء
الشيخ شفيق جرادي
-
 معنى (وعى) في القرآن الكريم
معنى (وعى) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ الضمير في: ﴿عَلَى حُبِّهِ﴾!
﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ الضمير في: ﴿عَلَى حُبِّهِ﴾!
الشيخ محمد صنقور
-
 أعظم امتحانات الحياة
أعظم امتحانات الحياة
السيد عباس نور الدين
-
 بين الإنسان والملائكة
بين الإنسان والملائكة
السيد محمد حسين الطبطبائي
-
 لماذا لا يستطيع مرضى الزهايمر التعرف إلى أفراد أسرهم وأصدقائهم؟
لماذا لا يستطيع مرضى الزهايمر التعرف إلى أفراد أسرهم وأصدقائهم؟
عدنان الحاجي
-
 تعقّل الدّنيا قبل تعقّل الدّين
تعقّل الدّنيا قبل تعقّل الدّين
الشيخ علي رضا بناهيان
الشعراء
-
 السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات
السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات
حسين حسن آل جامع
-
 اطمئنان
اطمئنان
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-

السّعادة والشّقاء ذاتيّان أم اكتسابيّان؟
-

علاج جديد قد يشفي من مرض السكري من النوع الأول الحاد
-

الثقة بوابة النجاح
-

محاضرة بعنوان: (العودة للقراءة) للأستاذ يوسف الحسن
-

ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقا بَعدية (5)
-
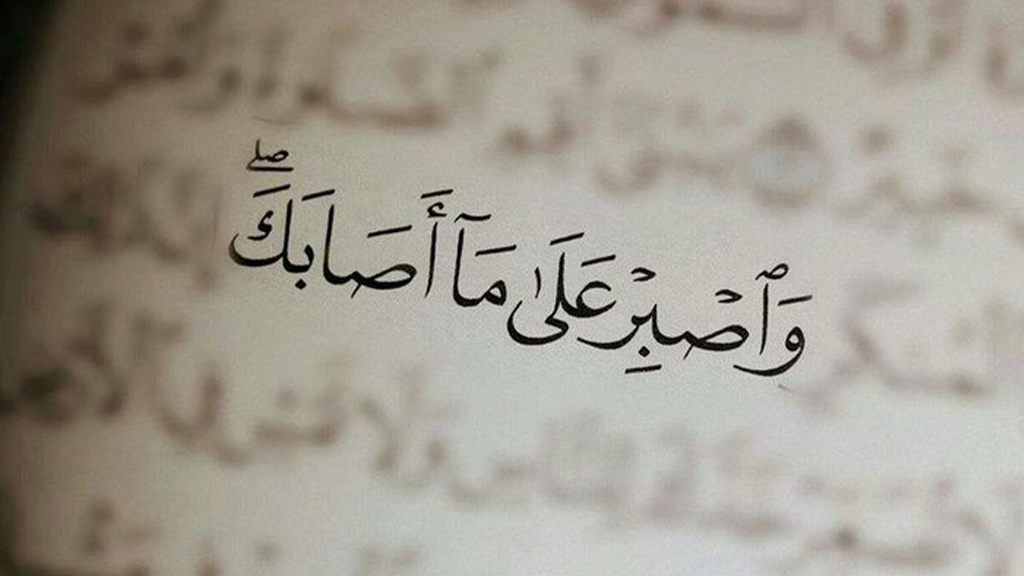
الصبر وحسن البلاء
-
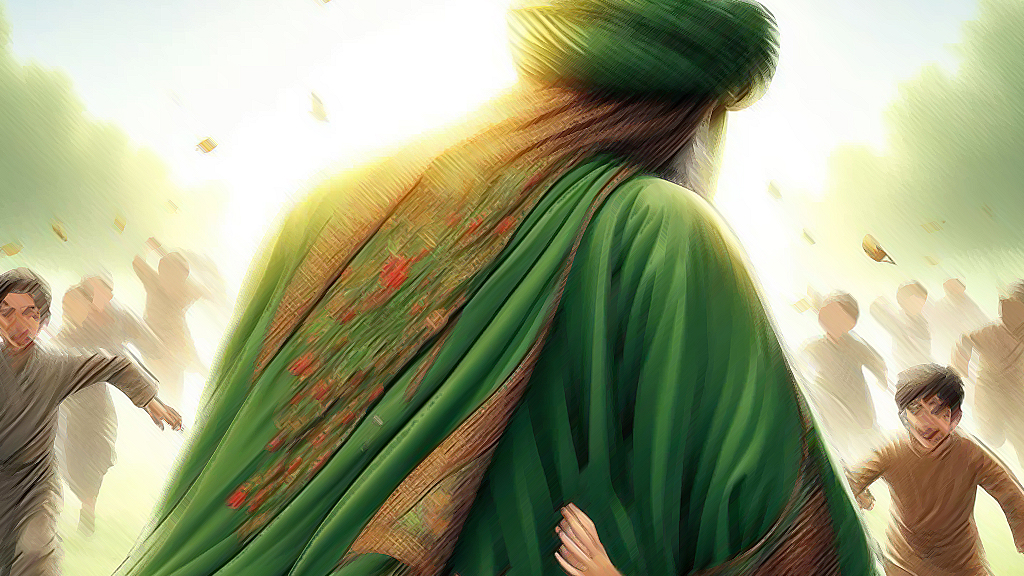
عبارة (بعدما مُلئت ظلماً وجَوراً) غير موجودة في الروايات!
-

(ظلال ومطر) أمسية شعريّة للمعيبد والدّريس في الأحساء
-

معنى (وعى) في القرآن الكريم
-

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ الضمير في: ﴿عَلَى حُبِّهِ﴾!









