علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشهيد مرتضى مطهريعن الكاتب :
مرتضى مطهّري (1919 - 1979) عالم دين وفيلسوف إسلامي ومفكر وكاتب شيعي إيراني، هوأحد أبرز تلامذة المفسر والفيلسوف الإسلامي محمد حسين الطباطبائي و روح الله الخميني، في 1 مايو عام 1979، بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتصار الثورة الإسلامية، اغتيل مرتضى مطهري في طهران إثر إصابته بطلق ناري.النّظريّات الأخلاقيّة (8)

نظريّة العبادة (2)
التوجيه الصحيح للأخلاق
بناءً على هذا، يكون قول «الأخلاق ذات جذر وجدانيّ» صحيحاً من جهة، وخاطئاً من جهة أخرى. هو صحيحٌ بلحاظ أنّ «قلب» الإنسان يُلهم الإنسان تلك الأخلاق، ومخطئٌ بلحاظ أنّ أولئك يتخيَّلون أنّ «الوجدان» حسٌّ مستقلّ عن حسّ معرفة الله، وأنّ وظيفته هي تشخيص تكليفنا فقط، من دون أن يكون معرِّفاً لمكلِّفِنا. إنّهم يتصوّرون «الوجدان» هو المكلِّف، وهو المعيّن لنا تكليفنا بشكل مستقلّ، ويجب علينا معرفة ما كُلِّفنا به، وهذا الخطأ هو العيب الوحيد في بيان «كانط»، حيث يريد تعريف «الوجدان الإنسانيّ» بأنّه حِسٌّ مستقلٌّ مشخِّصٌ للتكليف، لا غير. والحال أنّ الأمر ليس كذلك، بل «ضمير الإنسان» كما يدرك «التكليف»، فهو يدرك «المكلِّف» كذلك، وهذه الاتّهامات الوجدانيّة ناشئة من معرفة الله سبحانه فطرةً، وليست منفصلة عنها. يقول القرآن الكريم: ﴿وَنَفۡس وَمَا سَوَّىٰهَا ۞ فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا ۞ قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ۞ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا﴾؛ فالخلاص والانعتاق من الفجور حُكمٌ إلهيّ، والتقوى هي اجتناب الحرام قربةً إلى الله تعالى.
إنّ لوجدان الإنسان اتّصالاً بخالق عالَم الوجود، وارتباطاً بتمام عالَم الوجود وعمقه، وهو يتلقّى تكليف الإنسان من مكانٍ آخر ليُبَلِّغه له، وهذا الحسّ القلبيّ هو الّذي يتعرّف الله وتكليفه؛ ويُعَبَّر عن هذه الإلهامات القلبيّة بـ«الإسلام الفطريّ». يقول القرآن الكريم: ﴿وَجَعَلۡنَٰهُمۡ أَئِمَّة يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡهِمۡ فِعۡلَ ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِۖ وَكَانُواْ لَنَا عَٰبِدِينَ﴾؛ فهو لم يَقُل: وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات؛ كي يكون ذلك «تكليفاً تشريعيّاً» بحسب الاصطلاح المعروف -وهو ما ذكره الأستاذ الكبير العلّامة الطباطبائيّ في تفسير الميزان-، بل قال تعالى: إنَّنا ألهمنا قلوبَ الناس، نفس فعل الخير، وأوحينا إليهم به.
وفي منطق القرآن، للوحي عمومٌ ودائرةٌ تشمل مسائل أخرى أيضاً، مِن قَبيل «الجمال» و«العبادة»، ولا تنحصر بذلك الوحي الخاصّ النازل للأنبياء العظام، وإن كان هو أكمل درجات الوحي وأرقاها. ولكن مع ذلك يقول تعالى: نحن أوحينا لكلّ إنسان وألهمناه، وليس له وحده، بل أوحينا حتّى للنحل. يقول القرآن الكريم: ﴿وَأَوۡحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحۡلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلۡجِبَالِ بُيُوتا﴾ ، بل أوحينا حتّى للحيوانات وللنباتات والجمادات، ﴿وَأَوۡحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمۡرَهَاۚ﴾. وهذه كلّها أشكال عديدة لحقيقة واحدة، غاية الأمر أنّ الوحي المرسَل إلى الإنسان الكامل لا يُرسَل إلينا، ولكنّه وحيٌ على كلّ حال، ومثال ذلك: الشمعة المنيرة، والمصباح المنير، والشمس المشرقة على الدنيا، فهذه كلّها ذوات نور؛ فالوحي النازل على الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله) مثل نور الشمس الّذي يعمّ العالَم، والإلهام الممنوح للإنسان كالمصباح، مختلف الإضاءة شدَّةً وضعفاً.
وأمّا النظريّة القائلة بأنّ الأخلاق من مقولة «الجمال»، فهي أيضاً تامّة من جهة، وغير تامّة من جهة أخرى. هي غير تامّة من حيث إنّ أصحابها تخيَّلوا أنّ «الجمال المعنويّ» ينتهي إلى هذا المطاف، وأنّ روح الإنسان خُلِقَت لتُدرِك سلسلة من الأفعال بنحو الاستقلال، مثل: الجمال، والصدق، والأمانة، والإيثار، والعفّة، والشجاعة، والاستقامة، والإنصاف، والعلم؛ فهي تؤكّد قدرة النفس الإنسانيّة على تذوُّق الجمال وإدراكه، ولكنّها تقف به عند هذا الحدّ.
كان يجدر بأصحاب هذه النظريّة أن يطمحوا بأنظارهم وراء ذلك؛ لأنّ النفس الإنسانيّة تدرك بـ«اللاشعور» و«اللاوعي» أصلَ الجمال ومبدأه، وهو الله تعالى، ومن ثمّ ترى إراداته جميلة، فتسعى إلى رضاه بالفطرة الأصيلة، ورضاه تعالى هو سعادتنا. بعبارة أخرى، إنّ جمال الأخلاق -في الحقيقة- من جمال مبدأ كلِّ جمال وخير، وهو الله تعالى، لكنّ الكثير من البشر يدرك جمال الأخلاق بالشعور والوعي، ويدرك مبدأها لا عن شعور.
والحقّ أنّ الحُسن والقبح العقليّين يرجعان واقعاً إلى الحُسن والقبح القلبيَّين؛ لأنّ الشعور بحُسن الحَسَن وقُبح القبيح من مقولة «الإحساس»، لا من مقولة «الإدراك»؛ والإحساس ليس من وظائف العقل، فإنّ وظيفته الإدراك، بل هو يتدفَّق من القلب، فالإنسان السويّ يدرك بفطرته اللاواعية جمالَ ما يرتضيه الربّ الجميل وحُسنَه، فهو يدرك أنّ هذا تكليف إلهيّ، تماماً كما هو حال مَن يؤمن بالله إيماناً واعياً، فإنّه يدرك جمال مراداته تعالى وحُسنه.
شعر:
مبتهِجٌ أنا بكلّ العالَمِ
وعاشِقٌ له لأنَّه مِنَ الحبيب
وهذا أيضاً شأن النظريّات الأخرى، فإنّ كلّاً منها عكسَت جانباً من الحقيقة دون جانب. فمَن يؤمن بأنّ أساس الأخلاق وعمادها هو المحبّة والعاطفة، عليه أن يخطو للأمام أكثر، ليخبرنا عن السبب الكامن في أنْ يحبّ إنساناً آخر، وربّما آثَرَه على نفسه بلا رابط يربطه به، مِن رَحِم أو منفعة؛ إذ إنّ منطق «الأنا» يستنكر ذلك أشدّ إنكار، ويُسمّيه «حُمقاً»، فلا بدَّ من أن يكون ثمّة ما يدعو الإنسان للمحبّة الصادقة الخالصة، ولأنْ يتفانى في خدمة الأغيار، وكأنّه يخدم نفسه ولا يريد جزاءً ولا شكوراً. وهذا المنطق هو منطق «الشعور الباطنيّ» بالله تعالى، وهو إسلام فطريّ؛ فالإنسان السويّ يحسّ، بشامّة قلبه، أنّ محبوبه الواقعيّ يحبّ الآخرين من بني نوعه وجنسه؛ أعني البشر والحيوان، فهو يحبّ حبّاً لمحبوبه الحقيقيّ الّذي يُبعِده عن «الأنا» ويُذيبه في الآخرين.
الأخلاق من مقولة «العبادة»
ممّا تقدَّم، يتّضح بجلاء أنّ الحقيقة كاملةً تتلخّص في عدِّ الأخلاق من مقولة «العبادة». فالإنسان يتّبع سلسلةً من التعاليم الإلهيّة بقدر ما يعبد الله تعالى بطريق «اللاشعور» و«اللاوعي»، وحينما تتحوّل «عبادته اللاشعوريّة» إلى «عبادة شعوريّة واعية» -كما هو هدف الأنبياء- فستصبح أعماله وسلوكاته كلّها ذات صبغة أخلاقيّة، بلا فرق بين عمل وآخر، حتّى أكله ونومه. بعبارة أخرى، إذا جَعل الإنسانُ من تكليف الحقّ تعالى ورضاه، منطلَقاً لنشاطه، وأساساً لبرنامج حياته، وهدفاً يروم الوصول إليه، فسوف تكون حياته كلّها، من البدو حتّى الختام، وبأنحائها كلّها، شعاعاً أخلاقيّاً، وسيكون كلّ شيء لله وفي الله: ﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾.
ثمّة نظريّات أخرى مطروحة هنا، لكنّها لا تؤدّي إلّا إلى سلبِ أشرفِ ما لدى الإنسان، وأقدسِ ما تملكه الإنسانيّة؛ فأصحابُها غير مقتنعين بوجود معانٍ سامية تنطوي عليها النفس الإنسانيّة، ولا يعتقدون بوجود سلسلة من الأخلاق الشريفة في هذا العالَم، وأنّ ثمّة أُناساً يقومون بتلك الأعمال من دون أن تكون لديهم منافع مادّيّة ومصالح ذاتيّة، بل لمجرّد شرفها وقداستها؛ وسنبسط نقدنا لهذه النظريّات في ما بعد، ومنها نظريّة «برتراند راسل» (Bertrand Russel)، الّذي يرى الأخلاق من باب «المصلحة الفرديّة»، وكذلك النظريّة الماركسيّة ونظريّة الأخلاق الوجوديّة. وهذه النظريّات تهوي بالأخلاق من قمّـتها وأوجها إلى الحضيض، ومع ذلك، فهؤلاء يعتقدون بـ«الإنسانيّة» وبـ«شرف الإنسان». ومن ثمّ فمُنكِرو جمال الأخلاق وشرفها الذاتيّ كلّهم مجبورون على الاعتقاد بالإنسانيّة وشرف الإنسان؛ فـ«برتراند راسل» مثلاً، تراه يتحدّث في بعض المواطن عن الإنسانيّة وشرف الإنسان، على الرغم من أنّ فلسفته لا تستطيع -بوجه- دعم شرف الإنسان وتأييده.
إنّ مسألة «الأخلاق» وشرف الإنسان وكرامته لا يمكن توجيهها وتفسيرها وتأييدها إلّا في ظلّ نظريّة «عبادة الله تعالى» فقط، وأمّا النظريّات الأخرى، فهي كلّها عاجزة عن ذلك.
وأساساً، فإنّ الأخلاق تُعَدّ ممرّاً إلى عالَم المعنى، ومَعبَراً إلى المعنويّات في حياة الإنسان، إنّه مَنفَذٌ يتعرَّف الإنسانُ من خلاله على عالَم المعنويّات، ويدخل منه إلى عالَم «الدِين».
وهنا أمرٌ يجدر بنا ذكره، وهو أنّ جماعةً ذكروا أنّ «الدِين» و«الشرف الخُلُقيّ» لا يجتمعان ولا يتلاءمان؛ لأنّ معنى «الدين» هو عبادة الله تعالى، وعبادتُه تعالى إمّا أن تكون خوفاً من جهنّم، وإمّا طمعاً في الجنّة، فترجع العبادة إلى المطامع المادّيّة للإنسان، والحال أنّ العمل الأخلاقيّ المحض مُنزَّهٌ عن ذلك، ويتّسم بالشرف والقداسة الخالصَين.
والجواب عن هذا هو:
إنّ العبادة -في نظر الدين الإسلاميّ المقدَّس- مراتب ومستويات، والعبادة الأعلى مرتبةً هي العبادة الخالية من المطامع والأغراض كلّها؛ أي تلك الّتي لا تكون طمعاً في الجنّة أو هلعاً من جهنّم، وإنّما لأجل ذات الحقّ تعالى؛ لأنّه أهلٌ للعبادة. أمّا العبادة طمعاً في الجنّة أو خوفاً من جهنّم، فهي مرتبة نازلة، وإن كانت عبادة حقيقيّة أيضاً، وقد ذُكِر هذا الأمرُ في نهج البلاغة وفي أحاديث كثيرة.
يقول أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام): «إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللهَ رَغْبَةً، فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ؛ وَإِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ؛ وَإِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُكْراً، فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَار».
عبادة الناس على أقسام ثلاثة:
1. بعضٌ يعبد الله طمعاً بالثواب، وهذه عبادة التجّار؛ فهؤلاء يريدون المتاجرة مع الله تعالى، يبذلون شيئاً ويأخذون أكثر؛ فهم كالتاجر الّذي يعرض بضاعته كلّها في أثناء معاملاته، حتّى يكسب أكثر من رأس المال الّذي دخل به إلى السوق.
2. وبعضٌ يعبد الله خوفاً، وهذه عبادة العبيد؛ لأنّهم إذا كُلِّفوا مِن قِبَل مَواليهم بتكليف، فهم يمتثلونه وينجزونه حذراً من العقاب حال عدم الامتثال.
3. وآخرون يعبدونه تعالى من باب الشكر والحمد والحبّ والعشق له، وهذه العبادة منبثقة من عمق الفطرة والشعور الواعي؛ فهم يعبدون الله بالكيفيّة الّتي تقتضيها فطرتهم. فلأنّهم يحبّونه تعالى، تراهم يعبدونه سبحانه، وهم مداومون على عبادته حتّى لو لم يخلق الله الجنّة والنار، وهذه أعلى مرتبة للعبادة؛ لأنّها غير نابعة من مطامع ماديّة.
يقول الإمام عليّ (عليه السلام): «إِلهِي... مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ نَارِكَ، وَلَا طَمَعاً فِي جَنَّتِكَ، لَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ، فَعَبَدْتُكَ».
إنَّ جملة «أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ» ذات معنى كبير؛ يعني أعبدك إلهي فقط لأنّك أنتَ أنتَ، وأنا أنا، وأنّه لَطبيعيّ جدّاً في هذا العالَم، أن تكون معبوداً، وأن أكون عابداً. ومَن يقرأ دعاء «كميل» ويتأمّله، يرى أنّه -مِن أوّله إلى آخره- يدور حول عبادة العاشقين، ويدرك أيضاً معنى الانسلاخ من الذات والانعتاق منها؛ لأنَّ الإمام عليّ (عليه السلام) لا يوجد في كلامه مع البشر أدنى حدّ للمبالغة، فكيف وهو يتكلّم مع ربّه ويناجيه! في هذا الدعاء، تطالعنا جملةٌ مرتبطة بنار جهنّم، وهي ذات مضمون لا يمكننا تصوّره، وهي: «وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْض». إنّ نار جهنّم ليست من نوع نار الدنيا، بل هي نار لا تقاومها كلّ السماوات والأرض. بعد هذه الجملة، يقول (عليه السلام): «فَهَبْنِي، يَا إِلَهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَرَبِّي، صَبَرْتُ عَلَى عَذَابِكَ، فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ؟! وَهَبْنِي صَبَرْتُ عَلَى حَرِّ نَارِكَ، فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى كَرَامَتِك؟!»، فهو (عليه السلام) لا يستطيع الصبر على فراق الحقّ تعالى، وعن النظر إلى كرامته؛ وهذه هي عبادة العاشقين.
ونحن نعشق عليّاً لذلك، كما يقول «حافط»:
«لا يَسَعُ ضميرُنا وقلبُنا إلّا لحبِّ رجلٍ
نَصَب له العداوةَ كلِا العالَمَين؛ لكيلا نحبّه»
أجل، مقام الإنسان رفيع جدّاً، وليس منحصراً بعليّ (عليه السلام)، وثمّة الكثير ممَّن بلغوا درجة عالية من الإيمان الخالص لله وحده، وإن لم يبلغوا ذراه (عليه السلام).
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (فور) في القرآن الكريم
معنى (فور) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 معرفة الإنسان في القرآن (5)
معرفة الإنسان في القرآن (5)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
الشيخ محمد صنقور
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
-
 صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
السيد عادل العلوي
-
 هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
السيد عبد الحسين دستغيب
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

لقاء الرحمة والعبادة
-

معنى (فور) في القرآن الكريم
-

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحفز الإبداع إذا سألناه كيف يفكر لا ماذا يفكر
-
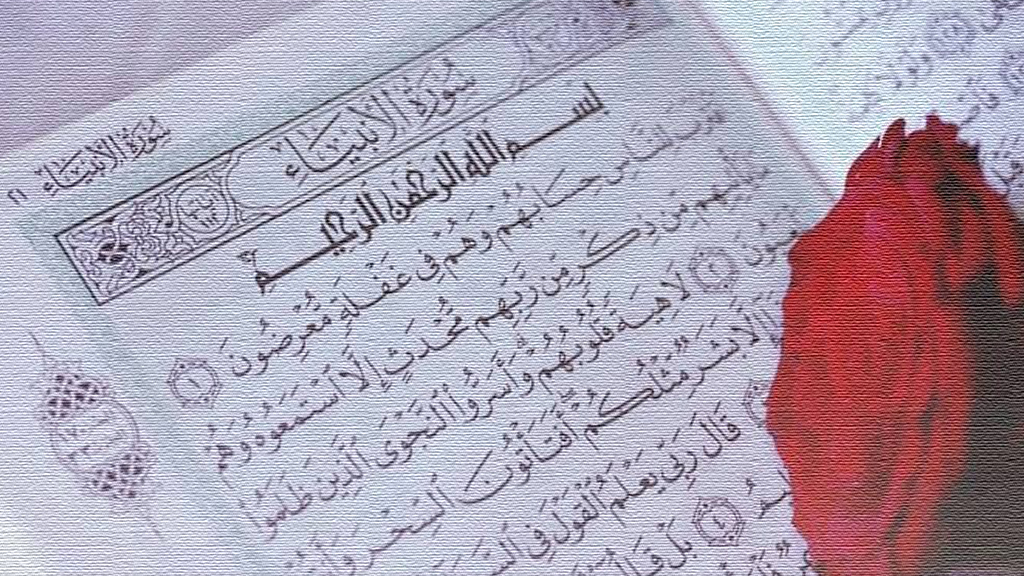
معرفة الإنسان في القرآن (5)
-

خديجة الكبرى المسلمة الأولى
-

شرح دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك
-

السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
-
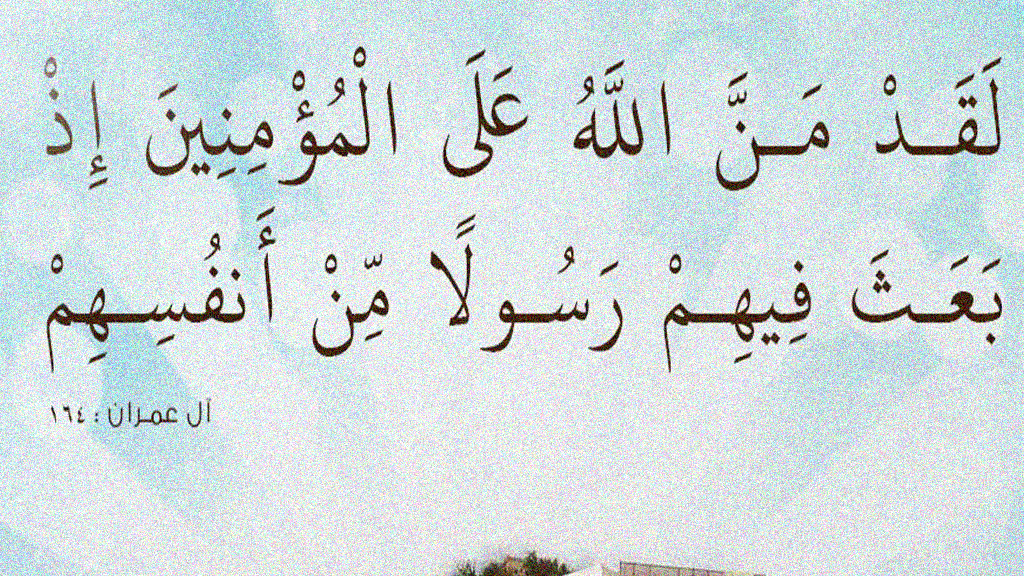
معنى (منّ) في القرآن الكريم
-

أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
-

اختتام حملة التّبرّع بالدّم (النّفس الزّكيّة)










