علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشهيد مرتضى مطهريعن الكاتب :
مرتضى مطهّري (1919 - 1979) عالم دين وفيلسوف إسلامي ومفكر وكاتب شيعي إيراني، هوأحد أبرز تلامذة المفسر والفيلسوف الإسلامي محمد حسين الطباطبائي و روح الله الخميني، في 1 مايو عام 1979، بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتصار الثورة الإسلامية، اغتيل مرتضى مطهري في طهران إثر إصابته بطلق ناري.الأزمة الأخلاقيّة في عصرنا (1)

قبل الشروع في تشخيص داء الإنسانيّة الّذي أفرزته الأيديولوجيّات المتعاقبة على فكر هذا «الإنسان» وقلبه المتوجّس خيفةً، من اللازم تقديم مقدّمة قصيرة عن «العقيدة وقيمتها».
قيمة العقيدة
تنقسم «قيمة» كلّ عقيدة إلى قسمَين:
1. قيمة نظريّة.
2. قيمة عمليّة.
المقصود من «القيمة النظريّة» مدى تطابُق تلك العقيدة والرؤية مع الواقع المعيش، حيث تكون شرعيّـتها مرهونة بمصادقة الواقع عليها. ولمعرفة ذلك، يُلجَأ إمّا إلى التجربة والاختبار، وإمّا إلى الاستدلال العقليّ. ومثال ذلك:
إنّ «بطليموس» (Claudius Ptolemy) كان يعتقد بمركزيّة الأرض للعالَم، وأنّ بقيّة الأفلاك تدور حولها، ثمّ جاء العلماء من بعده وأبطلوا هذا الرأي، منهم الفلكيّ «كوبرنيكُس» (Nicolaus Copernicus)، الّذي قال بمركزيّة الشمس للمنظومة الشمسيّة فقط، لا للكون كلّه. ونحن إذا أردنا معرفة القيمة النظريّة لكِلا هذَين الرأيَين، فلا بدّ من إخضاعهما معاً للتجربة، فإنّها أكبر برهان حيث تُمكِن؛ وحينئذٍ، تكون القيمة والاعتبار للرأي المؤيَّد مِن قِبَل التجربة والاختبار.
أمّا «القيمة العمليّة»، فالمقصود منها ملاحظة ما تُقدِّمه تلك النظريّة من نفعٍ مباشر، وفائدة ملموسة تعود بالخير على البشريّة، بصرف النظر عن مطابقتها للواقع وعدمها. وكلّما كانت الفائدة أكبر، كانت القيمة أكبر.
وهذا الكلام يأتي في كلّ مشروع وعقيدة تُقدَّم للاستهلاك البشريّ -إن صحّ التعبير- بما في ذلك المعتقدات الدينيّة وتصوّراته عن «الإله» و«الإنسان» و«الحياة». والّذي يتكفَّل بإثبات «القيمة النظريّة» للأصول الدينيّة -من توحيد ونبوّة وغيرها- هو «علم الكلام»، أمّا المتكفِّل بإثبات «القيمة العمليّة»، فهو «علم الأخلاق» و«حكمة التشريع».
هاتان القيمتان لا بدّ من توفُّرهما معاً لديمومة النظريّة واستمرارها، ولا تُغْني إحداهما عن الأخرى في ذلك؛ فإذا ما افتقدت النظريّة إحداهما، فَقدَت قيمتها وأهمّيّتها. لا حاجة للقول هنا بأنّ هاتَين القيمتَين متلازمتان، بمعنى أنّه لا يمكن بحال كون النظريّة معتضدة بصحيح البرهان ولا نفع فيها لبني الإنسان، أو تكون ذات نفعٍ عامٍّ لكنّها مهجورة العقول والأفهام؛ لأنّ الحقيقة تساوي الخير، كما يقرّر ذلك الذكر الحكيم، والحقيقة من دون خير زخرف وباطل؛ لأنّ الإنسان يسعى إلى ما فيه صلاحه، ويأخذ بما فيه قوامه.
بعبارة أخرى، العقيدة الّتي لا رصيدَ لها في صقع الواقع، ليست ذات خير ونفع للبشريّة مهما لمعَت؛ إذ ليس كلّ ما يلمع ذهباً؛ لأنّ مقصودنا هو النفع الأعمّ من المادّيّ والمعنويّ، فليس عندنا إلّا شقّان: إمّا عقيدة مدعومة نظريّاً فهي خير، وإمّا عقيدة مغشوشة فهي شرّ، ولا يوجد شقّ ثالث ملفَّق.
نعم، ربّما جلبَت العقيدة الفاسدة والمقولات الكاسدة شيئاً من الفائدة لبعض الناس، لكنّ ذلك إلى أجلٍ مسمّى؛ لأنّه لا دولة للباطل، بل هو -كما يقول القرآن الكريم- زَبَدٌ يَذهَبُ جُفاءً، يقول الحقّ تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذۡهَبُ جُفَآءۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمۡكُثُ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ﴾.
إنّ النِحَلَ المتطفّلة والمذاهب الجوفاء آيلةٌ للفناء والاضمحلال، وإنْ عمَّرَت حيناً من الدهر؛ لأنَّ حسّ الفطرة السليم يلفظها ويرمي بها بعيداً، وهذا ممّا يشهد به تاريخ البشريّة القديم والحديث. وهذه الآية الشريفة تُعَدّ من مظاهر إعجاز القرآن الكريم؛ لأنّ مضمونها أرقى من أن تناله يد البشر أو ينطق به لسان إنسان. ولقد ضرب الله تعالى في هذه الآية مَثَلاً هادياً، حيث شَبَّهَ الباطل بذلك الزَبَد الّذي يعلو ظهر الماء حينما ينحدر من الجبال سيلاً راعباً، فيحجب الماءَ عن الأبصار، فيحسب الجاهلُ قصيرُ النظر بأنّ الماء -وهو رمز الحقّ- صار مغلوب الزَبَد -وهو رمز الباطل-، ولكنّ الأمر ليس كذلك؛ لأنّ هذا الزبد سيذهب ويزول ليبقى الماء الزلال؛ لأنّه هو النافع، والحقّ هو ماء الحياة للناس، والباطل هو الزبد الّذي يغشى وجه الحقّ إلى حين.
هذه كانت مقدّمة قصيرة لِمَا نريد بحثه، وهو الداء المزمن الّذي يعاني منه إنسان العصر.
الأزمة المعنويّة والأخلاقيّة أعقَدُ مشكلات العصر
علماء الاجتماع والمحلِّلون يعلمون جيّداً بأنّ أكبر العقبات الّتي تواجه المجتمعات البشريّة -خصوصاً المجتمعات المتطوّرة أو ما يُسَمَّى بالعالَم الأوّل- هو التوتّر المعنويّ والضمور الأخلاقيّ. وفي جنب هذه المشكلة، تهون المشاكل الأخرى، سياسيّة كانت أم اقتصاديّة؛ لأنّ الأزمات السياسيّة، مثل قضيّة العرب وإسرائيل، ومسألة الحدود المتنازَع عليها بين الصين والاتّحاد السوفياتيّ، لا تُعَدّ من الأزمات المستعصية على الحلّ. ومثلها الأزمات الاقتصاديّة، كمسألة التضخّم العالميّ، بل حتّى مثل الحروب العالميّة، فهذه كلّها تُحَلّ بطريق أو بآخر. إنّ الأزمة الوحيدة الجامعة الّتي ما زال العالَم يتخبّط بها، هي الأزمة المعنويّة الجاثمة على صدر إنسان اليوم، ولربّما كانت بعض الأزمات المستفحلة غير معنويّة في الظاهر، لكنّها -في نهاية المطاف- تعود إلى أسباب معنويّة. وسأستعرض الآن جملة من مظاهر هذه الأزمات المستشرية.
1. الانتحار: تفشّي ظاهرة «الانتحار» من المسائل الّتي تؤرّق من يهمّهم الأمر. وتشير الدراسات في هذا الشأن إلى أنّ هذه الظاهرة المشؤومة تتوطّن، في الأصل، المجتمعات الراقية والمرفّهة؛ ممّا يعني أنّ أسبابها غير مادّيّة، وليست من سيّئات الفقر، وإن كان الفقر المادّيّ نفسه ناتجاً من أمر معنويّ.
إذاً، ما هو «العامِل» المتَّهَم هنا؟
إنّه الشعور المتنامي بعبثيّة الحياة والعجز عن معرفة سرّها؛ فالإنسان لا يدري لماذا يحيا؟ وما فائدة هذه الدنيا؟ إنّه الفراغ يملأ كيانه ويحوطه من كلّ جانب، إنّه الجزع وعدم القدرة على تحمُّل مصاعب الحياة ومكاره الدهر، فيكون هذا باعثاً على التنصّل من المسؤوليّة. وعلى حدّ تعبير هؤلاء: إنّ الحرّيّة تكون في الحياة المنفلتة والفارغة من أيّ معنى. فهذه المشكلات الحياتيّة، والّتي لم تكن تُعَدّ كذلك في السابق، ولا كانت تسلب نوم ساعة من أحد، غدت عقدة لا تنحلّ في عصرنا الحديث، حيث صارت تسلب الحياة، فضلاً عن النوم. والإحصاءات شاهدة على ذلك، وقد اقتطعتُ بعضاً من قصاصات جرائدنا الّتي تذكر أرقاماً إحصائيّة، أورَدتُ بعضاً منها في كتاب «مسألة الحجاب».
2. الفراغ: إذا عُرِفَت المقدّمات، ينبغي أن لا يُفاجَأ بالنتائج. إنّ الحياة السطحيّة والرفاهيّة، والفراغ الروحيّ، وضبابيّة الرؤى الاجتماعيّة والدينيّة، مضافاً إلى قلّة ساعات العمل وارتفاع الأجور في الدول الصناعيّة، هذه كلّها عوامل أوجدت فراغاً وأوقات ميتة، وقد قيل قديماً: إن يكن الشغل مَجهَدَةً، فإنّ الفراغَ مَفسَدَةً.
إنّ الفراغ نفسه سببٌ لكثير من السلبيّات، ما لم يُملَأ، لكن كيف يُملَأ؟ إنّ ما وفّروه من وسائل تسلية، كالسينما والمسرح ونحوهما، زاد الطين بلَّة -كما يقولون-؛ لأنّ هذه المسلّيات تؤدّي إلى نسيان «النفس» واللهْوِ عنها، وتنمية «النفس المتوَهَّمة» الخادعة، ولا يلبث الإنسان أن يرجع إلى نفسه مستشعراً الفراغ يلفّه من جديد.
3. شيوع الأمراض العصبيّة والنفسيّة: «أمراض المدنيّة» اسمٌ أُطلِق على مجموعة من الأمراض والاضطرابات النفسيّة الّتي أفرزَتها «المدنيّات» المعاصرة.
الإحصائيّات -وهي موجودة لدى الغرب من أكثر من مئتَي عام، خلافاً لحالنا- تشير إلى أنّه كلّما ارتفع المستوى الصناعيّ والرفاه المادّيّ، ازدادَت هذه الأمراض شيوعاً. ويؤيّد هذا أنّ أسلافنا كانوا بمنجى من هذه البليّات، على الرغم ممّا عانوه من خشونة الحياة وبدائيّتها. ثمّ إنّه غير خافٍ أنّ الأمراض العصبيّة تارةً تؤدّي إلى آلام وعلل عضويّة، مثل التهاب الأمعاء وقرحة المعدة، وتارةً تؤدّي إلى تأزُّم نفسيّ محض، مثل الاكتئاب.
آمل أن لا يُساء فهم كلامي، أنا لا أُحبّذ الفقر أو أدعو للحدّ من التمدُّن، كلّا، وإنّما أدعو إلى إيجاد الحلّ الأمثل لرفع هذه الأمراض المكدِّرة لصفو الحياة؛ لئلّا تكون ضريبة «التمدّن» هي حياة الإنسان وسعادته.
4. الانفلات وتمرُّد الشباب (الهيبّيّة): من الظواهر المنتشرة في عالَم الغرب، تميُّع الشباب وانفلاتهم من التقاليد والأعراف والسنن؛ فلو سرحتَ فيهم بصرك، لرأيتَ واحدهم وقد أطلق شعر رأسه ولِمَّته، وأبان عن ذارعه ومتنه، ولم يرتدِ من الملبوس إلّا ما تهلهل وتخرّق، ولا من السروال إلّا ما قصر وأطبق. وهذا النموذج من الشباب الّذي يُصطَلَح عليه بـ«اللاأُبالي» و«اللاأُباليّة»، يدلّ على صدوف الشبيبة عن المدنيّة الحاضرة وعزوفهم عنها، على الرغم ممّا توفّره لهم من أدوات المتعة ومستلزمات الراحة المادّيّة؛ وما ذلك إلّا لشعورهم بعدم أهليّتها وقدرتها على تلبية حاجاتهم الحقيقيّة، بل على العكس، وجدوا أنفسهم واقعين تحت ضغوط نفسيّة مرهبة، فرأوا أنّ الأجدر هو أن يكونوا «لاأُباليّين»، فتعاطوا المخدّرات؛ لعلّها تخفّف شيئاً من آلامهم وهمومهم.
هذا الجيل اللامبالي لديه قناعة بأنّ هذه المدنيّة فارغة المضمون، وأنّها عبث وضياع، وإن كانوا قد لا يستطيعون تحديد موضع عبثها وضياعها، فهل هذا العبث يكمن في تقصير الآلة الصناعيّة والآلة هي العبث؟ لماذا تكون الآلة هي العبث؟! وهل العلم هو العبث؟ لا يمكن أن يصبح العلمُ عبثاً.
ولأجل هذا كلهّ، نراهم يتوافدون على الشرق -خصوصاً أقصاه- زرافات ووحداناً ، اعتقاداً منهم بأنّ فيه بُغيتهم، وبأنّ فيه مِن الإيمان ما يُشبِع روحهم ويُطَمئِن نفوسهم القلقة. إنّ «الآلة» الصمّاء الّتي علَّقوا عليها آمالهم، لم تزدهم في أنفسهم إلّا خساراً، ولا في أخلاقهم إلّا جفافاً وانحداراً، فيمَّموا الشرق والبلاد الهنديّة، طلباً لندى الإيمان وطراوة العرفان.
من حسن الحظّ، أنّ هذه الظاهرة محدودة بين شبابنا، فهم واقعاً لا طغيان فيهم ولا انفلات، والموجود من ذلك بينهم تقليدٌ محض لشبيبة الغرب، فهي ظاهرة مهاجرة لا جذور لها في نفوس شبابنا.
5. انحسار العاطفة: إنّ اللهاث وراء سراب الحياة والابتعاد عن الله، أفضيا إلى جمود الإحساس بالحبّ والمودّة بين الأفراد، فهم يعيشون بلا روح تقدح فيهم شعلة العاطفة الدافئة، تماماً كالآلة الصمّاء، حتّى الأمومة فقدت معناها، فلم تعد الأمّهات يحببنَ أولادهنّ كما تقتضيه مشاعر الأمومة، وكذا الأخ لأخيه، وهكذا، حتّى نصل إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وهذا ينعكس سلباً على العلاقة الزوجيّة الّتي هي نواة المجتمع، فتزداد حالات الطلاق، وتتفرّق العائلة.
الحكايتان الآتيتان تعبّران تعبيراً صادقاً عن هذا الواقع المرير:
الأولى: نقلها إليَّ أحد علمائنا الأفاضل، قال: إنّه ابتُلِي قبل سنوات بقرحة المعدة، فعزم على السفر إلى النمسا للعلاج، ولزيارة ابنه المقيم هناك. فلمّا أتمَّ علاجه وتماثل للشفاء، ذهب وابنه إلى مطعم، وكان ابنه يقوم على خدمته ويبالغ، وكان بالقرب منهما رجل وامرأة يناهزان من العمر 65 عاماً، وكانا يختلسان النظر إليهما بين الفينة والأخرى. يقول هذا الفاضل: إنّهما استدعيا ابني وتحادثا معه قليلاً، فأخبرني أنّهما سألاه: مَن هذا الّذي تخدمه وتبالغ؟ فأجابهما: إنّه والدِي، فقالا مندهشَين: وإنْ، فهل يعمل المرء مجّاناً لأبيه، ولو شاء لاتّخذ أجراً؟! فردَّ عليهما: وكيف لا أكون كذلك؟ وهو الّذي يرسل إليّ من إيران نفقة دراستي هنا. فدُهِشا، ثمّ قالا: نحن زوجان، ولنا بنت وابن، لكنّهما تركانا وحيدَين وافترقنا كلٌّ في مكان.
وبعد التحقيق، أقرّا بأنّهما تلاقيا وأحبَّ كلٌّ منهما الآخر قبل 33 عاماً، واتّفقا -آنذاك- على أن يتعاشرا لفترة من الزمن، فإن توافقَت طباعُهما وتجانسَت أخلاقُهما، عندها يتزوّجان. وإلى الآن، بعد مرور ثلاثين عاماً، لم ينجبا أطفالاً، ولم ينتهيا إلى نتيجة بعد فترة الخطوبة الطويلة هذه.
الثانية: قرأتُها في إحدى صحفنا، وحاصلها: إنّ طائرة ارتطمت بالأرض في «مصر»، وقُتِل في الحادث 92 راكباً، وقيل وقتها: إنّ أحد موظّفي المطار كان يعمل مشرفاً على تنظيم حركة الطائرات في المطار، وكان مطّلِعاً سلفاً على مآل الطائرة، وأنّها سرعان ما تهوي؛ لأنّها كانت على ارتفاع 2000 متر، والمفروض ألّا يقلّ ارتفاعها عن 3500؛ لكنّه لم يحذّر قائدها. فلمّا سُئِل عن السبب في عدم تحذيره له، أجاب ببرودة أعصاب: ذلك ليس من وظيفتي! إنّ أصحاب هذه القلوب الّتي هي كالحجارة، بل أشدّ قسوة؛ أناس مثلنا خلقةً وفطرةً، وقد يأتي يوم -لا سمح الله- نصبح فيه مثلهم، نفقد إنسانيّتنا في أدغال المادّة.
6. المجاعة: ذكرنا سابقاً أنّ بعض الأزمات قد لا تُصنَّف ضمن الأزمات المعنويّة اصطلاحاً، لكن لها أسباب معنويّة، ومن ذلك مسألة المجاعة. فمن المعلوم أنّه يوجد الآن في العالم، أكثر من خمسمئة مليون إنسان جائع، أكثرهم من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيّة، وإن كان يوجد أيضاً كمٌّ غيرُ قليل منهم في الدول الغنيّة. وهذه المأساة مردُّها إلى عدم الإحساس بالمسؤوليّة الإنسانيّة، وسوء توزيع الثروة وتبديدها في ما لا ينفع؛ فلو خُصِّص خُمسُ ميزانيّات التسلّح العالميّ لصالح القطاع الزراعيّ، أو الثروة الخضراء كما يسمّونها، لانجلى هذا الكرب والهمّ.
لقد وصل رقم المخصّصات العسكريّة قبل ثلاث سنوات، إلى 204 مليار دولار، والحال أنّ 50 مليار دولار تكفي لإنقاذ هؤلاء البشر من خطر الجوع... ولكنّ السياسة هي الحاكمة، وإلّا فما أكثر المؤتمرات الّتي تُعقَد هنا وهناك لمعالجة هذه المشكلة، ولكن دونما فائدة، ومنها مؤتمر عُقِد في روما واستمرَّ أسبوعاً كاملاً؛ وفي ختامه، كان أهمّ خبر أُعلِن عنه هو الإشارة إلى كرم الضيافة الّذي غمر به المضيفون ضيوفهم، من ممثّلي الدول المشاركة.
ليس هذا فحسب، بل إنّ الأمريكيّين ينفقون سنويّاً ما يقارب مليارَي دولار على الكلاب والقطط، ويهدرون الفائض، وهم يرون أبناء جلدتهم يموتون بسبب الجوع والفقر.
7. تلوُّث البيئة: إنّ مشكلة تلوّث المحيط الحياتيّ للإنسان وغيره، تثير جدلاً عالميّاً لا ينقضي؛ ذلك أنّه، وبصوره كافّة، يُهدّد وجود الإنسان أو سلامته تهديداً جادّاً. وهذا التلوّث نعيشه في كبرى مدننا.
إنّ الهواء -وهو العنصر الأساس لحياة الإنسان- من أهمّ ضحايا التلوّث، وتلوّثُه يزداد يوماً بعد يوم. ولا أحسب أنّ هذا التلوّث لا مفرّ منه لكونه ضريبة للآلة الصناعيّة، كما يدَّعي بعضهم، بل أحسب أنّه ناتج عن التصنيع غير الرشيد وغير المتوازن مع حاجة المستهلك؛ فالمصنِّعون يُغرقون الأسواق بمنتجاتهم الّتي تزيد عن حاجة الإنسان بمرّات، وهذا يؤدّي إلى استمرار عمل المصانع، ومن ثمّ إلى ازدياد مخلّفاتها الضارّة بالصحّة والبيئة. والسبب في هذا كلّه، الحرص على الإثراء، ولو على حساب حياة البشر، وهم يبدون آلاف الحيل لتسويق منتجاتهم، ويستغلّون وسائل البثّ العالميّ الحديثة لإغراء المستهلكين وجذب أنظارهم، عن طريق الجنس والموسيقى الصاخبة ونحو ذلك.
بهذه الطريقة، تبقى تُروس المصانع تدور وتدرّ الربح الوفير من جيوب الشعوب. فالسبب في التلوّث ليس هو ذات الآلة، بقدر ما هو الإنسان الجشع، غريق المادّة. لذلك، فأنا لا أوافق «توِينْبي» (Arnold Toynbee) في ما يذهب إليه من أنّ الآلة هي المسؤولة، أوّلاً وأخيراً، عن مأساة الإنسان، وأنّها ستؤدّي إلى فنائه وطرده من جنّة الأرض، كما طُرِد أبوه «آدم» من جنّة السماء بسبب أكله من الشجرة المحرّمة. فالإنسان -والكلام له- بعد أن عمَّر هذه الأرض وجعل منها جنّة بديلة لجنّة أبيه، ارتكب خطأً فادحاً حينما اخترع هذه الآلة قبل ثلاثة قرون أو أربعة؛ لأنّه سيضطرّ لترك هذه الجنّة، فهو كدودة القزّ، تنسج شرنقتها لتموت داخلها، ولن يكون له مكان بديل عن هذه الأرض كما كان لأبيه، بل سيكون مصيره الفناء.
تدعيماً لرأيه، ذكر «توِينْبي» جنايات «الآلة» وما خلّفته من الآثار السيّئة على الطبيعة، هوائها وغاباتها، بحارها وأنهارها وحيواناتها. ثمّ شفّع كلامه بمَثَل أسطوريّ، وحاصله: أنّ ساحراً سحرَ جنّيّاً وحبسه في قارورة، وكان يتلفّظ بكلمة سرّ لإخراجه. وكان للساحر تلميذٌ يتحيَّن الفرص لمعرفة هذه الكلمة، وقد عرفها بعد حينٍ في غفلةٍ من أستاذه، فأخرَجَ الجنّيّ واستخدمه، لكنّه لم يكن يعرف كيف يدخله، فوقع في حيرة من أمره، ومن ثَمَّ انقلب الحال، وصار التلميذُ مُسَخَّراً للجنّيّ. وهكذا الإنسان، فإنّه تضاءل أمام قدرة الآلة، ووقع تحت سيطرتها.
هذا ما ذكره «توِينْبي» في مقال له نشرته صحيفة «اطّلاعات» مترجماً قبل عام، ولكنّني -كما عرفت- لا أشاطره هذا الرأي.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 خصائص الصيام (1)
خصائص الصيام (1)
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الشيخ محمد صنقور
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 معرفة الإنسان في القرآن (6)
معرفة الإنسان في القرآن (6)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (فور) في القرآن الكريم
معنى (فور) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

خصائص الصيام (1)
-

الموانع من حضور الضيافة الإلهية
-

البعث والإحياء بعد الموت
-

حديث للاختصاصيّ النّفسيّ أسعد النمر حول توظيف التّقنية في العلاج النّفسيّ
-

التقوى، العطاء، الإيثار في شهر رمضان
-

شرح دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان
-
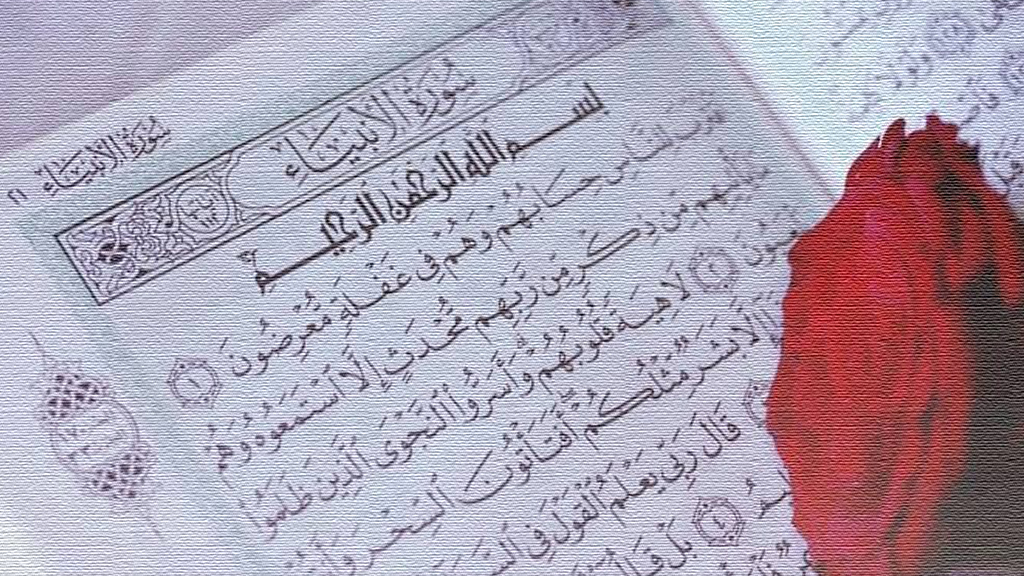
معرفة الإنسان في القرآن (6)
-

شرح دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان
-

لقاء الرحمة والعبادة
-

معنى (فور) في القرآن الكريم










