علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد محمد باقر الصدرعن الكاتب :
ولد في مدينة الكاظمية المقدسة في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 1353 هـ، تعلم القراءة والكتابة وتلقى جانباً من الدراسة في مدارس منتدى النشر الابتدائية، في مدينة الكاظمية المقدسة وهو صغير السن وكان موضع إعجاب الأساتذة والطلاب لشدة ذكائه ونبوغه المبكر، ولهذا درس أكثر كتب السطوح العالية دون أستاذ.rnبدأ بدراسة المنطق وهو في سن الحادية عشرة من عمره، وفي نفس الفترة كتب رسالة في المنطق، وكانت له بعض الإشكالات على الكتب المنطقية. بداية الثانية عشرة من عمره بدأ بدراسة كتاب معالم الأصول عند أخيه السيد إسماعيل الصدر، سنة 1365 هـ هاجر إلى النجف الاشرف، لإكمال دراسته، وتتلمذ عند آية الله الشيخ محمد رضا آل ياسين وآية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي. أنهى دراسته الفقهية عام 1379 هـ والأصولية عام 1378 هـ عند آية الله السيد الخوئي.rnمن مؤلفاته: فدك في التاريخ، دروس في علم الأصول، نشأة التشيع والشيعة، فلسفتنا، اقتصادنا وغير ذلك.نقد الحركة الديالكتيكية في الفكر

فهل الحقيقة القائمة في فكر الإنسان تتطوّر وتتكامل حقيقة؟ وهل يمكن للحقيقة أن تجتمع مع الخطأ؟
وهل تحتوي كلّ حقيقة على نقيضها وتنمو بهذا التناقض الداخلي؟
هذا ما نريد أن نتبيّنه فعلاً.
يجب قبل كلّ شيء أن نعرف ماذا يراد بالحقيقة القائمة في الفكر الإنساني التي آمنت الماركسية بنموّها وتكاملها؟
إنّ الفلسفة الواقعية تؤمن بواقع خارج حدود الشعور والذهن، وتعتبر التفكير ـ أيّ تفكير كان ـ محاولة لعكس ذلك الواقع وإدراكه. وعلى هذا، فالحقيقة هي الفكرة المطابقة لذلك الواقع والمماثلة له. والخطأ يتمثّل في الفكرة أو الرأي أو العقيدة التي لا تطابق الواقع ولا تماثله. فالمقياس الفاصل بين الحقّ والباطل، بين الحقيقة والخطأ هو: مطابقة الفكرة للواقع.
والحقيقة بهذا المفهوم الواقعي هي موضوع العراك الفلسفي العنيف بين الواقعيين من ناحية، والتصوّريين والسفسطائيين من ناحية أخرى. فالواقعيون يؤكّدون على إمكانها، والتصوّريون أو السفسطائيون ينفونها أو يتردّدون في القدرة البشرية على الظفر بها.
غير أنّ لفظ (الحقيقة) قد استخدمت له عدّة معانٍ أخرى، تختلف كلّ الاختلاف عن مفهومها الواقعي الآنف الذكر، وابتعد بذلك عن الميدان الأساسي للصراع بين فلسفة اليقين ، وفلسفات الشكّ والإنكار.
فمن تلك التطويرات الحديثة التي طرأت على الحقيقة، تطوير النسبية الذاتية الذي شاء أن يضع للفظ (الحقيقة) مفهوماً جديداً. فاعتبر (الحقيقة) عبارة عن الإدراك الذي يتّفق مع طبيعة الجهاز العصبي وشروط الإدراك فيه. وقد قلنا إنّ إعطاء (الحقيقة) هذا المفهوم يعني أنّها ليست أكثر من تعبير عن شيء ذاتي، فلا تصبح (الحقيقة) حقيقة إلاّ من ناحية اسمية فقط. وبذلك تفقد (الحقيقة) في المفهوم النسبي الذاتي صفتها كموضوع للنزاع والصراع الفلسفي بين اتّجاهات اليقين والشكّ والإنكار في الفلسفة. فالنسبية الذاتية مذهب من مذاهب الشكّ يتبرقع بستار من الحقيقة.
وهناك تفسير فلسفي آخر (للحقيقة)، وهو الذي يقدّمه لنا (وليم جيمس) في مذهبه الجديد في المعرفة الإنسانية: (البراجماتزم) أو (مذهب الذرائع). وليس هذا التفسير بأدنى إلى الواقعية أو أبعد عن فلسفات الشكّ والإنكار من التفسير السابق الذي حاولته النسبية الذاتية.
ويتلخّص مذهب (البراجماتزم) في تقديم مقياس جديد لوزن الأفكار والفصل فيها بين الحقّ والباطل، وهو: مقدرة الفكرة المعيّنة على إنجاز أغراض الإنسان في حياته العملية. فإن تضاربت الآراء وتعارضت، كان أحقّها وأصدقها هو أنفعها وأجداها، أي: ذلك الذي تنهض التجربة العملية دليلاً على فائدته. والأفكار التي لا تحقّق قيمة عملية ولا يوجد لها آثار نافعة فيما تصادف من تجارب الحياة، فليست من الحقيقة بشيء، بل يجب اعتبارها ألفاظاً جوفاء لا تحمل من المعنى شيئاً.
فمردّ الحقائق جميعاً في هذا المذهب إلى حقيقة عليا في الوجود، وهي الاحتفاظ بالبقاء أوّلاً، ثمّ الارتفاع بالحياة نحو الكمال ثانياً. فكلّ فكرة يمكن استعمالها كأداة للوصول إلى تلك الحقيقة العليا فهي حقّ صريح وحقيقة يجب تصديقها، وكلّ فكرة لا تصنع شيئاً في هذا المضمار فلا يصحّ الأخذ بها.
وعلى هذا الأساس عرّف (برغسون) الحقيقة: بأنّها اختراع شيء جديد، وليست اكتشافاً لشيء سبق وجوده. وعرّفها (شلر) بأنّها ما تخدم الإنسان وحده. وحدّد (ديوي) وظيفة الفكرة قائلاً: إنّ الفكرة أداة لترقية الحياة، وليست وسيلة إلى معرفة الأشياء في ذاتها.
وفي هذا المذهب خلط واضح بين (الحقيقة) نفسها، والهدف الأساسي من محاولة الظفر بها. فقد ينبغي أن يكون الغرض من اكتساب الحقائق، هو استثمارها في المجال العملي والاستنارة بها في تجارب الحياة، ولكن ليس هذا هو معنى (الحقيقة) بالذات. ونلخّص الردّ عليه فيما يأتي:
أوّلاً: إنّ إعطاء المعنى العملي البحت للحقيقة، وتجريدها من خاصّة الكشف عمّا هو موجود وسابق، استسلام مطلق للشكّ الفلسفي الذي تحارب التصوّرية والسفسطة لأجله، وليس مجرّد الاحتفاظ بلفظة (الحقيقة) في مفهوم آخر كافياً للردّ عليه أو التخلّص منه.
ثانياً: إنّ من حقّنا التساؤل عن هذه المنفعة العملية التي اعتُبرت مقياساً للحقّ والباطل في (البراجماتزم): أهي منفعة الفرد الخاصّ الذي يفكر؟! أو منفعة الجماعة؟ ومن هي هذه الجماعة؟ وما هي حدودها؟ وهل يقصد بها النوع الإنساني بصورة عامّة أو جزء خاصّ منه؟ وكلّ من هذه الافتراضات لا تعطي تفسيراً معقولاً لهذا المذهب الجديد.
فالمنفعة الشخصية إذا كانت هي المعيار الصحيح للحقيقة، وجب أن تختلف الحقائق باختلاف مصالح الأفراد، فتحدث بسبب ذلك فوضى اجتماعية مريعة حين يختار كلّ فرد حقائقه الخاصّة، دون أيّ اعتناء بحقائق الآخرين المنبثقة عن مصالحهم، وفي هذه الفوضى ضرر خطير عليهم جميعاً.
وأمّا إذا كانت المنفعة الإنسانية العامّة هي المقياس، فسوف يبقى هذا المقياس معلّقاً في عدّة من البحوث والمجالات؛ لتضارب المصالح البشرية واختلافها في كثير من الأحايين، بل لا يمكن البت ـ حينئذٍ ـ بحقيقة مهما كانت، ما لم تمرّ بتجربة اجتماعية طويلة الأمد. ومعنى ذلك: أنّ (جيمس) نفسه لا يمكنه أن يعتبر مذهبه (البراجماتزم) صحيحاً ما لم يمرّ بهذه التجربة، ويثبت جدارته في الحياة العملية. وهكذا يوقف المذهب نفسه.
ثالثاً : إنّ وجود مصلحة للإنسان في صدق فكرة ما، لا يكفي لإمكان التصديق بها. فالملحد لا يمكنه أن يصدّق بالدين ولو آمن بدوره الفعّال في تسلية الإنسان، وإنعاش آماله ومواساته في حياته العملية، فهذا (جورج سنتيانا) يصف الإيمان بأنّه (غلطة جميلة، أكثر ملاءمة لنوازع النفس من الحياة نفسها).
فليس التصديق بفكرة نظير الألوان الأخرى من النشاط العملي التي يمكن للإنسان أن يقوم بها إذا تحقّق من فائدتها. وهكذا يقوم (البراجماتزم) على عدم التفرقة بين التصديق (النشاط الذهني الخاصّ) ومختلف النشاطات العملية التي يباشرها الإنسان على ضوء مصالحه وفوائده.
ونخلص من هذه الدراسة إلى أنّ المفهوم الوحيد (للحقيقة) الذي يمكن للفلسفة الواقعية اتّخاذه، هو: (الفكرة المطابقة للواقع).
والماركسية التي تنادي بإمكان المعرفة الحقيقية، وترفض لأجل ذلك النزعات التصوّرية والشكّية والسفسطائية، إن كانت تعني بـ (الحقيقة) مفهوماً آخر غير مفهومها الواقعي، فهي لا تتعارض مع تلك المذاهب مطلقاً؛ لأنّ مذاهب الشكّ والسفسطة إنّما ترفض (الحقيقة) بمعنى الفكرة المطابقة للواقع، ولا ترفض لفظ (الحقيقة) بأيّ مفهوم كان. فلا يمكن للماركسية أن تبرأ من نزعات الشكّ والسفسطة لمجرّد اتّخاذ لفظ (الحقيقة) وبلورته في مفهوم جديد.
فيجب إذن؛ لأجل رفض تلك النزعات حقّاً، أن تأخذ الماركسية (الحقيقة) بمفهومها الواقعي الذي ترتكز عليه الفلسفة الواقعية؛ حتّى يمكن اعتبارها فلسفة واقعية مؤمنة بالقيم الموضوعية للفكر حقّاً.
وإذا عرفنا المفهوم الواقعي الصحيح (للحقيقة)، حان لنا أن نتبيّن ما إذا كان من الممكن (للحقيقة) بهذا المفهوم الذي تقوم على أساسه الواقعية أن تتطوّر وتتغيّر بحركة صاعدة كما تعتقد الماركسية أو لا ؟ إنّ (الحقيقة) لا يمكن أن تتطوّر وتنمو، وأن تكون محدودة في كلّ مرحلة من مراحل تطوّرها بحدود تلك المرحلة الخاصّة، بل لا تخرج الفكرة ـ كلّ فكرة ـ عن أحد أمرين: فهي إمّا حقيقة مطلقة وإمّا خطأ.
وأنا أعلم أنّ هذه الكلّمات تثير اشمئزاز الماركسيين، وتجعلهم يقذفون الفكر الميتافيزيقي بما تعوّدوا إلصاقه به من تهم، فيقولون: إنّ الفكر الميتافيزيقي يجمّد الطبيعة ويعتبرها حالة ثبات وسكون؛ لأنّه يعتقد بالحقائق المطلقة، ويأبى عن قبول مبدأ التطوّر والحركة فيها، وقد انهار مبدأ الحقائق المطلقة تماماً باستكشاف تطوّر الطبيعة وحركتها.
ولكنّ الواقع الذي يجب أن يفهمه قارئنا العزيز: أنّ الإيمان بالحقائق المطلقة ورفض التغيّر والحركة فيها. لا يعني مطلقاً تجميد الطبيعة، ولا ينفي تطوّر الواقع الموضوعي وتغيّره. ونحن في مفاهيمنا الفلسفية نعتقد بأنّ التطوّر قانون عام في عالم الطبيعة، وأنّ كينونته الخارجية في صيرورة مستمرّة، ونرفض في نفس الوقت كلّ توقيت للحقيقة وكلّ تغيّر فيها.
ولنفرض ـ لإيضاح ذلك ـ أنّ سبباً معيّناً جعل الحرارة تشتدّ في ماء خاص، فحرارة هذا الماء بالفعل في حركة مستمرّة، وتطوّر تدريجي . ومعنى ذلك: أنّ كلّ درجة من الحرارة يبلغها الماء فهي درجة مؤقّتة، وسوف يعبرها الماء بصعود حرارته إلى درجة أكبر. فليس للماء في هذا الحال درجة حرارة مطلقة. هذا هو حال الواقع الموضوعي القائم في الخارج، فإذا قسنا حرارته في لحظة معيّنة، فكانت الحرارة فيه حال تأثّر المقياس بها قد بلغت [90] مثلً ، فقد حصلنا على حقيقة عن طريق التجربة، وهذه الحقيقة هي: أنّ درجة حرارة الماء في تلك اللحظة المعيّنة كانت [90]. وإنّما نقول عنها: إنّها حقيقة؛ لأنّها فكرة تأكّدنا من مطابقتها للواقع، أي: لواقع الحرارة في لحظة خاصّة. ومن الطبيعي أنّ حرارة الماء سوف لا تقف عند هذه الدرجة، بل إنّها سوف تتصاعد حتّى تبلغ درجة الغليان.
ولكنّ الحقيقة التي اكتسبناها هي: (الحقيقة) لم تتغيّر، بمعنى: أنّا متى لاحظنا تلك اللحظة الخاصّة التي قسنا حرارة الماء فيها، نحكم ـ بكلّ تأكيد ـ بأنّ حرارة الماء كانت بدرجة [90]. فدرجة [90] من الحرارة التي بلغها الماء وإن كانت درجة مؤقّتة بلحظة خاصّة من الزمان وسرعان ما اجتازتها الحرارة إلى درجة أكبر منها، إلاّ أنّ الفكرة التي حصلت لنا بالتجربة (وهي: أنّ الحرارة في لحظة معيّنة كانت في درجة [90]) فكرة صحيحة وحقيقة مطلقة، ولذا نستطيع أن نؤكّد صدقها دائماً. ولا نعني بالتأكيد على صدقها بصورة دائمة: أنّ درجة [90] كانت هي الدرجة الثابتة لحرارة الماء على طول الخطّ؛ فإنّ الحقيقة التي اكتسبناها بالتجربة لا تتناول حرارة الماء إلاّ في لحظة معيّنة، فحين نصفها بأنّها حقيقة مطلقة وليست مؤقتة، نريد بذلك: أنّ الحرارة في تلك اللحظة المعيّنة قد تعيّنت في درجة [90] بشكل نهائي، فالماء وإن جاز أن تبلغ حرارته درجة [100] مثلاً عقيب تلك اللحظة، ولكن من غير الجائز أن يعود ما عرفناه من درجة الحرارة عن تلك اللحظة الخاصّة خطأ بعد أن كان حقيقة.
وإذا عرفنا أنّ (الحقيقة) هي: الفكرة المطابقة للواقع، وتبينّا أنّ الفكرة إذا كانت مطابقة للواقع في ظرف معيّن، فلا يمكن أن تعود بعد ذلك فتخالف الواقع في ذلك الظرف بالذات، أقول: إذا علمنا ذلك كلّه يتجلّى بوضوح الخطأ في تطبيق قانون الحركة على الحقيقة؛ لأنّ الحركة تثبت التغيّر في الحقيقة، وتجعلها ـ دائماً ـ حقيقة نسبية ومؤقتة بمرحلتها الخاصّة من التطوّر، وقد عرفنا أنّه لا تغيّر ولا توقيت في الحقائق، كما أنّ التطوّر والتكامل في الحقيقة يعني: أنّ الفكرة تصبح بالحركة حقيقية بشكل أقوى، كما أنّ الحرارة ترتقي بالحركة إلى درجة أكبر، مع أنّ الحقيقة تختلف عن الحرارة. فالحرارة يمكن أن تشتدّ وتقوى، وأمّا الحقيقة فهي ـ كما عرفنا ـ تعبّر عن الفكرة المطابقة للواقع، ولا يمكن أن تقوى مطابقة الفكرة للواقع وتشتدّ كما هو شأن الحرارة، وإنّما يجوز أن ينكشف للفكر الإنساني جانب جديد من ذلك الواقع لم يكن يعلم به قبل ذلك، غير أنّ هذا ليس تطوّراً للحقيقة المعلومة سلفاً، وإنّما هو حقيقة جديدة يضيفها العقل إلى الحقيقة السابقة.
فإذا كنّا نعرف ـ مثلاً ـ أنّ ماركس تأثّر بمنطق هيجل، فهذه المعرفة هي الحقيقة الأُولى التي عرفناها عن علاقة ماركس بفكر هيجل. وحين نطالع بعد ذلك تاريخه وفلسفته نعرف أنّه كان على النقيض من مثالية هيجل، كما نعرف أنّه اتّخذ جدله فطبّقه تطبيقاً مادّياً على التاريخ والاجتماع، إلى غير ذلك من العلاقات الفكرية بين الشخصين. فكلّ هذه معارف جديدة تكشف عن جوانب مختلفة من الواقع، وليست نموّاً وتطوّراً للحقيقة الأُولى التي حصلنا عليها منذ البدء.
وليس تحمّس المدرسة الماركسية لإخضاع (الحقيقة) لقانون الحركة والتطوّر، إلاّ لأجل القضاء على الحقائق المطلقة التي تؤمن بها الفلسفة الميتافيزيقية.
وقد فاتها أنّها تقضي على مذهبها بالحماس لهذا القانون؛ لأنّ الحركة إذا كانت قانوناً عاماً للحقائق فسوف يتعذّر إثبات أيّة حقيقة مطلقة، وبالتالي يسقط قانون الحركة بالذات عن كونه حقيقة مطلقة.
فمن الطريف أنّ الماركسية تؤكّد على حركة (الحقيقة) وتغيّرها طبقاً لقانون الديالكتيك، وتعتبر أنّ هذا الكشف هو النقطة المركزية لنظريتهم في المعرفة، وتتغافل عن أنّ هذا الكشف بنفسه حقيقة من تلك الحقائق التي آمنوا بحركتها وتغيّرها، فإذا كانت هذه (الحقيقة) تتحرّك وتتغيّر كما تتحرّك سائر الحقائق بالطريقة الديالكتيكية، فهي تحتوي على تناقض سوف ينحلّ بتطوّرها وتغيّرها كما يحتّم ذلك الديالكتيك، وإذا كانت هذه (الحقيقة) مطلقة لا تتحرّك ولا تتغيّر، كفى ذلك ردّاً على تعميم قوانين الديالكتيك والحركة للحقائق والمعارف، وبرهاناً على أنّ (الحقيقة) لا تخضع لأصول الحركة الديالكتية. فالديالكتيك الذي يراد إجراؤه على الحقائق والمعارف البشرية، ينطوي على تناقض فاضح وحكم صريح بإعدام نفسه على كلا الحالين. فهو إذا اعتبر حقيقة مطلقة انتقضت قواعده، وتجلّى أنّ الحركة الديالكتيكية لا تسيطر على دنيا الحقائق؛ لأنّها لو كانت تسيطر عليها لما وجدت حقيقة مطلقة ولو كانت هذه الحقيقة هي الديالكتيك نفسه. وإذا اعتبر حقيقة نسبية خاضعة للتطوّر والحركة بمقتضى تناقضاتها الداخلية، فسوف تتغيّر هذه الحقيقة ويزول المنطق الديالكتيك ، ويصبح نقيضه حقيقة قائمة.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 خصائص الصيام (1)
خصائص الصيام (1)
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الشيخ محمد صنقور
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 معرفة الإنسان في القرآن (6)
معرفة الإنسان في القرآن (6)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (فور) في القرآن الكريم
معنى (فور) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

خصائص الصيام (1)
-

الموانع من حضور الضيافة الإلهية
-

البعث والإحياء بعد الموت
-

حديث للاختصاصيّ النّفسيّ أسعد النمر حول توظيف التّقنية في العلاج النّفسيّ
-

التقوى، العطاء، الإيثار في شهر رمضان
-

شرح دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان
-
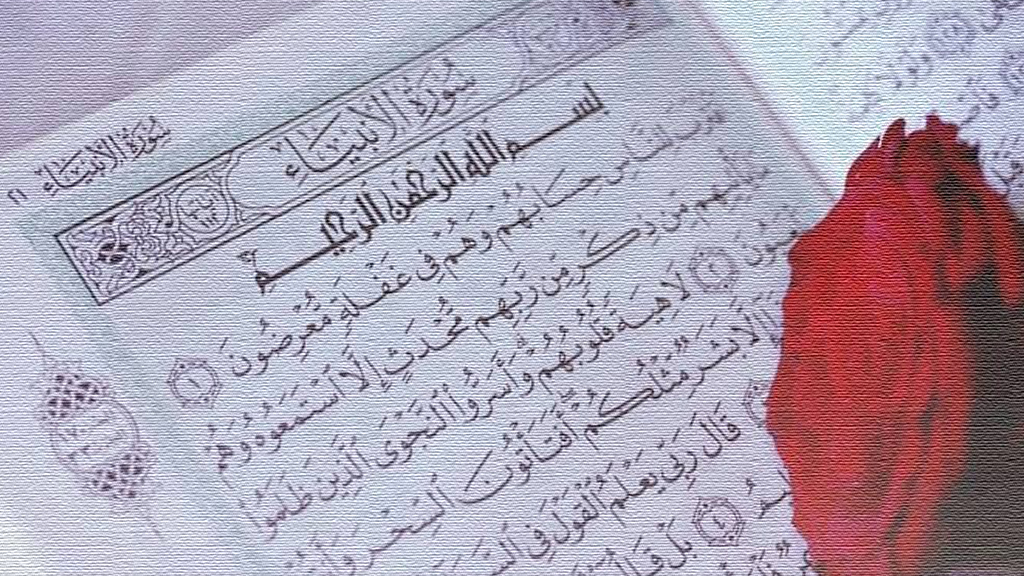
معرفة الإنسان في القرآن (6)
-

شرح دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان
-

لقاء الرحمة والعبادة
-

معنى (فور) في القرآن الكريم










