علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".أصالة (النومينولوجيا).. عَرَضيَّة (الفينومينولوجيا) (1)

نَدَر أن سُئِلت الفلسفةُ عن الدّوافع التي جعلتها تميلُ إلى الاعتناء بظواهر الموجودات والإعراض عن الأصل الذي هو علّة إظهارها. قد تكون هذه الندرة عائدةً في الغالب إلى أنّ الفينومينولوجيا لم تكن سوى مركَّبٍ ميتافيزيقيٍّ اتّخذ مكانةً حاكمةً في تاريخ الميتافيزيقا.
ابتدأت الملحمة مع السوفسطائيّة وما تلاها، ثمّ مع الانعطافة الأرسطيّة عبر المقولات العشر، ثم امتدَّت إلى عهود الحداثة بأطوارها المتعاقبة. ولقد تخالفت التنظيرات أو تقاطعت، بصدد ماهيّة الفينومينولوجيا، وهويّتها المعرفيّة، وطرائقها في التعرُّف إلى موضوعاتها. ولسوف نرى كيف امتلأ المعجم الفلسفيّ الحديث بما لا حصر له من التعاريف. منها من مضى إلى أنّ المعنى البَدئيّ لكلمة ظاهرة (Phainomenon) مشتقّة من فعل (Phainesthai) بمعنى «ظهر». ومنها من رأى أنّ الظاهرة هي ما يظهر من تلقاء ذاته، أو ما هو بادٍ للعيان، بقطع النّظر عن السبب الكامن وراء إبدائه.
لم تكن الفينومينولوجيا كمصطلح ومقصد حديثة العهد. فقد ظهرت في مستهلَّات العهد الفلسفيّ اليونانيّ مع المدرسة الشكِّيّة (في القرن الرابع ق.م). كان بيرون (Pyroon) المأخوذ حدّ الشغف بـ “التريُّب واللَّاأدريّة”، هو أوّل من استخدمه ليشير إليه بمفردة “الأبوخي”، التي تعني “تعليق الحكم”. أي التريُّب حيال، والإعراض (عن) كلّ ما ينتمي إلى عالم المغيَّبات بذريعة استحالة الأدلّة على إثباته. من ثمّ دعا أرقيسلاوس (Arcesilious) إلى إيقاف الحكم في قضايا الاعتقاد على نحوٍ كليٍّ. ثمّ لينتهي الأمر إلى ضربٍ من قطيعةٍ ابستمولوجيّةٍ بين الظواهر وبواعثها الأصليّة.
في أزمنة الحداثة بدا “الظواهريون” كأنّهم استورثوا المقولة الإغريقيّة عن ظهر قلب. الفيلسوف الألمانيّ يوهان هاينريش لامبرت (1728 ـ 1777 م) في كتابه (الأورغانون الجديد)، هو أوّل من استعمل الفينومينولوجيا كمصطلح، وكان مراده منها درس الخصائص الوهميّة للإدراك الإنسانيّ، ثم انبرى إلى نعت الظاهراتيّة بـ “نظريّة التوهّم”. بعد ذلك سيذهب كانط (1724 ـ 1804 م) خطوةً أبعد؛ ليميِّز بين الأشياء كما تظهر في الإدراك، والأشياء كما هي في نفسها وبشكل مستقلّ عن قوانا المعرفيّة. ثم ليخلص إلى أنّ “النومين” غير قابل للتعريف أبدًا، وأنّ الظاهر -“الفينومين”- هو وحده القابل للتعريف؛ وبذلك صارت المعرفة الكانطيّة معادلةً في معناها ودلالاتها للعلم بالظاهريّات.
مع أنّ كثيرين من “ظواهريي الغرب” سيعمد إلى استعمال الفينومينولوجيا كمرادف للواقعيّة، أو كإعراب عن الحقيقة الخارجيّة، سينبري جمعٌ من متأخِّري القرنين التاسع عشر والعشرين إلى تعريف المفهوم بأنّه "تحقيق توصيفيّ يشمل كلّ ما يرد على الذهن، سواء كان ذلك أمراً حقيقياً، أو مجرّد تداعيات وهمية…".
ربّما لهذا السبب، سيُقال إنّ الفينومينولوجيا لا تقدِّم نفسها كعلمٍ قائمٍ بذاته، وإنّما كرؤيةٍ وصفيّةٍ تحكي ما هو ظاهر، وتستحكي ما هو مستتر؛ لتستدلّ على واقعيّته أو إمكان ظهوره. فأنْ تكون الفينومينولوجيا وصفيّةً، إنّما هو تحصيلٌ حاصل.. إلّا أنّ ذلك لا يعني – كما يُبيِّن القائلون – أن تكون غايتها بناء المعنى، أو إعادة بنائه من منطلقِ ذاتٍ مفكِّرةٍ تجعلُ من ذاتها مركز كلّ دلالة.
إنّ تعريف الفينومينولوجيا على هذا النحو، يعني بصورةٍ أو بأخرى، تبرئتها من تَبِعات إصدار الأحكام. غير أنّ ادعاءً كهذا لا يلبث أن ينحدر إلى حقل التناقض حالما يتّخذ الفينومينولوجيّ سبيله إلى مختبر التجربة. في هذه الحال، لن يكون لأيّ منهج أن يزعم الحياد بذريعة أنّه يؤدّي مهمّةً توصيفيّةً. ذلك بأنّ كلّ توصيف يُجريه الفينومينولوجيّ حيال ظاهرة ما، هو في الناتج ضربٌ من حكمٍ شخصيٍّ يُصدرُه على الحالة الموصوفة، أنَّى كانت نسبة الموضوعيّة في حكمه.
ولقد دلَّت أعمال الفينومينولوجيين على أنّ التحقيق التوصيفيّ للظواهر لا يتوقّف عند سطوح الظاهرة، لكونه يحظى بمفهوم أوسع مما جيء به في القاموس الفلسفيّ الحديث. فالتوصيف ليس مجرّد بيان الأوصاف، بما في ذلك الأوصاف الذاتية؛ بل يمتد إلى ما هو أعم من ذلك، أي إلى مجرّد تبيين النسبة بين أمرين متغيِّرين. فالسؤال عن الآثار والعلامات ونسبة ظاهراتيّة ظاهرة معيّنة إلى الظاهراتيات الأخرى، إنّما يُعدّ في الواقع حرثاً معرفيّاً في أرض التوصيف.
وهذا يُحيلنا بداهةً إلى ما ذهب إليه نقّاد المسلك الفينومينولوجيّ لـمّا رأوا أنّ التعريف الحقيقيّ لكلّ مفهوم يروم الوصول إلى حقيقة الشيء والتعرُّف على ماهيّته وهويّته. وهو -أي المفهوم- إلى جانب سيرته التاريخيّة -التي تدخل في خصائص كل المفاهيم- له أيضاً خصوصيّة الكشف واستيلاد المعرفة. أمّا حاصل هذا التنظير فمؤدَّاه: أنّ التعاريف الحقيقيّة وإن جاءت في مقام التوصيف، فإنّها تختزن خاصيّة الكشف عن حقيقة الشيء. ومن هنا تطرح مسألة الخطأ في التعريف، وإمكان التنازع في صحّته أو عدم صحّته. فالتعريف الذي يُذكر في الجواب على مطلب “ما”، ينبغي أن يكون مطابقاً لواقع هذا المطلب، وإلا وقع النزاع فيه وعُدَّ خاطئاً.
حين وقفت المدارس الفينومينولوجيّة الحديثة بانذهال أمام “النومين”، كباعث خفيٍّ لـ “الفينومين”، دأبت على تعريفه باللَّا مشعور به، أو بالشيء المصموت عنه والمغفول عن سيرته. غير أنّ هذا “التسقيط المفهومي” لـ “الشيء في ذاته” لم يكن بداعي النّظر إليه كأمرٍ بديهيٍ، وإنّما لكونه السرَّ الذي اسْتَتَر عن النّظر، وعزَّ فهمُه على طبائع العقول المشغولة بدنيا المظاهر.
ولـمّا تنبَّه أدموند هوسرل إلى مشكلة تقديم الفينومينولوجيا كعلمٍ ومنهجٍ بينما هي مفصولة عن أصلها، طَفَقَ يرتِّب نظاماً للتفكير المفارق يُقصدُ منه إخراج مشروعه الفلسفيّ مما ينطوي عليــه من إغماضٍ، وما قد يُسفر عنه من عثرات فـي بنيتــه التكوينيّــة. لذا سيطلــق شعاره الأثير بضرورة “الرجوع إلى الأشياء ذاتها” (To The Things Themselves). أما ديناميات الرجوع إلى الأشياء في ذاتها واستبطان ماهياتها، فهذا ما لم نشهد له بيِّنة لدى هوسرل. حصل ذلك على الرّغم من تميُّزه عمّا ذهب إليه الإغريق حين استعملوا “الأبوخي” للإشارة إلى إستحالة معرفة الشيء في ذاته.
لقد أراد تأويل هذا المصطلح في إطار منهجيّته الجديدة التي تقول بالتقييد لا “الاستحالة”. أي بلزوم التعليق المؤقت للحكم على المدركات الماديّة، وذلك من أجل التوجّه نحو مقام متعالٍ (ترانسندنتالي) تُدركُ فيه الصور العقليّة الحقيقية للأشياء تبعاً لتلازم “القصدية” و”الشعور”، اللذين يشكّلان جوهر منهجه الفينومينولوجي.
الفينومينولوجيون من نظرائه، وكذلك الذين جاؤوا من بعده، سيواجهون هذه المعضلة، فضلاً عن معضلة التوفيق بين توصيف الظواهر وتعليق الحكم عليها. بسببٍ من هذا التعقيد المعرفيّ، سوف تنمو التباينات وتتضاعف حيال تعريف ماهيّة وهويّة ومهمّة المنهج الفينومينولوجيّ ومقاصده. من أبرز تداعيات هذه القضية أنّ جمعاً من هؤلاء ذهبوا شوطاً أبعد ليقرّروا أنّ الفينومينولوجيا هي علم الماهيات الذي يُدرَك بواسطة الحدس، بوصفه المرحلة القصوى من إدراك معنى الظواهر. والحدس -كما يقرّر المشتغلون بعلم الشيء في ذاته- هو المقدرة على التوغّل عبر الحاجز الفاصل بين الوعي والوعي الباطني (اللَّاوعي). ولأنّ هذا الأخير متّصلٌ بالوعي الكليّ، فإنّه يستطيع العثور على مَنفذٍ إلى مصدر لمعرفةٍ مفارقةٍ لأعراض الأشياء ومظاهرها.
الـمُحقَّقُ عن هوسرل أنّه حاول فهم الشّيء في حضوره الأوّليّ البَدئيّ في العالم. وأنّ هذا الشّيء سيكون عنده موضوع الإدراك الحسّيّ، والجوهر الحامل للمقولات، واستطراداً، هو ما يُقابل الذات العارفة على مستوى نظريّة المعرفة. لكنّ مشكلة فهم حقيقة الأشياء لدى رائد التنظير الفينومينولوجي، هي تلك التي ستظهر بصيغة الاستفهام الذي يحتاج إلى جواب: كيف يمكن لذات واحدة، من دون أن تتعرَّف إلى تاريخ الفكر البشريّ أن تعود إلى العلاقة الأوّليّة مع الأشياء المحضة، لتعيد تحديد حقيقتها من جديد؟
حيال هذا الاستفهام، دأب هوسرل في مسعاه المنهجيّ على عدم الفصل بين “النومين” و”الفينومين”، بل جعلهما كينونةً واحدةً، يُمكن التعرُّف إليها حضورياً من دون توسُّط المفاهيم. اعتَقَدَ أنّ ذات الأشياء (النومين) هي نفسها التي تحضر، فيُدركها الفاعل المعرفيّ -أي الإنسان- حيث يحصل التطابق بين الذهن والعين من بعد أن كانا منفصلين. وهذا الاعتقاد جاء نتيجة فرضيّته التي تقول إنّ ذات الأشياء هي ماهيتها. أي هي نفسها الخصائص التي تميّزها والعناصر التي تكوِّنها وتبدو من خلالها للعيان.
وبهذا المعنى، لن يكون ثمّة انفكاك بين الفاعل المعرفيّ وموضوع المعرفة، بل تطابق بين العارف والمعروف. حيث إنّ ذات الموضوع في هذه الحال، هو الذي يتبدَّى كعلمٍ حضوريٍّ لدى المدرِك خارج معياريّة المفاهيم ووساطتها. ذلك لأنّ المفاهيم تُقيم المسافة بين طرفي المعرفة، بينما يؤدّي التحرّر منها الى التعرُّف على ذات ماهيّة الشيء عبر شهودها في الواقع من جانب العارف.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 حقيقة التّكبّر
حقيقة التّكبّر
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 معنى (فره) في القرآن الكريم
معنى (فره) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 {حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ..} كيف يُنسب اليأس للرسُل؟
{حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ..} كيف يُنسب اليأس للرسُل؟
الشيخ محمد صنقور
-
 كيف تعزز الرضاعة الطبيعية جهاز مناعة الرضيع؟
كيف تعزز الرضاعة الطبيعية جهاز مناعة الرضيع؟
عدنان الحاجي
-
 أَمَرْنا مُتْرَفِيها!
أَمَرْنا مُتْرَفِيها!
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 كيف نحافظ على الفطرة قوية فاعلة؟
كيف نحافظ على الفطرة قوية فاعلة؟
السيد عباس نور الدين
-
 أنت أيضًا تعيش هذا النّمط الخطير من الحياة!
أنت أيضًا تعيش هذا النّمط الخطير من الحياة!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 رأس العبادة، آدابٌ للدعاء
رأس العبادة، آدابٌ للدعاء
الشيخ شفيق جرادي
-
 الملائكة وسائط في التدبير
الملائكة وسائط في التدبير
السيد محمد حسين الطبطبائي
-
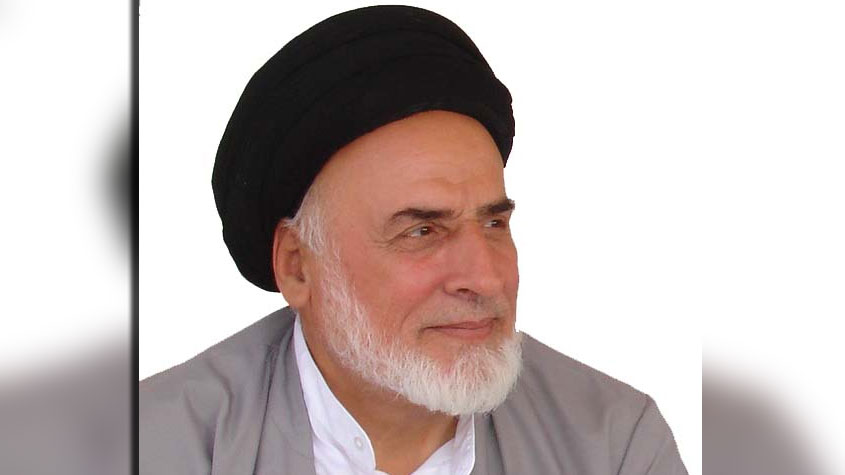 البحث التاريخي
البحث التاريخي
السيد جعفر مرتضى
الشعراء
-
 الحوراء زينب: قبلة أرواح المشتاقين
الحوراء زينب: قبلة أرواح المشتاقين
حسين حسن آل جامع
-
 على غالق
على غالق
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-

حقيقة التّكبّر
-

معنى (فره) في القرآن الكريم
-

{حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ..} كيف يُنسب اليأس للرسُل؟
-

الرمان قد يحدّ من مخاطر المكملات الغذائية الرياضية المثيرة للجدل
-

كيف تعزز الرضاعة الطبيعية جهاز مناعة الرضيع؟
-

زكي السالم: حين تُتخم بالمصطلحات والاستعراض الأجوف
-

على ذراعيكِ نبتت مَدينة
-

الحوراء زينب: قبلة أرواح المشتاقين
-

من آيات عظمة الله سبحانه
-
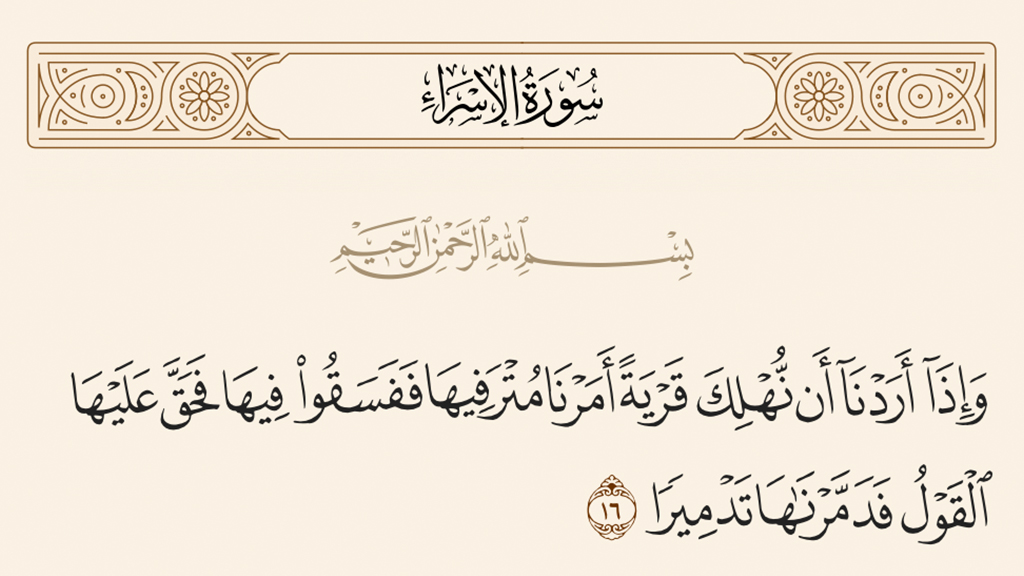
أَمَرْنا مُتْرَفِيها!










