علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ جعفر السبحانيعن الكاتب :
من مراجع الشيعة في ايران، مؤسس مؤسسة الإمام الصادق والمشرف عليهافلسفة التاريخ وعلم الاجتماع

المراد من فلسفة التاريخ هو: الاطّلاع على القوانين الكلية للمجتمع والتاريخ، والعلم بالتحولات والتطورات التي تحدث في المجتمعات من مرحلة إلى مرحلة، والعلم بالقوانين الحاكمة على تلك التحوّلات.
وإنّ أوّل من التفت إلى هذه المسألة وأزاح الستار عن تلك القوانين الكلية للتاريخ، ووضع أُسس هذا العلم، هو العالم المغربي المعروف «عبد الرحمن بن خلدون» المتوفّى عام 808هـ.ق. فقد كتب هذا الرجل موسوعة تاريخية تحت عنوان «العبر وديوان المبتدأ والخبر» في سبع مجلدات، ولكن هذه الموسوعة التاريخية لم تحظ بشهرة واسعة، ولكنّه في نفس الوقت كتب مقدمة لهذا التاريخ اشتهرت باسم «مقدمة ابن خلدون» هذه المقدّمة نالت حظاً وافراً من الشهرة في الأوساط العلمية حتّى أنّها ترجمت إلى أكثر من لغة، ثمّ جاء من بعد ابن خلدون علماء ومفكّرون واصلوا المسير في هذا المجال حتّى تمّت أركان هذا العلم وظهر في الساحة كعلم مستقل له أُسسه وقوانينه.
يوجد إلى جانب هذا العلم علم آخر هو «علم الاجتماع» يقترب بنحو خاص من علم فلسفة التاريخ، ولكن يوجد تفاوت أساسي وواضح بين العلمين، فبما أنّ علم فلسفة التاريخ يدرس القوانين الكلية التي تحكم المجتمع والتاريخ، فلذلك لا محيص من مطالعة ودراسة التاريخ البشري بصورة كاملة وتامّة، ثمّ معرفة القوانين الكلّية التي تحكمه وتسيطر عليه، ولا يمكن أبداً الاكتفاء بدراسة مقطع خاص من التاريخ أو دراسة تاريخ مجتمع خاص من المجتمعات البشرية بصورة مبتورة عن التواريخ أو المجتمعات الأخرى.
وليس الأمر كذلك في «علم الاجتماع»، إذ يكتفي العالم الاجتماعي بدراسة الحوادث والتحوّلات والمشاكل الحاكمة على مجتمع ما، إذ بإمكانه أن يأخذ مقطعاً زمانياً أو مكانياً خاصاً ويسلّط الأضواء عليه طبقاً لقوانين علم الاجتماع.
فعلى سبيل المثال: بإمكان العالم الاجتماعي دراسة المجتمع الإيراني في العصر الراهن قبل الثورة الإسلامية أو ما بعدها حيث بإمكانه أن يسلّط الأضواء على المسائل الاجتماعية والمشاكل الموجودة من قبيل مشكلة الإقطاعيّين والفلاحين، وأصحاب المصانع والعمّال، والطبقات الأخرى كأصحاب الشهادات ـ الدبلوم والبكالوريوس والماجستير و...ـ وكذلك مسألة العاطلين عن العمل، وغير ذلك من القضايا الاجتماعية، وأمّا دراسة العوامل المحركة للتاريخ والقوانين الكلية الحاكمة على المجتمع فإنّها من مهام ومسؤوليات علم «فلسفة التاريخ».
بعد أن اتّضح لنا الفارق الأساسي بين العلمين، يلزم التعرّف على مفهوم «المجتمع» وتسليط الأضواء عليه.
إنّ أوّل بحث يطرح في المجتمع والتاريخ، هو التعرف على معنى الحياة الفردية والحياة الاجتماعية، وبعد التعرف على حقيقة هاتين الحياتين يتّضح وبصورة قهرية مفهوم «المجتمع».
إنّ الحياة الفردية في الحقيقة هي ما يقابل الحياة الاجتماعية حيث يتّخذ الإنسان لنفسه نمطاً من العيش يفتقر لجميع القوانين والسنن والبرامج وتوزيع الاحتياجات والمنافع، بنحو يتحمّل كلّ إنسان مسؤولية تلبية متطلّبات حياته بمفرده ويتحمّل مسؤولية توفير كلّ ذلك بمعزل عن الآخرين ولم يستعن بأحد من الناس في كلّ ذلك، وهكذا ينفرد لوحده بالمنافع التي يحصل عليها والثمار التي يجنيها من خلال جهوده ومثابرته.
إنّ هذا النمط من الحياة ـ وفقاً لرؤية العلماء ـ مخالف للطبيعة الإنسانية ولابدّ للإنسان عاجلاً أم آجلاً أن يفلت من هذا النمط الحياتي ويولّي وجهه صوب الحياة الاجتماعية.
ففي الحياة الاجتماعية تكون للحياة ماهية اجتماعية وإنّ حياة الأفراد تتمّ على أساس تقسيم الثروة والمنافع، وإنّ هذا التقسيم محكوم بسنن وقوانين لا يحق للأفراد تجاوزها ويجب عليهم العمل طبقها والالتزام بها.
إنّه في إطار التقسيم القائم على أساس الاحتياجات والمنافع تتولّد بين الأفراد وحدة في الفكر وفي الآيديولوجية والأهداف، وفي الأخلاق والطبائع والخصال، تربط الأفراد فيما بينهم بصورة أكبر بحيث تغرق الناس جميعاً في نمط حياة مشتركة وتربطهم بمصير واحد كمثل ركاب السفينة الواحدة أو الطائرة واحدة الذين يشتركون في وحدة المكان، ووحدة المصير على متن الطائرة أو السفينة.
ويطلق على هذا النمط من الحياة والأفراد الذين يشكّلون هذا النوع من الحياة، اسم المجتمع.
إذاً، الأساس في الحياة الاجتماعية هو مسألة تقسيم الأعمال والمنافع، وحكومة الآداب والسنن، ووحدة الخلق والطبائع، ووحدة الأهداف والثقافة، وليس وحدة الماء والهواء والعيش في محيط جغرافي خاص.
ولا ريب أنّ الإنسان في حالة اختيار نمط الحياة الفردية لم يكن مسؤولاً تجاه الأفراد الآخرين بأيّ نحو من أنحاء المسؤولية، ولذلك يعيش حالة الاستقلال والحرية على العكس من الإنسان الذي يحيا حياة اجتماعية فإنّه مسؤول تجاه الآخرين، ولذلك نراه يفقد قسماً من حرّياته، وتكون حرّيته محدّدة بمصلحة ومنافع سائر أفراد المجتمع وأنّها تكون محترمة مدى التزم الإنسان بمراعاة حقوق الآخرين.
وانطلاقاً من وحدة المصير هذه التي تحكم أفراد المجتمع، يكون التظاهر بالذنوب وارتكاب المعاصي جهراً وأمام الملأ العام من الأمور المحظورة جداً في الإسلام وإنّ قسماً من المسائل المتعلّقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتعلّق بهذا الموضوع، ولذلك نجد الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) يطرحها بقوله: «إنّ المعصية إذا عمل بها العبد سرّاً لم تضرّ إلاّ صاحبها ،وإذا عمل بها علانية ولم يغيّر عليه أضرّت العامّة».
فلسفة الرقابة العامّة
من هذا المنطلق تتّضح لنا فلسفة الرقابة العامة والتي أشار إليها القرآن الكريم تحت عنوان «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في عشرة موارد، ومن خلال ملاحظة وحدة الرابطة والعلاقة بين أفراد المجتمع والحكم الواحد الذي يخضع له المجتمع، لا يمكن اعتبار الرقابة العامة ـ التي تتم من خلال كافة أفراد المجتمع، ومن خلال إجراء المقررات، وتنفيذ القوانين وتطبيق العقوبات على المخالفين ـ مخالفة لقوانين وسنن الحرية والاستقلال، وذلك لأنّ الحياة الاجتماعية لا يمكن بحال من الأحوال أن تقوم من دون تلك المراقبة ومن دون تنفيذ القوانين والمقررات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إنّ كلّ فرد حينما يختار الحياة الاجتماعية لابدّ أنّه قد اختار أيضاً تلك المقررات والقوانين التي ـ وبلا شكّ ـ سوف تحدُّ من صلاحياته واستقلاله وحريته.
وبسبب كون الحياة الاجتماعية هي حياة المسؤوليات والتعهّدات الاجتماعية، نجد القرآن الكريم قد أولاها أهمية خاصّة، ووضع على عاتق الإنسان المسلم الكثير من المسؤوليات والتكاليف تجاه المجتمع والتي تشكّل القسم الأكبر من سنن ومقررات الفقه الإسلامي، حتّى أنّها تفوق المقررات والقوانين والأحكام الفردية للإنسان المسلم.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 حقيقة التّكبّر
حقيقة التّكبّر
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 معنى (فره) في القرآن الكريم
معنى (فره) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 {حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ..} كيف يُنسب اليأس للرسُل؟
{حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ..} كيف يُنسب اليأس للرسُل؟
الشيخ محمد صنقور
-
 كيف تعزز الرضاعة الطبيعية جهاز مناعة الرضيع؟
كيف تعزز الرضاعة الطبيعية جهاز مناعة الرضيع؟
عدنان الحاجي
-
 أَمَرْنا مُتْرَفِيها!
أَمَرْنا مُتْرَفِيها!
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 كيف نحافظ على الفطرة قوية فاعلة؟
كيف نحافظ على الفطرة قوية فاعلة؟
السيد عباس نور الدين
-
 أنت أيضًا تعيش هذا النّمط الخطير من الحياة!
أنت أيضًا تعيش هذا النّمط الخطير من الحياة!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 رأس العبادة، آدابٌ للدعاء
رأس العبادة، آدابٌ للدعاء
الشيخ شفيق جرادي
-
 الملائكة وسائط في التدبير
الملائكة وسائط في التدبير
السيد محمد حسين الطبطبائي
-
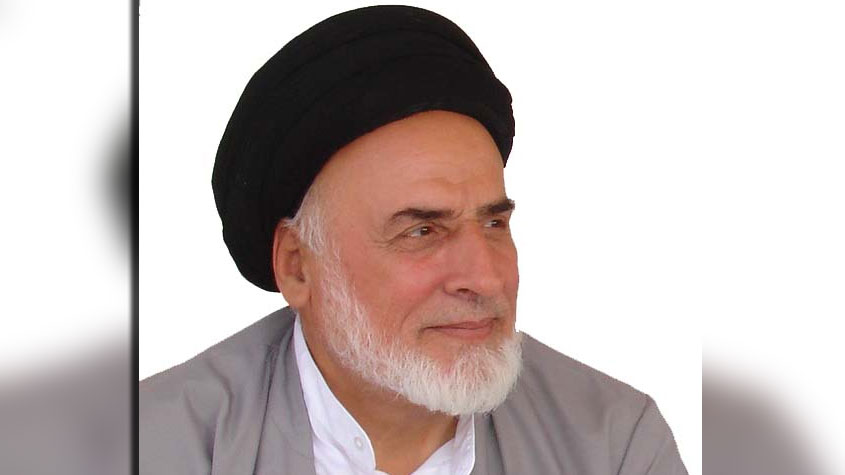 البحث التاريخي
البحث التاريخي
السيد جعفر مرتضى
الشعراء
-
 الحوراء زينب: قبلة أرواح المشتاقين
الحوراء زينب: قبلة أرواح المشتاقين
حسين حسن آل جامع
-
 على غالق
على غالق
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-

حقيقة التّكبّر
-

معنى (فره) في القرآن الكريم
-

{حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ..} كيف يُنسب اليأس للرسُل؟
-

الرمان قد يحدّ من مخاطر المكملات الغذائية الرياضية المثيرة للجدل
-

كيف تعزز الرضاعة الطبيعية جهاز مناعة الرضيع؟
-

زكي السالم: حين تُتخم بالمصطلحات والاستعراض الأجوف
-

على ذراعيكِ نبتت مَدينة
-

الحوراء زينب: قبلة أرواح المشتاقين
-

من آيات عظمة الله سبحانه
-
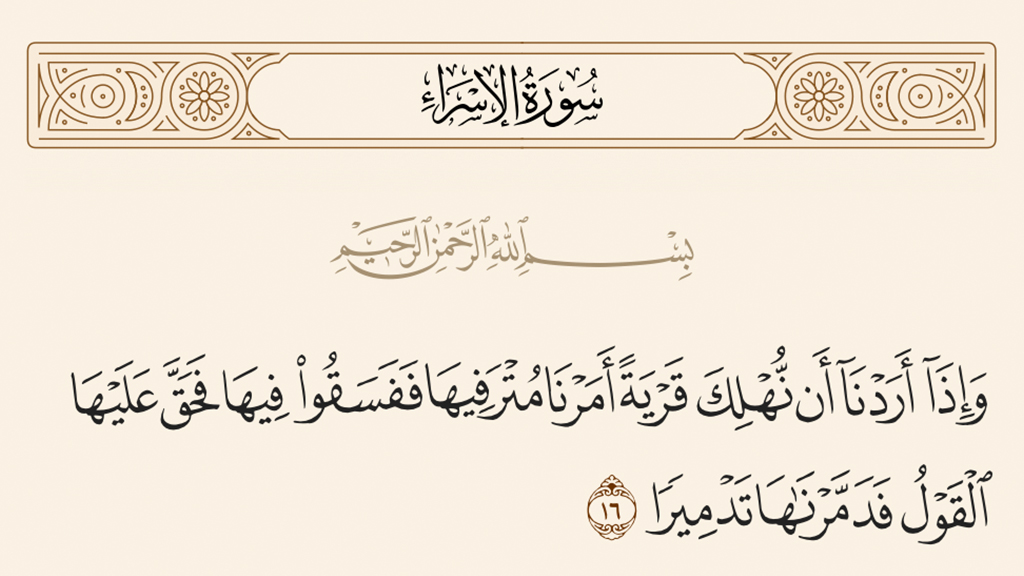
أَمَرْنا مُتْرَفِيها!










