علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
حيدر حب اللهعن الكاتب :
ولد عام 1973م في مدينة صور بجنوب لبنان، درس المقدّمات والسطوح على مجموعة من الأساتذة المعروفين في مدينة صور (المدرسة الدينية). ثم سافر إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية لإكمال دراساته الحوزويّة العليا، فحضر أبحاث الخارج في الفقه والأصول عند كبار آيات الله والمرجعيات الدينية. عام 2002م، التحق بقسم دراسات الماجستير في علوم القرآن والحديث في كلّية أصول الدين في إيران، وحصل على درجة الماجستير، ثم أخذ ماجستير في علوم الشريعة (الفقه وأصول الفقه الإسلامي) من جامعة المصطفى العالميّة في إيران (الحوزة العلمية في قم). من مؤلفاته: علم الكلام المعاصر، قراءة تاريخية منهجيّة، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حجية الحديث، إضاءات في الفكر والدين والاجتماع (خمسة أجزاء) ...العلم والدين، تصحيح المفاهيم وإعادة بناء اللغة

كانت الفلسفة والعلوم فيما يسمّى بالعصر الوسيط تدور في فلكٍ مركزُه الدّين واللاهوت، وبمجيء كوبرنيكوس (1543م) لم تتغيّر رؤيتنا للمركز والأطراف في علم الفلك والمجموعة الشمسيّة فحسب، بل بدأ العالم رحلةً جديدة من تغيير المركز والأطراف في الحياة الإنسانيّة نفسها أيضاً، فخرج الدين شيئاً فشيئاً في أوروبا عن أن يصبح هو المركز الذي تلتزم العلوم ـ ومعها الفلسفة ـ بخدمته والتضحية في سبيله، وظنّت الفلسفة في البداية أنّها تلعب دوراً بديلاً، لكنّ تسارع وتائر العلوم الطبيعيّة في إنجازاتها واكتشافاتها جعل الفلسفة نفسها تلحق العلم وتسعى لابتكار النظريّات التي يمكنها أن تفسّر ما وصل إليه العلم أو على الأقل يمكنها أن تفهم القضايا الفلسفيّة في ضوء ما وصل إليه العلم، وبهذا غدت العلوم الطبيعيّة هي المركز فيما البقيّة مجرّد أطراف، حتى بلغ الأمر مع بعض اتجاهات المدرسة الوضعيّة في القرن العشرين إلى التشكيك في صحّة إطلاق اسم "العلم" على غير العلوم القائمة على التجربة، فغدت العلوم الإنسانيّة ـ كما نسمّيها اليوم ـ في خطرٍ داهم يتهدّد وجودها وعلميّتها، قبل أن تسترجع بعضاً من اعتبارها في الربع الأخير من القرن العشرين.
كان هذا هو المشهد في الغرب، أمّا في عالمنا الإسلامي، فظلّ الدين وما يزال ـ ومعه الفلسفة في بعض تجلّياتها ـ يناضلان للبقاء بوصفهما عنصراً مركزيّاً غير هامشيّ، وبقيت الفلسفة منفصلةً ـ نسبيّاً ـ عن العلوم الطبيعيّة بعدما كانت مع الفلسفة المشائيّة متعاضدةً معها. وفي القرن العشرين ظهرت التيّارات التي تؤمن بإدارة الحياة كلّها بمختلف مرافقها عبر الدين، وظهرت حركات "أسلمة العلوم" ـ في بعض مظاهرها المتطرّفة، إذا صحّ التعبير ـ لتعتبر أنّ جميع العلوم، بما فيها العلوم الطبيعيّة، عليها أن تصبح إسلاميّةً. وما يخشاه المرء هنا هو أن تكون هذه التوجّهات تعبيراً آخر عن نهاية الطريق، وأنّنا ـ وفقاً للرسم البياني الذي وضعه أرنولد توينبي (1975م) للتاريخ ـ نقفز إلى الأعلى في زاوية حادّة تمهيداً للسقوط النهائي، فيظهر التطرّف الفكري في مواجهة الإبعاد والإقصاء الفكري للحضارة الحديثة.
هنا تظهر الحاجة لمحاولات توفيق بين الدين والعلم، وهذا التوفيق قد يتخذ أكثر من مسار، ومن بين المسارات:
1 ـ مسار تصحيح المفاهيم، وأعني به الانتقال من التفكير الديني الشعبي أو الشعبوي إلى فهمٍ أكثر عقلانية ودقّة، وعلى سبيل المثال كالحديث عن ثنائيّةٍ قابعة في تفكير كثيرين، من أنّ الله يظهر في خرق قوانين الطبيعة، لكنّه يختفي في سياق الفعل الطبيعي الخاضع للقانون، فالله هو الكرامة والمعجزة، ولكي أثبت الله عليّ أن أبتعد قليلاً عن النظام الطبيعي، في حين ـ وكما كان يقول مرتضى مطهّري (1979م) ـ فإنّ كلّ النظام الطبيعي هو معجزة، لكن لأنّنا اعتدنا عليه، فنحن لا نشعر بالقدرة الهائلة الكامنة فيه من قبل خالقه، ففي كلّ يوم عندما نستيقظ صباحاً وننظر إلى الأشجار المحيطة بنا أو ننظر إلى رمال الصحراء، أو نرى حركة الشمس، فنحن نرى مظاهر إعجازيّة يعجز البشر عن الإتيان بمثلها، فبدل أن نرى الله في ما نفهمه نحن عن المعجزة، علينا أن نرى الإعجاز المتواصل في الخلق الإلهي عبر فهم قوانين الطبيعة ومشاهدة بدائع الصنع الإلهيّ، ولهذا ركّز القرآن الكريم ـ لإثبات الله بوصفه حاملاً للصفات والأسماء الحسنى ـ على نظام الخلق، ولم يركّز على معاجز الأنبياء، فالمعاجز جزء يحتاجه المشروع النبويّ، وليس المشروع الإلهي؛ لأنّ العالم كلّه هو معجزة الله.
مفهومٌ آخر مغلوط وكثيراً ما نعاني منه، هو أن نعتبر أنّ مفتاح معرفة وجود الله يكمن في اكتشاف بداية الخلق، فإذا اكتشفنا بداية الخلق عرفنا أنّ الله موجود هناك أو غير موجود، ولهذا لما فهمنا الكثير مما وقع في الانفجار الكبير كما يسمّى اليوم، اكتشفنا أنّ الانفجار وقع ولم نرَ الله معه، وهذا يعني أنّ الله لا وجود له، وكأنّنا كنا نتصوّر أنّ لحظة بداية الكون سوف تُسعفنا في رؤية الله ماثلاً يقوم بعمليّة الصنع، وهو تفكيرٌ بدائي جداً وشعبويّ من منظور كبار الفلاسفة والحكماء، رغم أنّه تورّط فيه الكثير من علماء الطبيعيات المعاصرين في قراءتهم لبداية الخلق ولمسألة الخالق.
إنّ التفكير الفلسفي لا يرى الله في بداية الخلق فحسب، بل يراه في اللحظة الحاضرة متجلّياً في كلّ تفصيلٍ يحيط بنا، وظاهراً في كلّ قانون يحكم هذا العالم؛ لأنّ العقل الفلسفي يفهم أنّ العلاقة بين الخالق والخلق ليست علاقة اللحظة الأولى حتى يترك الخالقُ الخلقَ يسير لوحده ككرةٍ نطلقها فلا تتوقّف إلا إذا أوجَدْنا الموانعَ أمامها، كما تصوّر ذلك بالفعل بعض علماء الكلام الإسلامي المتقدّمين، بل إنّ العلاقة بين الخلق والخالق هي علاقةٌ أعمق بكثير من ذلك، وهي لا تنفصل ولو للحظة؛ لأنّ هذا الانفصال سوف يؤدّي إلى أن تزول السماوات والأرض على حدّ تعبير القرآن الكريم (فاطر: 41).
هذا كلّه يعني أنّ العلوم الطبيعيّة لا تستطيع أن تذهب أبعد من إطار موضوعها، وبالتالي فشبكة العلاقة بين الغيب والشهادة متعالية جداً عن شبكة العلاقة بين ظواهر الطبيعة ومكوّناتها فيما بينها، والمنهج محكوم لموضوع العلم في كثير من الأحيان؛ لهذا نحن بحاجة إلى منهجٍ آخر يلتقي مع المنهج العلمي ليتعاونا معاً في البحث عن الخالق.
2 ـ مسار اللغة، فلا يمكن تبسيط دور اللغة في تكوين المعرفة كما لا يمكن تبسيط دورها في التعبير عن المعرفة، فعبر التاريخ حاول كثيرون إعادة إنتاج التعريفات بما يخدم معرفتهم وقناعاتهم، فـ "الحكمة" في التعبير القرآني تحوّل معناها إلى الحكمة الفلسفيّة، و "الولاية" في التعبير القرآني اتخذت معنى الولاية بالمصطلح الصوفي العرفاني لتذهب أيضاً نحو مفهوم الولاية التكوينيّة، و "الفقه" في التعبير القرآني اتخذ معنى الفقه في التاريخ الإسلامي لاحقاً، وهو العلم الخاصّ المعنيّ بتحديد الوظائف الشرعيّة للمكلّفين. وسببُ ذلك أنّ كل فريق ـ يشعر أو لا يشعر ـ يُسقط فهمه ولغته على لغة النصّ؛ لأنّ إيجاد المماهاة بين اللغتين سوف يسهّل أخذ مفاهيمه للشرعيّة الدينيّة.
في المقابل، نجد ظاهرة الأسماء والصفات الإلهيّة التي اختلف حولها العلماء عبر التاريخ، بين كونها توقيفيّةً أو غير توقيفيّة، فأنت عندما لا تستعمل كلمة الله أو الرحمن أو الرحيم، بل تعبّر عن الله بالقوّة، أو القوّة المدبّرة، أو الروح، أو العقل المدبّر، أو العلّة الكبرى، أو العلّة الأولى، أو السبب، أو السبب الأوّل، أو المحرّك الأوّل، أو الجوهر، أو العقل أو واجب الوجود أو غير ذلك، فأنت ترسم له صورة نابعة من ثقافتك، لتراه من خلال نظارات عيني العقل اللتين تنظر بهما.
من هنا، عندما نقرأ علماً فإنّ لغة العلم تنبني على فلسفة تحتيّة يقوم عليها، فإذا كان علماً علمانياً بالمطلق فمن الطبيعي أن يستخدم المفردات والمصطلحات المتسقة مع خلفيّته الفكريّة والفلسفيّة، وعندما ينتقل هذا العلم إلى مجتمعات مختلفة في خلفيّتها الفلسفية والفكرية تحدث المشاكل، والجهد المهم هو في إعادة بناء اللغة بطريقة تستطيع أن تضع هذا العلم في بيئة مغايرة دون أن تضحّي به أو تجعلها تتصادم معه.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (لمز) في القرآن الكريم
معنى (لمز) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (3)
حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (3)
محمود حيدر
-
 التحسس الغلوتيني اللابطني لا علاقة له بمادة الغلوتين بل بالعامل النفسي
التحسس الغلوتيني اللابطني لا علاقة له بمادة الغلوتين بل بالعامل النفسي
عدنان الحاجي
-
 {وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا}
{وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا}
الشيخ مرتضى الباشا
-
 أكبر مسؤوليات التربية... منع تسلّط الوهم على الفطرة
أكبر مسؤوليات التربية... منع تسلّط الوهم على الفطرة
السيد عباس نور الدين
-
 الحرص على تأمين الحرية والأمن في القرآن الكريم
الحرص على تأمين الحرية والأمن في القرآن الكريم
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 نوازع وميول الأخلاقيات
نوازع وميول الأخلاقيات
الشيخ شفيق جرادي
-
 المذهب التربوي الإنساني
المذهب التربوي الإنساني
الشهيد مرتضى مطهري
-
 الحق والباطل: ماء راسخ وزبد يزول
الحق والباطل: ماء راسخ وزبد يزول
الشيخ جعفر السبحاني
-
 {حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ..} كيف يُنسب اليأس للرسُل؟
{حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ..} كيف يُنسب اليأس للرسُل؟
الشيخ محمد صنقور
الشعراء
-
 اطمئنان
اطمئنان
حبيب المعاتيق
-
 الحوراء زينب: قبلة أرواح المشتاقين
الحوراء زينب: قبلة أرواح المشتاقين
حسين حسن آل جامع
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-
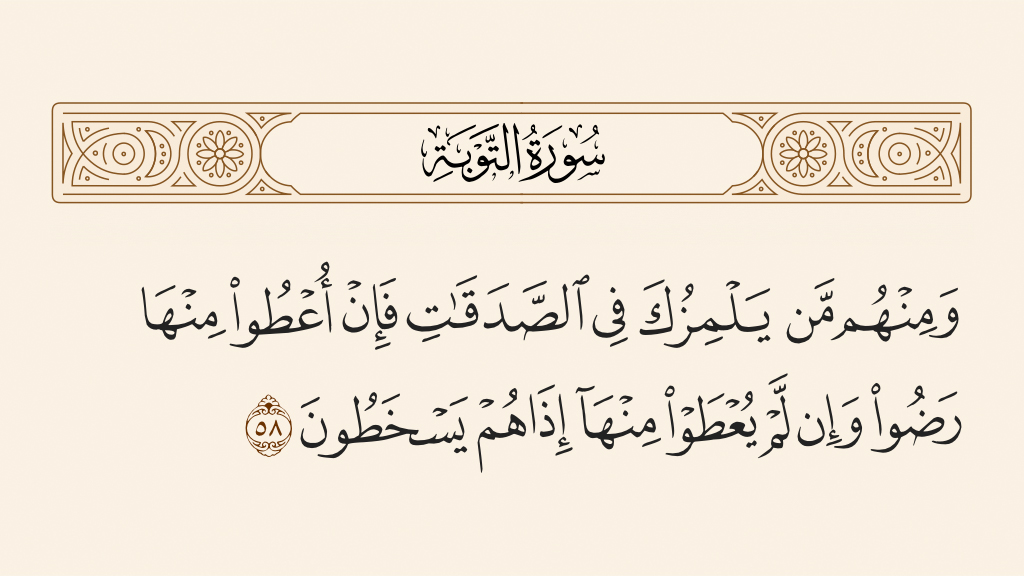
معنى (لمز) في القرآن الكريم
-

حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي (3)
-

التحسس الغلوتيني اللابطني لا علاقة له بمادة الغلوتين بل بالعامل النفسي
-

لا محبّ إلّا اللَّه ولا محبوب سواه
-

الدّريس يدشّن ديوانه الشّعريّ الأوّل: (صحراء تتنهد ومطر يرقص)
-

جلادة النّقد
-

{وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا}
-

فوائد الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر
-
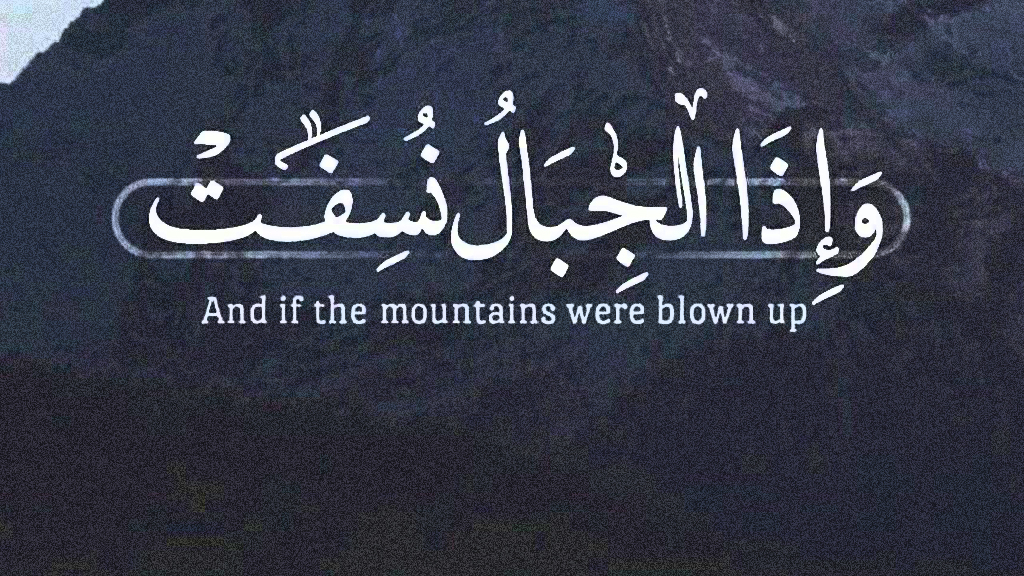
معنى (نسف) في القرآن الكريم
-

أكبر مسؤوليات التربية... منع تسلّط الوهم على الفطرة










