قرآنيات
معلومات الكاتب :
الاسم :
حيدر حب اللهعن الكاتب :
ولد عام 1973م في مدينة صور بجنوب لبنان، درس المقدّمات والسطوح على مجموعة من الأساتذة المعروفين في مدينة صور (المدرسة الدينية). ثم سافر إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية لإكمال دراساته الحوزويّة العليا، فحضر أبحاث الخارج في الفقه والأصول عند كبار آيات الله والمرجعيات الدينية. عام 2002م، التحق بقسم دراسات الماجستير في علوم القرآن والحديث في كلّية أصول الدين في إيران، وحصل على درجة الماجستير، ثم أخذ ماجستير في علوم الشريعة (الفقه وأصول الفقه الإسلامي) من جامعة المصطفى العالميّة في إيران (الحوزة العلمية في قم). من مؤلفاته: علم الكلام المعاصر، قراءة تاريخية منهجيّة، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حجية الحديث، إضاءات في الفكر والدين والاجتماع (خمسة أجزاء) ...النسخ في القرآن إطلالة على آية التبديل (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ) (4)
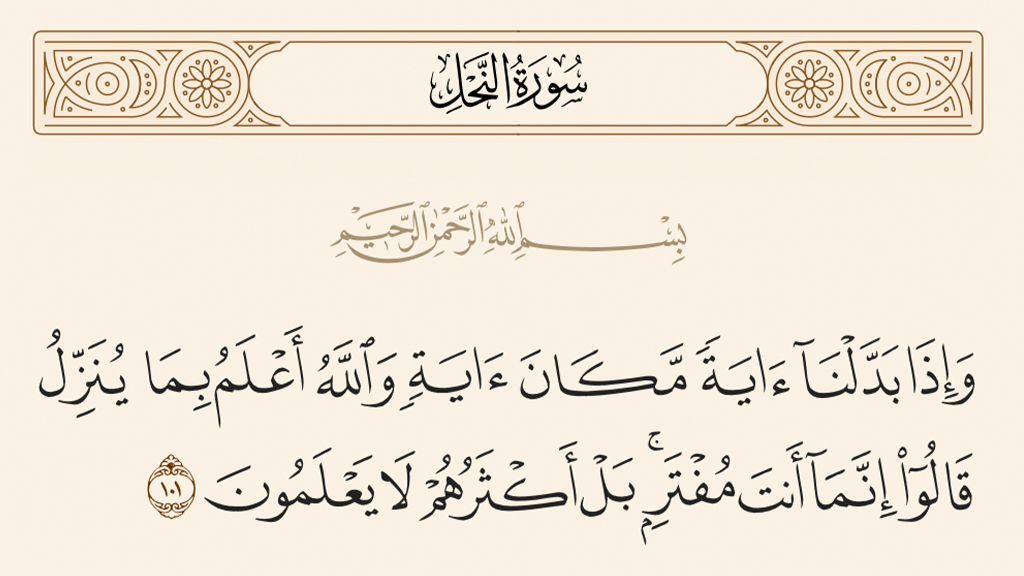
د ـ قراءة جمال الدين القاسمي لآية التبديل (الانفصال التامّ عن السياق التشريعي)
يقدّم الشيخ جمال الدين القاسمي (1914م) ـ أحد رموز النهضة الإسلاميّة الحديثة في بلاد الشام ـ قراءةً مختلفة تماماً لآية التبديل هنا، حيث يقول: «والأكثرون على أنّ المعنى نسخ آية من القرآن ـ لفظاً أو حكماً ـ بآية أخرى غيرها، لحكمةٍ باهرة أشير إليها بقوله: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ من ناسخ قضت الحكمة أن يتبدّل المنسوخ الأوّل به. وذهب قومٌ إلى أنّ المعنى تبديل آية من آيات الأنبياء المتقدّمين، كآية موسى وعيسى وغيرهما من الآيات الكونيّة الآفاقيّة، بآية أخرى نفسيّة علميّة، وهي كون المنزل هدى ورحمة وبشارة يدركها العقل إذا تنبّه لها وجرى على نظامه الفطري. وذلك لاستعداد الإنسان وقتئذٍ لأن يخاطب عقله ويستصرخ فمه ولبّه، فلم يؤتَ من قِبَل الخوارق الكونيّة ويدهش بها كما كان لمن سلف، فبدّلت تلك بآية هو كتاب العلم والهدى من نبيّ أمّيّ لم يقرأ ولم يكتب. وكون الكتاب بيّن الصدق قاطع البرهان ناصع البيان بالنسبة لمن أوتي ورزق الفهم. وهذا التأويل الثاني يرجّحه على الأوّل أنّ السورة مكيّة. وليس في المكّي منسوخ بالمعنى الذي يريدونه، وللبحث تفصيل في موضع آخر.. والمقصود أنّه تعالى، لما رحم العالمين وجعل القرآن مكان ما تقدّم، نسبوا الموحى إليه به إلى الافتراء، ردّاً للحقّ وعناداً للهدى وتولّياً للشيطان وتعبّداً لوسوسته، وما ذاك إلا لجهلهم المتناهي، كما قال: بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ. واعتراض قوله: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ لتوبيخ الكفرة والتنبيه على فساد رأيهم»[1].
ينطلق القاسمي في فكرته ـ التي نسبها لقومٍ لم يذكر من هم ـ من أنّ التبديل هنا هو في نوع الآية التي يمنحها الله لنبيّه؛ فسابقاً كانت الآية ذات طابع كوني، بينما تحوّل الأمر في النبوّة المحمّدية إلى طابع عقلي معرفي، فلم يعد هناك عصا تتحوّل إلى ثعبان أو بحر ينشطر إلى شطرين أو ميّت يتمّ إحياؤه، بل صارت الآية ذات بعد لغوي معرفي عقلي؛ لأنّ البشر تسامت عقولهم، فصاروا مؤهّلين لآياتٍ من هذا النوع.
ولكي أحلّل مقاربة القاسمي هنا ونفهم أكثر من هم القوم الذين قصدهم، يجب علينا أن نستعيد الطروحات المتأخّرة في العصر الحديث لفكرة ختم النبوّة، ففي سياق تحليل ظاهرة ختم النبوّة ومبرّراته طرحت مقولات أعتقد أنّها هي التي تكمن وراء تفسير القاسمي هنا، والمفترض أن نصنّف القاسمي هنا على أنّه يميل لأحد المدارس، وذلك أنّ هناك أكثر من اتجاه في تحليل الخاتميّة، أبرزها:
الاتجاه الأوّل: وهو الاتجاه المدرسي الموروث الذي يرى أنّ سبب الخاتميّة ومبررها وفلسفتها هو أنّ النبوّات السابقة كانت تغطّي حاجات الإنسانيّة بشكل محدود، بينما النبوّة المحمّديّة جاءت بما يغطّي حاجات الإنسانيّة إلى ما لا نهاية، الأمر الذي فرض منطق الخاتميّة.
الاتجاه الثاني: وهو الاتجاه الذي لا يدرس الخاتمية من خلال قدرة النبوّات على رفع حاجات البشر عبر التمييز بين النبوّة المحمّدية وما سبقها، بل يدرس الخاتميّة على أساس سبب ظهور النبوّة أصلاً في حياة الإنسان، فالنبوّة تكمن فلسفة وجودها في عدم بلوغ البشر المستوى العقلي المنشود الذي يمكّنهم من الاستمرار في مسير الكمالات بشكل ناضج، ولهذا كانت النبوّات تتتالى في حياة البشر، بينما في العصر المحمّدي كانت البشرية قد بلغت مرحلة النضج والرشد العقلي وتجاوزت مرحلة الطفولة، فصار العقل الإنساني قادراً على حمل الدين الخاتم وفهمه والعمل عليه وتطبيقه. وداخل هذا الاتجاه توجد مقولات مختلفة وشخصيّات متعدّدة وقع خلاف في تفسير نظريّاتها أصلاً، وعلى رأس هؤلاء: محمّد إقبال (1938هـ)، وعلي شريعتي، ومرتضى مطهري وغيرهم ممّن شارك في تقوية أو نقد هذا التوجّه مثل محمد الحسيني البهشتي ومحمّد تقي مصباح اليزدي وغيرهما.
وداخل هذا الاتجاه يوجد فريق آخر يذهب به أبعد من ذلك حين يرى أنّ العقل الإنساني ـ الفردي أو الجمعي ـ بلغ مراحل النضح بحيث لم يعد بحاجة للنبوّات، وأنّ مرحلة النبوّات تمّ تخطّيها، وهناك نقاشات في تفسير نظريّات متأخّرة على أنّها تنتمي لهذا الرأي في الوسط الإسلامي مثل نظريّات عبد الكريم سروش ومحمّد مجتهد شبستري وغيرهما، وهو الاتجاه الذي يصنّفه كثيرون على أنّه يعتقد بالعبور من مرحلة النبوّات إلى مرحلة العقل العلماني المؤمن بالله والقيم الروحيّة والدينيّة العليا، بل وفقاً لرأي شبستري نحن الآن في مرحلة نقد “تعالي الوحي عن النقد”.
بعد هذا التمهيد، يمكنني فهم الشيخ القاسمي أكثر، فهو يفكّر هنا في سياق طروحات ختم النبوّة، مطّلعاً فيما يبدو على بدايات الحديث عن هذا الموضوع، والذي ربما يقال بأنّه شرع في شبه القارّة الهنديّة نهايات القرن التاسع عشر الميلادي.
يريد القاسمي أن يقول بأنّ العقل الإنساني بلغ في عصر النبوّة المحمديّة مرحلة نضج عالية بحيث صار مؤهّلاً لأن يخاطَب بالكلمة بدل الحدث الكوني، ولهذا كانت النبوّة المحمديّة نبوّةَ كلمة ومعجزةَ كلمة، والكلمة هي اللغة والعقل والفهم والإدراك، هذا التحوّل حصل في عصرٍ برزخي ـ إذا صحّ التعبير ـ وهو العصر المحمدي، فاستغربه بعض الناس ورفضوه، وقالوا بأنّ النبوات آياتها وعلاماتها وبيّناتها كونيّة خارقة، من هنا تأتي هذه الآية ـ أعني آية التبديل ـ لتؤكّد أنّ تبديل الله لآيةٍ كونيّة بآية معرفيّة لا يمكن تفسيره في سياق افتراء محمّد، بل هو في سياق معرفة الله العالِم بكلّ شيء، والذي عرف أنّ البشريّة أخذت تعبر برزخ الواسطة بين العقل الطفولي والعقل الراشد.
وربما يعزّز القاسميُّ كلامَه هذا بالرفض القرآني المتكرّر لتقديم معجزات كونية ماديّة، وهو ما أثار بعضَ مفكّري شبه القارّة الهنديّة في القرنين: التاسع عشر والعشرين، وتبعهم غيرهم، والذين رفضوا وجود معجزة أخرى لمحمّد غير القرآن الكريم، مستندين لمثل قوله تعالى: (وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا) (الإسراء: 90 ـ 93). وقوله سبحانه: (وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآَيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآَيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا) (الإسراء: 59)، وقوله عزّ وجلّ: (وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) (يونس: 20).
فهذا التأكيد القرآني يعزّز موقف القاسمي من فكرة التحوّل من الآية الكونيّة إلى الآية المعرفيّة أو آية الكلمة. بل يمكن أن نضيف بأنّ القاسمي قد يعزّز موقفه في أنّ المراد التحوّل في نوعيّة الآيات الآتية مع الأنبياء بقوله تعالى في الآية الأخرى من آيات وقوع النسخ، حيث قال تعالى: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ * أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ) (البقرة: 106 ـ 108)، فإنّ التذييل بالقدرة أقرب لهذا الموضوع منه لموضوع النسخ التشريعي، إضافة للحديث عمّا سُئل موسى من قبل فإنّ مراجعة ما سألوا موسى يعطي أنّ المراد هي الأمور التكوينية كرؤية الله وغير ذلك من مظاهر قوّته.
هذه خلاصة تحليلي لفكرة وسياقات ما طرحه القاسمي هنا. وقد انتقد القاسميَّ الدكتورُ مصطفى زيد بأنّه لم يبيّن لنا من هم هؤلاء القوم الذين رجّح قولهم على قول الأكثر في تفسير الآية الكريمة؟! كما أنّ ادّعاء عدم وجود نسخ في مكّة لا دليل يُثبته، ودعوى أنّ أوّل نسخ هو نسخ القبلة المنسوبة إلى ابن عباس لم تثبت، وحتى لو ثبتت فإنّ الآية المكيّة تشير بكلمة «إذا» إلى ما سيقع، تماماً كما هي استخدامات «إذا» كثيراً في القرآن الكريم في قضايا تتصل بوقائع يوم القيامة [2].
ولكنّ مداخلات زيد قابلة للمناقشة، وذلك:
أوّلاً: إنّني أرجّح أنّ مقصود القاسمي من القوم هو السياق الذي تحدّثتُ عنه قبل قليل. ويحتاج الأمر لمراجعة التراث الإسلامي في شبه القارّة الهنديّة في تلك الفترة. ولو سلّمنا فمجرّد كون رأيه مخالفاً للمشهور لا يوجب التخلّي عنه.
ثانياً: إنّ مصطفى زيد وقع فيما يشبه التناقض هنا، ففي مناقشته للإصفهاني المعتزلي أصرّ على أنّ المعترضين على النبيّ هم المشركون في مكّة، فيما هنا يشير إلى أنّ كلمة «إذا» استقباليّة للحديث عن وقوع النسخ لاحقاً، ويبدو لي أنّ ثمّة منافرة بين الفكرتين، فتأمّل جيّداً فسوف تلاحظ ذلك.
وعلى أيّة حال، فهل تحليل القاسمي لآية التبديل صحيح أو لا؟
أعتقد بأنّ النصّ القرآني استخدم كلمة “الآيات” مرّات كثيرة جدّاً في الآيات الكونيّة، كما استخدمها ـ وبخاصّة في حال الجمع ـ في النصوص الدينيّة الموحاة للأنبياء، ومن ثمّ فتعبير الآية أو الآيات في القرآن الكريم لا يرجّح لنا بنفسه الآية الكونيّة على آية الكتاب المقدّس، أيّ كتابٍ كان، فعلينا النظر في السياقات.
كما أنّ ربط كلمة “الآية” في القرآن بالكونيّات دون الكلام الوحييّ، يغلب معه استخدام المجيء بآية أو الإتيان بآية، ممّا قد يرجّح في موضع بحثنا كون الآية مرتبطة هنا بأمرٍ وحييّ، لكنّ تعبير “تنزيل آية” في حقّ الآيات الكونيّة والمعاجز هو أمرٌ قائم في النصّ القرآني أيضاً، قال تعالى: (وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آَيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) (الأنعام: 37)، وقال سبحانه: (وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) (يونس: 20)، وقال عزّ من قائل: (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ) (الرعد: 7)، ومن ثمّ فلا يمكننا من تعبير “التنزيل” الوارد هنا في آية التبديل أن نجعله قرينة على كون المراد من الآية هو الأمر الكتابيّ الوحييّ. وعليه فلا كلمة “الآية” في الاستخدام القرآني ـ إفراداً وجمعاً ـ يمكنها أن تساعدنا هنا في الترجيح، ولا وضع هذه الكلمة ضمن مجموعة كلمات ذات صلة (أسرة لغويّة) من نوع “المجيء” أو “التنزيل” أو “الإتيان” يمكنه أن يحقّق لنا ذلك.
وسأفترض هنا أنّ السياق الفكري الذي انطلق منه القاسمي ـ وفقاً لما شرحناه آنفاً ـ هو صحيح بأكمله، لكن هل تدلّ آية التبديل على الفكرة التي طرحها القاسمي؟ ولو لم يكن هناك وضوح في الدلالة فهل يبقى فهم القاسمي محتملاً بقوّة بحيث يُربِك الفهم المشهور هنا؟
كما أنّ ربط الآية بقصّة تحويل القبلة لا معنى له بعد أن كان قبلة الأقصى لا وجود لها في القرآن أصلاً، وقد سبق أن تحدّثنا عن عدم وجود نسخ في مكّة.
يجرّنا تحليل القاسمي هنا إلى الوقوف عند فكرة إعجاز القرآن الكريم، فإذا كان القرآن معجزةً فإنّ العرب يفترض أن تعتبر هذا الإعجاز أمراً ماديّاً، فما الفرق بين إعجاز القرآن وإعجاز غيره، وبخاصّة أنّ فكرة الكتب السماويّة كانت موجودة قبل النبيّ محمّد، ولا سيما مع النبيّ موسى؟!
يبقى أن نشير لأمر مهمّ، وهو أنّ القاسمي في آية النسخ يقرّ بالنسخ التشريعي، لكنّه يمثّل له بالنسخ الشرائعي، إنّه يقول: «ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أي ما نبدّل من آية بغيرها ـ كنسخنا آيات التوراة بآيات القرآن ـ أَوْ نُنْسِها أي نذهبها من القلوب ـ كما أخبر بقوله: وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ (المائدة: 13) ـ وقرئ (أو ننسأها) أي نؤخّرها ونتركها بلا نسخ، كما أبقى كثيراً من أحكام التوراة في القرآن..» [3].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] محاسن التأويل 6: 408 ـ 409.
[2] النسخ في القرآن الكريم: 241 ـ 242.
[3] محاسن التأويل 3: 370 ـ 371.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 كرّار غير فرّار
كرّار غير فرّار
الشيخ محمد جواد مغنية
-
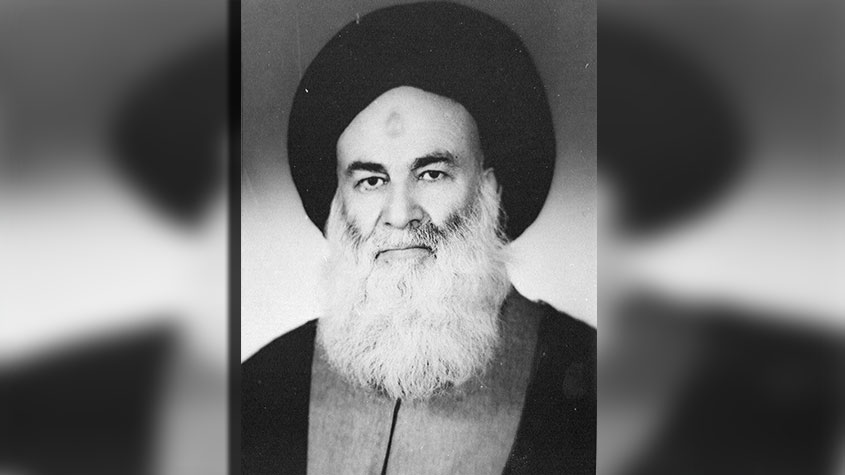 لا يبلغ مقام علي (ع) أحد في الأمّة
لا يبلغ مقام علي (ع) أحد في الأمّة
السيد محمد حسين الطهراني
-
 معنى (دهر) في القرآن الكريم
معنى (دهر) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 استعمالات الوحي في القرآن الكريم
استعمالات الوحي في القرآن الكريم
الشيخ مرتضى الباشا
-
 الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل
الإمام عليّ (ع) نموذج الإنسان الكامل
الشهيد مرتضى مطهري
-
 اختر، وارض بما اختاره الله لك
اختر، وارض بما اختاره الله لك
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 المشرك في حقيقته أبكم
المشرك في حقيقته أبكم
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 الصبر والعوامل المحددة له
الصبر والعوامل المحددة له
عدنان الحاجي
-
 كيف يكون المعصوم قدوة؟
كيف يكون المعصوم قدوة؟
السيد عباس نور الدين
-
 (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)
(وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)
الفيض الكاشاني
الشعراء
-
 فانوس الأمنيات
فانوس الأمنيات
حبيب المعاتيق
-
 الجواد: تراتيل على بساط النّدى
الجواد: تراتيل على بساط النّدى
حسين حسن آل جامع
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-

كرّار غير فرّار
-

أحمد آل سعيد: الطّفل صورة عن الأسرة ومرآة لتصرّفاتها
-

خيمة المتنبّي تسعيد ذكرى شاعرَين راحلَين بإصدارَينِ شعريّينِ
-

لا يبلغ مقام علي (ع) أحد في الأمّة
-

معنى (دهر) في القرآن الكريم
-
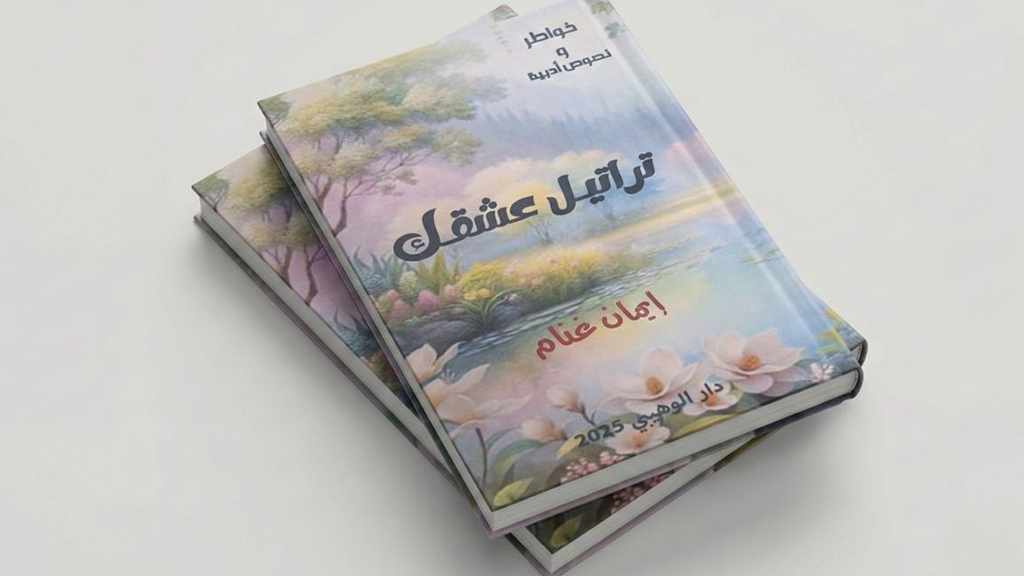
(تراتيل عشقك) باكورة إصدارات الكاتبة إيمان الغنّام
-
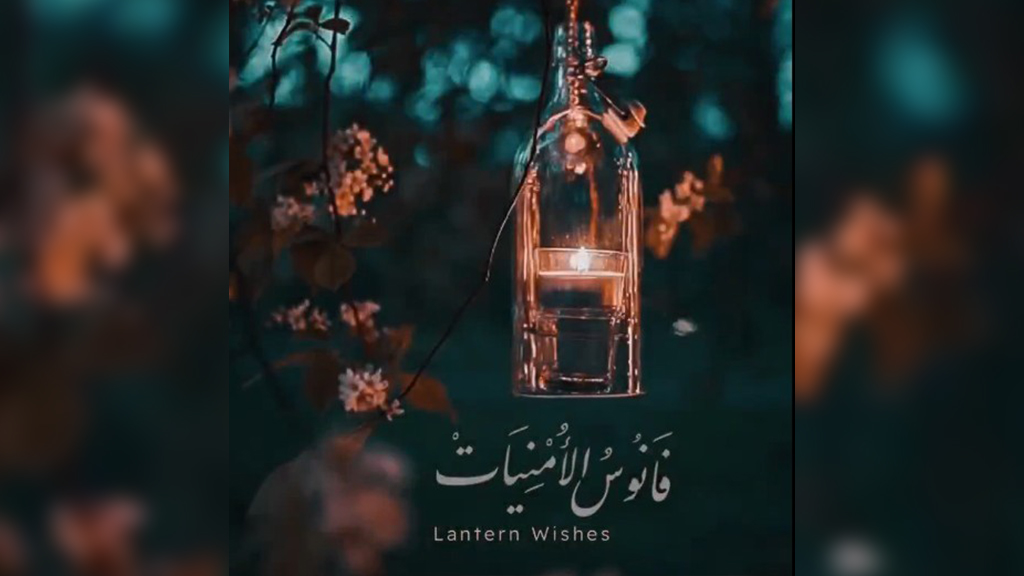
فانوس الأمنيات
-
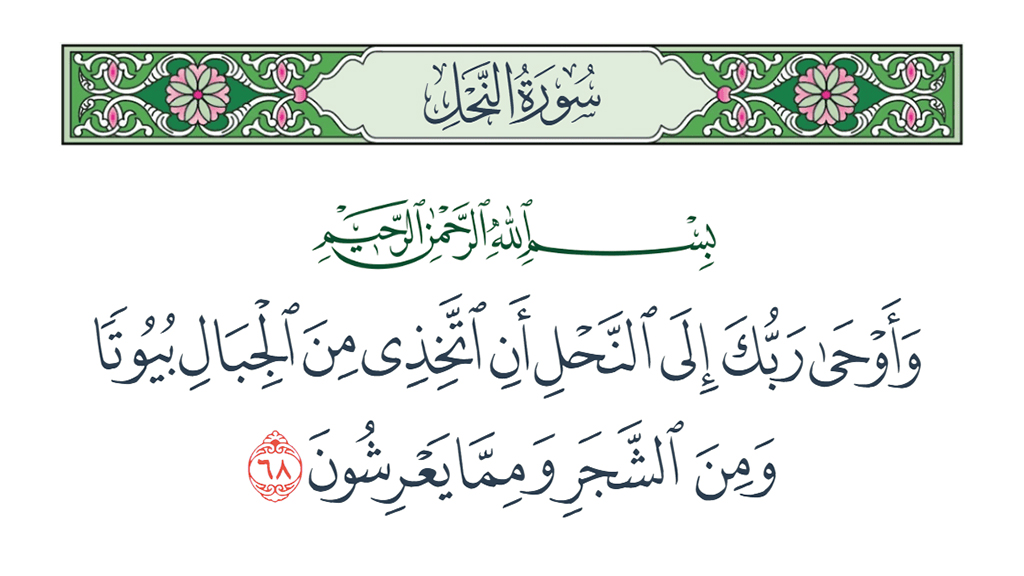
استعمالات الوحي في القرآن الكريم
-

قلع الإمام علي (ع) باب خيبر
-
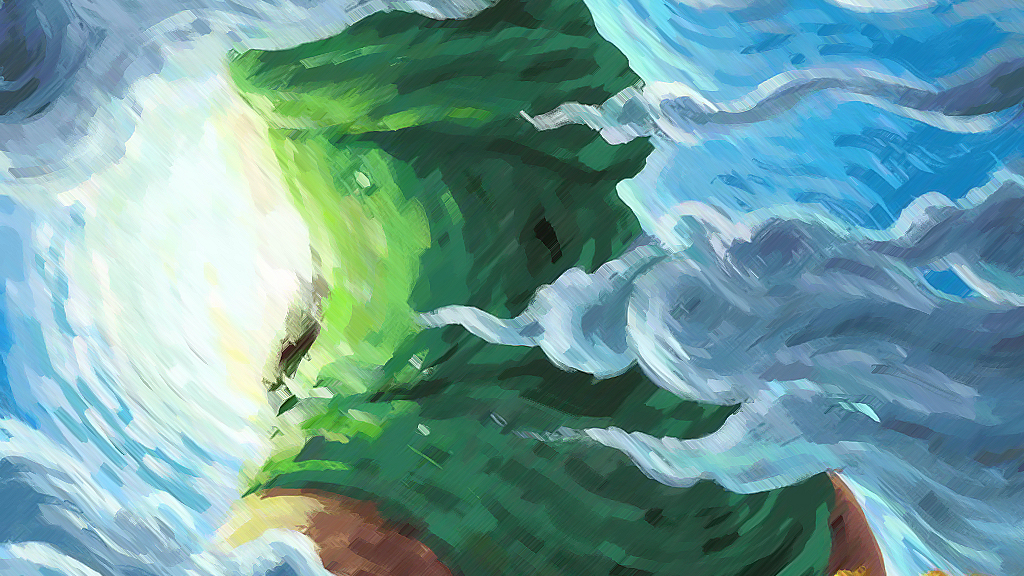
الإمام عليّ (ع): ما خفي من فضله أعظم










