قرآنيات
آداب قراءة القرآن

الإمام الخميني(قده) ..
من آداب قراءة القرآن حضور القلب، ومن الآداب المهمة الأخرى لذلك التفكر، والمقصود من التفكر أن يتحسس من الآيات الشريفة المقصد والمقصود، وحيث أن مقصد القرآن كما تقوله نفس الصحيفة النورانية هو الهداية إلى سبل السلام والخروج من جميع مراتب الظلمات إلى عالم النور، والهداية إلى الطريق المستقيم، فلابد أن يحصل الإنسان بالتفكر في الآيات الشريفة مراتب السلامة من المرتبة الدانية والراجعة إلى القوى الملكية إلى منتهى النهاية فيها، وهي حقيقة القلب السليم على ما ورد تفسيره عن أهل البيت، وهو أن يلاقي الحق وليس فيه غيره وتكون سلامة القوى الملكية والملكوتية ضالة قارئ القرآن فإنها موجودة في هذا الكتاب السماوي...
ولابد أن يستخرجها بالتفكر، وإذا صارت القوى الإنسانية سالمة عن التصرف الشيطاني وحصل طرق السلامة وعمل بها؛ ففي كل مرتبة من السلامة تحصل له ينجو من ظلمة ويتجلى فيه النور الساطع الإلهي قهراً حتى إذا خلص عن جميع أنواع الظلمات التي أولها ظلمات عالم الطبيعة بجميع شؤونه وآخرها ظلمة التوجه إلى الكثرة بتمام شؤونها يتجلى النور المطلق في قلبه، ويهديه إلى طريق الإنسانية المستقيم وهو في هذا المقام طريق الرب ﴿إن ربّي على صراط مستقيم﴾.
وقد كثرت الدعوة إلى التفكر وتمجيده وتحسينه في القرآن الشريف، قال تعالى ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم ولعلّهم يتفكرون﴾ وفي هذه الآية مدح عظيم للتفكر، لأن غاية إنزال الكتاب العظيم السماوي، والصحيفة العظيمة النورانية قد جعلت احتمال التفكر، وهذا من شدة الاعتناء به، حيث أن مجرد احتماله صار موجباً لهذه الكرامة العظيمة، وقال تعالى في آية أخرى ﴿فاقصص القصص لعلّهم يتفكرون﴾.
والآيات من هذا القبيل أو ما يقرب منه كثيرة، والروايات أيضاً في التفكر كثيرة. فقد نقل عن الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما نزلت الآية الشريفة ﴿إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات﴾ إلى آخرها … قال صلى الله عليه وآله "ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها".
والعمدة في هذا الباب أن يفهم الإنسان ما هو التفكر الممدوح، وإلا لا شك في أن التفكر ممدوح في القرآن والحديث، وأحسن تعبير عنه ما عبّر به العلامة عبدالله الأنصاري قدس سره حيث قال "اعلم أن التفكر تلمّس البصيرة لاستدراك البغية" يعني أن التفكر هو تجسّس البصيرة، وهي بصر القلب للوصول إلى المقصود، والنتيجة التي هي غاية الكمال، ومن المعلوم أن المقصد والمقصود هو السعادة المطلقة التي تحصل بالكمال العلمي والعملي. فلابد للإنسان إذاً أن يحصل على المقصود والنتيجة الإنسانية، وهي السعادة من الآيات الشريفة للكتاب الإلهي ومن قصصه وحكاياته، وحيث أن السعادة هي الوصول إلى السلامة المطلقة وعالم النور والطريق المستقيم؛ فلابدّ للإنسان أن يطلب من القرآن المجيد الشريف سبل السلامة، ومعدن النور المطلق، والطريق المستقيم كما أشير إليها في الآية الشريفة السابقة، فإذا وجد القارئ المقصد تبصّر في تحصيله، وانفتح له طريق الاستفادة من القرآن الشريف، وفتحت له أبواب رحمة الحق، ولا يصرف عمره القصير العزيز، ورأس مال تحصيل سعادته على أمور ليست مقصودة لرسالة الرسول صلى الله عليه وآله، ويكف عن فضول البحث وفضول الكلام في مثل هذا الأمر المهم. فإذا أشخص بصيرته مدة إلى هذا المقصود، وصرف نظره عن سائر الأمور تتبصّر عين قلبه، وتصبح حديداً، ويصبح التفكر في القرآن للنفس أمراً عادياً، وتنفتح طرق الاستفادة، وتفتح له أبواب لم تكن مفتوحة له إلى الآن، ويستفيد مطالب ومعارف من القرآن ما كان يستفيدها إلى الآن بوجه. فحين ذاك يفهم كون القرآن شفاءً للأمراض القلبية، ويدرك مفاد الآية الشريفة﴿وننزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا﴾ ومعنى قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه "وتعلموا القرآن فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور" ولا يطلب من القرآن شفاء الأمراض الجسمانية فقط، بل يجعل عمدة المقصد شفاء الأمراض الروحانية -الذي هو مقصد القرآن-.
إن القرآن لم ينزل لشفاء الأمراض الجسمانية، وإن كان يحصل به، كما أن الأنبياء عليهم السلام لم يبعثوا للشفاء الجسماني، وإن كانوا يشفون، فهم أطباء النفوس، والشافون للقلوب والأرواح.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 خصائص الصيام (1)
خصائص الصيام (1)
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الشيخ محمد صنقور
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 معرفة الإنسان في القرآن (6)
معرفة الإنسان في القرآن (6)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (فور) في القرآن الكريم
معنى (فور) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

خصائص الصيام (1)
-

الموانع من حضور الضيافة الإلهية
-

البعث والإحياء بعد الموت
-

حديث للاختصاصيّ النّفسيّ أسعد النمر حول توظيف التّقنية في العلاج النّفسيّ
-

التقوى، العطاء، الإيثار في شهر رمضان
-

شرح دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان
-
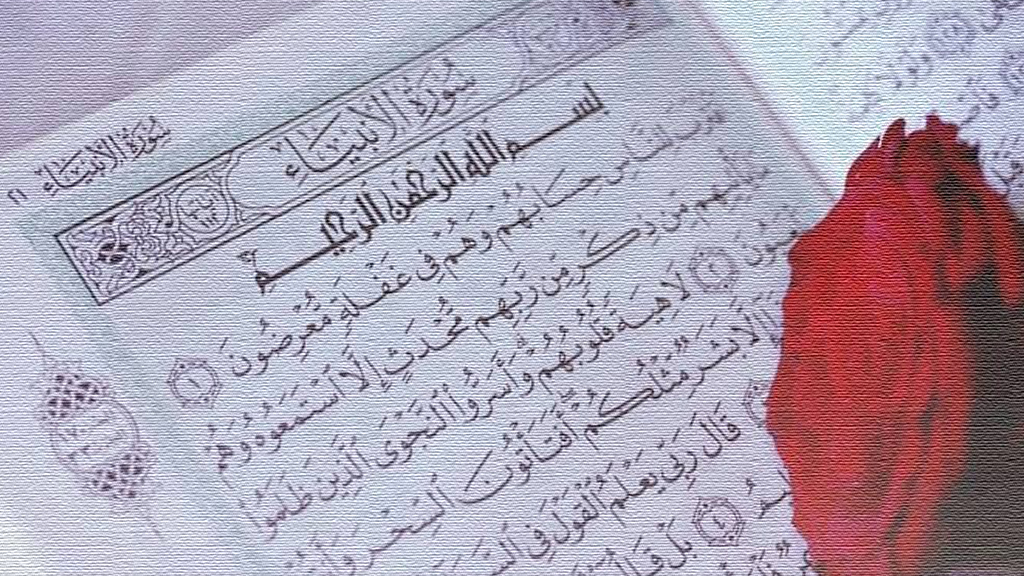
معرفة الإنسان في القرآن (6)
-

شرح دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان
-

لقاء الرحمة والعبادة
-

معنى (فور) في القرآن الكريم









