قرآنيات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد محمد حسين الطبطبائيعن الكاتب :
مفسر للقرآن،علامة، فيلسوف عارف، مفكر عظيمإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (2)
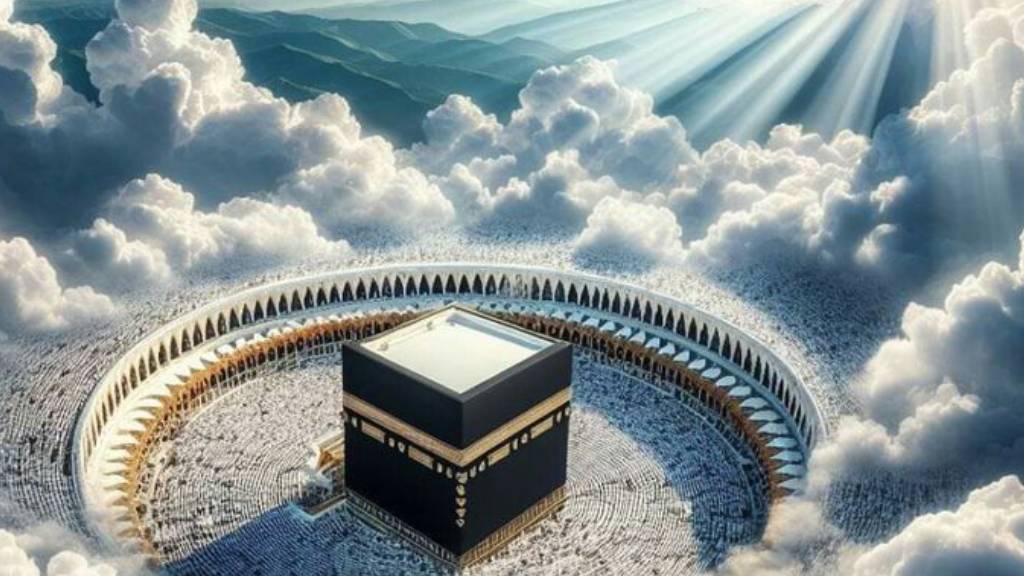
قوله تعالى: ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ التأذين: الإعلام برفع الصوت ولذا فسر بالنداء، والحج القصد سمي به العمل الخاص الذي شرعه أولاً إبراهيم عليه السلام، وجرت عليه شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما فيه من قصد البيت الحرام، ورجال جمع راجل خلاف الراكب، والضامر المهزول الذي أضمره السير، والفج العميق - على ما قيل - الطريق البعيد.
وقوله: ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ أي ناد الناس بقصد البيت أو بعمل الحج والجملة معطوفة على قوله: ﴿لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا﴾ والمخاطب به إبراهيم وما قيل: إن المخاطب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعيد من السياق.
وقوله: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ إلخ، جواب الأمر أي أذن فيهم، وأن تؤذن فيهم يأتوك راجلين وعلى كل بعير مهزول يأتين من كل طريق بعيد، ولفظة ﴿كل﴾ تفيد في أمثال هذه الموارد معنى الكثرة دون الاستغراق.
قوله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ﴾ إلخ، اللام للتعليل أو الغاية والجار والمجرور متعلق بقوله: ﴿يَأْتُوكَ﴾ والمعنى يأتوك لشهادة منافع لهم أو يأتوك فيشهدوا منافع لهم وقد أطلقت المنافع ولم تتقيد بالدنيوية أو الأخروية.
والمنافع نوعان: منافع دنيوية وهي التي تتقدم بها حياة الإنسان الاجتماعية، ويصفو بها العيش وترفع بها الحوائج المتنوعة، وتكمل بها النواقص المختلفة من أنواع التجارة والسياسة والولاية والتدبير وأقسام الرسوم والآداب والسنن والعادات ومختلف التعاونات والتعاضدات الاجتماعية وغيرها.
فإذا اجتمعت أقوام وأمم من مختلف مناطق الأرض وأصقاعها على ما لهم من اختلاف الأنساب والألوان والسنن والآداب، ثم تعارفوا بينهم وكلمتهم واحدة هي كلمة الحق، وإلههم واحد وهو الله عز اسمه، ووجهتهم واحدة هي الكعبة البيت الحرام، حملهم اتحاد الأرواح على تقارب الأشباح، ووحدة القول على تشابه الفعل، فأخذ هذا من ذاك ما يرتضيه، وأعطاه ما يرضيه، واستعان قوم بآخرين في حل مشكلتهم، وأعانوهم بما في مقدرتهم، فيبدل كل مجتمع جزئي مجتمعًا أرقى، ثم امتزجت المجتمعات فكونت مجتمعًا وسيعًا، له من القوة والعدة ما لا تقوم له الجبال الرواسي، ولا تقوى عليه أي قوة جبارة طاحنة، ولا وسيلة إلى حل مشكلات الحياة كالتعاضد، ولا سبيل إلى التعاضد كالتفاهم، ولا تفاهم كتفاهم الدين.
ومنافع أخروية وهي وجوه التقرب إلى الله تعالى بما يمثل عبودية الإنسان من قول وفعل وعمل الحج بما له من المناسك يتضمن أنواع العبادات من التوجه إلى الله، وترك لذائذ الحياة، وشواغل العيش، والسعي إليه بتحمل المشاق، والطواف حول بيته، والصلاة والتضحية والإنفاق والصيام وغير ذلك.
وقد تقدم فيما مر أن عمل الحج بما له من الأركان والأجزاء، يمثل دورة كاملة مما جرى على إبراهيم عليه السلام في مسيره في مراحل التوحيد، ونفي الشريك وإخلاص العبودية لله سبحانه.
فإتيان الناس إبراهيم عليه السلام، أي حضورهم عند البيت لزيارته يستعقب شهودهم هذه المنافع أخرويها ودنيويها، وإذا شهدوها تعلقوا بها فالإنسان مجبول على حب النفع.
وقوله: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ قال الراغب: والبهيمة ما لا نطق له، وذلك لما في صوته من الإبهام، لكن خص في التعارف بما عدا السباع والطير فقال تعالى: ﴿َأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ﴾.
وقال: والنعم مختص بالإبل، وجمعه أنعام، وتسميته بذلك لكون الإبل عندهم أعظم نعمة، لكن الأنعام تقال للإبل والبقر والغنم، ولا يقال لها: أنعام حتى تكون في جملتها الإبل.
فالمراد ببهيمة الأنعام الأنواع الثلاثة: الإبل والبقر والغنم من معز أو ضأن والإضافة بيانية.
والجملة أعني قوله: ﴿وَيَذْكُرُوا﴾، إلخ معطوف على قوله: ﴿يَشْهَدُوا﴾ أي وليذكروا اسم الله في أيام معلومات، أي في أيام التشريق على ما فسرها أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وهي يوم الأضحى عاشر ذي الحجة وثلاثة أيام بعده.
وظاهر قوله: ﴿عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ أنه متعلق بقوله: ﴿يَذْكُرُوا﴾ وقوله: ﴿مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ بيان للموصول والمراد ذكرهم اسم الله على البهيمة - الأضحية - عند ذبحها أو نحوها على خلاف ما كان المشركون يهلونها لأصنامهم.
وقد ذكر الزمخشري أن قوله: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ إلخ كناية عن الذبح والنحر، ويبعده أن في الكلام عناية خاصة بذكر اسمه تعالى بالخصوص، والعناية في الكناية متعلقة بالمكني عنه دون نفس الكناية، ويظهر من بعضهم أن المراد مطلق ذكر اسم الله في أيام الحج وهو كما ترى.
وقوله: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير﴾ البائس من البؤس وهو شدة الضر والحاجة، والذي اشتمل عليه الكلام حكم ترخيصي إلزامي.
قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ التفث شعث البدن، وقضاء التفث إزالة ما طرأ بالإحرام من الشعث بتقليم الأظفار وأخذ الشعر ونحو ذلك وهو كناية عن الخروج من الإحرام.
والمراد بقوله: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ إتمام ما لزمهم بنذر أو نحوه، وبقوله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ طواف النساء على ما في تفسير أئمة أهل البيت عليهم السلام فإن الخروج من الإحرام يحلل له كل ما حرم به إلا النساء فتحل بطواف النساء وهو آخر العمل.
والبيت العتيق هو الكعبة المشرفة، سميت به لقدمه فإنه أول بيت بني لعبادة الله كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾ آل عمران: 96، وقد مضى على هذا البيت اليوم زهاء أربعة آلاف سنة، وهو معمور وكان له يوم نزول الآيات أكثر من ألفين وخمسمائة سنة.
قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ﴾ إلى آخر الآية الحرمة، ما لا يجوز انتهاكه ووجب رعايته، والأوثان جمع وثن وهو الصنم، والزور الميل عن الحق ولذا يسمى الكذب وقول الباطل زورًا.
وقوله: ﴿ذلك﴾ أي الأمر ذلك أي الذي شرعناه لإبراهيم عليه السلام ومن بعده من نسك الحج، هو ذلك الذي ذكرناه وأشرنا إليه من الإحرام والطواف والصلاة والتضحية بالإخلاص لله والتجنب عن الشرك.
وقوله: ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ﴾ ندب إلى تعظيم حرمات الله، وهي الأمور التي نهى عنها وضرب دونها حدودًا منع عن تعديها واقتراف ما وراءها وتعظيمها الكف عن التجاوز إليها.
والذي يعطيه السياق أن هذه الجملة توطئة وتمهيد لما بعدها من قوله ﴿وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ فإن انضمام هذه الجملة إلى الجملة قبلها يفيد أن الأنعام - على كونها مما رزقهم الله وقد أحلها لهم - فيها حرمة إلهية وهي التي يدل عليها الاستثناء - إلا ما يتلى عليكم -.
والمراد بقوله ﴿مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ استمرار التلاوة، فإن محرمات الأكل نزلت في سورة الأنعام وهي مكية، وفي سورة النحل وهي نازلة في آخر عهده صلى الله عليه وآله وسلم بمكة وأول عهده بالمدينة، وفي سورة البقرة وقد نزلت في أوائل الهجرة بعد مضي ستة أشهر منها - على ما روي - ولا موجب لجعل ﴿يُتْلَى﴾ للاستقبال وأخذه إشارة إلى آية سورة المائدة كما فعلوه.
والآيات المتضمنة لمحرمات الأكل وإن تضمنت منها عدة أمور، كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، إلا أن العناية في الآية بشهادة سياق ما قبلها وما بعدها بخصوص ما أهل به لغير الله، فإن المشركين كانوا يتقربون في حجهم - وهو السنة الوحيدة الباقية بينهم من ملة إبراهيم - بالأصنام المنصوبة على الكعبة وعلى الصفا وعلى المروة وبمنى ويهلون بضحاياهم لها، فالتجنب منها ومن الإهلال بذكر أسمائها، هو الغرض المعنى به من الآية، وإن كان أكل الميتة والدم ولحم الخنزير أيضًا من جملة حرمات الله.
ويؤيد ذلك أيضا تعقيب الكلام بقوله: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ فإن اجتناب الأوثان واجتناب قول الزور وإن كانا من تعظيم حرمات الله ولذلك تفرع ﴿فاجتنبوا الرجس﴾ على ما تقدمه من قوله: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ﴾ لكن تخصيص هاتين الحرمتين من بين جميع الحرمات في سياق آيات الحج بالذكر، ليس إلا لكونهما مبتلى بهما في الحج يومئذ، وإصرار المشركين على التقرب من الأصنام هناك وإهلال الضحايا باسمها.
وبذلك يظهر أن قوله: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ نهي عام عن التقرب إلى الأصنام وقول الباطل أورد لغرض التقرب إلى الأصنام في عمل الحج كما كانت عادة المشركين جارية عليه، وعن التسمية باسم الأصنام على الذبائح من الضحايا، وعلى ذلك يبتني التفريع بالفاء.
وفي تعليق حكم الاجتناب أولا بالرجس ثم بيانه بقوله: ﴿مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ إشعار بالعلية كأنه قيل: اجتنبوا الأوثان لأنها رجس، وفي تعليقه بنفس الأوثان دون عبادتها، أو التقرب أو التوجه إليها أو مسها ونحو ذلك - مع أن الاجتناب إنما يتعلق على الحقيقة بالأعمال دون الأعيان - مبالغة ظاهرة.
وقد تبين بما مر أن ﴿من﴾ في قوله: ﴿مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ بيانية، وذكر بعضهم أنها ابتدائية، والمعنى: اجتنبوا الرجس الكائن من الأوثان وهو عبادتها، وذكر آخرون أنها تبعيضية، والمعنى: اجتنبوا الرجس الذي هو بعض جهات الأوثان وهو عبادتها، وفي الوجهين من التكلف وإخراج معنى الكلام عن استقامته ما لا يخفى.
قوله تعالى: ﴿حُنَفَاء لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ﴾ إلخ، الحنفاء جمع حنيف وهو المائل من الأطراف إلى حاق الوسط.
وكونهم حنفاء لله ميلهم عن الأغيار وهي الآلهة من دون الله إليه فيتحد مع قوله غير مشركين به معنى.
وهما أعني قوله: ﴿حُنَفَاء لِلَّهِ﴾ وقوله: ﴿غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِه﴾ حالان عن فاعل ﴿فَاجْتَنِبُوا﴾ أي اجتنبوا التقرب من الأوثان والإهلال لها حال كونكم مائلين إليه ممن سواه، غير مشركين به في حجكم، فقد كان المشركون يلبون في الحج بقولهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك.
وقوله: ﴿وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ﴾ أي تأخذه بسرعة، شبه المشرك في شركه وسقوطه به من أعلى درجات الإنسانية إلى هاوية الضلال فيصيده الشيطان، بمن سقط من السماء فتأخذه الطير.
وقوله: ﴿أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ أي بعيد في الغاية وهو معطوف على ﴿تَخْطَفُهُ الطَّيْرُ﴾ تشبيه آخر من جهة البعد.
قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ ﴿ذلك﴾ خبر لمبتدإ محذوف أي الأمر ذلك الذي قلنا، والشعائر جمع شعيرة وهي العلامة، وشعائر الله الأعلام التي نصبها الله تعالى لطاعته كما قال: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ﴾ وقال: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآية.
والمراد بها البدن التي تساق هديا وتشعر أي يشق سنامها من الجانب الأيمن ليعلم أنها هدي على ما في تفسير أئمة أهل البيت عليهم السلام ويؤيده ظاهر قوله تلوا: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ إلخ، وقوله بعد: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا﴾ الآية، وقيل: المراد بها جميع الأعلام المنصوبة للطاعة، والسياق لا يلائمه.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 القوّة الحقيقيّة للإيمان
القوّة الحقيقيّة للإيمان
السيد عباس نور الدين
-
 جائحة التقنية
جائحة التقنية
محمود حيدر
-
 معنى قوله تعالى:{أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيَةً تَعْبَثُونَ..}
معنى قوله تعالى:{أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيَةً تَعْبَثُونَ..}
الشيخ محمد صنقور
-
 حبط الأعمال
حبط الأعمال
الشيخ مرتضى الباشا
-
 ما هي ليلة القدر
ما هي ليلة القدر
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 لماذا يصاب المسافر بالأرق ويعاني من صعوبة في للنوم؟
لماذا يصاب المسافر بالأرق ويعاني من صعوبة في للنوم؟
عدنان الحاجي
-
 معنى سلام ليلة القدر
معنى سلام ليلة القدر
السيد محمد حسين الطهراني
-
 معنى (نكل) في القرآن الكريم
معنى (نكل) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 مميّزات الصّيام
مميّزات الصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
الشعراء
-
 عرجت روح عليّ وا أمير المؤمنين
عرجت روح عليّ وا أمير المؤمنين
حسين حسن آل جامع
-
 جرح في عيون الفجر
جرح في عيون الفجر
فريد عبد الله النمر
-
 من لركن الدين بغيًا هدما
من لركن الدين بغيًا هدما
الشيخ علي الجشي
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

القوّة الحقيقيّة للإيمان
-

جائحة التقنية
-

مكاسب رمضانية
-

معنى قوله تعالى:{أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيَةً تَعْبَثُونَ..}
-

حبط الأعمال
-

شرح دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان
-

الصوم رائض وواعظ
-

علماء يطورون أدمغة مصغرة، ثم يدربونها على حل مشكلة هندسية
-

العدد الحادي والأربعون من مجلّة الاستغراب
-

إحياء ليلة القدر الكبرى في المنطقة










