مقالات
معنى حب اللّه لعبده

الشيخ محمد مهدي النراقي
شواهد الكتاب والسنة ناطقة بأن اللّه - سبحانه- يحب العبد ، كقوله - تعالى- : {يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} [المائدة : 54] ، وقوله - تعالى- : {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ } [الصف : 4] ، وقوله - تعالى- : {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } [البقرة : 222] ، وقوله تعالى : {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [آل عمران : 31] .
وقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): «إن اللّه يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ، ولا يعطى الإيمان إلا من يحب» ، وقال (صلى الله عليه وآله): «اذا أحب اللّه عبدًا لم يضره ذنب» وقال (صلى الله عليه وآله): «اذا أحب اللّه عبدًا ابتلاه ، فإن صبر اجتباه ، وإن رضى اصطفاه» ، وقال (صلى الله عليه وآله): «من أكثر ذكر اللّه أحبه اللّه» ، وقال (صلى الله عليه وآله) حاكيًا عن اللّه : «لا يزال العبد يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ولسانه الذي ينطق به» ، وقال (صلى الله عليه وآله): «إذا أحب اللّه عبدًا ، جعل له واعظًا من نفسه ، وزاجرًا من قلبه ، يأمره وينهاه» .
ثم حقيقة الحب - وهو الميل إلى موافق ملائم - غير متصور في حق اللّه - تعالى- ، بل هذا إنما يتصور في حق نفوس ناقصة ، واللّه - سبحانه- صاحب كل جمال وكمال وبهاء وجلال ، وكل ذلك حاضر له بالفعل أزلًا وأبدًا ، إذ لا يتصور تجدده وزواله ، فلا يكون له إلى غيره نظر من حيث إنه غير، بل ابتهاجه بذاته وصفاته وأفعاله ، وليس في الوجود إلا ذاته وصفاته وأفعاله ، ولذلك قال بعض العرفاء - لما قرئ قوله - تعالى- : {يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} [المائدة : 54] : «نحن نحبهم ، فإنه ليس يحب إلا نفسه» ، على معنى أنه الكل وأنه في الوجود ليس غيره ، فمن لا يحب إلا ذاته ، وصفات ذاته ، وأفعال ذاته وتصانيف ذاته ، فلا يجاوز حبه وذاته وتواضع ذاته من حيث هي متعلقة بذاته ، فهو إذًا لا يحب إلا ذاته ، وليس المراد من محبة اللّه لعبده هو الابتهاج العام الذي له- تعالى- بأفعاله له، إذ المستفاد من الآيات والأخبار : أن له - تعالى - خصوصية محبة لبعض عباده ليست لسائر العباد والمخلوقات فمعنى هذه المحبة يرجع إلى كشف الحجاب عن قلبه حتى يراه بقلبه ، وإلى تمكينه إياه من القرب إليه ، وإلى إرادته ذلك به في الأزل ، وإلى تطهير باطنه عن حلول الغير به ، وتخليته عن عوائق تحول بينه وبين مولاه ، حتى لا يسمع إلا بالحق ومن الحق ، ولا يبصر إلا به ، ولا ينطق إلا به- كما في الحديث القدسي- فيكون تقربه بالنوافل سببًا لصفاء باطنه ، وارتفاع الحجاب عن قلبه ، وحصوله في درجة القرب من ربه ، وكل ذلك من فضل اللّه تعالى ولطفه به.
ثم قرب العبد من اللّه لا يوجب تغيرُا وتجددُا في صفات اللّه - تعالى- ، إذ التغير عليه سبحانه محال ، لأنه لا يزال في نعوت الكمال والجلال والجمال على ما كان عليه في أزل الآزال بل يوجب مجرد تغير العبد بترقيه في مدارج الكمال ، والتخلق بمكارم الأخلاق التي هي الأخلاق الإلهية ، فكلما صار أكمل صفة وأتم علمًا وإحاطة بحقائق الأمور، وأثبت قوة في قهر الشياطين وقمع الشهوات ، وأظهر نزاهة عن الرذائل ، وأقوى تصرفًا في ملكوت الأشياء صار أقرب إلى اللّه.
ودرجات القرب غير متناهية ، لعدم تناهي درجات الكمال ، فمثل تقرب العبد إلى اللّه ليس كتقرب أحد المتقاربين إلى الآخر إذا تحركا معُا ، بل كتقرب أحدهما مع تحركه إلى الآخر الذي كان ساكنًا ، أو كتقرب التلميذ في درجات الكمال إلى أستاذه ، فإن التلميذ متحرك مترق من حضيض الجهل إلى بقاع العلم ، ويطلب القرب من أستاذه في درجات العلم والكمال ، والأستاذ ثابت واقف ، وإن كان التلميذ يمكن أن يصل إلى مرتبة المساواة الأستاذة لتناهي كمالاته ، وأما العبد ، كائنًا من كان ، لا يمكن أن يصل إلى كمال يمكن أن يكون له نسبة إلى كمالاته - سبحانه- ، لعدم تناهي كمالاته شدة وقوة وعدة ، وعلامة كون العبد محبوبًا عند اللّه. أن يكون هو محبًّا له - تعالى- ، مؤثرًا إياه على غيره من المحاب ، وأن يرى من بواطن أموره وظواهره أنه - تعالى- يهيء له أسباب السعادة فيها ، ويرشده إلى ما فيه خيره ، ويصده عن المعاصي بأسباب يعلم حصولها منه - سبحانه- ، أنه - تعالى- يتولى أمره ، ظاهره وباطنه ، وسره وجهره ، فيكون هو المشير عليه ، والمدبر لأمره ، والمزين لأخلاقه ، والمستعمل لجوارحه ، والمسدد لظاهره وباطنه ، والجاعل لهمومه همًّا واحدًا ، والمبغض للدنيا في قلبه ، والموحش له من غيره ، والمؤنس له بلذة المناجاة في خلواته والمكاشف له عن الحجب بينه وبين معرفته.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 المراد من عدم استحياء الله
المراد من عدم استحياء الله
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
-
 التجلّيات السّلوكية والعمليّة لذكر الله تعالى
التجلّيات السّلوكية والعمليّة لذكر الله تعالى
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 معنى (عمد) في القرآن الكريم
معنى (عمد) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 الأساس العصبي للحدس: هل يستطيع دماغك فعلًا أن يعرف قبل أن تعرف أنت
الأساس العصبي للحدس: هل يستطيع دماغك فعلًا أن يعرف قبل أن تعرف أنت
عدنان الحاجي
-
 الإمام السابع
الإمام السابع
الشيخ جعفر السبحاني
-
 علّة اختيار موسى (ع) لهارون (ع) وزيرًا
علّة اختيار موسى (ع) لهارون (ع) وزيرًا
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 التأسيس الَّلاهوتي لفلسفة الحرب (4)
التأسيس الَّلاهوتي لفلسفة الحرب (4)
محمود حيدر
-
 أربع قواعد ألماسية في علاج المشاكل الزوجية
أربع قواعد ألماسية في علاج المشاكل الزوجية
الشيخ مرتضى الباشا
-
 الرياء وموقف العرفان من النية والعمل
الرياء وموقف العرفان من النية والعمل
الشيخ شفيق جرادي
-
 كن سببًا لنجاح ابنك وتألّقه
كن سببًا لنجاح ابنك وتألّقه
عبدالعزيز آل زايد
الشعراء
-
 الكاظم.. تهجّد في محاريب الشّوق
الكاظم.. تهجّد في محاريب الشّوق
حسين حسن آل جامع
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 تجلّـيت جلّ الذي جمّـلك
تجلّـيت جلّ الذي جمّـلك
الشيخ علي الجشي
-
 فانوس الأمنيات
فانوس الأمنيات
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
آخر المواضيع
-

المراد من عدم استحياء الله
-

التجلّيات السّلوكية والعمليّة لذكر الله تعالى
-
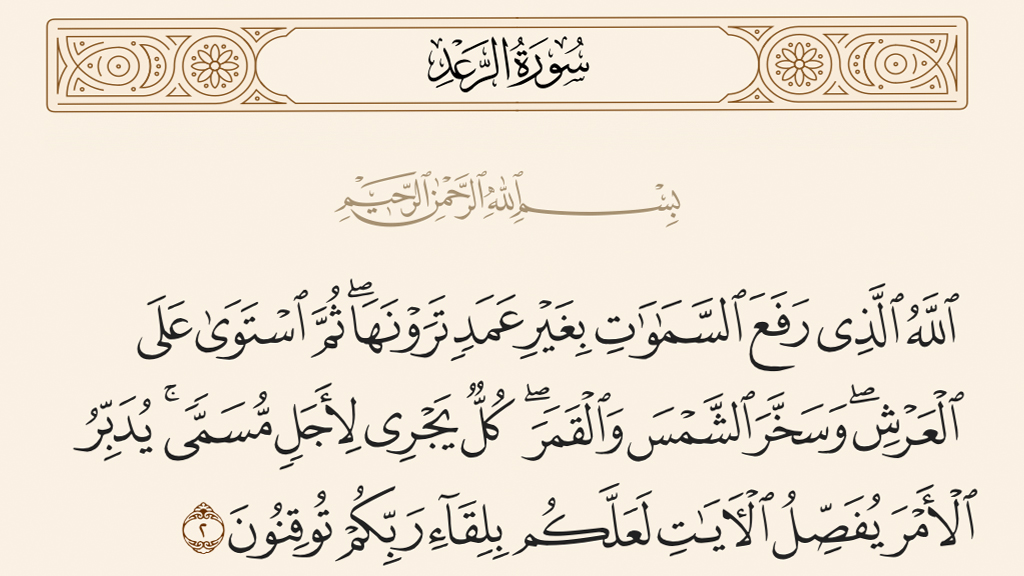
معنى (عمد) في القرآن الكريم
-

الأساس العصبي للحدس: هل يستطيع دماغك فعلًا أن يعرف قبل أن تعرف أنت
-

الإمام السابع
-
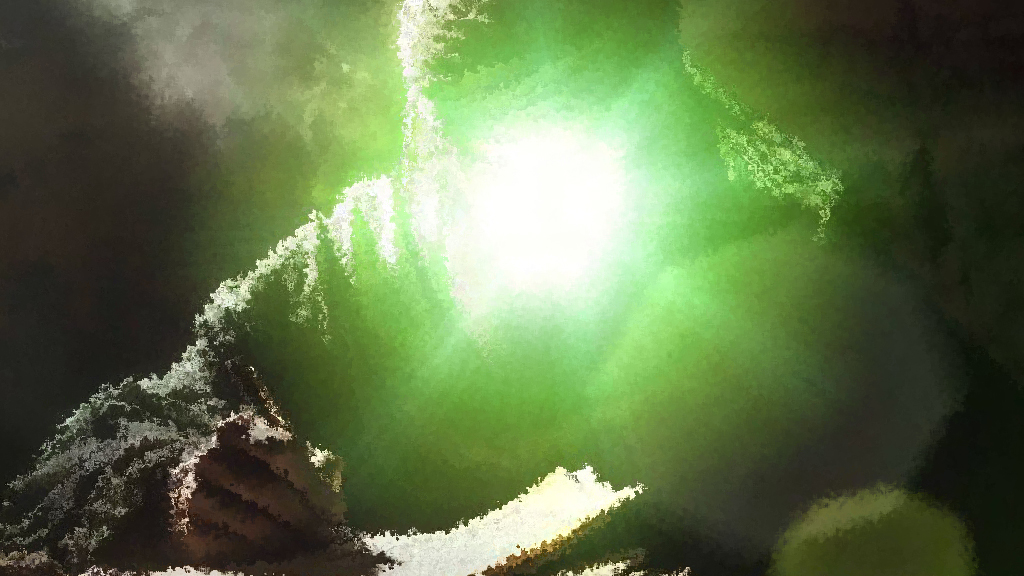
حجية العقل عند الإمام الكاظم (ع)
-

الكاظم.. تهجّد في محاريب الشّوق
-

وجهة
-

أمسية للأديبة مريم الحسن بعنوان: (الحكاية الشّعبيّة في القصّة الأحسائيّة)
-

علّة اختيار موسى (ع) لهارون (ع) وزيرًا









