مقالات
معلومات الكاتب :
الاسم :
إيمان شمس الدينعن الكاتب :
باحثة في الفكر الديني والسياسي وكاتبة في جريدة القبس الكويتيةكربلاء وصناعة الوعي الثوري

أهم مواجهة عبر التاريخ كانت المواجهة بين الوعي والتخلف، بين الانعتاق والعبودية، بين الاستبداد ومبدأ المشاركة والكرامة الإنسانية.
مواجهات تأخذ منحنيات متعددة صعودًا وهبوطًا عبر التاريخ، منذ نبينا آدم إلى وقت واقعة كربلاء، التي أحدثت تبدًلا في موازين القوى، و تقدمًا لصالح حركة الوعي التاريخي والاجتماعي.
كان الصراع عبر التاريخ صراع سلطة كما يراه المستبدون والطامحون للسلطان، لكنه في واقع الأمر هو صراع بين الحرية والعبودية، صراع الكرامة والعزة مع الذل والهوان، وتحرر من كل الآلهة وتحقق عبودية الروح والجسد لله، مع محاولات حثيثة في استعباد الروح والجسد، ومحاولات ناجزة في تفعيل انحسار كل مقوِّمات الوعي والتقدم.
صراع سعى فيه الاستبداد بكل تجلياته من السلطة إلى الأمة إلى المجتمع، بهدم تدريجي للمفاهيم الكبرى، وبتغيير معالم الشريعة وتبديل القيم والمعايير، هذا الهدم المنهجي هدفه السيطرة والتسلط على الثروات ورقاب الناس. ولكنه بلغ ذروته قبل نهضة الإمام الحسين عليه السلام، وهي النهضة التي تأتي ضمن سياقها الصحيح وفق سنن التاريخ ومحاولات الطغاة عبر التاريخ تحدي السنن الإلهية، وعندما يصل التحدي ذروته ينقلب رأسًا على عقب، ويعود المسار السنتي الإلهي إلى سيره السليم في المجتمعات، فيزول الطغيان بحركة تاريخية، حركة وعي تعيد الاتزان للمسار التاريخي السنتي، ومحاولة النهوض مجددًا لتحقيق العدالة ورفض الظلم.
فتأسيس بنية الاستبداد كانت باستلاب القدرة على القرار، وقطع مشروع الوعي والتحصين الذي ابتدأه النبي (ص) ويفترض أن يكمله الأوصياء من بعده.
هذا الاستلاب في تلك الفترة انبنى على أساس العصبيات القبلية، وتمكن تحت هذا الشعار أن يكرس سلطته ويعيد المشروع الطبقي في المجتمع، ولكن هذه المرة كان متلبسًا بشعارات دينية تناسب المرحلة، حيث كانت المفاهيم الكبرى ما تزال كمشروع وعي في بداياتها، ولم يدرك أغلب الداخلين إلى الإسلام خاصة بعد فتح مكة، كثيرًا من أهداف الرسالة ومقاصدها، فتراكمت بعد ذلك مفاهيم ظاهرها ديني وروحها جاهلية، واكتفى الناس بهذه الشعارات الطقوسية، وبدأت مسيرة استعباد جديدة للإنسان وهذا المرة باسم الدين.
تحقق الاستلاب لإرادة الإنسان وإخضاعه لإرادات أخرى، من خلال الصراع على السلطة والمال وامتلاك القوة المادية، مما كرس حالة الخضوع والرضوخ جيلًا بعد جيل، لتصبح واقعًا متوارثًا، وكأنه الحقيقة التي يجب أن يكون عليه واقع الحال. واستلاب الإرادة يعني بالضرورة استلاب قدرة الإنسان ودافعيته للاختيار الحر، فيصبح أسير خيارات الطغاة خاصة حينما يقع التزاوج بين المستبد والفقيه، ليتحول المستبد بشرعنة الفقيه إلى مقدس معصوم وممنوع المساس به وبسلوكه، فيتحول إلى رمز وقدوة يكرس واقعًا وفهمًا جديدًا للدين، مشوّه الروح وسليم الجسد والظاهر، لتصبح القشور والطقوس هي كل الدين، وتهمل المقاصد والمفاهيم الكبرى التي حفظت روح الدين وكرامة الإنسان وخاصة مفاهيم كالعدل والظلم وكيفية الأمر بالأول ورفض الثاني ومواجهته.
تبدلت خلال هذه الفترة مفاهيم كثيرة دلاليًّا، وإن بقيت في تركيبها الحرفي كما هي، وتغيرت كثير من معالم الحق وانقلبت منظومة القيم والمعايير رأسًا على عقب تحت سياط القهر والاستبداد، وتكريس كل مقومات التخلّف بشعارات دينية وفتاوى دفعت ثمنها سلطة فاسدة لفقهاء فاسدين، فمثلًا مفهوم القوة والسلطة والشجاعة والكرامة والولاية، بقيت كشكل كما هي، لكن انحرفت دلالاتها من خلال تطبيقاتها السلوكية، فالتمييز الطبقي بات واقعًا مقبولًا، لأن من يمارسه هو الخليفة المفترض الطاعة، ويرضى به فقهاء ونخب دينية يحملون راية الدين، فبدت معالم الشريعة الأساسية وقد تشوهت في وعي الأمة والمجتمعات، وهو الأمر الذي يتطلب حركة تصحيحية بارزة وعميقة تعيد مسار الشريعة للطريق السليم، وتخضع الوعي المستلب لصدمة تعيد له الرشد التشريعي الإلهي، وتضرب تشريعات البشر المنحرفة وحضارتهم المزخرفة، وتهدم وجودها في ذاكرة المجتمعات والأمة. فحضارة المسلمين ليست هي ذاتها الدين، كونها سلوكًا وفهمًا بشريًّا في زمان ومكان معيّنين لتطبيق الدين الذي تبنته السلطة، فالمواجهة تكون لحفظ الشرع، حتى لو قوّضت حضارة صنعتها أفهام بشرية انحرفت عن جادة الحق.
وجاءت حركة الإمام الحسين (ع) في ظل هذه التغيرات الجذرية في وعي المسلم، خاصة فيما يتعلق بأصل الأصول "التوحيد"، حيث خاضت النخب في تلك الفترة معركة عقائدية، طرحت من خلالها شبهات كثيرة، وغيرت مباني مفاهيم كثيرة، كانت الغلبة فيها لتلك التي تتبناها السلطة، وبالتالي تكرسها كحقيقة في ذهنية الجمهور من خلال مجموعة فقهاء تدير معاشهم وتغدق عليهم المال والجاه، كصراعات الجبر والتفويض، ومواجهة الحاكم وطاعته، وهي مفاهيم لها اتصال مباشر في مفهوم التوحيد، ومدى ارتكازه بشكل سليم في وعي الناس، فكانت ثورة الإمام ثورة تغيير وعي ومفاهيم، وحركة تصحيحية ونهضوية ليس فقط ضد استبداد يزيد ونكوص المجتمع، بل حتى ضد أغلب أتباع مدرسة أهل البيت (ع)، الذين تكرست في بنيتهم العقلية ثقافة انهزامية تسربت إليها دعوى عدم جواز الخروج على السلطان، حيث تراجع في وعيهم الرشد بحقيقة وظيفة المأموم، هذا فضلًا عن مفهوم الانتظار السلبي للمخلص، والتي تعني تراكم الكسل والاستسلام للأقوى في ذهنيتهم، ودليلهم نصوص دينية يتم تأويلها بطرق منحرفة تتناسب وإحساسهم بالذل والنكوص .
فخروج الإمام الحسين (ع) مع نخبة من الشيعة الأتبا،ع وتقاعس نخب أخرى، هو دلالة على عدم بلوغ وعي الشيعة مبلغًا يدرك حقيقة مقام الإمام وحقيقة وظيفة المأموم، فوقعت مأساة كربلاء التي أحدثت صدمة وعي عند أتباع الإمام خاصة من قبل الناس العاديين، وكانت الثورة الحسينية محطة منهجية مهمة في عودة مسار الأمة الوظيفي كما رسمه رسول الله (ص)، فالخذلان كان سببًا من أسباب تحول كربلاء إلى مأساة في مشهديتها، فسكوت الناس وخوفهم وعدم اكتراثهم بما سيحدث لآخر ابن بنت نبي (ص)، لهو دلالة على الانهزام النفسي والتبدل الكبير الذي حدث في المفاهيم والمعايير والقيم، وهو ما يدفعنا لمعرفة مقومات ظهور المخلص التي يمكن استلهامها من نهضة الإمام الحسين (ع) وملابساتها التاريخية، فالإمام المنتظر سيرفع شعار يا لثارات الحسين (ع)، لأنها الثورة التاريخية التي استطاعت أن تفشل كل محاولات تشويه الشريعة وتزويرها وتحريف وعي الناس وتشوهه، وهي الثورة التي لعبت عبر التاريخ إلى يومنا هذا دورًا نهضويًّا متجدًدا من خلال التأكيد على إحيائها كذكرى، ورصد ثواب وأجر كبير على ذلك، بل التشديد الكبير في اعتبارها من شعائر الله التي يجب إحياؤها، هذا التشديد الإحيائي يجعلها نهضة مستديمة وتجديدية في كل زمان ومكان، بالتالي هي مرجعية معرفية نستقي منها المنهج والطريق الذي يصلح عثرات زماننا، ويقوض كل محاولات الاستلاب المتجددة من الطغاة عبر الزمن، وتقويض محاولاتهم في تحدي السنن الإلهية التاريخية في المسار التاريخي والاجتماعي، الذي تسعى به الأمة والمجتمعات نحو كمالاتها اللائقة بها، فتكون مناسبة الإحياء مناسبة مهمة لترشيد الناس وتقويم مسارهم نحو الكمال، خاصة بعد أن تعمد الأنظمة إلى حرفه عن مساره السليم. فالنهضة الحسينية حاجة ضرورية في مشروع التمهيد لظهور المخلص كونها تجدد مستوى القابليات، وترتفع بها كي تعي حاجاتها الزمانية والمكانية، وتدرك مكامن الخلل وآليات الإصلاح، وكيفية النهوض بالواقع الذي ابتعد عن العدالة وعن مسار الله، فالهدف الأول المراد تحقيقه من الظهور هو العدالة، وإعادة إحياء الدين وحقيقته الواقعية للناس. فالعدالة ضرورة ومقدمة مدخلية لتحقيق كرامة الإنسان ورفع الظلم عنه، وفك كل محاولات تكبيله، سواء تكبيل عقله بمفاهيم وأفكار وعقائد مغلوطة، أو تكبيل جسده وسلب إرادته بالاستبداد وسلب حريته.
ولذلك يمكن أن نرى أن مسألة الظهور مسألة طرفانية تحتاج توافر الشروط في كل الأطراف، لتكتمل العوامل المؤثرة في الظهور، وتحقيق العدالة التي باتت مطلبًا ينشده الإنسان.
الأطراف هي الإمام والمأموم، فالإمام ينتظر ارتفاع قابليات المأمومين وإدراكهم لحقيقة وظيفتهم الاستخلافية، وقدرتهم على أن يشكلوا الجماعة الصالحة القادرة على التغيير تحت قيادة الإمام، والمأمومون ينتظرون المخلص من خلال سعيهم الدؤوب لنشر الوعي والفهم والحقيقة والنهوض بواقعهم وقابليات المجتمعات، لتصبح أهلًا لحقيقة الظهور ومقوماته، فالغاية هي العدالة، وحتى لا تتكرر مشهدية كربلاء مجددًا، و لتصبح كربلاء تجربة تلهم الإنسان وتمده بآليات النهوض والمواجهة الناجحة، وكيفية حفظ الثورة والانتصار بها ماديًّا ومعنويًّا.
فالغاية الكبرى من الظهور هو تحقيق العدالة، وتحقيق العدالة لا يتم إلا من خلال توفر مجموعة تشبه في بعدها الروحي والمعنوي والمادي مجموعة أنصار الحسين (ع)، وهو ما يعني إقامة العدالة في النفس لتصبح قادرة على إقامتها في الخارج، فنموذج عاشوراء هو نموذج مرجعي يمدنا بماهية المواصفات والشروط التي يجب أن تتوفر فينا ونوفرها بأنفسنا وعقولنا وفي محيطنا كي تتحقق واقعيًّا فكرة المخلص وفكرة الظهور.
فالعبرة التاريخية تتحقق عندما لا نكرر أخطاء تلك الحقبة الزمنية، وأن نحول الفشل إلى عوامل نجاح، والهزيمة المادية إلى نصر مادي ومعنوي، من خلال دراسة الظروف والملابسات في أبعادها كافة حول تلك الحقبة الزمنية، هذه الدراسة لنهضة الحسين (ع)، ستكون بمثابة القاعدة التي سننطلق منها لإحراز حقيقة ما يجب أن يكون المأموم عليه، والسير قدمًا في هذا المنهج لتوفير شروط الظهور في النفس والمجتمع، وتحقيق كل شروط الظهور ومقوماته من طرف المأموم ومن ثم انتظار الفرج انتظارًا إيجابيًّا حركيًّا، يجعل من عاشوراء ملهمًا معرفيًّا يغذي فكرة الانتظار بشكل إيجابي حركي تصاعدي نحو الوصول للهدف، وانتظار الفرج بعد توفر كل شروطه ومقوماته المادية والمعنوية.
فالنهضة هي إحياء للدين الذي أماته السلاطين في نفوس الناس وشعورهم وعقائدهم تحت سياط التعذيب والحرمان وفتاوى فقهاء السلطة، والتفاف نخب حول سلطات فاسدة انحرفت بالدين عن حقيقته وواقعه.
والإنسان المقهور يفتقد الطابع الاقتحامي في السلوك، ونتيجة ممارسة القهر والقمع كرد فعل على أي محاولة تغيير من قبله، فهو يتخلى بسرعة عن المجابهة إما بانسحابه أو استسلامه للقهر أو تجنبه لكل تلك الأحداث.
وهذا تمامًا ما كان عليه المجتمع قبل ثورة الإمام الحسين (ع)، مجتمع تغلب عليه سمة القهر والخضوع والرضوخ وتوارثتها الأجيال منذ تم سحق إرادة الأجداد. تراكم الفهم المتخاذل للدين، وتراكم العجز والقهر، فكان الفهم المتخاذل يكرس السلوك المتخاذل، ويسحق إرادة الفرد والمجتمع، تحت سياط الاستبداد والقهر والتخلف.
جاءت نهضة الحسين (ع) لتشكل صدمة وعي من خلال عنف المشهدية الكربلائية، ونوعية الشخصيات التي قادت المعركة، سواء من حيث موقعها الاجتماعي أو الديني الراكز في ذاكرة التاريخ دينيًّا وسياسيًّا، هذا فضلًا عن انتشارها الاجتماعي إنسانيًّا وأخلاقيًّا مما عمق وجودها في الوجدان الجمعي الشعبي، لذلك كان ثقل المعركة يرتكز على نوعية الشخوص وعلى امتدادهم في الوجدان الشعبي، بما يشكلونه من سيرة دينية وقيمية واجتماعية في ذاكرة المجتمع في الماضي والحاضر.
وخذلان نصرة الإمام كان يعكس مدى تعمق ثقافة القهر في نفسية المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى تراجع دلالات المفاهيم الكبرى التي يرتكز عليها الدين كالتوحيد ومتعلقاته العقائدية وهنا مكمن الخطر.
تكرست مفاهيم غيبية وأسطورية كالفرد المنقذ وقوته الخارقة للخلاص من سلطة الاستبداد في ذهنية الجماهير، بينما الحقيقة التاريخية توضح أنها ليست سلطة وقوة خارقة غيبية، بقدر ما هي تلازم شرطي بين إمداد الغيب شريطة توفر الإيرادات الثابتة القاطعة في مواجهة كل أنواع القهر الإنساني، مع وجود قيادة ربانية مخلصة، إذًا هي عبارة عن :
-قيادة ربانية
-إرادة ووعي ثابتة وقطعية في مواجهة الانحراف
- دعم غيبي
ثلاثية لا ينفك بعضها عن بعض، وعدم توفر أحدها لا يحقق ثمرة النصر المادي والمعنوي .
فثورة كربلاء من وجهة نظري كرست ثقافة انتظار ملهمة لا مثبطة، وأعادت رسم معالم المفاهيم في وعي الإنسان ووجدانه، فكانت إحيائية نهضوية تستهدف إحياء المفاهيم الكبرى بدلالاتها الواقعية في أذهان الناس، ونهضة الشريعة التي حرفتها حضارة مسلمين لا حضارة الإسلام، حيث صنعوا حضارتهم على أنقاض الشريعة، وحولوا الأمة من أمة شريعة إلى أمة قبيلة. فتحولت هي كثورة إلى ملهمة بشكل مستديم في أبعادها كافة، لأنها قدمت مشروع الإصلاح بالتضحية بأفضل الحيوات الموجودة على تلك البقعة في ذلك الزمن، متجاوزة كل محاولات التسلق والاستفادة والمصالح التي كان يحملها دعاة الإصلاح حينها، وكانت كثيرة تلك الدعوات الإصلاحية، لكنها رغم كثرتها كانت مثقلة بغايات إما شخصية أو دينية أو بمصالح ذاتية بعيدة عن النهوض بوعي الجمهور، بل عمدت إلى تكريس عملية نكوص الوعي لصالح هيمنتها تحت شعاراتها الدينية والإصلاحية.
لذلك كان تقديم النفوس في سبيل رفع الظلم عن الناس، ومنع تكريس مبدأ توارث السلطة وتكريس منهجها في استعباد الناس، وسبيل تحريرهم حتى من أنفسهم، هذا ما أحدث زلازل مازالت ارتداداتها مستمرة إلى الآن، وملهمة لكثير من الثوار والمصلحين، لأنها تسامت عن الذات وكل متعلقاتها بالسلطة والدنيا، وكرست بالفعل حقيقة الثورة ودلالاتها والإصلاح ومقوماته.
كانت النهضة الحسينية ومازالت المرجعية التي تصوب انحراف المفاهيم، وتعيد إحياء القيم والمعايير الإلهية، وتحيي فكرة المخلص المنشود لإقامة العدل، لكنه إحياء يوضح منهج الخلاص، ويحدد آليات التمهيد ومعالم الانتظار الصحيح، وتبني وعيًا ثوريًّا ناهضًا وناظرًا بعينه لأقصى القوم، وعاملًا بجد واجتهاد لتعبيد الطريق أمام كل مستضعف ومظلوم، والعمل الدؤوب للارتفاع بمستوى القابليات والوعي والإدراك لحقيقة الشريعة والدين، ولواقع وظيفة المأموم كي يحقق الإمامة بوجهها السليم الذي يؤدي المقصد في الدنيا ويوصل للهدف في الآخرة.
وحتى لا تتكرر مشهدية كربلاء الدموية بسبب الخذلان وانتكاسة الإرادة بسبب فقدان الوعي والتشويه المتراكم للمفاهيم الكبرى في الدين، والتغييب شبه كلي للحقيقة الإنسانية واستحضار الغريزة بكل أبعادها في النفس الإنسانية، فهناك اتصال بين نهضة الحسين (ع) وظهور المخلص المقيم للعدل، اتصال عضوي ووظيفي، وبناء الجسر بين الحقبتين – حقبة النهضة الحسينية والظهور- هي وظيفتنا شريطة اقترانه بالوعي وإدراك الحقيقة بعيدًا عن كل الغرائز بما فيها الغرائز المذهبية.
فالنهضة الحسينية هي المقدمة الواجبة التي إن أدركنا أبعادها ومقاصدها استطعنا العبور منها وبها إلى الهدف، وتحقيق مقومات الظهور ليكون انتظارنا على أسس سليمة أهمها زوال كل أنواع الحرج النفسي من قبول الحقيقة التي سيطرحها الإمام المهدي (ع)، فحقيقة ما طرحه الحسين (ع) في نهضته لم تسعها حتى النفوس الموالية له، فكانت النتيجة أن شخصيات شيعية كبيرة سقطت في امتحان معرفة حقيقة الإمام ووجوب طاعته والتسليم له، وهو تشويه متراكم عبر الزمن في معرفة وظيفة المأموم وحقيقة وظيفة الإمام نتيجة تغييب الأئمة عن ممارسة دورهم الاستخلافي، وبسبب محاولات حثيثة لتشويه العلاقة بين الإمام وأتباعه، فأدى ذلك بعدد كبير من الشيعة إلى خذلان الإمام وعدم طاعته بشكل كلي وقطعي دون نقاش أو حرج نفسي لقراره في المواجهة، وهو ما أدركه كثير منهم بعد استشهاد الإمام بشكل بشع، فرصدت بعد واقعة كربلاء ٥٠ ثورة للعلويين والشيعة، هذا فضلًا عن ملء السجون والقبور منهم.
فالوعي واتساع القابليات وإدراك الوظيفة المناطة بالمأموم شروط لازمة لتحقيق النهضة الكبرى، وإقامة العدالة التي هي هدف رئيسي عبر التاريخ لكل الأنبياء والرسل والأوصياء والصالحين. فالإمام الحسين عليه السلام طرح منهجًا لم يعتده المسلمون والشيعة خاصة في ذلك الزمان، حتى أخوه ابن الحنفية اعترض على خروجه، بل هناك شخصيات كوفية شيعية كبيرة وكان لها دور بارز في خوض معارك الإمام علي كافة، لكنها لم تخرج لنصرة الإمام الحسين (ع) لحرج نفسي في تقبل حقيقة الإمام وحقّه فخذلته.
وينقل في الأثر أن الإمام المنتظر (عج) سيأتي بدين جديد، فإن كان واقعنا يعكس عنفًا في مواجهة كل ما هو مخالف للمشهور والمألوف علميًّا وفقهيًّا أو على مستوى الآراء المتعلقة بالدين والاجتماع والسياسة، فكيف سنواجه ما سيطرحه الإمام المنتظر (عج) سواء على مستوى المنهج أو على مستوى الحقائق؟ وكيف سيكون تفاعلنا مع رسالته وما سيطرحه؟ وما هو مدى طاعتنا له دون حرج نفسي كإمام معصوم مفترض الطاعة؟ وهي أسئلة يمكن استلهامها من واقعة كربلاء وتداعياتها سواء من قبل عموم الناس أو خواصهم من الموالين للإمام. هي أسئلة رهن المؤسسات الدينية والأحزاب والتيارات السياسية والدينية، ورهن كل الرموز والقداسات التي صنعتها عقولنا أو أوهامنا.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 شتّان بين المؤمن والكافر
شتّان بين المؤمن والكافر
الشيخ جعفر السبحاني
-
 معنى (عول) في القرآن الكريم
معنى (عول) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 فاطمة الزهراء (ع) تجلٍّ للرحمة الإلهيّة المحمّديّة
فاطمة الزهراء (ع) تجلٍّ للرحمة الإلهيّة المحمّديّة
الشيخ شفيق جرادي
-
 المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (2)
المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (2)
إيمان شمس الدين
-
 (التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها
(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها
عدنان الحاجي
-
 الموعظة بالتاريخ
الموعظة بالتاريخ
الشيخ محمد مهدي شمس الدين
-
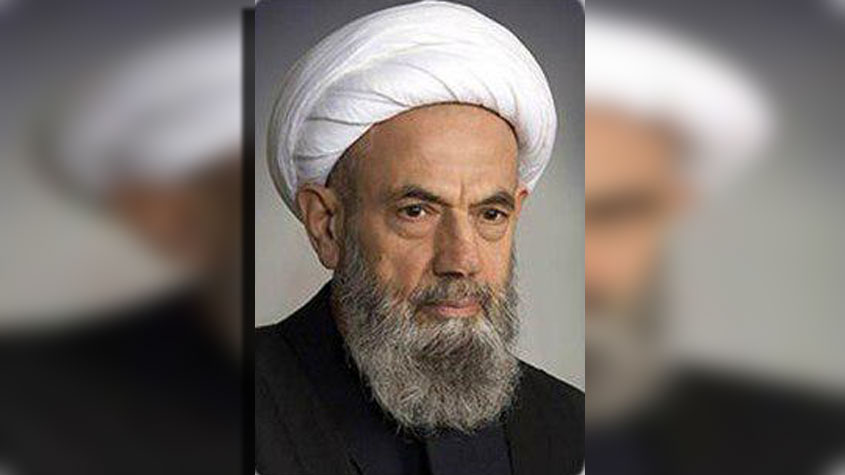 كلام عن إصابة العين (1)
كلام عن إصابة العين (1)
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)
الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)
الدكتور محمد حسين علي الصغير
-
 صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)
صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)
محمود حيدر
-
 مجلس أخلاق
مجلس أخلاق
الشيخ حسين مظاهري
الشعراء
-
 السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى
السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى
حسين حسن آل جامع
-
 الصّاعدون كثيرًا
الصّاعدون كثيرًا
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-

لـمّا استراح النّدى
-

شتّان بين المؤمن والكافر
-
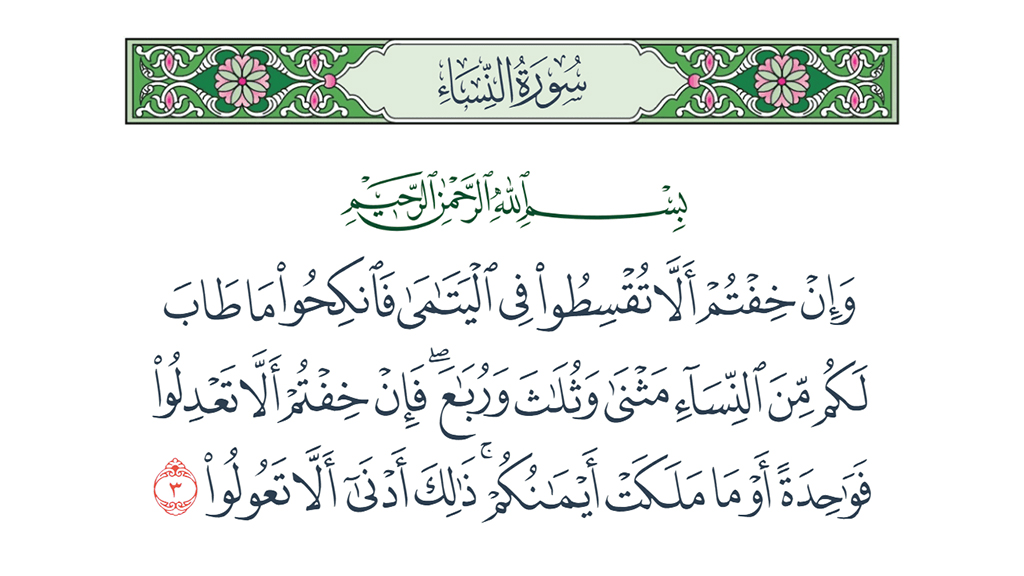
معنى (عول) في القرآن الكريم
-
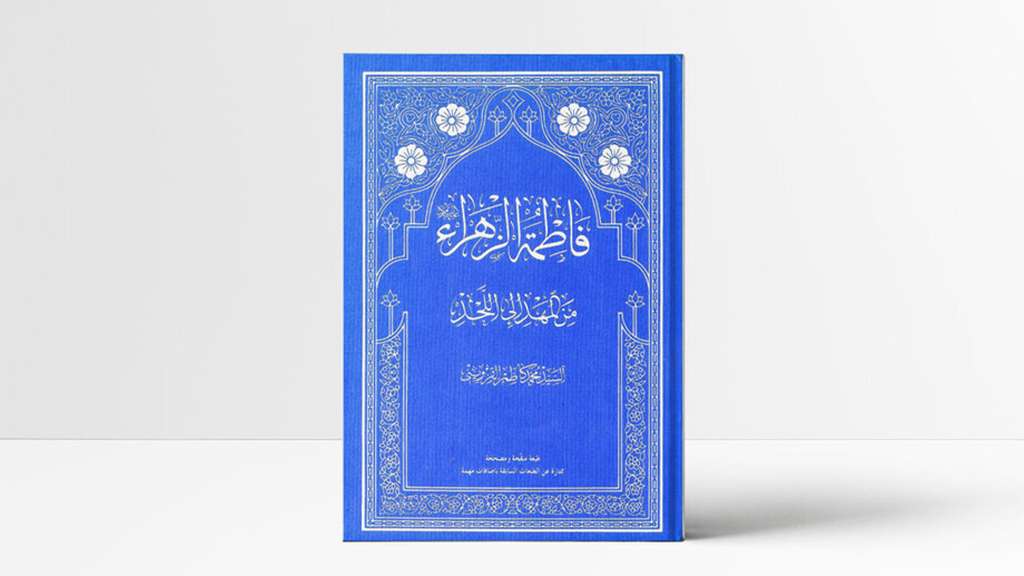
فاطمة الزهراء عليها السلام من المهد إلى اللّحد
-

السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى
-

فاطمة الزهراء (ع) تجلٍّ للرحمة الإلهيّة المحمّديّة
-

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (2)
-

من كنوز الغيب
-

(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها
-

معنى (ملأ) في القرآن الكريم









