مقالات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد محمد باقر الصدرعن الكاتب :
ولد في مدينة الكاظمية المقدسة في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 1353 هـ، تعلم القراءة والكتابة وتلقى جانباً من الدراسة في مدارس منتدى النشر الابتدائية، في مدينة الكاظمية المقدسة وهو صغير السن وكان موضع إعجاب الأساتذة والطلاب لشدة ذكائه ونبوغه المبكر، ولهذا درس أكثر كتب السطوح العالية دون أستاذ.rnبدأ بدراسة المنطق وهو في سن الحادية عشرة من عمره، وفي نفس الفترة كتب رسالة في المنطق، وكانت له بعض الإشكالات على الكتب المنطقية. بداية الثانية عشرة من عمره بدأ بدراسة كتاب معالم الأصول عند أخيه السيد إسماعيل الصدر، سنة 1365 هـ هاجر إلى النجف الاشرف، لإكمال دراسته، وتتلمذ عند آية الله الشيخ محمد رضا آل ياسين وآية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي. أنهى دراسته الفقهية عام 1379 هـ والأصولية عام 1378 هـ عند آية الله السيد الخوئي.rnمن مؤلفاته: فدك في التاريخ، دروس في علم الأصول، نشأة التشيع والشيعة، فلسفتنا، اقتصادنا وغير ذلك.حاجتنا إلى النظام الإسلامي خاصّة

وهو يعدّ حاجة ضروريّة لنا بوصفنا مسلمين، وذلك:
أوّلًا: لإيجاد الانسجام بين التشريع والعقيدة، فإنّ مردّ النظام الإسلامي إلى أحكام الشريعة الإسلاميّة، وهي أحكام يؤمن المسلمون بقدسيّتها وحرمتها ووجوب تنفيذها بحكم عقيدتهم الإسلاميّة وإيمانهم بأنّ الإسلام دين نزل من السماء وعلى خاتم النبيّين صلى الله عليه وآله، وعلى عكس ذلك الأنظمة والتشريعات الأخرى، فإنّها في نظر المسلمين، وبحكم عقيدتهم لا تحتوي على الحرمة والقدسيّة ولا يوجد أيّ مبرّر شرعي لها، وما من ريب في أنّ من أهمّ العوامل في نجاح القوانين والتشريعات التي تتّخذ لتنظيم الحياة الاجتماعيّة احترام الناس لها، وتجاوبهم العاطفي والنفسي مع أهدافها، وإيمانهم بحقّها في التنفيذ والتطبيق، وهذا ما لا يتوفّر للمسلمين إلّا بالنسبة إلى أحكام الشريعة الإسلاميّة والنظام الإسلامي.
وثانيًا: لإيجاد التوافق بين الجانب الروحي والجانب الاجتماعي من حياة الإنسان المسلم، وذلك أنّ الأنظمة الاجتماعيّة الأخرى غير الإسلام لا تعالج إلّا جانب العلاقات الاجتماعيّة من حياة الإنسان، تاركة - على الأغلب - الجانب الروحي الذي يشمل علاقة الإنسان بربّه وتنميته لإرادته وأخلاقه ومُثُله، فإذا أخذنا تشريعاتنا للحياة الاجتماعيّة ونظامها من مصادر بشريّة بدلًا عن النظام الإسلامي، لم نستطع أن نكتفِ بذلك عن تنظيم آخر، أي الجانب الروحي منه، ولا يوجد مصدر صالح لتنظيم حياتنا الروحيّة إلّا الإسلام، ولأجل ذلك ينشأ التناقض حينئذٍ بين طريقة تنظيم حياتنا الروحيّة المستمدّة من الإسلام، وطريقة القوانين الوضعيّة في تنظيم الحياة الاجتماعيّة؛ لأنّ الطريقتين مختلفتان ومتعارضتان في أسسهما وقواعدهما، مع أنّ الحياة الروحيّة والحياة الاجتماعيّة متفاعلتان.
ونتيجة ذلك أن يسود القلق ويتأرجح الفرد المسلم بين التيّار الروحي والتيّار الاجتماعي، ويعيش في حالة تناقض بين المصادر التي يستلهمها في تنظيم حياته الروحيّة، والمصادر التي تنظّم حياته الاجتماعيّة. وعلى العكس من ذلك كلّه، إذا اتّخذنا الإسلام قاعدة للتنظيم والتشريع في مختلف شؤون الحياة الروحيّة والاجتماعيّة، فإنّنا بذلك نبني حياتنا كلّها على أساس قاعدة واحدة وهي الإسلام، بدلًا عن قاعدتين متنافرتين.
وثالثًا: إنّ تبنّي الأمّة للنظام الإسلامي المرتبط بعقيدتها وتاريخها بدلًا من الأنظمة والمذاهب الاجتماعيّة الأخرى، يساهم بدرجة كبيرة في المعركة التي تخوضها الأمّة ضدّ الكافر المستعمر منذ غزا العالم الإسلامي بجيوشه العسكريّة والفكريّة؛ لأنّه يحرّرها من التبعيّة الفكريّة لمذاهب المستعمرين أنفسهم، ويؤكّد للأمّة شخصيّتها العقائديّة الخاصّة، ووجودها المتميّز، ويقضي على كلّ أنواع الأفكار التي نشرها الكافر المستعمر بقصد إعاقة حركات التحرّر في العالم الإسلامي.
ومن ناحية أخرى إنّ شعور الأمّة الإسلاميّة بأنّ النظام الإسلامي مرتبط بتاريخها وأمجادها، ومعبّر عن أصالتها، ومنقطع الصلة تاريخيًّا وفكريًّا بحضارات المستعمرين، يجعل ضمير الفرد الشرقي المستعمَر منفتحًا عليه، بينما ينكمش تجاه الأنظمة المستمدّة من الأوضاع الاجتماعيّة في بلاد المستعمرين ويعيش حسّاسيّة شديدة ضدّها، وهذه الحسّاسيّة تجعل تلك الأنظمة - حتّى ولو كانت صالحة ومستقلّة عن الاستعمار من الناحية السياسيّة - غير قادرة على تفجير طاقات الأمّة وقيادتها في معركة البناء، فلا بدّ للأمّة إذن - بحكم ظروفها النفسيّة التي خلقها عصر الاستعمار وانكماشها تجاه ما يتّصل به - من إقامة نهضتها الحديثة على أساس نظام اجتماعي ومعالم حضاريّة لا تمتّ إلى بلاد المستعمرين بنسب.
وهذه الحقيقة الواضحة هي التي جعلت عددًا من التكتّلات السياسيّة في العالم الإسلامي ترتدّ في بعض الأحيان إلى فكرة متخلّفة ذهبت مرحلتها التاريخيّة، وهي اتّخاذ القوميّة نفسها فلسفة وقاعدة للحضارة، وأساسًا للتنظيم الاجتماعي حرصًا منهم على تقديم شعارات منفصلة عن الكيان الفكري للاستعمار انفصالًا كاملًا، غير أنّ القوميّة في الحقيقة ليست إلّا عبارة عن انتماء الفرد إلى مجتمع معيّن له تاريخه ولغته وليست فلسفة ذات مبادئ، ولا عقيدة ذات أسس، ولا تعني رأسماليّة ولا اشتراكيّة ولا ديمقراطيّة ولا دكتاتوريّة ولا كفرًا ولا إيمانًا، بل هي بحاجة إلى الأخذ بوجهة نظر معيّنة تجاه الكون والحياة، وفلسفة خاصّة تصوغ على أساسها معالم حضارتها ونهضتها وتنظيمها الاجتماعي.
ويبدو أنّ كثيرًا من الحركات القوميّة أحسّت بذلك أيضًا وأدركت أنّ القوميّة كمادّة خام بحاجة إلى الأخذ بفلسفة اجتماعيّة ونظام اجتماعي معيّن، وحاولت أن توفّق بين ذلك وبين أصالة الشعار الذي ترفعه، فنادت بالاشتراكيّة العربيّة، نادت بالاشتراكيّة؛ لأنّها أدركت أنّ القوميّة وحدها لا تكفي، بل هي بحاجة إلى نظامٍ ونادت بها في إطار عربي تفاديًا لحسّاسيّة الأمّة ضدّ أيّ ستار أو فلسفة مرتبطين بعالم المستعمرين، فحاولت عن طريق توصيف الاشتراكيّة بالعربية تغطية الواقع الأجنبي المتمثّل في الاشتراكيّة من الناحية التاريخيّة والفكريّة، وهي تغطية كشفتها حسّاسيّة الأمّة التي تحدّثنا عنها؛ لأنّ هذا الإطار القلق ليس إلّا مجرّد تأطير ظاهري وشكلي للمضمون الأجنبي الذي تمثّله الاشتراكيّة.
وإلّا فأيّ دور يلعبه هذا الإطار في مجال التنظيم الاشتراكي؟ وأيّ تطوير للعامل العربي في الموقف؟ وما معنى أنّ العربيّة كلغة وتاريخ تطوّر فلسفة معيّنة للتنظيم الاجتماعي؟ بل كلّ ما وقع في المجال التطبيقي نتيجة للعامل العربي، إنّ هذا العامل أصبح يعني في مجال التطبيق استثناء ما يتنافى من الاشتراكيّة مع التقاليد السائدة في المجتمع العربي والتي لم تحثّهم الظروف الموضوعيّة لتغييرها، كالنزعات الروحيّة بما فيها الإيمان باللَّه. فالإطار العربي، إذن لا يعطي الاشتراكيّة روحًا جديدة تختلف عن وصفها الفكري والعقائدي المعاش في بلاد المستعمرين، وإنّما يراد به التعبير عن استثناءات معيّنة وقد تكون موقوتة، والاستثناء لا يغيّر جوهر القضيّة والمحتوى الحقيقي للشعار.
ولا يمكن لدعاة الاشتراكيّة العربيّة أن يميّزوا الفوارق الأصليّة بين اشتراكيّة عربيّة، واشتراكيّة فارسيّة واشتراكيّة تركيّة، ولا أن يفسّروا كيف تختلف الاشتراكيّة بمجرّد إعطائها هذا الإطار القومي أو ذاك؛ لأنّ الواقع أنّ المضمون والجوهر لا يختلف، وإنّما هذه الأطر تعبّر عن استثناءات قد تختلف من شعب إلى آخر لنوعيّة التقاليد السائدة في الشعوب.
وبالرغم من أنّ دعاة الاشتراكيّة قد فشلوا في تقديم مضمون حقيقي جديد لهذه الاشتراكيّة عن طريق تأطيرها بالإطار العربي، فإنّهم أكّدوا بموقفهم هذا تلك الحقيقة التي قلناها، وهي أنّ الأمّة بحكم حسّاسيّتها الناتجة عن عصر الاستعمار لا يمكن بناء نهضتها الحديثة إلّا على أساس قاعدة أصيلة لا ترتبط في ذهن الأمّة ببلاد المستعمرين أنفسهم، ولا توجد هذه القاعدة إلّا في الإسلام نفسه، فالإسلام كقاعدة للنهضة الجديدة، والنظام الإسلامي كصياغة لهذه النهضة هو الطريق الوحيد الذي يمكن للأمّة أن تتفتّح عليه، ولا تشمّ منه رائحة الخطر ولا تتبيّن فيه أصابع أولئك الذين داسوا كرامتها واستعمروها.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 نشر الخلق الحسن فلسفة نبويّة
نشر الخلق الحسن فلسفة نبويّة
السيد عادل العلوي
-
 هل نملك تاريخاً؟!
هل نملك تاريخاً؟!
السيد جعفر مرتضى
-
 الاقتصاد بين الإسراف والتقتير
الاقتصاد بين الإسراف والتقتير
الشيخ جعفر السبحاني
-
 علوم مختّصة بالله
علوم مختّصة بالله
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 ما سوى الله تعالى حجاب
ما سوى الله تعالى حجاب
السيد محمد حسين الطهراني
-
 ما هي أولويات التمهيد؟
ما هي أولويات التمهيد؟
السيد عباس نور الدين
-
 الكفر والفسق والظلم
الكفر والفسق والظلم
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 معنى (حرى) في القرآن الكريم
معنى (حرى) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 الأسرة بين العفاف والخيانة الزوجية
الأسرة بين العفاف والخيانة الزوجية
الشيخ فوزي آل سيف
-
 هل لأحدٍ حقٌّ على الله؟
هل لأحدٍ حقٌّ على الله؟
الشيخ محمد صنقور
الشعراء
-
 السيّدة المعصومة: ملتقى الجمال والجلال
السيّدة المعصومة: ملتقى الجمال والجلال
حسين حسن آل جامع
-
 على غالق
على غالق
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-

أمسية لنادي صوت المجاز حول جماليّات السّرد وتحوّلات الرّواية في الخليج العربيّ
-

لأول مرة يتم كشف بنية وخلل بروتين باركنسون
-

نشر الخلق الحسن فلسفة نبويّة
-

هل نملك تاريخاً؟!
-

الاقتصاد بين الإسراف والتقتير
-
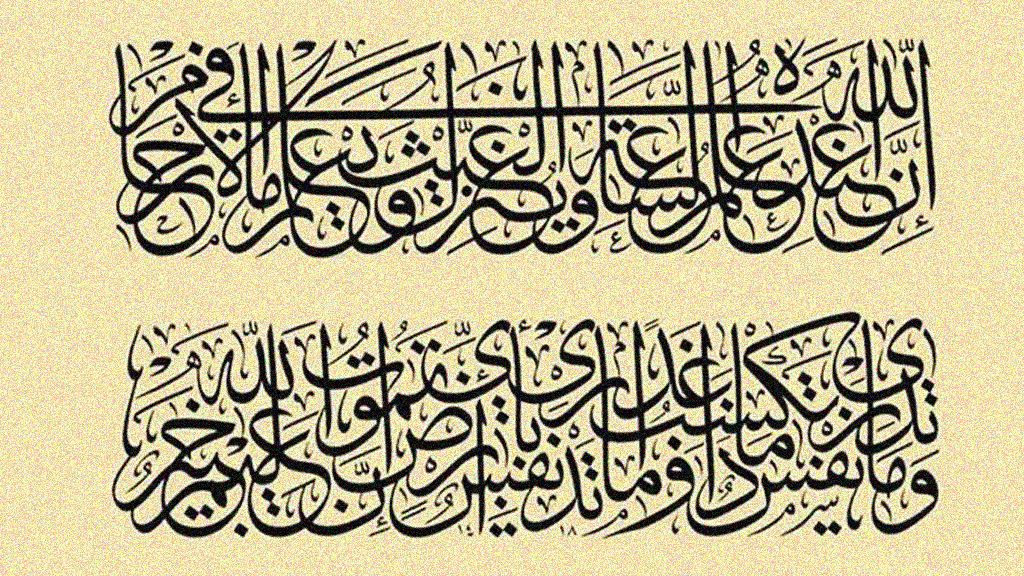
علوم مختّصة بالله
-
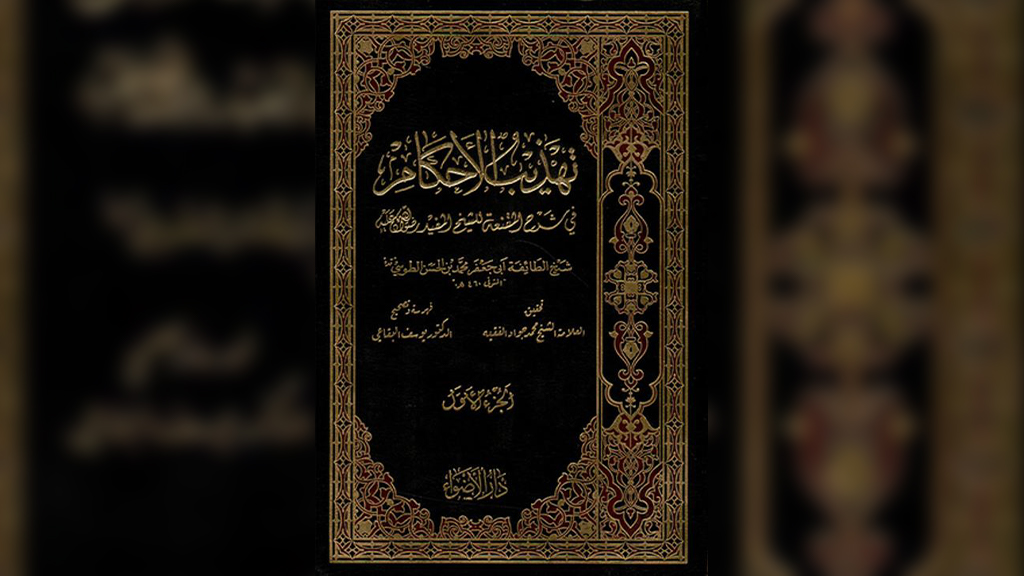
(تهذيبُ الأحكام) لشيخ الطّائفة، أبي جعفر الطّوسيّ
-

(التجربة الرّوائيّة بين الرجل والمرأة) أمسية أدبيّة في الدمّام
-

قشرة الأرض تخفي احتياطيات هائلة من الهيدروجين
-

ما سوى الله تعالى حجاب










