علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقا بَعدية (2)

معضلة الجحود بالألوهة
لم تكن مباني فلسفة الدين وفرضيَّاتها بمنأى من مشاغل الوضعانيَّة على اختلاف تيَّاراتها الإلحاديَّة ومذاهبها الفلسفيَّة ونزعاتها الأيديولوجيَّة. لقد تلاقت هذه جميعًا على جملة قواعد: أبرزها، أنَّ الكون نشأ من تلقاء نفسه ومن دون الحاجة إلى صانع، وأنَّ الحياة ظهرت ذاتيًّا من المادَّة عن طريق قوانين الطبيعة، وأنَّ الفرق بين الحياة والموت هو فرق فيزيائيٌّ بحت، وأنَّ الإنسان ليس غير جسد مادّيٍّ، يفنى تمامًا بالموت.
سوى أنَّ هذه القواعد – التي باتت لدى أصحابها مثابة نظريَّة معرفة – ستدخل دخولًا بيِّنًا في الهندسة المعرفيَّة الأصليَّة لفلسفة الدين. وهكذا ستجد منفسحًا تنظيريًّا خصبًا لرواجها في القرن التاسع عشر من تاريخ أوروبا الحديثة. ففي العام 1841، وبعد مرور عشر سنوات على وفاة هيغل، نشر الألمانيُّ لودفيغ فويرباخ Ludwig Feuerbach كتابه المشهور “جوهر المسيحيَّة”، ثمَّ ما لبث أن ألحقه بكتاب “جوهر الدين”. ومع أنَّ السجال لم يتوقَّف حول ما إذا كان فيورباخ ملحدًا أم لا، إلَّا أن النتائج العامة المترتبة على نظرياته أسهمت في رفد الإلحاد، وعزَّزت من شيوع ثقافة الدين الطبيعي. الذين استقرأوا السيرة الشخصيَّة لفيورباخ قرَّروا غير ذلك. فهو عندهم لم يكن منكرًا للدين ولو من زاوية النظر إليه كضرورة ملازمة للطبيعة البشرية، والدليل على هذا قولُه: إنَّ الإنسان حيوان متديِّنٌ بماهيَّته، وإنَّ الدين هو الأساس في الفصل الماهويِّ بين الإنسان والحيوان.
يُستنتج من قول كهذا أنّ هدف فويرباخ في المطاف الأخير هو تدمير كلِّ المعارف المعتبرة “فوق الطبيعيَّة” supernaturalism. ولقد سعى لتحقيق هذا الهدف من خلال إقناع الإنسان بأنَّه هو الحقيقة السامية، وعليه ألَّا يبحث عن السعادة خارج ذاته، بل في نفسه، لأنَّه عندما يكون هو المطلق بالنسبة إلى نفسه، فسوف يفقد كلَّ الرغبات فوق الطبيعيَّة، والذي لا يبقى لديه رغبات فوق طبيعيَّة لا يكون لديه كائن فوق طبيعيٍّ كذلك. ورغم موقفــه الحـادِّ من الدين ظلَّ فيورباخ شغوفًـا بدراسته بعمق، إلى الحدِّ الذي مضى فيه إلى صريح التعبــير بأنَّ العناية المعرفيَّة بالدين هو أوجب واجبات الفلسفة.
L. Feuerbach, The Essence of Christianity, trans, by M vans, New York, 1855; Chap. I, pp. 21- 22.
هذا هو الشيء الذي التَفَتَ إليه نيقولا بريائيف (N. Berdyaev) ليبيِّن أنَّ الفلسفة الحديثة عامَّة والفلسفة الألمانيَّة على وجه الخصوص، هي أشدُّ مسيحيَّة في جوهرها من فلسفة العصر الوسيط، وذلك بسبب موضوعاتها الرئيسيَّة وطبيعة تفكيرها، الأمر الذي يشي بوضوح أنَّ المسيحيَّة نفذت إلى ماهيَّة الفكر نفسه منذ فجر العصور الحديثة.
لكن الوضعانيَّة التي قدّستها الحداثة، سوف تطوي فلسفة الدين تحت أجنحتها لتوظف نُسُقِها المعرفية في تقويض الإيمان المسيحي. وهكذا راحت تنتج من خلالها شبكة معقدة من النظريَّات المتداخلة مؤدَّاها: أنَّ العالم الدينيَّ القائم على الخوارق هو عالم وهميٌّ لأنَّه يسلب الجوهر الإنسانيَّ من الإنسان لأجل الله. وأنَّ فكرة الإله مجرَّد إسقاطٍ أجراه العقل البشريُّ على نفسه من أجل أن يعثر على حلٍّ آمن لسرِّ وجوده.
لقد جاءت أطروحة فيورباخ لتختزل القضيَّة بعبارات وافية، وهي أنَّ الفهم الأساسيَّ والأولي للدين يتلخَّص في كون “الأنثروبولوجيّ هو سرُّ الَّلاهوت”، وأنَّ جوهر وحقيقة الدين ومعناه الباطنيَّ العميق هو الجوهر الإنسانيّ. فالدين عنده له مضمون خاصٌّ في ذاته، أي أنَّ معرفة الله هي معرفة الإنسان بذاته التي لم تعِ ذاتها بعد. والوعي بالدين هو الوعي الأول وغير المباشر للإنسان، وهو الوسيلة التي يتَّخذها الموجود البشريُّ في البحث عن نفسه. والنتيجة التي ينتهي إليها، أنَّ كلَّ صفات الجوهر الإلهيّ هي صفات لجوهر الإنسان في أقصى درجات كمالها، وأنَّ الروح الإلهيَّة التي ندركها أو نعتقد بها هي نفسها الروح المدرِكة.
على التأسيس الذي مرَّ معنا، ستنشأ حقولٌ معرفيَّة تفرَّعت من فلسفة الدين، وقامت على منطقها، أهمُّها اثنان شكَّلا سحابة قرن ويزيد، مساحة احتدام لم تهدأ ضوضاؤها بين التيَّارين العلمانيِّ والَّلاهوتيِّ وهما حقل “التجربة الدينيَّة”، وحقل “التعدُّديَّة الدينيَّة”.
حقل التجربة الدينيّة
لدى الحديث عن التجربة الدينيَّة، ترِدُ إلى الأذهان سلسلة من الاستفهامات حول طبيعة المشاعر والأحاسيس والأحوال الروحيَّة التي يختبرها المتديّن. حلُّ الأجوبة على هذه الاستفهامات تُظهِرُ على نحو البداهة التلقائيَّة، أنَّ الاعتقاد بوحدانيَّة الله هي الوجهة القصوى التي يتطلَّع إليها المتديِّن والتي تشكِّل جوهر تجربته الدينيَّة. فلكي يُفهم الإيمان بالأمر الغيبيِّ على ما هو عليه في حقيقته، لا بدَّ من أن يُعاش. ومقتضى عيشه أن تكونَه. كأنْ تنظر إلى قداسته بالرضا والتسليم، ثمَّ أن تتعقَّل ما أنت فيه ليكون فهمك له حاصل نظر وعمل.
أما “الميثاق الروحيّ” الذي ينبغي أن يُبرم مع المقدَّس فإنه يوجب عليك الاستعداد للقاءٍ لم تعهده من قبل. فسيكون على الداخل في الاختبار أن يتهيَّأ لحوار لا يدور إلَّا على نحو شخصيّ. فلا تقبل الحضرة القدسيَّة حوارًا مع المقبل إليها، إلا أن يأتيها فردًا رغم كثرة المقبلين. فلكلِّ فردٍ سبيل إليها، ولا ينالها – إلَّا من وقف – وقوفًا ما – على سرِّها. فمن خَلُصت نيَّتُه انفتح له باب السرّ، ودخل الحضرة بيُسْر. حتى إذا دنا من مقصوده راح يتوسَّلُه بلطف المحاورة. أمَّا علامة القبول، فشعورٌ بالأمان وإحساس باليقين. في هذه اللحظة التي عُرفت عند الصوفية بـ “لحظة التجلِّي” يحدثُ ضربٌ من انخطافٍ روحيٍّ لا يتوفَّر عليها سوى الذي يعيشها بالفعل. فقد تواصل سرُّ الفرد مع سرِّ الألوهيَّة، حتى ليُمسِيا على صراط واحد. ومثل هذا التجلّي لا يُحصَّل إلَّا في الفضاء الرحب للإيمان الأعلى، الذي منه يولد المقدَّس وفي لحظته تشرق شمس الألوهيَّة.
كان عالم الأنثروبولوجيا ومؤرِّخ الأديان ميرسيا إلياد، ينفي أن يكون المقدَّس مجرَّد مرحلة من مراحل الوعي البشريِّ، بل يعتبره عنصرًا مكوِّنًا لبنية هذا الوعي. وأكثر من هذا فإنَّه يعتبر وجود العالم حصيلة جدليَّة لتجلّي المقدَّس وظهوره. وكان يلاحظ أنَّ أقدم صورة لعلاقة الإنسان بعالمه هي تلك العلاقة المشبعة بالمقدَّس حيث يفيض هذا المقدَّس بمعانيه على مكان الإنسان، وحيث تكون ممارسته له في حدِّ ذاته عملًا دينيًّا.
M. Eliade La Nostalgie des origins: Méthodologie et histoire des religions, ed Gallimard, Paris 1971. P 7.
خاصّية هذا التأصيل الجوهريُّ لمكانة المقدَّس في الحياة البشريَّة، تبيينُها أنَّ الإنسان – بوصفه إنسانًا – هو كائن دينيّ. وإذا كان الإنسان لا يستطيع العيش إلَّا في عالم ذي معنى، فالإنسان المتديِّن على وجه الخصوص، هو الأكثر توقًا إلى العيش في محاريب القدسيِّ، أو إلى الهجرة نحوها بلا كلل. وما ذاك إلَّا لأنَّ هذا العالم المتسامي الذي يستمدُّ جاذبيَّته من الغيب، هو بالنسبة إلى المتديِّن عالمه الواقعيٌّ والحقيقيّ، وهو الذي يمنحه الأمل بالآتي، وبالسعادة التي لم تأتِه بعد. ولأنَّه لا يجد نفسه إلَّا في محلٍّ ممتلئ بجلال المقدَّس، فقد شاء أن يفتتح سبيلًا إلى السكن في رحاب الألوهيَّة الفائضة بالُّلطف والأمان ولذَّة القرب. ذلك بأنه يرجو الخاتمة في المكان الأعلى طهرًا وتقدُّسًا، مثلما كان من قبل أن يكون: كائنًا طهرانيًّا في علم الله وحضرته المقدَّسة. في هذا السياق يلاحظ علماء اجتماع الأديان أنَّ تجربة الإحساس بالقداسة لدى الأفراد والجماعات تأسَّست على عدم انفصال الرُّموز لديهم عن الحقيقة التي تدلُّ عليها تلك الرموز. من أجل ذلك توفَّرت للرمز الدينيِّ القدرة على إدخال العابدين في مختبر القداسة..
ولم يكن من أحد على مرِّ التاريخ، يستطيع أن يخبر عن كشوفات هذا المطرح المدهش بصورة مباشرة، اللهمّ إلَّا عدد بالغ الضآلة من الأفذاذ، فكان على الإنسان أن يدركها من خلال شيء آخر، وكان الناس مثلًا يخبرون القداسة من خلال إنسان ما، أو أرض مقدَّسة، وكان المكان من رموز القداسة الأولى وأكثرها انتشارًا. ويشير هؤلاء إلى أنَّ الطقوس التي يؤدّيها الناس في المكان المقدَّس، إنَّما هي صورة أخرى من صور محاكاة الألوهيَّة والدخول إلى عالم الوجود الأكمل. وهذه الصورة تكتسب أهميَّة أساسيَّة لفهم قداسة المزار أو أيِّ مدينة مقدَّسة، لأنَّه ينظر إليهما كنظير لأصل سماويٍّ؛ فإذا قام الإنسان بمحاكاة الصورة السماويَّة القديمة للمعبد فلربما استطاع أن يحيل المعبد بيتًا للربِّ هنا على الأرض. (كارين آرمسترونغ – القدس مدينة واحدة – إشراف: راغب السرجاني – نقلًا عن موقع قصة الإسلام- ص 30-31).
في الجغرافيا الثقافيَّة الدينيَّة لحداثة الغرب، كانت ثنائيَّة المقدَّس والدنيويِّ تُعرَّف بأنَّها السمة الأساسيَّة للأديان، وأنَّ “الأديان نسقٌ موحَّدٌ من المعتقدات والممارسات ذات الصلة بأشياء مقدَّسة أو بأشياءٍ حُرم أو محرَّمة”. وإذا رجعنا إلى لغتنا العربيَّة فنجد أنَّ القداسة تعني الطهر والبركة، وإذا نسبت إلى الله فهي الكمال الإلهيُّ الكلّيُّ والتنزُّه عن الموجودات، أي الانفصال عن عالم الطبيعة والمادَّة، ومن هنا مقابلتها بالدنيويِّ والدهريِّ والفاني، فيقال إنَّ المقدَّس هو من الحرام الذي لا يمكن انتهاكه أو الخروج عليه، فالشيء المقدّس يكتسب قداسته من ارتباطه أو صلته بمصدر القداسة، كما أنَّ درجة قداسته تتحدَّد بمدى القرب أو البعد عن المصدر القدسيّ.
فالله هو المقدَّس الصمديُّ والمطلق، وهناك مقدَّسات نسبيَّة تكتسب قداستها من صلتها به وليس من ذاتها. ومن المفيد عند هذا الموضع، الإلفات إلى جملة دواعٍ تؤلِّف معًا خطوطًا هادية للتعرُّف إلى هذا الحقل: أولها، ما يفترضه المنشأ الجيو- حضاريِّ الغربيِّ الذي ولدت فيه.. ثانيها: نظريَّة المعرفة التي اعتُمدت من أجل مقاربة التديُّن كموضوع للبحث،.. ثالثها، الالتباسات الكثيفة التي ظلَّلت المفهوم، وما ترتَّب على تلك الأضلّة من سوء.. أمَّا رابعها، فمفاده أنَّ التجربة الدينيَّة غالبًا ما أُخِذت في مجتمعاتنا العلميَّة والثقافيَّة كمقولة معياريَّة محايدة، تمامًا كما يحصل في العادة من إسقاطات مفاهيميَّة في معرض الانشغال بفلسفة الدين أو بعلم اجتماع التديُّن.
بناءً على هذا، لا تنفصل نظريَّات التجربة الدينيَّة عن حزمة المفاهيم التي اكتظَّ بها تاريخ الحداثة على مدى ستة قرون متَّصلة. فلاسفة الغرب الذي اشتغلوا عليها، لم يفارقوا فضاء النظر إلى الدين باعتباره ظاهرة “أرضانيَّة” منحكِمةً إلى ظروف المكان ومقتضيات الأوان. عند هؤلاء – كما سَلَفَت الإشارة – أن لا شيء يعوَّل عليه إلَّا ما ينالُه المنطق الوضعيُّ والعلوم التجريبيَّة بالإحاطة والفهم. من هذا النحو سنرى كيف انبسطت التجربة الدينيَّة على هَدْيِ تفكير يكتفي بمعاينتها وتنظيرها بما هي ظاهرة فرديَّة – أو جماعاتيَّة لا تُستقرأ إلَّا بمنهجية سوسيو- تاريخيَّة.
هذه الدربة من التفكير سوف تختزِلُ ميراث الحداثة كلَّه. وسنرى كيف أنَّ وقائعها الأولى سَرَتْ في تاريخ فلسفة الدين منذ اللحظة التي انقلب فيها “التنوير” على مسيحيَّة القرون الوسطى. وقتذاك طفق التنويريون يشتغلون على منفسح آخر من التفكير لن يكون النظر في أثنائه إلى الإيمان الدينيِّ غير تهيُّؤات نفسانيَّة لأفراد متفرِّقين. وهكذا جرى التعامل مع الدين واختباراته تبعًا لمعايير الأنسنة المطلقة، الأمر الذي سيفضي إلى تنظير التجربة الدينيَّة بوصفها قضيَّة شخصيَّة متحوِّلة وغير مستقرَّة. وسيتبيَّن لنا كيف ستؤول مقولة التجربة الدينيَّة كمصطلح ومفهوم إلى أصلها الذي جاءت منه. فلقد ألقى هذا الأصل بظلِّه الثقيل عليها ليُسقِطَ قِيَمَه ومعاييره الكبرى، وعلى الأخصِّ منها تاريخانيَّة الدين وفينومينولوجيَّته، وما نجم عن هذين المعيارين من نظريَّات معرفة لا تفسِّر الدين إلَّا بوصفه فعلًا افترضته الحاجة إلى الخلاص الشخصيِّ سواء لدى الأفراد أم ما يخصُّ العصب الدينيَّ للجماعات.
أول ما يطالعنا من تداعيات هذه المعضلة أنَّ التنظيرات التي دارت في رحاب فلسفة الدين، لم تفلح في فهم الماهيَّة “المابعد- تاريخيَّة” للدين، ولذا تعذَّر عليها إدراك جوهره المتعالي. وإذ استشعرت عجزها عن استكشاف ما تنطوي عليه المعارف الوحيانيَّة، فقد حرصت على معاملتها كقضيَّة خادمة للوضعانيَّة بأشكالها ومذاهبها كافَّة. من هذا المنظر على وجه الخصوص، لم تكن فكرة التجربة الدينيَّة لدى الحداثات المتتالية سوى ثمرة تأويليَّة لما تنطوي عليه الخبرة الدينيَّة للأفراد والجماعات. فالخبرة بناء على هذا التفكير، إمَّا أنَّها وُلدَت من تلقاء نفسها، أي بسبب ظروف نفسانيَّة- مجتمعيَّة معيّنة، وبذلك تكون فاقدة لبعدها الوحيانيِّ، وإمَّا أن يُرى إليها كظهور تاريخيٍّ لعادات وطقوس وأعراف ذات جذور أسطوريَّة أو اعتقادات وثنيَّة. وفي الحالتين تظلُّ النتيجة هي هي.
فرغم إيلائها مكانة استثنائيَّة من البحث العلميِّ، ظلَّت التجارب والاختبارات الدينيَّة أسيرة الأحكام الكليَّة للعقل الوضعانيّ. من أظهر السمات التي نجمت عن دراسات التجربة الدينيَّة في الغرب، أنَّ هذه الأخيرة اتَّخذت سياقات متناقضة. فقد توسَّعت دائرة الاشتغال عليها إلى دوائر الهرمنيوطيقا واللاهوت. فرغم ما فعله التكيُّف المديد الذي أجرته الكاثوليكيَّة لصالح العلمنة، وكذلك ما فعله الإصلاح البروتستانتيُّ لجهة ما سُمّي بـ “الدين المدنيّ”، كان ثمَّة مطارحات جادَّة تنقض المقاربات العَلمانيَّة للدين.
ولقد بدت الصورة على الوجه التالي: تلقاء الرؤية الوضعانيَّة التي ملأت الحقل المعرفيَّ الأوروبيَّ بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كان ثمَّة في الوسطين الفلسفيِّ والَّلاهوتيِّ من أقام التجربة الدينيَّة على وجهين متلازمين: وجهٌ متصلٌ بسوسيولوجيا الحياة وتحيُّزاتها الثقافيَّة والحضاريَّة، ووجهٌ منوطٌ بالتطلُّع إلى معرفة الخالق المعتني بالإنسان والكون. فالتجربة بما هي تجربة تحتمل الصواب والخطأ أنَّى كان الحقل الذي تقع فيه. ومن البيِّن أنَّ فلاسفة الدين الذين اتَّخذوا لأعمالهم نسقًا مغايرًا للظواهريَّة، خاضوا سجالًا لم ينتهِ ضدَّ الذين يزعمون أنَّ “الحقَّ” غير معروف، ويبتنون على هذا الزعم بأنَّ الحقَّ غير موجود. ولقد تبيَّن أنَّ هذه البيئة المفارقة لم تتعدَّ نطاقاتها المحدودة الأثر، ولم تستطع – وبسبب من محدوديَّة تأثيرها – أن تُحدث خرقًا في الجدار السميك للوضعانيَّة وسلطانها العنيد. ومهما يكن من أمر، ثمَّة من فلاسفة الَّلاهوت في الغرب من ميَّز بين نموذجين في ميدان التجربة الدينيَّة:
ـ النموذج الكوزمولوجيّ، وينسبه إلى توما الأكوينيِّ، الذي يرى أنَّ الله موجود “هناك”، ولا يكون الوصول إليه إلَّا بعد عمليَّة استدلال خطيرة، أمَّا العثور عليه فشبيه بلقاء شخص غريب.
ـ النموذج الأنطولوجيُّ، ومفادُه أنَّ الله بالأصل حاضرٌ لنا من حيث هو أساس وجودنا، ولكنَّه في الآن عينه مفارق لنا إلى حدٍّ لا متناهٍ، وأنَّ وجودنا المتناهي هو حلقة متَّصلة ومستمرَّة للوجود اللامتناهي؛ وبالتالي فإنَّ معرفة الله تعني التغلُّب على اغترابنا عن أصل وجودنا. العقل الطبيعي بطبيعته العائدة إلى أصل نشأته يستطيع أن ينتقل من الغربة إلى الحضرة. ذلك بأنه يسلِّم بما يؤمن به حتى لو لم يكن ثمَّة كتاب مقدَّس. وما ذاك إلَّا لأنَّ البشر يجدون هذا المعتقد مكتوبًا في قلوبهم، ويعترفون به أنَّه قائم بالبرهان، حتى من دون رغبة منهم في ذلك.
حقل التعدُّديَّة الدينيَّة
كما هو الحال في التجربة الدينيَّة، كذلك هو في ما عُرِفَ بالتعدُّديَّة الدينيَّة. لقد أوضحت الاختبارات التنظيريَّة التي خاضها فيلسوف الدين البريطانيُّ جون هيغ (1922…) أنَّ أطروحة التعدُّديَّة الدينيَّة لم تكن خارج البيئة الفكريَّة المهيمنة على تفكير الغرب حيال الدين. فما أخرجه من تنظيراتٍ سيُدرج ضمن المسار الكلِّيِّ للعقلانيَّة الوضعانيَّة التي أنشأتها الحداثة، وحكمت على أساسها مناهج العلوم الإنسانيَّة كافَّة. ورغم التفسيرات المتعدِّدة والمتناقضة لأطروحاته، تبقى فكرة التعدُّديَّة الدينيَّة وليدة مناخٍ ثقافيٍّ وضعانيٍّ شديد الصرامة. ولهذا الدّاعي بدت الفكرة إيَّاها غير قادرة على الإحاطة أو التكيُّف مع ما هو مقدَّس أو فوق تاريخانيّ. ومع أنَّ الرجل زعم استظهار نظريَّته بمنهجيَّة التفكير المحايد، إلَّا أنَّ رؤيته للأمر القدسيِّ ظلَّت أسيرة حقلٍ معرفيٍّ أنثرو- فينومينولوجيٍّ ألقى بأعبائه على مجمل المعارف المتَّصلة بفلسفة الدين وعلم الاجتماع الدينيّ.
أخذ التيَّار التعدُّديُّ أخذ اليقين بما أسَّست له الحداثة من نظريَّات فلسفيَّة وسوسيولوجيَّة حيال الدين. سنجد أنَّ رائد هذا التيَّار، فضلًا عن أنَّه كان مسكونًا بنظريَّات فيورباخ الإقصائيَّة للجانب الوحيانيِّ للدين، كان من قبل ذلك مسحورًا بالنظريَّة الكانطيَّة في تقسيم الوجود إلى “نومين” (الشيء في ذاته حيث لا تبصره الأعين ولا تدركه الحواسّ)، و”فينومين” (الشيء كما يبدو لنا في الأعيان). ومثلما انصرف فلاسفة الحداثة إلى الإعراض عن الشيء في ذاته بذريعة استحالة إدراك ماهيَّته الذاتيَّة والبرهان عليه، جاءت النظريَّة التعدُّديَّة لتبني مجمل منظومتها على هذه الدربة، ثمَّ مضت إلى تقسيم الدين تبعًا لمنهج القطيعة بين بُعدَيه الوحيانيِّ والتاريخيِّ فيه.
كثيرون ممَّن تناولوا أطروحات هيغ وأتباعه بالنقد، ذهبوا إلى أنَّ فرضيَّاته ليست بريئة ولا تخلو من بواعث أيديولوجيَّة شاع أمرها تحت رعاية سلطة ثقافيَّة منكرة للدين. ولأنَّ المبدأ المؤسِّس لهذه الأخيرة قام على التعدُّد الانفصاليِّ في بنية الوجود، فمن البديهيِّ أن تفضي الأطروحة في منزلتها الأنطولوجيَّة إلى القول بتعدُّد منازل الحقّ. حتى لقد بدت الصورة كما لو أنَّ لكلِّ دينٍ إلهَه المخصوص به. أمَّا الحجَّة التي يرفعها أصحاب هذه النظريَّة فهي متأتِّية أصلًا من تعريفهم لماهيَّة الدين، حيث اعتبروه إطارًا أيديولوجيًّا، أو طريقة لفهم الكون بطريقةٍ ملائمة للعيش فيه. وعلى زعمهم، أنَّ الديانات السائدة في العالم، إنْ هي إلَّا معبِّرات عن تنوُّع النماذج الإنسانيَّة وتعدُّدها، وعن أنماط التفكير والطبائع والتقاليد الثّقافيَّة والأشكال الفنيَّة والسياسيَّة واللغويَّة والاجتماعيَّة. أمَّا حاصل هذه الرؤية فهو صيرورة الأديان مظهريات وضعانية مناقضة للتوحيد وللحقيقة الإلهيَّة الواحدة. (محمود حيدر- التعدُّديَّة الدينيَّة كوريث لوثنيَّة الحداثة – فصلية الاستغراب – العدد 25- 2021).
ولبيان ما نقصد إليه، سنبيِّن الوجه الأيديولوجيَّ لأطروحة التعدُّديَّة الدينيَّة بمجموعة شواهد:
أوَّلًا: حين نظر أصحاب التعدُّديَّة إلى نظريَّتهم بوصف كونها الحقيقة الكلية الحاكمة على عالم الأديان، ثمَّ أقاموا حقيقتهم المدَّعاة فوق حقائق الأديان جميعًا…
ثانيًا: حين قدَّمت الأطروحة نفسها باعتبارها سلطةً معرفيَّةً تفرض الحقيقة، وتعبِّر بالتالي عن مركزيَّة الحضارة الغربيَّة وهيمنتها.
ثالثًا: لمَّا نظَّر أصحابها لفرادة نظريَّتهم باعتبارها إحدى أبرز ابتكارات الحداثة الغربيَّة في مجال اللاهوت الطبيعيِّ وفلسفة الدين.
رابعًا: لمَّا استخدم رائدها جون هيغ العموميَّات الَّلفظيَّة في صياغة أطروحته مثل “التاريخ المشترك”، و”المجتمع العالميّ”، و”اللاهوت العولميّ”، وسوى ذلك ممَّا يشير إلى الرَّغبة ببناء منظومةٍ كونيَّةٍ تجعل الثقافات الدينيَّة غير الغربيَّة موادَّ ثانويَّة وفضاءات حضاريَّة تابعة.
البيِّن أنَّ نظريَّة التعدُّديَّة الدينيَّة غير بريئةٍ من التّوظيف الأيديولوجيِّ في مشروع الحداثة، أمّا استعاداتها الراهنة من جانب نيوليبراليَّة ما بعد الحداثة فإنَّما هي استئنافٌ أيديولوجيٌّ يجري معه تحويل الأديان العالميَّة غير الغربيَّة إلى منفسحاتٍ وظائفيَّة تبغي إعادة تشكيل العالم الآخر على نشأة الهيمنة والاحتواء.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 تعقّل الدّنيا قبل تعقّل الدّين
تعقّل الدّنيا قبل تعقّل الدّين
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 معنى (مال) في القرآن الكريم
معنى (مال) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 القرآنُ مجموعٌ في عهد النبيِّ (ص)
القرآنُ مجموعٌ في عهد النبيِّ (ص)
الشيخ محمد صنقور
-
 ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقا بَعدية (2)
ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقا بَعدية (2)
محمود حيدر
-
 الحِلم سجيّةُ أولياء الله وزينتهم
الحِلم سجيّةُ أولياء الله وزينتهم
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 كيف تفهم أدمغتنا أفعال الآخرين وتصرفاتهم؟
كيف تفهم أدمغتنا أفعال الآخرين وتصرفاتهم؟
عدنان الحاجي
-
 (لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ)
(لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ)
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
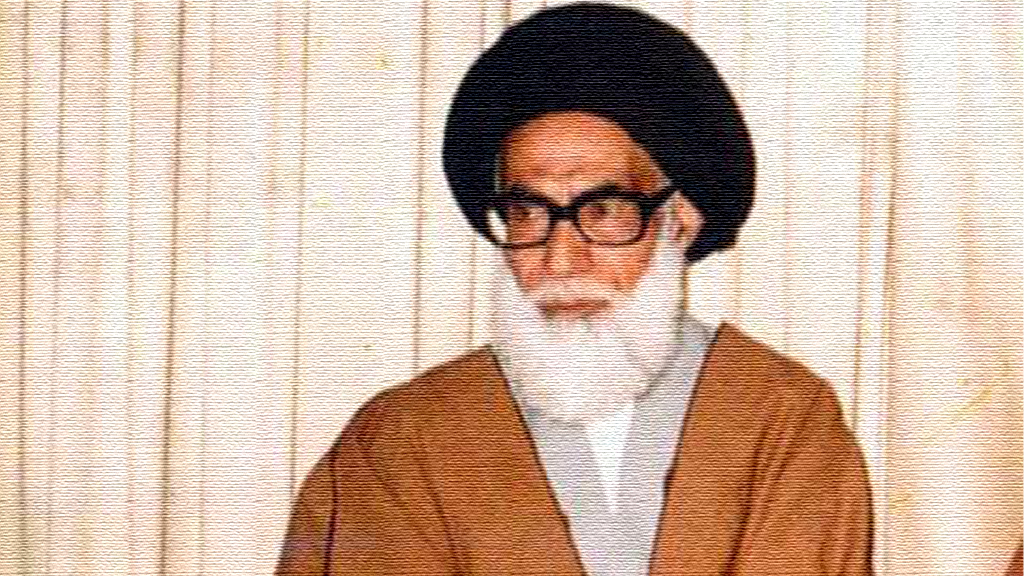 التّوحيد والمحبّة
التّوحيد والمحبّة
السيد عبد الحسين دستغيب
-
 من هي السيدة فاطمة عليها السلام؟
من هي السيدة فاطمة عليها السلام؟
الشيخ شفيق جرادي
-
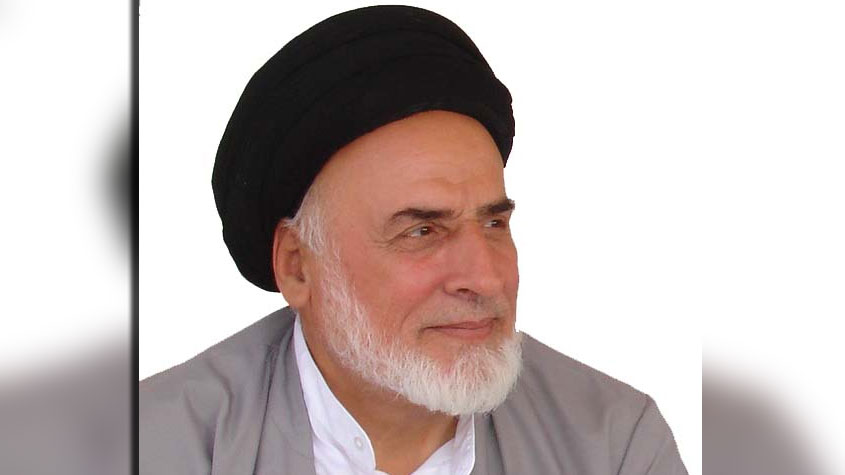 كيف يخاف النبي موسى عليه السلام من اهتزاز العصا؟!
كيف يخاف النبي موسى عليه السلام من اهتزاز العصا؟!
السيد جعفر مرتضى
الشعراء
-
 السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات
السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات
حسين حسن آل جامع
-
 اطمئنان
اطمئنان
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-

تعقّل الدّنيا قبل تعقّل الدّين
-

معنى (مال) في القرآن الكريم
-

القرآنُ مجموعٌ في عهد النبيِّ (ص)
-

ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقا بَعدية (2)
-

الحِلم سجيّةُ أولياء الله وزينتهم
-

(رحلة برفقة قلم) جديد الكاتب عبدالعزيز آل زايد
-

كيف تفهم أدمغتنا أفعال الآخرين وتصرفاتهم؟
-

(مداد في ظلال خراسان.. سيرة الشيخ إبراهيم بن مهدي آل عرفات القديحي القطيفي) جديد الشّيخ عبدالغني العرفات
-

الشباب والرجوع إلى الدين
-

غزو مكة









