علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".معضلة الميتافيزيقا، العقل الأدنى هو نفسه من الإغريق إلى ما بعد الحداثة (1)
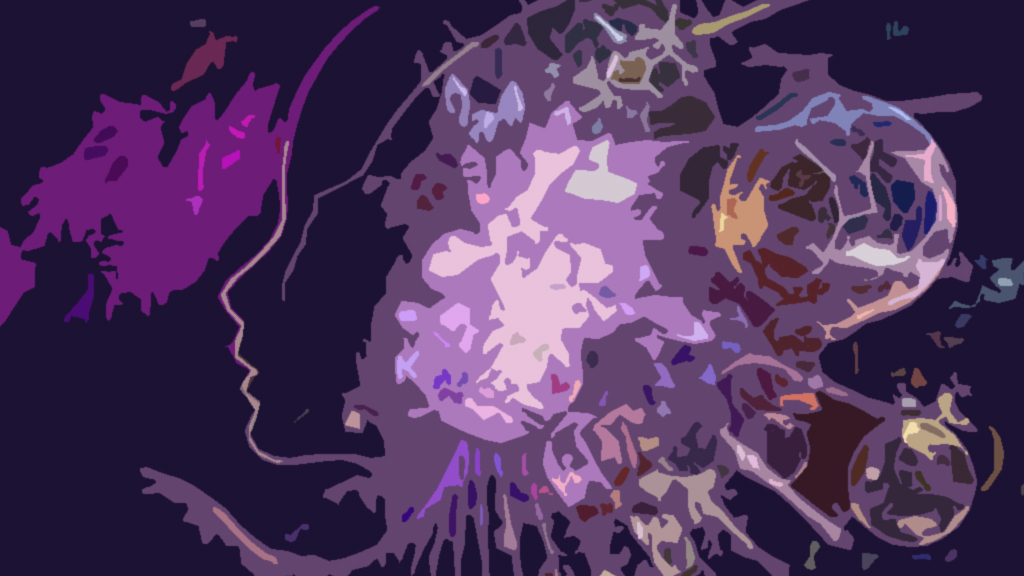
التأسيس للعقل الأدنى
بذلت الميتافيزيقا مذ ولدت في أرض الإغريق وإلى يومنا الحاضر ما لا حصر له من المكابدات. اختبرت النومين (الشيء في ذاته)، والفينومين (الشيء كما يظهر في الواقع العيني)، لكنها ستنتهي إلى استحالة الوصل بينهما. ذريعتها في هذا أن العقل قاصرٌ عن مجاوزة دنيا المقولات، ولا يتيسَّر له العلم بما وراء عالم الحس. أمّا النتيجة الكبرى المترتِّبة على هذا الـمُنتهى، فهي إعراض الفلسفة الأولى عن سؤال الوجود كسؤال مؤسِّس، واستغراقها في بحر خضمّ تتلاطم فيه أسئلة الممكنات الفانية وأعراضها.
في بدايات التفلسف سبق لأفلاطون أن بيَّن أن “الفلسفة هي العلم بالحقائق المطلقة المستترة وراء ظواهر الأشياء”. وكان بهذا يصدق النية في الدعوة إلى تأسيس ميتافيزيقا ما ورائيّة تتغيّا الكشف عن حقيقة الوجود. ولـمَّا جاء أرسطو ليعرِّف الفلسفة بأنّها “العلم بالأسباب القصوى للموجودات، أو هي علم الموجود بما هو موجود” ربّما لم يكن يدرك أنه بهذا التعريف سيفتح الباب واسعًا أمام إلحاق الميتافيزيقا بعلم المنطق، واسترجاعها إلى دنيا التقييد. وعلى غالب الظن كان أرسطو توَّاقًا إلى الانعطاف بمهمّة الفلسفة من أجل أن يجاوز التعالي الميتافيزيقي للمُثُل الأفلاطونيّة ويحسم الجدل حول تعريفاتها. كانت هندسة العقل بالمقولات العشر ثمرة هذا الانعطاف. وهو لم ينفِ ما أعلنه القدماء من أن الفلسفة تبقى العلم الأشرف من المعرفة العلميّة، وأن إدراك الحقيقة ومعرفة جوهر الأشياء تحتاج إلى إلهام وحدسٍ عقلي يمضي إلى ما وراء طور العقل. إلا أنّه – مع ذلك- سيبقى أول من افتتح باب السؤال المتشكِّك عمّا إذا كان بمستطاع العقل البشري إدراك الحقائق الجوهريّة للأشياء.
إرهاصات المنقلب الأرسطي
في كتابه “ما بعد الطبيعة” بدا أرسطو كما لو أنّه يعلن عن الميقات الذي نضج فيه العقل البشري ليسأل عما يتعدى فيزياء العالم ومظاهره. لكن السؤال الأرسطي- على سموِّ شأنه في ترتيب بيت العقل- سيتحول بعد برهة من زمن، إلى علّةٍ سالبة لفعاليات العقل وقابليته للامتداد. وما هذا إلا لحَيْرة حلّت على صاحبه ثم صارت من بعده قلقًا مريبًا. والذي فعله ليخرج من قلقه المريب، أنّه أمسك عن مواصلة السؤال الذي تعذَّر الجواب عليه في حساب المنطق، ثم مضى شوطًا أبعد ليُعرِضَ عن مصادقة السؤال الأصل الذي أطل منه الموجود على ساحة الوجود. والحاصل أن فيلسوف “ما بعد الطبيعة” مكث في الطبيعة وآَنَسَ لها فكانت له سلواه العظمى. رضي بما تحت مرمى النظر ليؤدي وظيفته كمعلِّم أول لحركة العقل. ومع أنه أقرَّ بالمحرِّك الأول، إلا أن شَغَفَه بعالم الإمكان أبقاه سجين المقولات العشر. ثم لـمَّا تأمَّل مقولة الجوهر، وسأل عمَّن أصدرها، عاد إلى حَيْرته الأولى. لكن استيطانه في عالم الممكنات سيفضي به إلى الجحود بما لم يستطع نَيْلَه بركوب دابّة العقل. حَيْرتُه الزائدة عن حدّها أثقلت عليه فلم يجد معها مخرجًا. حتى لقد بدت أحواله وقتئذٍ كمن دخل المتاهة ولن يبرحها أبدًا. مثل هذا التوصيف- يصل إلى مرتبة الضرورة المنهجيّة ونحن نعاين الحادث الأرسطي. لو مضينا في استقراء مآلاته لظهر لنا بوضوح كيف اختُزلت الميتافيزيقا إلى علم أرضي محض. من أبرز معطيات هذا السياق الاختزالي في جانبه الأنطولوجي أن أرسطو لم يولِ عناية خاصّة بمعرفة الله، ولم يعتبرها غرضًا رئيسيًّا لفلسفته، ولم يدخلها بالتالي في قوانينه الأخلاقيّة ولا في نظمه السياسيّة[1]. الأولويّة عنده كانت النظر إلى العالم الحسي وبيان أسبابه وعلله من دون أن يفكّر في قوّة خفيّة تدبّره. مؤدى منهجه أن الطبيعة، بعدما استكملت وسائلها وانتظمت الأفلاك في سيرها، انتهى بها المطاف إلى محرك أول أخصّ خصائصه أنّه يحرِّك غيره ولا يتحرك هو[2]. هذا المحرك الساكن أو المحرك الصُّوَري هو عنده الإله الذي لا يذكر من صفاته إلا أنّه عقل دائم التفكير، وتفكيره منصبٌّ على ذاته. يتحرَّج أرسطو عن الكلام في المسائل الدينيّة، ويعدها فوق مقدور البشر، ويصرِّح بأن الكائنات الأزلية الباقية، وإن تكن رفيعة مقدّسة، فهي ليست معروفة إلا بقدر ضئيل[3]. لكن أرسطو الذي لم يفكر مبدئيًّا إلا في الطبيعة وعللها والأفلاك ومحركاتها سيق في آخر الأمر إلى إثبات محرك أكبر تتجه نحوه القوى وتشتاق إليه[4].
البيِّن أن الفلسفة لم تتخلَّص من تاريخها الإشكالي هذا منذ اليونان إلى أزمنة الحداثة الفائضة. ذلك ما جعل كل مسألة ذات طبيعة فوق ميتافيزيقية (غيبية) تستعصي على الحل. المعثرة الكبرى في مكابدات الميتافيزيقا الكلاسيكيّة كامنة في الانزياح عن مهمتها الأصلية، وهي فهم العالم كوجود متصل، والنظر إليه بما هو امتداد أصيل بين مراتبه المرئية واللامرئية، الطبيعية وفوق الطبيعية. ولئن كانت هذه هي مهمّتها الأصليّة- وهذا ما يميّزها عن العلم- فذلك تذكير بما هو بديهي فيها. والتذكير بمهمة الميتافيزيقا بما هي استكشاف ما يحتجب عن ملكات العقل النظري، وتجاربه، هو إقرار لها بوصفها علمًا حيًّا يحيي نفسه ويحيي سواه من العلوم في الآن عينه. إنه أيضًا عرفان لها بالجميل وهي تقيم علاقة شديدة الخصوصية بالوجود خلافًا لسائر المعارف والعلوم. إذ إنها لا تكف عن إعلان رسالتها الأصلية، حتى وهي تعتني بعالم الممكنات وعوارضه من خلال الاهتمام بأسئلة الممكنات المتناهية وعوارضها. وهذا مألوف في سيرتها التاريخيّة ومدوَّناتها، حيث إن الخاصية الملحوظة لكل التعاليم الميتافيزيقية هي التقاؤها على ضرورة البحث عن السبب الأوّل لكل ما هو موجود. ذاك الذي سمِّي المادة الأولى مع ديمقريطس، والخير مع أفلاطون، والفكر الذي يفكّر بذاته مع أرسطو، والواحد مع أفلوطين، والوجود مع كل الفلاسفة المسيحيين، والقانون الأخلاقي مع كانط، والإرادة مع شوبنهاور، والفكرة المطلقة عند هيغل، والديمومة الخلّاقة عند برغسون، وأي شيء يمكن أن تذكره. في جميع الأحوال، فإن الميتافيزيقي- كما يبين الفيلسوف واللاهوتي الفرنسي إتيان جلسون (1979-1984) ـ إنسان يبحث وراء وبعد التجربة عن مصدر مطلق لكل تجربة حقيقية وممكنة[5].
وبحسب جلسون- أننا حتى لو حدّينا من مجال ملاحظتنا لتاريخ الحضارة الغربية، فثمّة حقيقة موضوعية هي أن الإنسان سعى إلى هذه المعرفة منذ أكثر من خمسة وعشرين قرنًا، ثم بعدما برهن أنه لا يجب البحث عنها وأقسم أنه لن يبحث عنها بعد الآن، وجد نفسه يطلبها من جديد. هذا هو القانون الكامن في العقل البشري. وتبعًا لهذه الرؤية الميتافيزيقيّة المستحدثة لا يصح اعتبار الإنسان حيوانًا ناطقًا كما قرّر أرسطو، وإنّما هو حيوان ميتافيزيقي بالطبع والغريزة. أي أن ماهيَّته ميتافيزيقية، وهي عكس كل الماهيَّات التي تنطوي في خلقتها الأولى على عقل ما يرعاها ويدبِّر لها أمرها. فالقانون الذي هو مخصوص بالكائن الإنساني لا يكتفي بتقرير الحقيقة، بل يشير إلى سببها، فبما أن الإنسان عاقل بماهيَّته، يجب أن يكون لتكرار الميتافيزيقا الثابت في تاريخ المعرفة الإنسانية تفسيره في بنية العقل نفسها. بتعبير آخر، يجب أن يكون السبب في أن الإنسان حيوان ميتافيزيقي كامنًا في مكان ما من طبيعته العقلانية[6]. لقد أكّد الفلاسفة، لقرون عدّة قبل كانط، على حقيقة أن في المعرفة العقلية أكثر ممّا نجده في التجربة الحسّية. فالصفات النموذجية للمعرفة العلمية، كالكلَّية والضرورة، لا يمكن إيجادها في الحقيقة الحسية، وواحد من التفاسير الأكثر عمومية هو أنها تأتي إلينا من قدرتنا على المعرفة. إذ كما يقول لايبنتس، لا شيء في العقل ما لم يمرّ من قبل في الحواس، إلا العقل ذاته. وكما كان كانط أول من فقد الثقة بالميتافيزيقا وتمسّك بها باعتبارها لا مفر منها، كذلك كان أوّل من أعطى اسمًا لقوّة العقل البشري الملحوظة في تجاوز كل تجربة حسية. وهو ما ذهب إلى تسميته بـ “الاستعمال المتعالي للعقل”، ثم ليتهمها (أي الميتافيزيقيا) بأنها المصدر الدائم لأوهامنا الميتافيزيقية[7].
معثرة العقل المكتفي بذاته
لم تجد الميتافيزيقا المعاصرة في الحادث الأرسطي سوى هذا المنقلب الذي أُعلِن فيه عن العقل المكتفي بذاته. فلقد غفل وَرَثةُ الأرسطية عن حقيقة أن العقل الممتد إلى ما وراء ذاته وما بعدها هو عقل جامع للشمل ومن خصائصه صنع الأعاجيب. ولأنه ممتد ولا يتوقف عند حد فهو يتعقَّل ما يظنُّه العقل الحسَّاب نقيض المنطق. وهذا غالبًا كان يستثير حفيظة فلاسفة الحداثة لا سيّما أولئك الذين حرصت منظومته على تقديس الكبرياء الأرضي ومضت إلى واقعية صمَّاء يسددها عقل صارم يقبض على المحسوس بكلتا يديه.
لقد ورِثَ فلاسفة الحداثة الذين أخذوا دربتهم عن الإغريق، معضلة “الفصل الإكراهي” بين واجد الوجود والموجود الخاضع لمحسوبات العقل الحسي ومقولاته. هذا الفصل لم يكن أمرًا عارضًا في الأذهان، بل سيكون له امتداده وسريانه الجوهري في ثنايا العقل الكلِّي لحضارة الغرب الحديث. بسبب من ذلك، غدا كل سؤال تعلنه الفلسفة الحديثة على الملأ مثقلًا بحوامل الموجودات وعروضها. وسنجد كيف اكتظَّت بياناته بألوان الظنون، وهو يُسلم أمره لسلطان العقل واستدلاله.
تأسِّيًا بالقدماء، غالبًا ما دارت اختبارات الميتافيزيقا الحديثة مدار الفراغ العجيب. ولقد أظهرت معطياتها عن حيرة بين الموجود الفاني وواجب الوجود الحي. تتخطَّفها أسئلة قلقة لا تنتهي إلى قرار. وكثيرًا ما لجأ المحدثون من بعد يأسهم من تحصيل الأجوبة إلى توجيهات المعلم الأول وخصوصًا إلى التعاليم التي تؤنس الذهن الشغوف بعالم الممكنات. حال هؤلاء أنّهم كلما أشغلوا فكرهم بشيء فوق واقعي، انزلق ذلك الشيء من بين أصابعهم ككائنٍ زئبقيٍ. صار سؤال الفيلسوف المستحدث المأخوذ في قلقه حد التطيُّر، حائرًا وكذلك جوابُه حائرًا. ولأنه لا يقدر على تحصيل اليقين طابت له الإقامة في دنيا الأسئلة الفانية. وحين كتب على نفسه أن يتعرَّف إلى الأشياء كما هي في ذاتها، وأن يقتفي أثر الأحداث والظواهر قصد تحرِّي عِللِهَا وأسبابها والنتائج المترتبة عليها، تاه في أمره؛ حتى أخذه الظن بأن الاهتداء إلى الحقيقي والعقلاني إنما يمر عبر الحواس واستدلالات الذهن الحاسب.
في حقبة الحداثة التي تلت العصر الوسيط في الغرب، أسهم تطوّر العلم الوضعي إلى حدٍ كبير في بروز الاتجاه الذي يفصل الإيمان بالله عن الحياة الواقعيّة للإنسان الحديث. وبتأثير من علماء مثل كـوبرنيكُس(Copernicus)(1473-1543)، وغاليليــو(Galileo)(1564، 1642)، وبالأخص نيوتن (Newton)(1642-1727)، كشف نمو العلم الوضعي عن أسلوبٍ جذريٍ جديد في التفكر بالكون الماديّ وفهمه[8].
بدءًا من هذه الحقبة، سوف تمضي لعبة العقل العلمي في رحلة لن تتوقف عند حد. إذ مع وفود العلم الحديث، فرضت الرياضيات- وليس الميتافيزيقيا- نفسها كأسلوب مناسب لتشكيل فهمٍ علمي وتجريبي للعالم. لم يستمدّ العلم الجديد في تطوره الناضج قوانينه من اعتباراتٍ ميتافيزيقية، ولم يُقدّم نفسه كتابعٍ جوهريًّا لها أو كطالبٍ للاندماج والاكتمال ضمن منظومة الميتافيزيقا واللاهوت الطبيعي. كانت أي إشارة إلى الله أو إلى الملائكة كأسباب لما يجري في العالم خارجة عن مناط الإسناد المناسب للنظرة العلمية الجديدة. كانت الفرضية الوحيدة المناسبة للاتجاه العلمي الجديد هي تلك التي يمكن من حيث المبدأ إثباتها أو نقضها من خلال الملاحظة التجريبية والاختبار. كان واضحًا في التفكير الفلسفي للحداثة الغربيّة أن الرجوع إلى الإله الذي “لم يره أي إنسان في أي وقت” هو نموذج لما لا يُمكن أن يرد كفرضية حقيقية في هذا السياق. وهكذا جرى تمهيد السبيل لرؤية هي أشبه بعقيدة راسخة لدى الغرب الحديث، وتُفيد بأنّ إثبات الله يُشكّل إقصاءً للديناميكية الذاتية لأكثر إنجازات الإنسان حسمًا، وهي العقلية العلمية. وللمفارقة، فإن الرواد المميزين في العلم المعاصر من أمثال بُويل (Boyle) ونيوتن(Newton) كانوا مقتنعين بأن تأملاتهم تُثبت وجود الله بما لا مجال فيه للشك؛ وأنّ وجود الإله الحكيم ضروري قطعًا لضمان ضبط الساعة الكونية العظيمة كما ينبغي، والمحافظة على عملها بشكلٍ جيد. لكن لم يمضِ سوى وقت قصير حتّى ظهر النزوع الإلحادي في أفق المنهج العلمي الذي يُسنده. وبالتدريج، أصبحت أيُّ إشارة إلى الله في التفسير العلمي للعالم عَرَضيةً بشكلٍ متزايد. ومع الوقت، أصبح الله خارجًا عن الموضوع حتى حين يجري الحديث عن مصدر النظام الشمسي وصيانته. كما أضحى التفسير الطبيعي الحصري لكل الظواهر المادية هو محور الاهتمام المسيطر.
الميتافيزيقا الحديثة سليلة ماضيها
وفقًا لما مرَّ معنا من شواهد على تقلُّص حضور الميتافيزيقا، ينبغي عدُّ تطوّر العلم الوضعي الذي بدّل الأفق الفكري للغرب بشكل دراماتيكي على أنّه عاملٌ ذو أهمية مركزية في تشكيل الإلحاد المعاصر. يتضح هذا التطور جيدًا في فكر ديكارت(Descartes) (1596-1650) حيث مضى في التنظير لذاتية مفرطة سيكون لها أثرها العميق في التسييل الفلسفي للإلحاد المعاصر. وكما يُلاحظ البروفيسور فابرو(Fabro) مثّل الإلحاد ظاهرةً متفرقة تقع ضمن حدود النخبة الثقافية، ولكن بمجرد بروز الكوجيتو على الساحة فقد اتخذ الإلحاد بُنية محيطة وبشكلٍ متزامن اجتاح الحياة العامة والسلوك الفردي[9].
للوهلة الأولى، يبدو مستهجنًا وصفُ فكر ديكارت كمصدرٍ للإلحاد لأنه كان مسيحيًّا مُقتنعًا، وكان يعتبرُ أنّ كامل فلسفته هي دفاعٌ بالغ القوة عن الإيمان بالله. وبالفعل، فإن فكرة الله التي يُشتق منها إثبات وجوده هي سمةٌ لا غنى عنها إطلاقًا في منظومته الفلسفية. ولكن على الرغم من ذلك، ينبغي التمييز بين نوايا أي مفكّر وبين المنطق الضمني لمنهجه ومبادئه من ناحيةٍ أخرى. في ما يتعلق بديكارت، ظهر بوضوح أن فلسفته مصدر خصيب للإلحاد وذلك من خلال المسار اللاحق للتأمل الفلسفي الذي استمد إلهاماته من أعماله.
إذا كان ديكارت هو الفيلسوف المؤسِّس لحداثة الغرب فإن مشروعه لم يقطع مع الأرسطية، بل شكل امتدادًا جوهريًّا لمنطقها من خلال الخضوع لوثنية الأنا المفكِّرة. وسيجوز لنا القول إن الكوجيتو الديكارتي ما هو إلا استئناف مستحدث لـ “دنيوية” أرسطو. وبسبب من سطوة النزعة الدنيوية هذه على مجمل حداثة الغرب لم يخرج سوى “الندرة” من المفكّرين الذين تنبهّوا إلى معاثر الكوجيتو وأثره الكبير على تشكلات وعي الغرب لذاته وللوجود كلّه. من هؤلاء نشير إلى الفيلسوف الألماني فرانز فونبادر الذي قامت أطروحاته على تفكيك جذري لمباني الميتافيزيقا الحديثة وحكم بتهافتها الأنطولوجي والمعرفي في آن. وإذا كانت فلسفة بادر النقديّة طاولت الأسس التي انبنت عليها الميتافيزيقا الأولى، فإن نقده للديكارتيّة يشكّل ترجمة مستحدثة للميراث الأرسطي بمجمله.
يمكن إيجاز نقد بادر للكوجيتو الديكارتي في النقاط الثلاث التالية:
أولًا: إن الكوجيتو الديكارتي “مبدأ الأنا أفكر” يؤدّي إلى قلب العلاقة التأسيسية للوعي بجناحيه المتناهي واللامتناهي. يحتج بادر على العقليين بقوله: “كيف يمكن أن يعرفوا بتفكير لا إلهي، أو تفكير لا إله فيه، وبتفكير مدعوم إلهيًّا، مع أن نفس وجود أو لا وجود اللَّه يُحدَّد فقط من خلال تفكيرهم، وطالما أن قضيتهم “تجري وفق معادلة مختلة الأركان قوامها: “اللَّه موجود مجرّد نتيجة للأنا موجود[10]“.
ثانيًا: ما يريد الشك الديكارتي أن يقوله فعلًا، بوصفه استقلالية مطلقة للمعرفة، ليس أقل من أن الإنسان بوصفه مخلوقًا يكوّن معرفته الخاصة، ويجعلها تؤسّس ذاتها من دون مسبقات. الـ “أنا موجود” ( ergo sum) التي تلي “الأنا أفكّر” (co gito) هي تعبير عن كيان يريد إظهار نفسه بالتفكير والكينونة، بمعزل عن الله، وكونه عاجزًا عن فعل هذا، يمنع تجلّي نفسه وتجلّي الله. فالموجود المتناهي، الإنسان، من خلال تأسيس يقينه الوجودي والمعرفي في الأنا الواعي يحاول إظهار ذاته كموجود مطلق، ويجعل نفسه إلهًا مؤسِّسًا لذاته[11]“.
ثالثًا: يشكّل الكوجيتو الديكارتي، بالأساس، انعطافة أبستمولوجية نحو الأنا، مما يستلزم انعطافة أنطولوجية تليها انعطافة أبستيموليجية منطقية أنطولوجية للعودة إلى ذاتها، بهذا يساعد ويحرّض على نسيان خاصية الوحدة المرتبطة بالشخصية والعقل الفردي. الأنوية الأبستمولوجية والأنانة الأنطولوجية لـ “الأنا أفكر أنا موجود” في تطبيقها للفلسفة الاجتماعية والسياسية تؤدي إلى أنانية سياسية ليبرالية ذات نظام سياسي واقتصادي أناني[12].
على هذا النحو من النظر إلى “العقل الأناني” المستكفي بذاته، سيؤسس ديكارت فلسفة العصر الحديث. وهي كما يظهر مما أنجزته في رحلتها المتمادية، فلسفة أيقنت دعوتها على الاكتفاء الذاتي للتفكير والوجود الإنساني. وجل الفلاسفة الذي خَلَفوا ديكارت أو تبعوا دربته الاكتفائية، رأوا أن ذات المرء كافية في تأسيس وجوده وتفكيره. وأن الإنسان بسبب هذا الاكتفاء الذاتي لا يحتاج إلى اللَّه في التأسيس والمساعدة، ولا في وجوده ولا في معرفته ولا في وعيه الذاتي.
لقد نبَّه التحليل النقدي لـ “الأنا أفكر إذًا أنا موجود” إلى أن الأنا، عندما تتأمّل المكان الذي أتت منه، سوف تدرك أنها لا تملك “كوجيتو” خاصًّا بها، ولا وعيّا ذاتيًّا خاصًّا بها، ومنسجمًا معه. عندما نفكر بشكل أعمق في شروط الوعي- كما يبيّن نقّاد الكوجيتو- يصل المرء إلى معرفة أن الوعي المتناهي يعرف ذاته على أنه وعي لشخص لا يُحدِث نفسه ولا يعرف نفسه بنفسه وحده. وفي ذات الوقت الذي يعرف الوعي المتناهي “الأنا أفكر” ماهيته، يعرف أنه: “مفكَّر فيه”. فالوعي المتناهي مؤسَّس في وعي مطلق مستقل بشكل كامل عن الوعي المتناهي[13].
و”مبدأ المفكَّر فيه” يعبّر عن عقيدة حضور كل الأشياء في اللَّه على مستوى الوعي، بمعنى أن الوعي المتناهي مؤسَّس في اللامتناهي، ومن ناحية أخرى يبيّن أن معرفة الإنسان ليست صنيعة الإنسان، بل هي موهبة إلهية.
من الفلاسفة الذين اتبعوا “مبدأ الكوجيتو” الديكارتي والذين انتقدهم بادر بسببه: (إيمانويل كانط – Kant ( 1724 1804، و(جوهان غوتليب فيخته Fichte 1762- 1814)، وشلنغ (Schelling 1775- 1845)، و(هيغل Hrgel 1770 -1831) وغيرهم. ويهمنا هنا أن نعرض بإيجاز إلى كل من كانط وهيغل بوصفهما وريثين شرعيين للمدرسة الديكارتيّة بأصولها الأرسطيّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إبراهيم مدكور، فلاسفة الإسلام والتوفيق بين الفلسفة والدين – في إطار كتاب “قضيّة الفلسفة”، تحرير وتقديم: محمّد كامل الخطيب، (دمشق: دار الطليعة الجديدة، 1998)، الصفحة 165.
[2] Aristote, Physique, 258 a, 5-b, 4.
[3] Aristote, Des parties des animaux. 1, 5.
[4] إبراهيم مدكور، مجلة الرسالة، القاهرة، السنة الرابعة، العدد 141- 13-9-1936، الصفحة 200.
[5] إتيان جلسون، وحدة التجربة الفلسفيّة، ترجمة: طارق عسيلي، (بيروت: المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجيّة، الطبعة1، 2017)، الصفحة 256.
[6] وحدة التجربة الفلسفيّة، مصدر سابق، الصفحة إيّاها.
[7] المصدر نفسه، الصفحة 257.
[8] H.Butterfield, The Origins of Modern Science 1300-1800, London, 1951, p.7.
[9] C.Fabro, God in Exile-Modern Atheism: AStudy of the Internal Dynamic of Modern Atheism, from itsRoots in the Cartesian Cogito to the Present Day, NewYork, 1968, pp.26 -27.
[10] Franz von Baader،BB،Brief an Dr. vonStransky،77. April 5485،in SW،Vol. XV،p. 757.
[11] Ipid. P. 776
[12] رولاند بيتشي- فرانز فون بادر، ناقد العلمانية الملحدة، ترجمة: طارق عسيلي، فصلية الاستغراب، العدد السابع، ربيع 2017.
[13] المصدر نفسه.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 خصائص الصيام (1)
خصائص الصيام (1)
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الشيخ محمد صنقور
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 معرفة الإنسان في القرآن (6)
معرفة الإنسان في القرآن (6)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (فور) في القرآن الكريم
معنى (فور) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

خصائص الصيام (1)
-

الموانع من حضور الضيافة الإلهية
-

البعث والإحياء بعد الموت
-

حديث للاختصاصيّ النّفسيّ أسعد النمر حول توظيف التّقنية في العلاج النّفسيّ
-

التقوى، العطاء، الإيثار في شهر رمضان
-

شرح دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان
-
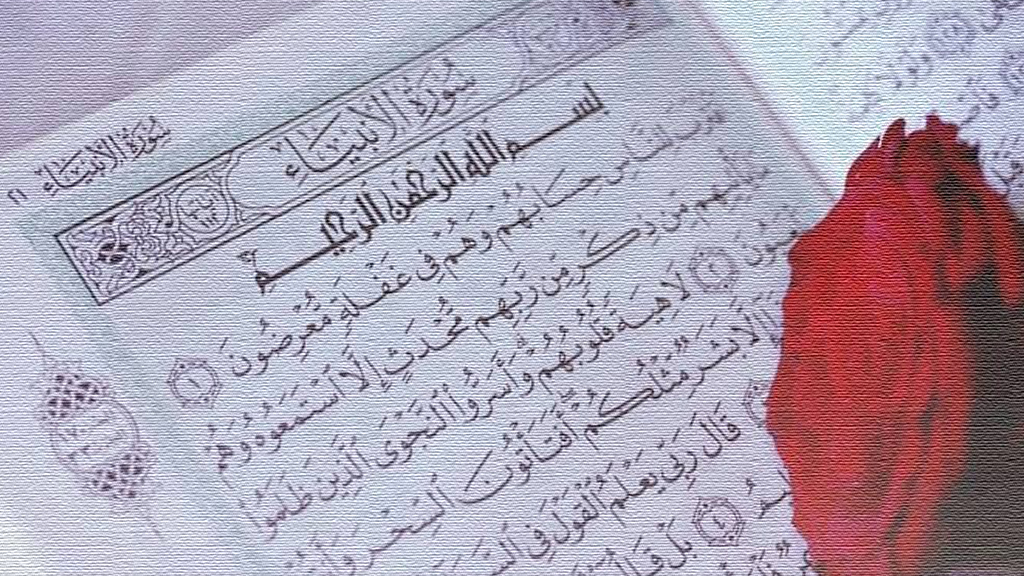
معرفة الإنسان في القرآن (6)
-

شرح دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان
-

لقاء الرحمة والعبادة
-

معنى (فور) في القرآن الكريم










