علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ عبدالهادي الفضليعن الكاتب :
الشيخ الدكتور عبدالهادي الفضلي، من مواليد العام 1935م بقرية (صبخة العرب) إحدى القرى القريبة من البصرة بالعراق، جمع بين الدراسة التقليدية الحوزوية والدراسة الأكاديمية، فنال البكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية ثم درجة الدكتوراه في اللغة العربية في النحو والصرف والعروض بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، له العديد من المؤلفات والمساهمات على الصعيدين الحوزوي والأكاديمي.rnتوفي في العام 2013 بعد صراع طويل مع المرض.أسلوب البحث (4)

أدلة الحجية من العقل:
وخلاصة ما استدل به للاستصلاح منها بعد إكمال نواقص بعضها ببعض هو:
1 - إن الأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد، وإن هذه المصالح التي بنيت عليها أحكام الشريعة معقولة، أي مما يدرك العقل حسنها، كما أنه يدرك قبح ما نهى عنه، فإذا حدثت واقعة لا نص فيها "وبنى المجتهد حكمه فيها على ما أدركه عقله من نفع أو ضرر، كان حكمه على أساس صحيح معتبر من الشارع، ولذلك لم يفتح باب الاستصلاح إلا في المعاملات ونحوها مما تعقل معاني أحكامها فلا تشريع فيها بالاستصلاح" (1).
وهذا الاستدلال لا يتم إلا على مبنى من يؤمن بالتحسين والتقبيح العقليين، والدليل كما ترون قائم على الاعتراف بإمكان إدراك العقل لذلك. وقد سبق أن قلنا: إن العقل قابل للإدراك، ولو أدرك على سبيل الجزم كان حجة قطعًا لكشفه عن حكم الشارع، ولكن الإشكال، كل الإشكال، في جزمه بذلك لما مر من أن أكثر الأفعال الصادرة عن المكلفين، إما أن يكون فيها اقتضاء التأثير أو ليس فيها حتى الاقتضاء، وما كان منها من قبيل الحسن والقبح الذاتيين فهو نادر جدًّا، وأمثلته قد لا تتجاوز العدل والظلم وقليلًا من نظائرهما.
وما فيه الاقتضاء يحتاج إلى إحراز تحقق شرائطه وانعدام موانعه، أي إحراز تأثير المقتضى وهو مما لا يحصل به الجزم غالبًا لقصور العقل عن إدراك مختلف مجالاته، وبما كان بعضها مما لا يناله إدراك العقول...
2 - قولهم: "إن الوقائع تحدث والحوادث تتجدد، فلو لم يفتح للمجتهدين باب التشريع بالاستصلاح ضاقت الشريعة الإسلامية عن مصالح العباد وقصرت عن حاجاتهم، ولم تصلح لمسايرة مختلف الأزمنة والأمكنة والبيئات والأحوال مع أنها الشريعة العامة لكافة الناس، وخاتمة الشرائع السماوية كلها" (2).
وقد أجبنا على نظير هذا الاستدلال في مبحث القياس، وبينّا أن أحكام الشريعة بمفاهيمها الكلية، لا تضيق عن مصالح العباد ولا تقصر عن حاجاتهم، وهي بذلك مسايرة لمختلف الأزمنة والأمكنة والبيئات والأحوال وبخاصة إذا لوحظت مختلف المفاهيم بعناوينها الأولية والثانوية وأحسن تطبيقها والاستفادة منها.
والحقيقة أن تأثير الزمان والمكان والأحوال إنما هو في تبدل مصاديق هذه المفاهيم. فالآية الآمرة بالاستعداد بما يستطيعون له من قوة لإرهاب أعداء الله قد لا نجد لها مصداقًا في ذلك الزمن إلا بإعداد السيوف والرماح والتروس والخيول وأمثالها، لأن القوة السائدة هي من هذا النوع، ولكن تبدل الزمان وتغير وسائل الحرب حول الاستعداد إلى إعداد مختلف الوسائل السائدة في الأمم المتحضرة للحروب كالقنابل النووية وغيرها، فالمفهوم هو وجوب الاستعداد بما يستطاع لهم من قوة لم يتغير في الآية، وإنما مصاديقه وهكذا...
فالتبدل في الحقيقة، لم يقع في المفاهيم الكلية، وإنما وقع في أفرادها ومصاديقها، فما كان مصداقًا لمفهوم ما ربما تحول إلى مصداق لمفهوم آخر. ولقد وسع لنا الشارع المقدس بما شرحه لنا من العناوين الثانوية من جهة، وبفتحه لنا أبواب الاجتهاد سواء في التعرف على أحكامه الكلية أم التماس مصاديقها بما سد حاجاتنا الأساسية إلى تطوير أنفسنا، ومسايرة عصورنا ضمن إطار ما جاء به من أحكام، ولكن لا على أن نفسح المجال أمام أوهامنا وظنوننا لنتحكم في مصائر العباد كيفما نشاء، وما دام مقياس الحجية بأيدينا - وهو ما سبق أن عرضناه - فلا مجال لاعتماد ما يخالف هذا المقياس، والأساس فيه هو تحصيل العلم بالحكم أو العلمي، ولا أقل من تحصيل الوظيفة التي يأمن الإنسان من غائلة العقاب.
الاستدلال بسيرة الصحابة:
وكما استدلوا بالعقل فقد استدلوا عليها بسيرة الصحابة، ومما جاء في دليلهم: "أن أصحاب رسول الله لما طرأت لهم بعد وفاته حوادث وجدت لهم طوارئ شرعوا لها ما رأوا أن فيه تحقيق المصلحة، وما وقفوا عن التشريع لأن المصلحة ما قام دليل من الشارع على اعتبارها، بل اعتبروا أن ما يجلب النفع أو يدفع الضرر حسبما أدركته عقولهم هو المصلحة، واعتبروه كافيًا لأن يبنوا عليه التشريع والأحكام، فأبو بكر جمع القرآن في مجموعة واحدة، وحارب مانعي الزكاة، ودرأ القصاص عن خالد بن الوليد، وعمر أوقع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ووقف تنفيذ حد السرقة في عام المجاعة، وقتل الجماعة في الواحد، وعثمان جدد أذانًا ثانيًا لصلاة الجمعة (3)... الخ".
والغريب أن تنزل هذه التصرفات وأمثالها على القياس تارة والاستحسان أخرى والمصالح ثالثة، وتعتبر على ألسنة البعض أدلة عليها، وما أدري هل تتسع الواقعة الواحدة لمختلف هذه الأدلة مع تباينها مفهوما أم ماذا؟! ومهما يكن فإن النقاش في هذا النوع من الاستدلال واقع صغرى وكبرى.
أما الصغرى فلعدم إمكان تكوين سيرة لهم من مجرد نقل أحداث عن أفراد منهم يمكن أن تنزل على هذا الدليل أو ذاك، ومن شرائط السيرة أن يصدر المجموع عنها في سلوكها الخاص، وكذلك لو أريد من هذا الدليل إجماعهم السكوتي على ذلك بالتقريب الذي ذكروه بالقياس، أما إذا أريد الاستدلال بتصرفاتهم الفردية فهي لا تصلح للدليلية على أي حال لعدم الإيمان بعصمتهم أولًا، واجتهادهم لا يتجاوز في حجيته أنفسهم ومن يرجع إليهم بالتقليد.
وأما المناقشة في الكبرى فلعدم حجية مثل هذه السيرة أو الإجماع على أمثال هذه الأدلة، لأن هذه التصرفات غير معللة على ألسنتهم، وما يدرينا أن الباعث على صدورها هو إدراك المصالح من قبلهم، والسيرة مجملة لا لسان لها لنتمسك به، وغاية ما يمكن أن تدل عليه هو حجية نفس ما قامت عليه من أفعال لو كانت مثل هذا السيرة من الحجج التي يركن إليها لا حجية مصادرها المتخيلة، على أن هذه التصرفات - كما سبقت الإشارة إليها - جار أكثرها على مخالفة النصوص لأمور اجتهادية لا نعرف اليوم عواملها وبواعثها الحقيقية.....
الاستدلال بحديث لا ضرر:
وقد تبناه الطوفي وقرب دلالته - بعد أن أطال الحديث في سنده - بقوله: "وأما معناه فهو ما أشرنا إليه من نفي الضرر والمفاسد شرعًا، وهو نفي عام إلا ما خصصه الدليل، وهذا يقتضي تقديم مقتضى هذا الحديث على جميع أدلة الشرع، وتخصيصها به في نفي الضرر وتحصيل المصلحة لأنا لو فرضنا أن بعض أدلة الشرع تضمن ضررًا، فإن نفيناه بهذا الحديث كان عملًا بالدليلين، وإن لم ننفه به كان تعطيلًا لأحدهما وهو هذا الحديث، ولا شك أن الجمع بين النصوص في العمل بها أولى من تعطيل بعضها" (4).
ويقول: "ثم إن قول النبي (صلى الله عليه وسلم): لا ضرر ولا ضرار يقتضي رعاية المصالح إثباتًا والمفاسد نفيًا إذ الضرر هو المفسدة فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما" (5).
والذي يرد على هذا الاستدلال:
1 - اعتقاده أن نسبة هذا الحديث إلى الأدلة الأولية هي نسبة المخصص مع أن شرائط المخصص أن يكون أخص مطلقًا من العام ليصح تقديمه عليه... والنسبة هنا بين حديث لا ضرر وأي دليل من الأدلة الأولية، هي نسبة العموم من وجه، فوجوب الوضوء مثلًا، بمقتضى إطلاقه شامل لما كان ضرريًّا وغير ضرري، وأدلة لا ضرر شاملة للوضوء الضرري وغير الوضوء، فالوضوء الضرري مجمع للحكمين معًا، ومقتضى القاعدة التعارض بينهما والتساقط، ولا وجه لتقديم أحدهما على الآخر لأن نسبة العامين إلى موضع الالتقاء من حيث الظهور نسبة واحدة.
والظاهر أن الطوفي - بحاسته الفقهية - أدرك تقديم هذا الدليل على الأدلة الأولية وإن لم يدرك السر في ذلك. والسر هو ما سبق أن ذكرناه من حكمة هذا النوع من الأدلة على الأدلة الأولية لما فيه من شرح وبيان لها، فكأنه يقول بلسانه إن ما شرع لكم من الأحكام هو مرفوع عنكم إذا كان ضرريًّا، فهو ناظر إليها ومضيق لها. وما دام لسانه لسان شرح وبيان فلا معنى لملاحظة النسبة بينه وبين غيره من الأدلة.
2 - اعتقاده أن بين الضرر والمصلحة نسبة التناقض، ولذلك رتب على انتفاء أحدهما ثبوت الآخر لاستحالة ارتفاع النقيضين مع أن الضرر معناه لا يتجاوز النقص في المال أو العرض أو البدن وبينه وبين المصلحة واسطة، فالتاجر الذي لم يربح في تجارته ولم يخسر فيها لا يتحقق بالنسبة إليه ضرر ولا منفعة فهما إذن من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث، ومتى حصلت واسطة بينهما فانتفاء أحدهما لا يستلزم ثبوت الآخر، وعلى هذا المعنى يبتنى ثبوت المباح، وهو الذي لا ضرر ولا مصلحة فيه.
وإذن فانتفاء الضرر هنا لا يستلزم ثبوت المصلحة، ومن هنا قلنا: إن حديث لا ضرر رافع للتكليف لا مشرع، فهو لا يتعرض إلى أكثر من ارتفاع الأحكام الضرورية عن موضوعاتها، أما إثبات أحكام أخر فلا يتعرض لها، وإنما المرجع فيها إلى أدلتها الأخرى. وإذا اتضح هذا لم يبق أمام الطوفي ما يصلح للاستدلال به على المصالح المرسلة فضلًا عن الغلو فيها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)، (2) مصادر التشريع، ص 75.
(3) مصادر التشريع، ص 75.
(4) رسالة الطوفي، ص 90.
(5) رسالة الطوفي، ص 91.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 ﴿غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ هل هو تكرار؟
﴿غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ هل هو تكرار؟
الشيخ محمد صنقور
-
 (وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ)؟!
(وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ)؟!
الشيخ مرتضى الباشا
-
 ما هي ليلة القدر
ما هي ليلة القدر
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 لماذا يصاب المسافر بالأرق ويعاني من صعوبة في للنوم؟
لماذا يصاب المسافر بالأرق ويعاني من صعوبة في للنوم؟
عدنان الحاجي
-
 معنى سلام ليلة القدر
معنى سلام ليلة القدر
السيد محمد حسين الطهراني
-
 لأجل ليلة القدر، الأخلاق الفاضلة وقوة النفس
لأجل ليلة القدر، الأخلاق الفاضلة وقوة النفس
السيد عباس نور الدين
-
 معنى (نكل) في القرآن الكريم
معنى (نكل) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 مميّزات الصّيام
مميّزات الصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
الشعراء
-
 عرجت روح عليّ وا أمير المؤمنين
عرجت روح عليّ وا أمير المؤمنين
حسين حسن آل جامع
-
 جرح في عيون الفجر
جرح في عيون الفجر
فريد عبد الله النمر
-
 من لركن الدين بغيًا هدما
من لركن الدين بغيًا هدما
الشيخ علي الجشي
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

الصوم رائض وواعظ
-

علماء يطورون أدمغة مصغرة، ثم يدربونها على حل مشكلة هندسية
-

العدد الحادي والأربعون من مجلّة الاستغراب
-

إحياء ليلة القدر الكبرى في المنطقة
-

المساواة في شهر العدالة
-
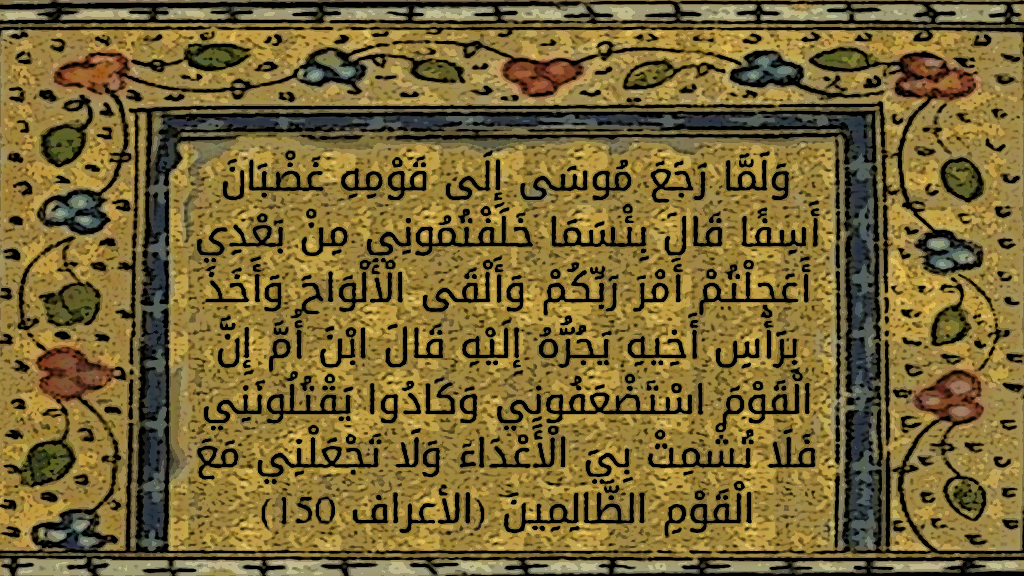
﴿غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ هل هو تكرار؟
-
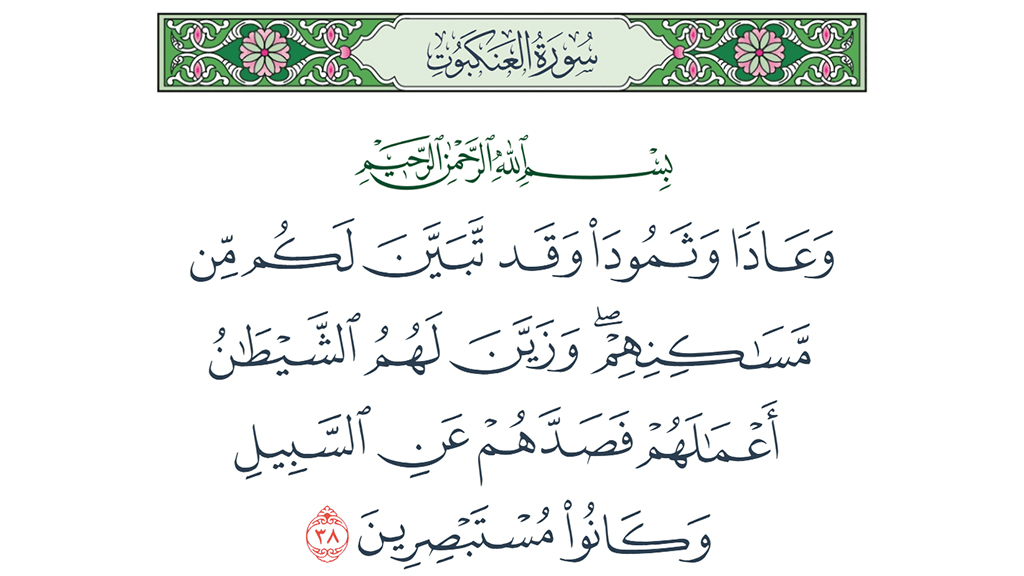
(وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ)؟!
-

شرح دعاء اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان
-

ما هي ليلة القدر
-

لماذا يصاب المسافر بالأرق ويعاني من صعوبة في للنوم؟










