علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".المعنى في دُنُوِّهِ وتعاليه (1)

لا وجودَ بلا معنى، ولا معنى لوجودٍ من دون نطقٍ ولغة. كما لو أنَّ قَدَرَ الإنسان أن ينفرد بمزيَّة التعرُّف بالكلمات على معنى الوجود وسرِّ الإيجاد من دون سائر الموجودات. وسواءٌ جاءَكَ المعنى بالاستقراء المنطقيِّ، أم من تأتِّيات الحدس والمكاشَفة، يظلُّ الموجود العيانيُّ هو الذي يستدرجك لإدراكه والاستفهام عمَّا يستتر فيه. فإنَّك في هذه الحال، تلقاءَ حقلٍ هيرمنيوطيقيٍّ لا متناهٍ يدعوك إلى فهمه وسَبر مجهولاته. فالمعنى كامن في هذا الحقل أنَّى تكثَّرت أجناسه ومراتبه وأنواعه وما يحويه. ولئن كان عالم المعاني مستقلًّا -كما يقال- عن عالم الألفاظ والأشياء والحوادث، فذلك ممَّا يوجبُ علينا التمييز بين ما يصدر عن الأشياء البادية للعيان من معانٍ، وبين ما ينبغي مكابدتُه لمعرفة ما يتخفَّى وراءها من أسرارٍ وغوامض.
المعنى في مقام الاصطلاح
تُبيِّن المدوَّنة المعجميَّة أنَّ ما يطويه اصطلاح المعنى، هو كلُّ ما يتأتَّى ويُفهمُ من ظاهر الَّلفظ، فلا يحتاج فهمه إلى وساطة. أمَّا ما يُقصد من معنى المعنى فهو ذلك الفضاء التأويليُّ الذي تتمدَّد فيه الأفهام وتتكثَّر المعاني. السبيل إليه، أن تعقل من الَّلفظ معنىً ما، ثمَّ يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر، وكذا دواليك. والخلاصة أنَّ المعاني الأولى هي تلك التي تُفهمُ من الألفاظ نفسها، بينما المعاني البَعديَّة اللَّاحقة هي التي يُومأُ إليها بتلك المعاني ليقوم المعنى الدلاليُّ أخيرًا بتظهيرها على أطوار ومراتب شتَّى. وأنَّى كان الأمر، فإنَّ “معنى المعنى”، وإن راح يتمدَّد إلى المابعد المفتوح على فضاء التأويل، يبقى على رباط وثيق بالَّلفظ الذي يحمله على الظهور والاعتلان، ما يعني أنَّ تحصيل معنى حقيقة الشيء، وحتى يصير مطابقًا للقصد، ينبغي أن يرتقي إلى مقام أبلغ في مندرجات الفهم. أي أن ينمو ويترقَّى في أحضان البلاغة بوصفها علمًا تُعرَفُ به أحوال الَّلفظ الذي يطابق مقتضى الحال. ربما هذا هو الذي قصدته العرب لـمَّا قالت: “لو شئتَ معنىً شريفًا فتخيَّر له لفظًا شريفًا”. كما لو أنَّ البيان الجماليَّ هو القيمة الحاكمة على معنى الشيء، وهذه القيمة هي التي تعرب عن ماهيَّته وحقيقته الذاتيَّة. المقصود من الَّلفظ الشريف في هذا المقام هو تبيين سموِّ المعنى للقضيَّة الـمُراد فهم معناها على الوجه الأحسن. إذ المعنى الرديء لزومه لفظٌ رديء، وكذلك الجميل، فإنَّ مقتضى تحصيل معناه أن يُهيَّأ له لفظٌ جميلٌ يناسبه ويكون على شاكلته. وما كلُّ هذا إلَّا لأنَّ ترتيب الألفاظ في النطق- كما يقرِّر النُحَّاة- يجري على ترتيب المعاني في النفس.
الأمر البديهيُّ، أنَّك لو شئتَ الحصول على معنى الشيء – في بُعدَيه البائن والمخبوء – وَجَبَ أن تعيشه وتختبره من دون مُسبَقات مفاهيميَّة. فغالبًا ما تشكِّل المفاهيم والتصوُّرات عائقًا أمام جلاء التعرُّف على حقيقة الشيء المطلوب فهمُه. فإنَّك متى أدركتَ معنى هذا الشيء بالمشاهدة والحضور لا يعود ثمَّة حاجة -حالئذٍ – إلى نظريَّة معرفة. فهذه الأخيرة لاحقة على تحصيل معنى الشيء وإدراك حقيقته.. إذ من بعد أن تعاين الشيء بالعيش المجرَّب تتبدَّى لك معالم الصواب الموصلة إلى ماهيَّته ومعناه. يسري ذلك على أفراد الأشياء كما تبدو لك في الواقع، وكذلك على “الشيء في ذاته”، بالتبصُّرِ والشهودِ العقليِّ من بعد ذلك. واستتباعًا لهذه الصيرورة، ينفتح أفق التعرُّف على مُبدِئِ المبادئ ومعاني فعله وغايته. هنالك على وجه التعيين، أي حين يصل الاستفهام عن معنى الألوهيَّة وعنايتها بالعالم يرتفع المعنى عمَّا يحدُّه من حدود، مثلما ترتفع الستائر التي تحجبه عن النَّظر. الأمر الذي يشير إلى أنَّ كشف معنى كلِّ موجود هو عمليَّة تأويليَّة شخصيَّة لا تفضي بالضرورة إلى تشكُّل نظريَّة معرفة جامعة للمعنى.
من الشواهد على ما تَقدَّم، وفي سياق تظهيرها الإبستمولوجيِّ للمعنى، لم تقرّ الحكمة المتعالية أن يكون بإمكان الإنسان الحصول على أيِّ معنىً ذهنيٍّ – تصوُّرًا كان أو تصديقًا – ما دام هو في متن شهود الواقع. ولعلَّ أول تجلٍّ لشهود كهذا على صعيد المفاهيم والمعاني الذهنيَّة هو «مفهوم الوجود». ففي متن الشهود الواقعيِّ بالذات يدرك الإنسان حقيقة وجوده الخاصِّ بالعلم الحضوريِّ، ويجد معنى وجوده الجزئيِّ في الذِّهن، ومن هنا يُنتَزع معنى «الوجود» الكلّيِّ، ويُطلَق عنوان «المفهوم» على هذا المعنى الحصوليّ.
في السياق إيَّاه، يُشار إلى نوعين من إدراك المعاني هما: الإدراك الحقيقيُّ، والإدراك الاعتباريّ. الأول، كناية عن انكشافات وانعكاسات ذهنيَّة للواقع، والثاني، يجيء في صيغة افتراضات صنَّعها الذِّهنُ لرفع الحاجات الحياتيَّة. وهذه الافتراضات تمتاز بكونها موضوعة وتابعة، وبكونها أيضًا فَرَضيَّة واعتباريَّة ونفس أمرها هو الصنع والوضع الصادر من الإنسان. كذلك يجوز القول، أنَّ الإدراكات الحقيقيَّة ليست تابعة لحاجات الكائن الحيِّ الطبيعيَّة وعوامل خاصَّة في بيئة عيشه، فلا تتغيَّر بتغيُّر الحاجات الطبيعيَّة والعوامل البيئيَّة، في حين أنَّ الإدراكات الاعتباريَّة تابعة للحاجات الحياتيَّة والعوامل البيئيَّة الخاصَّة، فتتغيَّر بتغيُّرها. فضلًا عن ذلك جميعًا، فإنَّ الإدراكات الحقيقيَّة ليست قابلة للتطوُّر والنشوء والرُّقيِّ، بينما الإدراكات الاعتباريَّة تسير سيرًا ديناميًّا باتِّجاه التكامل والترقِّي. ولقد أعرب ملَّا صدرا عن ذلك لـمَّا رأى أنَّ الأشياء المحسوسة المادِّيَّة تحكي الحقيقة القيوميَّة حكايةً ضعيفة بعيدة، وذلك بسبب كثرة حُجُبها. لكنَّ الأشياء الواقعة فوق مرتبة المادَّة – سواء كانت برزخيَّة أم عقليَّة – لها حكايتها الأقوى بالقياس إلى الأشياء المحسوسة.
أمَّا حيال كيفيَّة العلم بحقائق الأشياء فنراه يوضح أنَّ الإنسان – وبقدر سعته الوجوديَّة – قد وصل إلى متن الواقع وتوسَّع في دائرة المعاني الموجودة لديه على أساس هذا الوصول. ثمَّ يعلم -أي الإنسان- أنَّ العلم بالعلَّة يُنتج العلمَ بالمعلول، وأنَّ العلم بحقائق الأشياء بعد الفناء في الله والوصول إلى الإلهيِّ، لا يكون كإفاضة صورة من الشيء في قلب الإنسان العالِم، ولا كالنظر إلى الشيء المعلوم في مرآة الحقِّ، بل كالنظر إلى حقيقة الشيء في الموطن الخاصِّ به. وعليه، تذهب نفسُ العالم نحوَ المعلوم، وتدرك حقيقتَه كما هي. وعلى أساس هذا التفسير، يحدُث شهود الأشياء في مواطنها الخاصَّة بها بوساطة شهود علَّتها، فمع أنَّ لكلِّ شيء في موطن الطبيعة- وفوق ذلك في موطن البرزخ، وفوقهما في الخزائن الإلهيَّة، وقبل هذه كلِّها في علم الحقِّ الذاتيِّ- وجودًا بسيطًا جامعًا إلهيًّا، بل إنَّ جميع هذه الوجودات في مواطنها هي أمر واحد مشكَّك، إلَّا أنَّ مفهومها وماهيَّتها واحدة متشابهة تعرضها الكثرةُ بالعرَض وبتبع الوجود.
من هنا، فإنَّ إدراكًا حقيقيًّا كهذا موجود في كلِّ من مواطن الطبيعة والمثال والخزائن الإلهيَّة وعلم الحقِّ الذاتيِّ بوجود بسيط وجامع إلهيٍّ ويكون بالحضور والشهود، وحكم كلٍّ منهما ممتاز عن الآخر، و«المعنى» هو ذلك الوجود الذي يقع في مراتب الكون المختلفة بصورة تشكيكيَّة بحمل الحقيقة والرقيقة، ويدركه الإنسان ببركة اتِّحاد العلم والعالم والمعلوم.
المعنى وحقيقة الشيء
لا يتوقَّف البحث عن المعنى بما هو حقيقة الشيء، عند تخوم البادي من هذا الشيء. فلو حصل أنَّ جرى التوقُّف عند تخوم ما يبدو ويظهر، لَتَعذَّر على الساعي نحو المعنى، أن يوصل مسعاه إلى غايته. ولأنَّ من بديهيَّات الفكر وطبائعه استكشاف باديات الوجود وتحرِّي أصولها والعلم بمبدئها، ولماذا بدأت، وإلى أين ستؤول؟ فإنَّ رحلة التعرُّف ماضية في انفتاحاتها على ما لا يتناهى من معانٍ. في هذا المنفسَح، تصحُّ مشروعيَّة القول بأنَّ ثمَّة حقائق تمكث وراء ما يتبدَّى من مظاهر الأشياء ومعانيها. وما هذا إلَّا لأنَّ العلم بالبديهيَّات الأولى يشكِّل مدخلًا إلى تفسير وكشف الغوامض والمجهولات.
ولئن تكلَّمنا بلسان المعنى اتَّضح لنا أنَّ معاني الأشياء لا تُنال من الصور البادية منها؛ بل حتى لو حظي الساعي بشيء منها فلن يتعدَّى سعيُه أرض النقص. لهذا، سينعتُ الشيخ محيي الدين ابن عربي الأعيان الآدميَّة بأنَّها “كانت حروفًا عاليات لم تُقرأ”، كما لو أنَّه يشير إلى أنَّ المعنى الأنطولوجيَّ للإنسان راجعٌ إلى أمرٍ بَدئيٍّ لا يُفقَهُ سرُّه إلَّا في سماء الرحمانيَّة، أو لدى من عنده علم الكتاب. وهذا الأخير علمٌ عزيز ومفارق ليس بمقدور العقل القياسيِّ الإحاطة بمقدِّماته ومآلاته. والسبب هو أنَّ ما يعقله الفكر من أجل أن يستخرج معناه مقيَّدٌ بالعقل المقياسيِّ نفسه، ما يعني أنَّ العقل بهذه المثابة منحصرٌ في كهف التقييد، وكلّ ما يُقيَّد بشروط المعقوليَّة المقياسيَّة ومعاييرها يبقى أسير الكون الناقص وتحت ظلاله.
في محضر الكلام على “المعنى” و”معنى المعنى”، قد يكون علينا التمييز بين حقلين معرفيَّين: أوَّلهما، حقل التعرُّف على ظواهر الأشياء. وثانيهما، حقل الاستفسار عمَّا تنطوي عليه الأشياء من خفايا يتعذَّر إدراكُها ما لم يتهيَّأ المستفسرُ للانتقال إلى طور مُفارِق من المكابدة، وعلى نحو يجاوز فيه الَّلفظ وفرضيَّات الذهن والواقع المباشر. ولبيان القصد، يمكن أن نؤسِّس مسعانا على مجالين متَّصلين ومُفارِقين في الآن عينه: الأول، مجال المعنى الفاني المحكوم بالتغيُّر والتبدُّل والزوال، والثاني، مجال المعنى الباقي المؤيَّد بسيرورة الثبات والديمومة.
يتَّخذ المعنى الفاني صفة الفناء لتعلّقه بالموجود المتغيِّر والزائل. أمَّا المعنى الباقي فـ”بقائيَّته” عائدةٌ إلى استمداد مكانته الوجوديَّة ممَّا هو باقٍ ودائم ولا متناهٍ. الأول يفضي إلى الاكتفاء باستظهار المعاني الفانية ممَّا هو عارضٌ وفانٍ؛ وهو ما عكفت عليه الميتافيزيقا القبْليَّة لـمَّا أخلدت إلى دنيا المفاهيم فاستيقنتها، أمَّا الثاني، فقد اتَّخذ سبيلًا إلى ميتافيزيقا بَعديَّة ترمي إلى اكتناه سرِّ الوجود والاهتداء إلى حكمة الإيجاد من أجل بلوغ المعنى الأتم. رُبَّ ثمة من يتساءل عمَّا إذا كان فهم معنى الظواهر ممكنًا علميًّا بالتجربة والاستدلال والاستقراء المنطقيِّ، ثمَّ يضيف محتجًّا، أنَّ ما يعرب عنه التعالي الميتافيزيقيُّ إن هو إلَّا استشعار حدسيٌّ أو عاطفيٌّ لا برهان عليه، ولا دليل يوصل إلى كنه معناه وماهيَّته. ثمَّ يخلص إلى أنَّ ما يُتوصَّل إليه هو خالٍ من المعنى تمامًا، بدعوى أنَّ كلَّ لفظ لامعنى له إلَّا متى علمنا مسبقًا قابليَّته للاستنباط، وبأيِّ وجه يمكن التحقُّق منه.
من أجل هذا، سينبري رهطٌ من الفلاسفة المحدَثين إلى القول بلا جدوى الألفاظ والمفردات الميتافيزيقيَّة؛ نظير “المبدأ” والشيء في ذاته- والروح والمطلق – والفيض – والتجلِّي- والكشف إلخ… وذريعتهم في هذا أنَّ هذه الألفاظ لا معنى لها، بمعزل عن البناء العنصريِّ الذي تتقوَّم به. وعليه، فإنَّ الألفاظ والكلمات تكتسب معناها وقيمتها من حيث كونها تعيُّنات واقعيَّة فحسب، وأمَّا الميدان الوحيد الذي تتحقَّق فيه مثل هذه المعادلة فهو ميدان العلم التجريبيّ.
مثل هذه الدعاوى تختزل سياقًا مديدًا ممَّا كان تأسَّس ثمَّ أعيد تأسيسه في تاريخ الفلسفة الكلاسيكيَّة. سوى أنَّ معضلة المعنى التي استوطنت أرض الميتافيزيقا منذ البدء اليونانيِّ مع السوفسطائيَّة والمشائيَّة، ستقود حضارة الُّلوغوس إلى ضربٍ من فراغٍ عجيبٍ غزا عالم المعنى وراح يستحوذ عليه. والفراغُ العجيبُ ذاكْ، يتراءى على صورة شغبٍ مُستدام في معركة المعنى. والخائضُ في لُجَّته محمولٌ على الظنِّ بأنَّ السؤالَ الـمُستَنْبَتَ من حجَّةِ العقلِ كفيلٌ بجعلِنا ننحني لظهورِ الحقيقة ومعانيها الخفيَّة. لكنْ، الظَّانُّ إيَّاهُ، كثيرًا ما يغفلَ عن أمرٍ يؤيِّده العقلُ نفسه، وهو أنَّ السؤالَ الذي اتُّخِذَ سبيلًا أوحَدَ لنيلِ الحقيقةِ المتأمَّلة، سوف يُمسي مع الزمنِ داءً لا شفاءَ منه. كلَّما انتهى السائلُ من سؤالٍ ابتدأ بآخر، حتى ليصير الخائضُ في اللُّجَّةِ كالظَّمآنِ المضطرِّ لماءِ البحرِ كلَّما ارتوى ازداد عطشًا.
في الفراغ العجيب لا استشعارَ للمكانِ ولا للزمانِ، حتى ليخالُ الذي هو ساكنٌ فيه كأنَّه في تيهٍ لا مُمْسِكَ له، أو لكأنَّه شيءٌ محاطٌ باللَّاشيء. إنَّه غريبٌ في أرضهِ، ولا يجدُ ما يؤنسهُ في غربتهِ سوى علاماتِ استفهامٍ لا جوابَ عليها. حتى لقد بدا العائشُ في حقله الزئبقيِّ كمثْلِ من يقف بقدمينِ مهزوزتينِ وقد أوشك على السقوطِ من منحدرٍ شاهقْ. وحالذاك يصير الـمُمتَحنُ في ابتلاءاتِ المعنى حاملًا في نفسه ضدَّين يتنازعانه على غير هدى: ضدٌّ يصرُفه عن الاهتداء إلى معنى فاضل لكينونته في الوجود.. وضدٌّ يدعوه إلى الانعتاقِ والتحرُّر ممَّا هو فيه فلا يجد إلى ذلك سبيلًا.. ولولا أن بقيَ للمُمتحنِ حظٌّ من عقلٍ يميِّز الخير من الشرِّ، ورجاءٌ يُسكنُ الفؤادَ الحائر، لمكثَ في بطنِ الظُّلمةِ أبدًا.
السؤال كدُربة للعثور على المعنى
من أجل أن يصل الباحث عن المعنى إلى مأربه، سَلَك دربة السؤال. إلَّا أنَّه سيعلم أنَّه لن يعثر على جوابٍ شافٍ من دون سؤال يتوفَّر على مقوِّمات الشفاء. فالسؤال ذو المعنى لا مناص من أن يفضي إلى إجابة ذات معنى لقد اختبر العقل البشريُّ بالسؤال أول تمرين له في رحلة الاستفهام الأنطولوجيِّ عن معنى الوجود بأركانه الثلاثة: الله، الكون، الإنسان. مؤدَّى ما نقصده من الاستفهام، أنَّ الفلاح بمعنى الوجود والموجود يجري عن طريق السؤال الذي يتاخم الأصل والبَدء والماهيَّة الذاتيَّة للشيء المستفهَم عنه. وهذا النوع من السؤال له وجهة تفارق سائر الأسئلة؛ لأصالته التأسيسيَّة للمعنى. فالسؤال الذي لا يؤسِّس ولا تؤسَّس عليه المعاني والكشوفات لا يُعوَّل عليه.
ومقتضى التأسيس العودة إلى منابت الأفهام والأفكار، وتمييز صوابها من بطلانها، ثمَّ إعادة تأليفها تبعًا لتحوُّلات الأزمنة وشروطها. ما يعني أنَّ السعي للعثور على سؤال مؤسِّس هو فعلٌ زمانيٌّ ومكانيٌّ بقدر ما هو فعلٌ يجاوز الزمان والمكان. لكن، وفقًا لمبدأ التكامل، فإنَّ جميع ما في العالم ـ على تراتب موجوداته واختلافها بما فيها الكائن الإنسانيُّ ـ له نصيبه في التأسيس، وكلٌّ بحسب وضعيَّته الوجوديَّة. ذلك بأنَّ رسم حدود التمايز بين الإنسان والشيء لا يعني تغييب الشيء عن الحضور بوصفه عنصرًا جوهريًّا في تكوين هذا السؤال. فالكائنات كلُّها مطويَّة فيه ومتضمَّنة في غضونه، ولولاها لما كان للسؤال أن يُطرح، ولا كان له أن يكون سؤالًا يستدرج روح المعنى. حتى الاستفهام عن المطلق الذي يفترضه الذهن البشريُّ حين يتأمَّل عالم المعنى، لا ينفصل البتَّة عن عالم الممكنات.
فعالم الإمكــان ضروريٌّ في تظهــير السـؤال المؤسّس والتعرُّف على إمكانيَّاتــه ووعوده. وما ذاك إلَّا لأنَّ الممكنات التي تمدُّ الحياة الإنسانيَّة بأسباب القدرة والديمومة هي التي توفِّر للسؤال مواقيته ومكان حدوثه. لكن السؤال المؤسِّس رغم عنايته بعالم الإمكان يبقى متعلقًا بمهمَّته الأصليَّة من خلال اعتنائه بالحقيقة المؤسِّسة للوجود. وعليه، لا يُنجز الاستفسار عن الشيء وشيئيَّته، ولا عن الموجود بما هو موجود، بمعزل عن هذه المهمَّة. فقد بذلت الميتافيزيقا مذ أبصرت النور في أرض الإغريق وإلى يومنا الحاضر، ما لا حصر له من المكابدات، إلَّا أنَّها غالبًا ما انتهت إلى الَّلايقين. لقد اختبرت النومين (الشيء في ذاته)، والفينومين (الشيء كما يظهر)، وكانت النتيجة أن نشأ حائلٌ حدَّ من جاذبيَّة العقل، وحال دون قدرته على تحرِّي غموض الوجود وخفائه.
وعليه، فإنَّ ثمَّة جدليَّة اتِّصال وانفصال بين هذا السؤال ومراتبه الوجوديَّة. ولـمَّا أن كان الوجود واحدًا متَّصلًا ومبنيًّا على التراتب، كذلك يكون الاستفهام عنه. أي أنَّه وجود واحد ذو مراتب. ولإنجاز الاستفهام وفق هذه الجدليَّة، وجدنا أن نرى إلى السؤال على ثلاث مراتب: – سؤال فانٍ، سؤال باقٍ، وسؤال يتردَّد بين الفناء والبقاء. ولكلٍّ من هذه المنازل خصائصُه المعرفيَّة ومقتضياتُه وظروفُه الزمانيَّة والمكانيَّة وآثارُه النفسيَّة والمعنويَّة.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 خصائص الصيام (1)
خصائص الصيام (1)
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الشيخ محمد صنقور
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 معرفة الإنسان في القرآن (6)
معرفة الإنسان في القرآن (6)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (فور) في القرآن الكريم
معنى (فور) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

خصائص الصيام (1)
-

الموانع من حضور الضيافة الإلهية
-

البعث والإحياء بعد الموت
-

حديث للاختصاصيّ النّفسيّ أسعد النمر حول توظيف التّقنية في العلاج النّفسيّ
-

التقوى، العطاء، الإيثار في شهر رمضان
-

شرح دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان
-
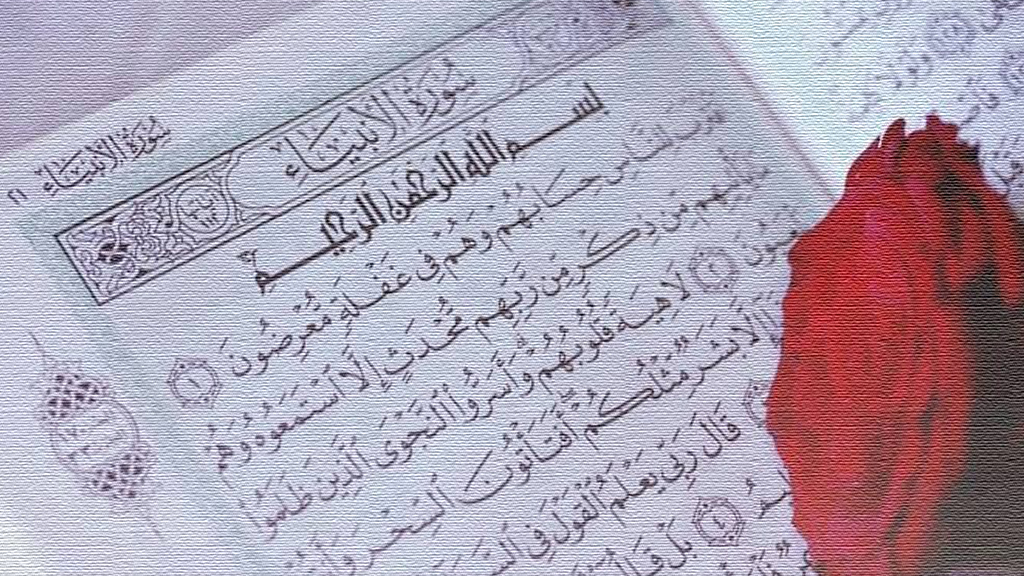
معرفة الإنسان في القرآن (6)
-

شرح دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان
-

لقاء الرحمة والعبادة
-

معنى (فور) في القرآن الكريم










