قرآنيات
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ علي رضا بناهيانعن الكاتب :
ولد في عام 1965م. في مدينة طهران وكان والده من العلماء والمبلغين الناجحين في طهران. بدأ بدراسة الدروس الحوزوية منذ السنة الدراسية الأولى من مرحلة المتوسطة (1977م.) ثم استمرّ بالدراسة في الحوزة العلمية في قم المقدسة في عام 1983م. وبعد إكمال دروس السطح، حضر لمدّة إثنتي عشرة سنة في دروس بحث الخارج لآيات الله العظام وحيد الخراساني وجوادي آملي والسيد محمد كاظم الحائري وكذلك سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي. يمارس التبليغ والتدريس في الحوزة والجامعة وكذلك التحقيق والتأليف في العلوم الإسلامية.تشبيه الإيمان بالحياة

الشيخ محمد جواد مغنية
قال تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَ﴾[الأنعام: 122].
قد يقول القائل: إنَّ الآية شبَّهت الإيمان بالحياة، والكفر بالموت، مع أنَّ الكافرين والملحدين في هذا العصر أكثر ثراءً ورفاهية من المؤمنين والعابدين.
الجواب: ليس المراد بالحياة في هذه الآية أن يعيش الإنسان في النعيم والرفاهية، فيأكل طيّباً، ويلبس ثميناً، ويشرب سائغاً... إن الرفاهية لا تناط بالكفر ولا بالإيمان، وإلا كان المؤمنون سواء في الشرق والغرب من حيث الحضارة والرفاهية، وكذلك الملحدون والكافرون. إن للرفاهية أسباباً وملابسات لا تمتّ إلى الإيمان والكفر بسبب.. وإنما المراد بالحياة في الآية، الإيمان والشعور الديني الذي يدفع بصاحبه إلى القيام بالواجب كإنسان مسؤول عن سلوكه، يحاسب عليه، ويكافأ على إحسانه بالثّواب، وإساءته بالعقاب.
ولو كان الإنسان غير مسؤول عن شيء، لكانت الشرائع والقوانين ألفاظاً بلا معان.. ومتى سلّمنا بأنّ الإنسان مسؤول، ولا يترك سدى، يلزمنا حتماً أن نسلم بأنّه مسؤول أمام من لا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون.. ولو كان هذا السائل مسؤولاً، لوجب وجود سائل له، وهكذا إلى ما لا نهاية.
ومن كفر بوجود السائل الأعلى الّذي يسأل ولا يسأل، فقد كفر بالمسؤوليّة ونفاها من الأساس، لأنه لا مسؤوليّة من غير سائل، ومن كفر بالمسؤوليّة، فقد كفر بالحياة الاجتماعية.
وتقول: أجل، إن الإنسان مسؤول، ولكن ليس من الضروريّ أن يكون السائل هو الله، فللناس أن يختاروا هيئة منهم يكون الإنسان مسؤولاً أمامها.
ونسأل بدورنا: إذا أخطأت هذه الهيئة، فمن يسألها ويحاسبها؟ وإن قيل: الوجدان، قلنا: أوّلاً الوجدان أمر معنويّ لا عينيّ. وثانياً: أن الوجدان مشاع يدّعيه كلّ واحد، فلماذا يترك هذا لوجدانه دون ذاك؟ إذاً، لا سائل غير مسؤول إلا الله وحده، فمن آمن بالله وألزم نفسه بشريعته وأحكامه، فقد سار على بصيرة من أمره في عقيدته وسلوكه، وإلا كان مثله كمن يمشي في الظلمات ليس بخارج منها.
﴿كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[الأنعام: 122]. أي مثل ما زيّن للمؤمنين أعمالهم، أيضاً زيّن للمشركين أعمالهم، والفرق أنّ تزيين أولئك انعكاس عن الواقع، وتزيين هؤلاء وهم وخيال.
﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَ﴾[الأنعام: 123]. المراد بالقرية كلّ مجتمع من الناس قلّ أو كثر، والمعنى أنّه كما وجد في مجتمعك يا محمّد رؤوس للإجرام تمكر وتنصب العداء لدين الله، كذلك وجد في المجتمعات السابقة، ويوجد في اللاحقة أيضاً، رؤساء يمكرون بأمّتهم، ويقفون موقف العداء للحقّ وأهله.
وتسأل: ظاهر الآية يدلّ على أن الله سبحانه هو الذي جعل أكابر المجرمين يجرمون ويمكرون بأهل الحقّ، مع العلم بأنّه تعالى ينهى عن المكر والإجرام، ويعاقب عليهما، فما هو التّأويل؟.
الجواب: إنّ القصد من هذه النّسبة إليه جلّ ثناؤه، هو الإشارة إلى أنّ مشيئة الله قضت بأن تقوم السنن الاجتماعيّة على أساس التناقض بين المحقّين والمبطلين، بين أرباب السلطان المعتدين، وبين الناس المعتدى عليهم، ولا مفرّ من هذا التناقض والصراع إلا بالقضاء على المجرمين، ولا بدّ أن يتم ذلك، وتعلو كلمة الحقّ على أيدي دعاة العدل والصلاح، مهما تضخّم الباطل واستطال. وقد سجّل سبحانه ذلك في كتابه، حيث قال عزّ من قائل: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلً}[فاطر: 43]. إنّ هذا التكرار تأكيد قاطع بأنّ العاقبة للمتقين على المجرمين، مهما طال الزمن، وبهذا نجد تفسير قوله تعالى: ﴿لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾[الأنعام: 123].
﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ﴾ [الأنعام: 124].
اختلف المفسّرون في معنى هذه الآية، على قولين: الأوّل أن أكابر المجرمين من العرب اقترحوا على محمّد (صلى الله عليه وآله) أن يأتيهم من المعجزات مثل ما أوتي موسى من فلق البحر، وعيسى من إحياء الموتى. القول الثاني: أنهم قالوا له: لن نؤمن حتى ينزل علينا الوحي كما نزل على الأنبياء. وقال الرازي: هذا القول مشهور بين المفسّرين. ونحن نرجّحه على الأوّل، لأن سياق الآية يدلّ عليه، حيث ردّ سبحانه على أكابر المجرمين بقوله: ﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: 124].
بالإضافة إلى أنّ طلبهم أن ينزل الله الوحي عليهم، يتلاءم مع حسدهم لرسول الله.
قال تعالى في الآية 54 من سورة النساء: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: 54]. وفي مجمع البيان وغيره، أنّ الوليد بن المغيرة قال للنبيّ (صلى الله عليه وآله): "لو كانت النبوّة حقّاً، لكنت أولى بها منك، لأني أكبر منك سنّاً، وأكثر منك مالاً".
ومعنى قوله: ﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ﴾ واضح، وهو أنه تعالى يختار لرسالته من يصلح لها من خلقه، ومحمد أكرم خلق الله وأشرفهم.
﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللهِ﴾، لأنهم استعلوا وتعاظموا، فاستحقّوا الجزاء بالاحتقار والإذلال. وفي بعض الروايات: أن المتكبرين يحشرون في صورة الذرّ، يطأهم الناس بأقدامهم جزاءً على تعاظمهم في الدنيا ﴿وعَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ﴾.
فالصغار جزاء التكبر، والعذاب جزاء المكر والخداع. وبكلمة، إن الله سبحانه يعامل أرباب النوايا الخبيثة، والأهداف الفاسدة، بعكس ما يقصدون ويهدفون.
________________________________________
الكتاب
-
 خصائص الصيام (2)
خصائص الصيام (2)
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 معرفة الإنسان في القرآن (7)
معرفة الإنسان في القرآن (7)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الشيخ محمد صنقور
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 معنى (فور) في القرآن الكريم
معنى (فور) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

خصائص الصيام (2)
-

الإرادة والتوكل في شهر رمضان
-
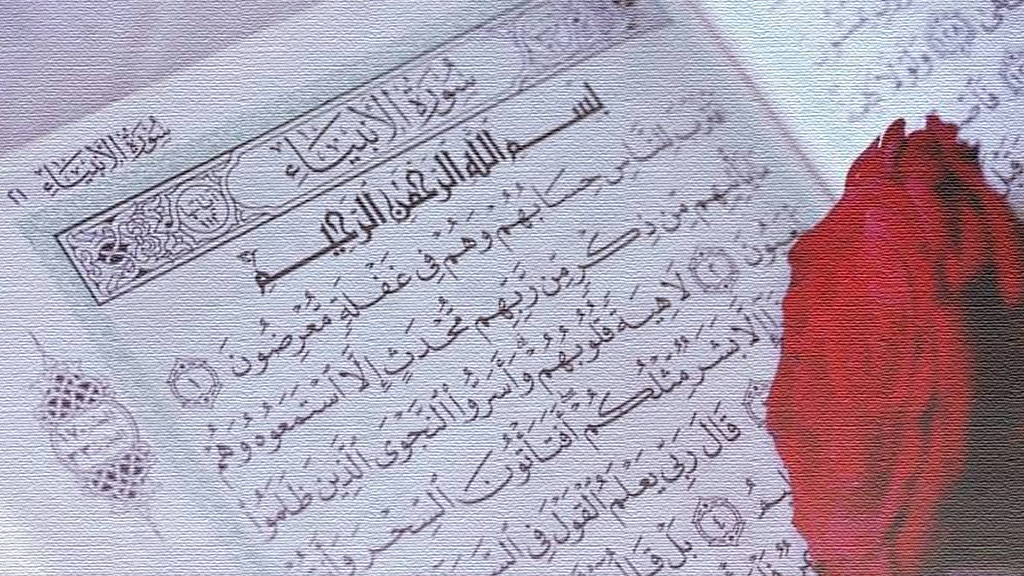
معرفة الإنسان في القرآن (7)
-

شرح دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان
-

خصائص الصيام (1)
-

الموانع من حضور الضيافة الإلهية
-

البعث والإحياء بعد الموت
-

حديث للاختصاصيّ النّفسيّ أسعد النمر حول توظيف التّقنية في العلاج النّفسيّ
-

التقوى، العطاء، الإيثار في شهر رمضان
-

شرح دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان









