قرآنيات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد محمد باقر الصدرعن الكاتب :
ولد في مدينة الكاظمية المقدسة في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 1353 هـ، تعلم القراءة والكتابة وتلقى جانباً من الدراسة في مدارس منتدى النشر الابتدائية، في مدينة الكاظمية المقدسة وهو صغير السن وكان موضع إعجاب الأساتذة والطلاب لشدة ذكائه ونبوغه المبكر، ولهذا درس أكثر كتب السطوح العالية دون أستاذ.rnبدأ بدراسة المنطق وهو في سن الحادية عشرة من عمره، وفي نفس الفترة كتب رسالة في المنطق، وكانت له بعض الإشكالات على الكتب المنطقية. بداية الثانية عشرة من عمره بدأ بدراسة كتاب معالم الأصول عند أخيه السيد إسماعيل الصدر، سنة 1365 هـ هاجر إلى النجف الاشرف، لإكمال دراسته، وتتلمذ عند آية الله الشيخ محمد رضا آل ياسين وآية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي. أنهى دراسته الفقهية عام 1379 هـ والأصولية عام 1378 هـ عند آية الله السيد الخوئي.rnمن مؤلفاته: فدك في التاريخ، دروس في علم الأصول، نشأة التشيع والشيعة، فلسفتنا، اقتصادنا وغير ذلك.توفّر القرآن على بحث سنن التاريخ

الساحة التاريخية كأيّ ساحة أخرى زاخرة بمجموعة من الظواهر، كما أنّ الساحة الفلكية، الساحة الفيزيائية، الساحة النباتية زاخرة بمجموعة من الظواهر، كذلك الساحة التاريخية - بالمعنى الذي سوف نفصّل من التاريخ إن شاء اللَّه بعد ذلك - زاخرة بمجموعة من الظواهر. كما أنّ الظواهر في كلّ ساحة أخرى من الساحات لها سنن ولها نواميس، من حقّنا أن نتساءل: هل أنّ الظواهر التي تزخر بها الساحة التاريخية، هل هذه الظواهر أيضاً ذات سنن وذات نواميس؟ وما هو موقف القرآن الكريم من هذه السنن والنواميس؟ وما هو عطاؤه في مقام تأكيد هذا المفهوم إيجاباً أو سلباً، إجمالاً أو تفصيلاً؟
وقد يخيّل إلى بعض الأشخاص، أنّنا لا ينبغي أن نترقّب من القرآن الكريم أن يتحدّث عن سنن التاريخ؛ لأنّ البحث في سنن التاريخ بحث علمي كالبحث في سنن الطبيعة والفلك والذرّة والنبا ، والقرآن الكريم لم ينزل كتاب اكتشاف بل كتاب هداية، القرآن الكريم لم يكن كتاباً مدرسيّاً، لم ينزل على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بوصفه معلّماً - بالمعنى التقليدي من المعلّم - لكي يدرّس مجموعة من المتخصصين والمثقّفين، وإنمّا نزل هذا الكتاب عليه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، لكي يخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الهداية والإسلام. إذن، فهو كتاب هداية وتغيير، وليس كتاب اكتشاف.
ومن هنا لا نترقّب من القرآن الكريم أن يكشف لنا الحقائق والمبادئ العامّة للعلوم الأخرى، ولا نترقّب من القرآن الكريم أن يتحدّث لنا عن مبادئ الفيزياء أو الكيمياء أو النبات أو الحيوان. صحيح أنّ في القرآن الكريم إشارات إلى كلّ ذلك، ولكنها إشارات بالحدود التي تؤكّد على البعد الإلهي للقرآن، وبقدر ما يمكن أن يثبت العمق الرباني لهذا الكتاب الذي أحاط بالماضي والحاضر والمستقبل، والذي استطاع أن يسبق التجربة البشرية مئات السنين في مقام الكشف عن حقائق متفرّقة في الميادين العلمية المتفرّقة، لكن هذه الإشارات القرآنية إنّما هي لأجل غرض عملي من هذا القبيل، لا من أجل تعليم الفيزياء والكيمياء.
القرآن لم يطرح نفسه بديلاً عن قدرة الإنسان الخلّاقة، عن مواهبه وقابلياته في مقام الكدح، الكدح في كلّ ميادين الحياة بما في ذلك ميدان المعرفة والتجربة، القرآن لم يطرح نفسه بديلاً عن هذه الميادين، وإنّما طرح نفسه طاقة روحية موجّهة للإنسان، مفجّرة طاقاته، محرّكة له في المسار الصحيح.
فإذا كان القرآن الكريم كتاب هداية وتوجيه وليس كتاب اكتشاف وعلم، فليس من الطبيعي أن نترقّب منه استعراض مبادئ عامّة لأيّ واحد من هذه العلوم التي يقوم الفهم البشري بمهمّة التوغّل في اكتشاف نواميسها وقوانينها وضوابطها. لماذا ننتظر من القرآن الكريم أن يعطينا عموميات، أن يعطينا مواقف، أن يبلور له مفهوماً علمياً في سنن التاريخ على هذه الساحة من ساحات الكون، بينما ليس ـ للقرآن مثل ذلك على الساحات الأخرى؟ ولا حرج على القرآن في أن لا يكون له ذلك على الساحات الأخرى؛ لأنّ القرآن لو صار في مقام استعراض هذه القوانين وكشف هذه الحقائق، لكان بذلك يتحوّل إلى كتاب آخر نوعياً، يتحوّل من كتاب للبشرية جمعاء إلى كتاب للمتخصّصين يدرّس في الحلقات الخاصة.
قد يلاحظ بهذا الشكل على اختيار هذا الموضوع، إلّا أنّ هذه الملاحظة رغم أنّ الروح العامّة فيها صحيحة، بمعنى أنّ القرآن الكريم ليس كتاب اكتشاف ولم يطرح نفسه ليجمد في الإنسان طاقات النمو والإبداع والبحث وإنّما هو كتاب هداية، ولكن مع هذا يوجد فرق جوهري بين الساحة التاريخية وبقية ساحات الكون، هذا الفرق الجوهري يجعل من هذه الساحة ومن سنن هذه الساحة أمراً مرتبطاً أشدّ الارتباط بوظيفة القرآن ككتاب هداية، خلافاً لبقية الساحات الكونيّة والميادين الأخرى للمعرفة البشرية؛ وذلك أنّ القرآن كتاب هداية وعمليّة تغيير، هذه العمليّة التي عُبّر عنها في القرآن الكريم بأنّها إخراج للناس من الظلمات إلى النور.
عمليّة التغيير الاجتماعي وأبعادها:
وعمليّة التغيير هذه فيها جانبان:
الجانب الأوّل: جانب المحتوى، المضمون، ما تدعو إليه هذه العملية التغييرية من أحكام، من مناهج، ما تتبنّاه من تشريعات، هذا الجانب من عملية التغيير جانب ربّاني، جانب إلهي سماوي، هذا الجانب يمثّل شريعة اللَّه سبحانه وتعالى التي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وآله وتحدّت بنفس نزولها عليه كلّ سنن التاريخ المادية؛ لأنّ هذه الشريعة كانت أكبر من الجوّ الذي نزلت عليه، ومن البيئة التي حلّت فيها، ومن الفرد الذي كلّف بأن يقوم بأعباء تبليغها.
هذا الجانب من عملية التغيير، جانب المحتوى والمضمون، جانب التشريعات والأحكام والمناهج التي تدعو إليها هذه العملية، هذا الجانب جانب ربّاني إلهي، لكن هناك جانب آخر لعمليّة التغيير التي مارسها النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه الأطهار: هذه العملية حينما تلحظ بوصفها عملية متجسّدة في جماعة من الناس وهم النبي والصحابة، بوصفها عملية اجتماعية متجسّدة في هذه الصفوة، وبوصفها عملية قد واجهت تيارات اجتماعية مختلفة من حولها واشتبكت معها في ألوان من الصراع والنزاع العقائدي والاجتماعي والسياسي والعسكري، حينما تؤخذ هذه العملية التغييرية بوصفها تجسيداً بشرياً واقعاً على الساحة التاريخية مترابطاً مع الجماعات والتيارات الأخرى التي تكتنف هذا التجسيد والتي تؤيّد أو تقاوم هذا التجسيد، حينما تؤخذ العملية من هذه الزاوية تكون عملية بشرية، يكون هؤلاء أناساً كسائر الناس تتحكّم فيهم إلى درجة كبيرة سنن التاريخ التي تتحكّم في بقية الجماعات وفي بقية الفئات على مرّ الزمن.
إذن، عملية التغيير التي مارسها القرآن ومارسها النبي صلى الله عليه وآله لها جانبان، من حيث صلتها بالشريعة وبالوحي ومصادر الوحي هي ربانية، هي فوق التاريخ، ولكن من حيث كونها عملاً قائماً على الساحة التاريخية، من حيث كونها جهداً بشرياً يقاوم جهوداً بشرية أخرى، من هذه الناحية يعتبر هذا عملاً تاريخياً تحكمه سنن التاريخ وتتحكّم فيه الضوابط التي وضعها اللَّه سبحانه وتعالى لتنظيم ظواهر الكون في هذه الساحة المسمّاة بالساحة التاريخية؛ ولهذا نرى أنّ القرآن الكريم حينما يتحدّث عن الزاوية الثانية، عن الجانب الثاني من عملية التغيير يتحدّث عن أناس، يتحدّث عن بشر، لا يتحدّث عن رسالة السماء، بل يتحدّث عنهم بوصفهم بشراً من البشر تتحكّم فيهم القوانين التي تتحكّم في الآخرين.
حينما أراد أن يتحدّث عن انكسار المسلمين في غزوة أحد بعد أن أحرزوا ذلك الانتصار الحاسم في غزوة بدر، بعد ذلك انكسروا وخسروا المعركة في غزوة أحد، تحدّث القرآن الكريم عن هذه الخسارة، ماذا قال؟ هل قال بأنّ رسالة السماء خسرت المعركة بعد أن كانت ربحت المعركة؟ لا؛ لأنّ رسالة السماء فوق مقاييس النصر والهزيمة بالمعنى المادي، رسالة السماء لا تهزم، ولن تهزم أبداً، ولكن الذي يهزم هو الإنسان، الإنسان حتى ولو كان هذا الإنسان مجسِّداً لرسالة السماء؛ لأنّ هذا الإنسان تتحكّم فيه سنن التاريخ.
ماذا قال القرآن؟ قال: «وتِلكَ الأيامُ نُدِاوِلُها بينَ الناسِ»(1). هنا أخذ يتكلّم عنهم بوصفهم أناساً، قال: بأنّ هذه القضية هي في الحقيقة ترتبط بسنن التاريخ، المسلمون انتصروا في بدر حينما كانت الشروط الموضوعية للنصر بحسب منطق سنن التاريخ تفرض أن ينتصروا، وخسروا المعركة في أحد حينما كانت الشروط الموضوعية في معركة أحد تفرض عليهم أن يخسروا المعركة. «إن يمسسكم قرحٌ فقد مسَّ القومَ قرحٌ مثلُهُ وتِلكَ الأيامُ نُدَاوِلُها بينَ الناسِ»(2). لا تتخيلوا أنّ النصر حقّ إلهي لكم، وإنّما النصر حقّ طبيعي لكم بقدر ما يمكن أن توفّروا الشروط الموضوعية لهذا النصر بحسب منطق سنن التاريخ التي وضعها اللَّه سبحانه وتعالى كونيّاً لا تشريعيّاً، وحيث إنّكم في غزوة أحد لم تتوفّر لديكم هذه الشروط ولهذا خسرتم المعركة.
فالكلام هنا كلام مع بشر، مع عملية بشرية لا مع رسالة ربانية، بل يذهب القرآن إلى أكثر من ذلك، يهدّد هذه الجماعة البشرية التي كانت أنظف وأطهر جماعة على مسرح التاريخ، يهدّدهم بأنهم إذا لم يقوموا بدورهم التاريخي، وإذا لم يكونوا على مستوى مسؤولية رسالة السماء فإنّ هذا لا يعني أن تتعطّل رسالة السماء، ولا يعني أن تسكت سنن التاريخ عنهم، بل إنّهم سوف يُستبدلون، سنن التاريخ سوف تعزلهم وسوف تأتي بأمم اأخرى قد تهيّأت لها الظروف الموضوعية الأفضل لكي تلعب هذا الدور، لكي تكون شهيدة على الناس إذا لم تتهيّأ لهذه الأمّة الظروف الموضوعية لهذه الشهادة: «إلّا تنفِروا يُعَذّبكم عَذاباً أليماً ويَستَبدِل قوماً غَيرَكُمْ ولا تَضرّوهُ شيئاً واللَّهُ على كُلِّ شيءٍ قدير»(3)، «يا أيّها الذين آمنُوا مَن يَرتدّ مِنكُم عن دِينِهِ فَسَوفَ يأتي اللَّهُ بقومٍ يُحِبُّهُم ويُحِبُّونَهُ أذِلَّةٍ عَلى المؤمنِينَ أعِزّةٍ عَلى الكافِرينَ يُجاهِدُون في سَبِيلِ اللَّهِ ولا يَخافُونَ لَومَةَ لَائِمٍ ذلِكَ فَضلُ اللَّهِ يُؤتِيهِ مَن يَشاءُ واللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ »(4).
إذن فالقرآن الكريم حينما يتحدّث عن الجانب الثاني من عملية التغيير، يتحدّث مع البشر، مع البشر في ضعفه وقوّت ، في استقامته وانحرافه، في توفّر الشروط الموضوعية له وعدم توفّرها.
من هنا يظهر بأنّ البحث في سنن التاريخ مرتبط ارتباطاً عضوياً شديداً بكتاب اللَّه بوصفه كتاب هدىً، بوصفه كتاب إخراج للناس من الظلمات إلى النور؛ لأنّ الجانب العملي من هذه العملية، الجانب البشري والتطبيقي من هذه العملية، جانب يخضع لسنن التاريخ، فلابدّ إذن أن نستلهم، ولابدّ إذن أن يكون للقرآن الكريم تصوّرات وعطاءات في هذا المجال لتكوين إطار عام للنظرة القرآنية والإسلامية عن سنن التاريخ.
إذن، هذا لا يشبه سنن الفيزياء والكيمياء والفلك والحيوان والنبات، تلك السنن ليست داخلة في نطاق التأثير المباشر على عملية التغيير، ولكن هذه السنن داخلة في نطاق التأثير المباشر على عملية التغيير، باعتبار الجانب الثاني. إذن لا بدّ من شرح ذلك، ولا بدّ أن نترقّب من القرآن إعطاء عموميات في ذلك.
نعم لا ينبغي أن نترقّب من القرآن أن يتحوّل أيضاً إلى كتاب مدرسي في علم التاريخ وسنن التاريخ بحيث يستوعب كلّ التفاصيل، وكلّ الجزئيات حتى ما لا يكون له دخل في منطق عملية التغيير التي مارسها النبي صلى الله عليهو آله، وإنّما القرآن الكريم يحتفظ دائماً بوصفه الأساسي والرئيسي، يحتفظ بوصفه كتاب هداية، كتاب إخراج للناس من الظلمات إلى النور، وفي حدود هذه المهمّة الكبيرة العظيمة التي مارسها، في حدود هذه المهمّة يعطي مقولاته على الساحة التاريخية ويشرح سنن التاريخ بالقدر الذي يلقي ضوءاً على عملية التغيير التي مارسها النبي صلى الله عليه وآله بقدر ما يكون موجّهاً وهادياً وخالقاً لتبصُّر موضوعي للأحداث والظروف والشروط.
_______
(1) و (2) آل عمران: 140
(3) التوبة : 39
(4) المائدة : 54
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معرفة الإنسان في القرآن (10)
معرفة الإنسان في القرآن (10)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
الشيخ شفيق جرادي
-
 آل عمران في آية الاصطفاء
آل عمران في آية الاصطفاء
الشيخ محمد صنقور
-
 معنى (ستر) في القرآن الكريم
معنى (ستر) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
حقائق ودروس مهمّة تتعلّق بالصّيام
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
الشعراء
-
 كريم أهل البيت (ع)
كريم أهل البيت (ع)
الشيخ علي الجشي
-
 الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
الإمام الحسن (ع): أوّل فراقد العصمة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

عن الصدق والصادقين في شهر رمضان
-
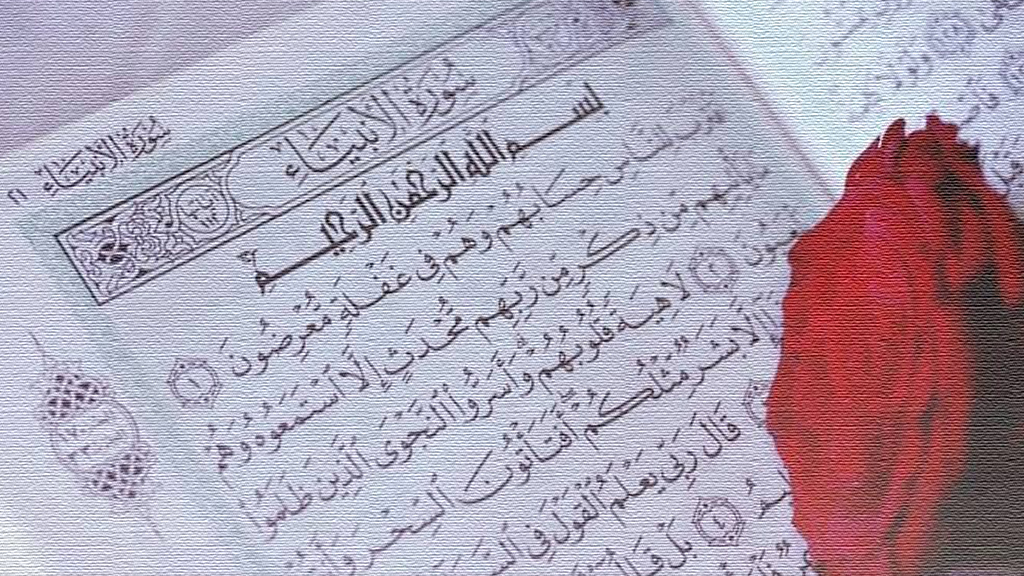
معرفة الإنسان في القرآن (10)
-

شرح دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان
-

كريم أهل البيت (ع)
-

الدم الزاكي وأثره على الفرد والجماعة
-

آل عمران في آية الاصطفاء
-

الإمام الحسن المجتبى (ع) بين محنتين
-
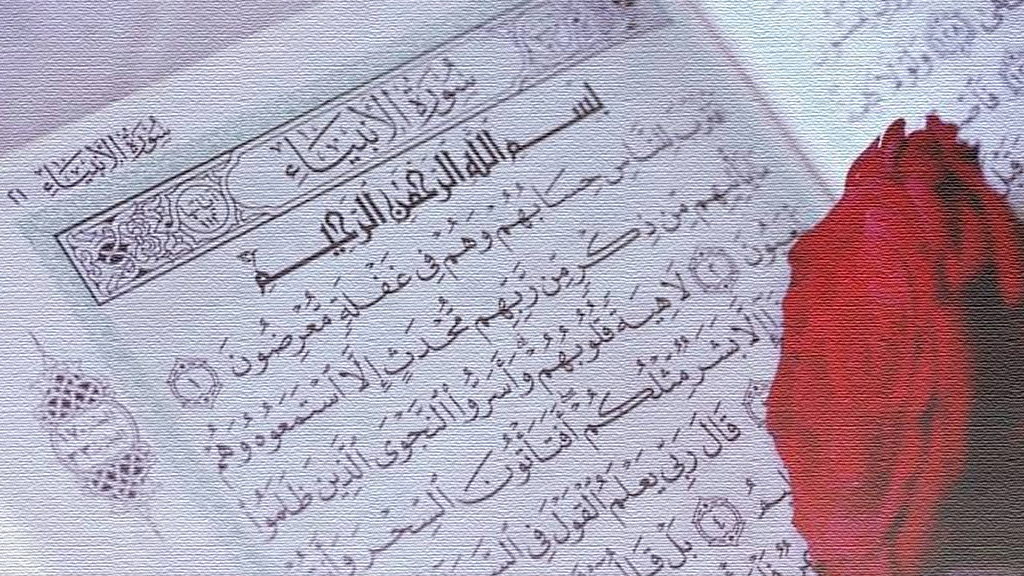
معرفة الإنسان في القرآن (9)
-

شرح دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان
-

إفطار جماعيّ في حلّة محيش، روحانيّة وتكافل وتعاون










