من التاريخ
صلحُ الإمام الحسن عليه السلام (1)

السيد عبد الحسين شرف الدين
كان صلح الحسن عليه السلام مع معاوية، من أشدّ ما لقيَه أئمة أهل البيت عليهم السلام من هذه الأمة بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. لقيَ به الحسن عليه السلام مِحناً يضيق بها الوُسع، لا قوّة لأحد عليها إلا بالله عزّ وجلّ. لكنه رضخ لها صابراً محتسباً، وخرج منها ظافراً بما يبتغيه من النصح لله تعالى، ولكتابه عزّ وجلّ، ولرسوله، ولخاصّة المسلمين وعامّتهم، وهذا الذي يبتغيه ويحرص عليه في كلّ ما يأخذ أو يدَع من قول أو فعل.
ولا وزن لمَن اتّهمه بأنه أخلدَ بصُلحه إلى الدَّعة، وآثَرَ العافية والراحة، ولا لمَن طوّحت بهم الحماسة من شيعته فتمنّوا عليه لو وقف في جهاد معاوية فوصل إلى الحياة من طريق الموت! وفاز بالنصر والفتح من الجهة التي انطلق منها صِنوه يوم الطفّ إلى نصره العزيز، وفتْحه المبين.
ومن الغريب بقاءُ الناس في عشواء غمّاء من هذا الصلح إلى يومهم هذا، لا يقوم أحد منهم في بيان وُجهة الحسن عليه السلام في صلحه، بمعالجة موضوعية مستوفاة ببيانها وبيّناتها، عقلية ونقلية، وكم كنت أحاول ذلك، لكنّ الله عزّ وجلّ شاء بحكمته أن يختصّ بهذه المأثرة مَن هو أولى بها، وأحقّ بكلّ فضيلة، ذلك هو مؤلّف هذا السِّفر البِكر (صلح الحسن عليه السلام). ".."
ومَن أمعن فيما اشتمل عليه هذا الكتاب، من أحوال الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية، علم أنهما لم ترتجِلهما المعركة ارتجالاً، وإنما كانا في جبهتَيهما خليفتَين، استخلفهما الميراث على خُلُقَين متناقضَين: فخُلق الحسن عليه السلام إنّما هو خُلق الكتاب والسنَّة، وانْ شئتَ فقل: خلُق محمّدٍ وعليٍّ صلوات الله عليهما.
وأما خُلق معاوية، فإنّما هو خُلق (الأمويّة)، وان شئتَ فقل: خلُق أبي سفيان وهند، على نقيض ذلك الخُلق. والمتوسّعُ في تاريخ البيتَين وسيرة أبطالهما من رجال ونساء يدركُ ذلك بجميع حواسّه. لكن لمّا ظهر الإسلام، وفتح الله لعبده ورسوله فتحَه المبين، ونصره ذلك النصر العزيز، انقطعتْ نوازي الشرّ (الأموي)، وبطلت نزَعات أبي سفيان ومن إليه مقهورةً مبهورة، متواريةً بباطلها من وجه الحقّ الذي جاء به محمّد صلّى الله عليه وآله عن ربه عزّ وجلّ، بفُرقانه الحكيم، وصراطه المستقيم، وسيوفه الصارمة لكلّ من قاومه. وحينئذٍ لم يجِد أبو سفيان وبنوه ومَن إليهم بدّاً من الاستسلام، حقناً لدمائهم المهدورة يومئذٍ لو لم يستسلموا، فدخلوا فيما دخل فيه الناس، وقلوبهم تنغلُ بالعدواة له، وصدورهم تَجيش بالغلّ عليه، يتربّصون الدوائر بمحمد صلّى الله عليه وآله ومَن إليه، ويبغون الغوائلَ لهم.
لكنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كان - مع علمه بحالهم - يتألّفهم بجزيل الأموال، وجميل الأقوال والأفعال، ويتلقّاهم بصَدرٍ رَحْبٍ، ومُحيّا منبسط، شأنه مع سائر المنافقين من أهل الحقد عليه، يبتغي استصلاحَهم بذلك. وهذا ما اضطرّهم إلى إخفاء العداوة له، يَطوون عليها كَشْحَهم خوفاً وطَمَعاً، فكاد الناس بعد ذلك ينسون (الأمويّة) حتّى في موطنها الضيّق: مكّة.
أما في ميادين الفتح بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فلم تعرَف (الأمويّة) بشيء، سوى أنّها من أُسرة النبيّ ومن صحابته. ثمّ أُتيح بعد النبيّ لقوم ليسوا من عِترته، أن يتبّوؤا مقعده، وأُتيح لمعاوية في ظلّهم أن يكون من أكبر ولاة المسلمين، أميراً من أوسع أمرائهم صلاحيةً في القول والعمل. ومعاويةُ إذ ذاك يتّخذ بدهائه من الإسلام سبيلاً يزحف منه إلى المُلك العضوض، ليتّخذ به دينَ الله دَغَلاً، وعباد الله خَوَلاً، ومال الله دُوَلاً، كما أنذر به رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فكان ذلك من أعلام نبوّته.
تأريخ التمهيد للأمويّة
نشط معاوية في عهد الخليفتَين الثاني والثالث، بإمارته على الشام عشرين سنة، تمكّن بها في أجهزة الدولة، وصانعَ الناس فيها وأطمَعهم به، فكانت الخاصّة في الشام كلّها من أعوانه، وعَظُم خطرُه في الإسلام، وعُرف في سائر الأقطار بكونه من قريش - أُسرة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم - وأنه من أصحابه، حتّى كان في هذا أشهرَ من كثيرٍ من السابقين الأوّلين الذين رضيَ الله عنهم ورضوا عنه، كأبي ذر وعمّار والمقداد وأضرابهم.
هكذا نشأت (الأموية) مرّةً أخرى، تغالب الهاشميّةَ باسم الهاشميّة في علَنِها، وتكيدُ لها كيدَها في سرّها، فتندفع مع انطلاق الزمن تخدعُ العامّة بدهائها، وتشتري الخاصّة بما تُغدقه عليهم من أموال الأمّة، وبما تُؤْثِرهم به من الوظائف التي ما جعلها الله للخَونة من أمثالهم، تستغلّ مظاهر الفتح وإحراز الرضا من الخلفاء.
حتّى إذا استتبّ أمر (الأمويّة) بدهاء معاوية، انسلّت إلى احكام الدين انسلالَ الشياطين، تدسّ فيها دسَّها، وتُفسد إفسادها، راجعةً بالحياة إلى جاهلية تبعثُ الاستهتارَ والزندَقَة، وفقَ نهجٍ جاهليّ، وخطّةٍ نفْعية، ترجوها (الأموية) لاستيفاء منافعها، وتًسخّرها لحفظ امتيازاتها. والناس - عامّة - لا يفطنون لشيء من هذا، فإنّ القاعدة المعمول بها في الإسلام - أعني قولهم: الإسلام يَجُبُّ ما قبله - ألقت على فظائع (الأموية) ستراً حجبَها، ولا سيّما بعد أنْ عفا عنها رسول الله وتألّفَها، وبعد أن قرّبَها الخلفاء منهم، واصطفوها بالولايات على المسلمين، وأعطوها من الصلاحيات ما لم يعطوا غيرها من ولاتهم. فسارت في الشام سيرتَها عشرين عاماً: ﴿.. لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ..﴾ (المائدة:79) ولا يَنهون. وقد كان الخليفة الثاني عظيمَ المراقبة لعمّاله، دقيقَ المحاسبة لهم ".." لكنّ معاوية كان أثيرَه وخلّصَه.. ما كفَّ يده عن شيء ولا ناقشَه الحساب في شيء، وربّما قال له: (لا آمرُك ولا أنهاك)، يفوّض له العملَ برأيه. وهذا ما أطغى معاوية، وأرهف عزمَه على تنفيذ خططه (الأموية). وقد وقف الحسن والحسين عليهما السلام من دهائه ومكره إزاء خطر فظيع، يهدّد الإسلام باسم الإسلام، ويطغى على نور الحقّ باسم الحقّ، فكانا في دفع هذا الخطر، أمام أمرَين لا ثالث لهما: إما المقاومة، وإما المسالمة. وقد رأيا أن المقاومة في دور الحسن عليه السلام تؤدّي لا محالة إلى فناء هذا الصفّ المدافع عن الدين وأهله، والهادي إلى الله عزّ وجلّ، وإلى صراطه المستقيم. إذ لو غامر الحسن عليه السلام يومئذٍ بنفسه وبالهاشميّين وأوليائهم، فواجه بهم القوّة التي لا قِبَلَ لهم بها مصمّماً على التضحية، تصميمَ أخيه يوم (الطفّ)، لانكشفت المعركة عن قتلِهم جميعاً، ولانتصرت (الأمويّة) بذلك نصراً تعجز عنه إمكانياتها، ولا تنحسر عن مثله أحلامها وأمنياتها. إذ يخلو بعدهم لها الميدان، تُمعن في تيهها كلّ إمعان، وبهذا يكون الحسن عليه السلام - وحاشاه - قد وقع فيما فرّ منه على أقبح الوجوه، ولا يكون لتضحيته أثر لدى الرأي العام إلا التنديد والتفنيد.
ومن هنا رأى الحسن عليه السلام أن يترك معاوية لطغيانه، ويمتحنه بما يصبو إليه من المُلك، لكنْ أخذ عليه في عقد الصلح، أن لا يعدو الكتاب والسنّة في شيءٍ من سيرته وسيرة أعوانه ومقوّية سلطانه، وأن لا يطلب أحداً من الشيعة بذنبٍ أذنبَه مع الأموية، وأن يكون لهم من الكرامة وسائر الحقوق ما لغيرهم من المسلمين، وأن، وأن، وأن. إلى غير ذلك من الشروط التي كان الحسن عليه السلام عالماً بأنّ معاوية لا يفي له بشيء منها، وأنه سيقوم بنقائضها.
هذا ما أعدّه عليه السلام لرفع الغطاء عن الوجه (الأموي) المموّه، ولصَهر الطِّلاء عن مظاهر معاوية الزائفة، ليبرزَ حينئذٍ هو وسائر أبطال (الأموية) كما هم: جاهليّين، لم تخفق صدورُهم بروح الإسلام لحظة، ثأريّين لم تُنسِهم مواهب الإسلام ومراحمُه شيئاً من أحقاد بدر وأُحد والأحزاب.
وبالجملة، فإنّ هذه الخطّة ثورةٌ عاصفةٌ في سِلم لم يكن منه بدّ، أملاه ظرفُ الحسن عليه السلام، إذ التبسَ فيه الحقّ بالباطل، وتسنّى للطغيان فيه سيطرة مسلّحة ضارية.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (فور) في القرآن الكريم
معنى (فور) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 معرفة الإنسان في القرآن (5)
معرفة الإنسان في القرآن (5)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
الشيخ محمد صنقور
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
-
 صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
السيد عادل العلوي
-
 هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
السيد عبد الحسين دستغيب
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

لقاء الرحمة والعبادة
-

معنى (فور) في القرآن الكريم
-

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحفز الإبداع إذا سألناه كيف يفكر لا ماذا يفكر
-
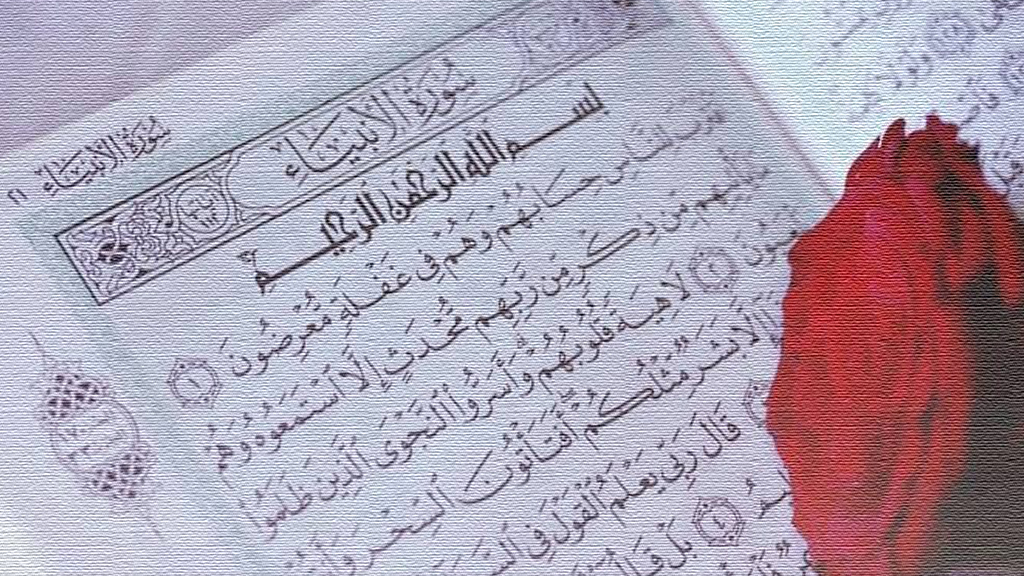
معرفة الإنسان في القرآن (5)
-

خديجة الكبرى المسلمة الأولى
-

شرح دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك
-

السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
-
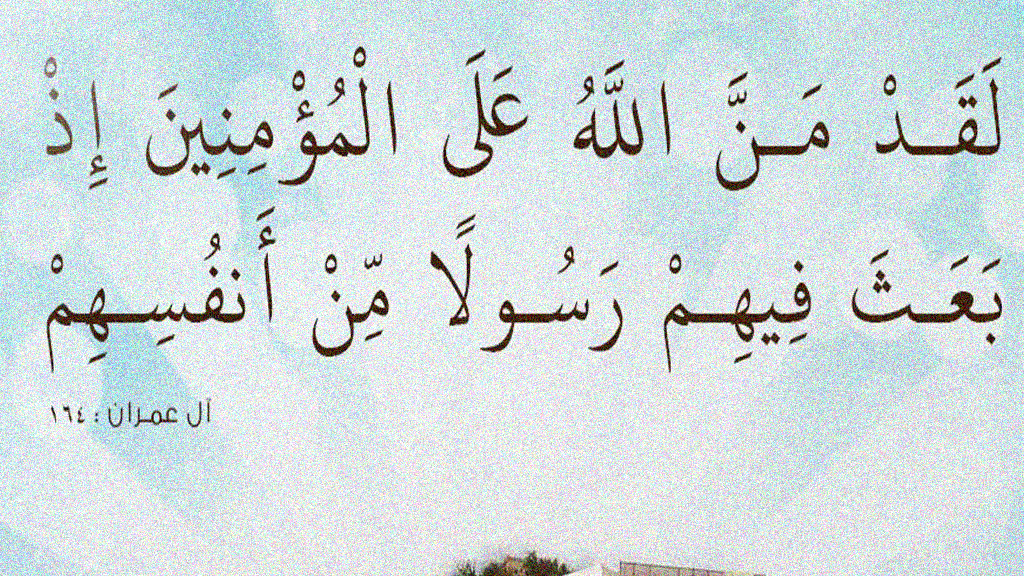
معنى (منّ) في القرآن الكريم
-

أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
-

اختتام حملة التّبرّع بالدّم (النّفس الزّكيّة)









