مقالات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد عباس نور الدينعن الكاتب :
كاتب وباحث إسلامي.. مؤلف كتاب "معادلة التكامل الكبرى" الحائز على المرتبة الأولى عن قسم الأبحاث العلميّة في المؤتمر والمعرض الدولي الأول الذي أقيم في طهران: الفكر الراقي، وكتاب "الخامنئي القائد" الحائز على المرتبة الأولى عن أفضل كتاب في المؤتمر نفسه.هل يمكن بناء حضارة إسلامية جديدة؟
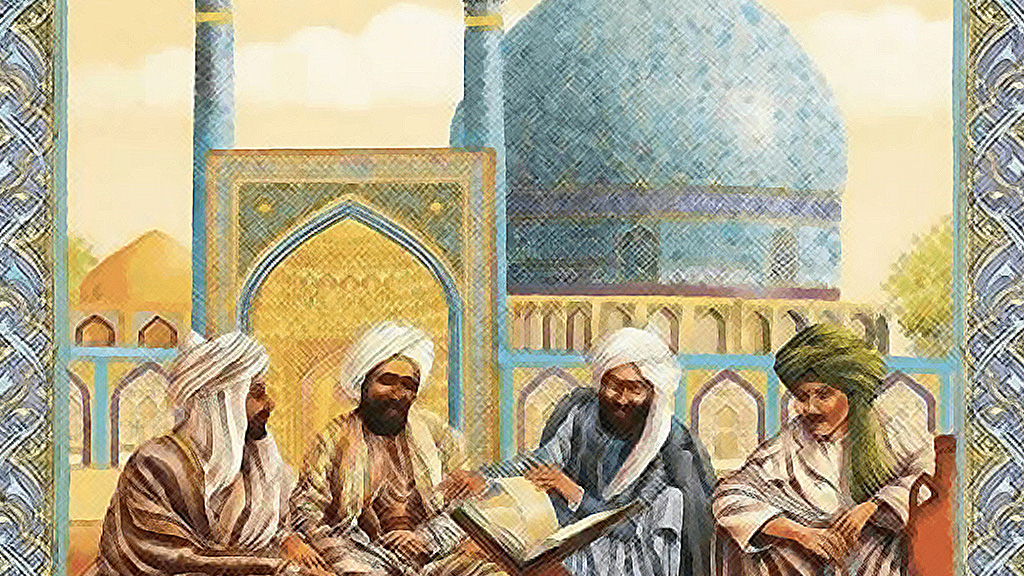
إقامة حضارة إسلامية جديدة تعني أنّ المسلمين سينخرطون مرة أخرى في عملية تقديم نموذج جديد للبشرية. وهذا النموذج يرتبط في الأساس بنمط العيش أكثر من العمران والمدنية. كما إنّ المتوقع هو أن يكون لهذا النموذج الحضاري أكبر الأثر على صعيد تغيير العالم بأسره.
ليس مبالغة القول بأنّ أزمة البشرية الكبرى ومعاناتها المتصاعدة في هذا العصر تكمن في افتقادها المزمن لتلك الأطروحة التي تبلور لها نموذجًا واضحًا للعيش، سواء على مستوى إدارة الحكم أو طبيعة الحياة الأُسرية والعلاقات.
هذا اليأس الذي يُطبق على أرواح أهل الأرض ويفرض عليهم الإذعان للواقع المر ناتج عن خفاء البرنامج المُقنع أو خارطة الطريق المرشدة إلى الحياة الطيبة. البرنامج المُقنع يتمثل في وجود نموذج حي يمكن فحصه ومشاهدته وتجربته أيضًا. الدعوة الفكرية والإعلامية مهمة، لكنها لن تصل إلى نتيجة ما لم يتمكن أصحاب هذه الأطروحة من تحقيق هذا النموذج.
العقود الأخيرة التي شهدها التاريخ المعاصر كانت إعلانًا مدوّيًا عن فشل الديمقراطية وموت الليبرالية بانهيار نموذجها الاقتصادي المتمثل بالرأسمالية. وما نشاهده اليوم من نهاية للتاريخ هو في الواقع ليبرالية تحتضر بخلاف ما تخيله مُنظّر الديمقراطية فرانسيس فوكوياما.
عجز الديمقراطية عن إدارة الرأسمالية لتحقيق المساواة والازدهار يعود أولًا إلى كون الديمقراطية بحدّ ذاتها على تعارض صريح مع الرأسمالية! لا بد أن تؤدي الرأسمالية المتفلتة إلى حكم أقلية وسيطرتها في النهاية. المجتمعات التي اختارت بإرادتها هذه الرأسمالية كنظام اقتصادي كانت في الواقع تُضحّي بديمقراطيتها المزعومة. كلما طبقت الرأسمالية الليبرالية وسمح لحرية السوق المطلقة كان ذلك عاملًا أساسيًّا لاتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء والمزيد من التحكُّم والاستبداد. ما ظنّه الناس كمُنقذ بعد عهود الفاشية لم يجلب سوى المزيد من الفشل والمعاناة.
نحن اليوم في عصر موت الأيديولوجيات ونهاية الأُطروحات في الغرب ومن يدور في فلكه. أما إذا نظرنا إلى العالم الإسلامي، فنستطيع أن نقول بأنّ المسلمين ما زالوا يمتلكون قابلية فريدة لتقديم البديل المنقذ. الأمر الذي يبدو حلمًا مستحيل التحقُّق، يُصبح ممكنًا بالنظر إلى ما يمتلكه المسلمون من مبادئ وعقائد وعناصر ثقافية. أحد أهم أسرار هذه القابلية هو أنّ المسلمين لم يتخلوا لحد الآن عن إيمانهم بضرورة حكومة السماء؛ الأمر الذي يعني بأنّه يسهل عليهم تقبُّل تدخل الله في الحياة العامة وهم ينتظرون ذلك بنحو أو بآخر.
معرفتنا بقواعد التاريخ وسنن المجتمعات تُثبت بأنّه لا يمكن للبشرية أن تنجح في إدارة حياتها بصورة عادلة وصحيحة. هذا ما يحتاج إلى تفصيل لا مجال له الآن. لكنّ الفكر الإسلامي كان ولا يزال مشغولًا بمناقشة هذا التدخُّل الإلهي في الوقت الذي أضحى في الثقافات الأخرى بمثابة الأسطورة. وهناك عوامل منطقية تاريخية وتجريبية وراء تمسُّك المسلمين بهذا المبدأ وتخلّي الآخرين عنه.
في اللحظة التي يتمكّن المسلمون من تفسير هذا التدخُّل تفسيرًا قابلًا للتطبيق، ويحققون أنموذجًا منه على بقعة من الأرض سوف تتغير جميع المعادلات القائمة، وتنهار أبنية العلوم الإنسانية قاطبة. ربما يمكن القول بأنّ مثل هذا لم يتحقق لحد الآن. وهذا ما يعجز عن فهمه الكثير من المفكرين.
معظم المهتمين بالعلاقة بين النظرية الإسلامية والتطبيق يتصورون أنّ هذه النظرية قد أُعطيت فرصتها في العصور السابقة وقدّمت كل ما عندها. يُطلق البعض على تلك العصور عنوان الذهب لا الفضة. بعض هؤلاء يدعو إلى استعادة ذلك المجد التليد.
لكن على مدى التاريخ الإسلامي كان هناك ضعف مُزمن في بلورة قضية التدخُّل الإلهي في الحياة وعلاقته بالمسؤوليات الملقاة على عاتق المسلم. من الطبيعي أن ينتقل هذا الضعف النظري إلى الجانب العملي والتجربة. حتى في أحسن الحالات النظرية، كان هناك مشكلة واضحة في إقناع المسلمين أنفسهم. فما الذي افتقده المعتقدون بهذا المبدأ حتى عجزوا عن إقناع الناس؟!
الحركة الهادرة للفتوحات "الإسلامية" في البدايات وما جلبته للمسلمين من ثروات مكّنهم بشكل طبيعي من تقديم نوع من النموذج الحضاري الذي تفوّق على نماذج عصره. لم يكن وضع الحضارات الأخرى متألقًا البتّة. عند صعود تلك الحضارة الإسلامية العباسية كان العالم في أسوأ عصور الظلام.
لعل هذه النقطة بالتحديد هي التي يُفترض أن تخضع لمناقشة دقيقة حين يتم الحديث عن العصور الذهبية للإسلام. بالتأكيد لم يكن هذا الذهب صدفة، لكنه بالتأكيد أيضًا لم يكن حضارة بالمعنى الدقيق. حضارة إسلامية تقدم أنموذجًا للعيش بناء على مبادئ دينها. كان هناك هوة تتّسع يومًا بعد يوم بين المبادئ والتجربة. لم تتمكن تلك التجارب الأموية والعباسية والمملوكية والعثمانية من تقديم أي نوع من الأطروحة. كان الأمر أشبه بالصدفة أو بالثراء الذي يحصل بالإرث.
لا شك بأنّ جانبًا أساسيًّا من قوة هذه الحكومات والسلطات كان مستفادًا من عناصر مهمة في ثقافة الإسلام. التعبئة المذهلة التي تحققت في بعض هذا العصور لم تكن من فراغ. كان للدين حضوره اللافت، وكان هناك الآلاف من الحالمين بنشر الدين في كل العالم. لكن التاريخ أصدر حكمه في النهاية، وعلمنا من الذي استغل من. ينتصر أولئك الذين يسيطرون على مقاليد الحكم ومعهم أحلامهم.
السذاجة التي ميزت قسمًا كبيرًا من هؤلاء الفاتحين ترجع بالدرجة الأولى إلى الاعتقاد بأنّ الإسلام لا يحتاج إلى ما هو أكثر من السيف. ما كانت عقولهم لتقدر على استيعاب شروط النصر الحقيقي وعلى رأسها وجود أطروحة دقيقة للحكم والإدارة وقائد يؤمن بهذه الأطروحة وقادر على تنفيذها.
هذه السذاجة تظهر دومًا بصورة القبول بحكومة الجائر؛ وفق هذا التصوُّر السلطان ظل الله على الأرض؛ والأهداف الإلهية ستتحقق كيفما كان! ربما لا يُلام أصحاب هذا التصوُّر حين نظروا إلى التاريخ ووجدوا أنّ أمثال معاوية بن أبي سفيان كان له كل ذلك الفضل في انتشار الإسلام. يتفق هنا أنّ بعض أكثر السلاطين إجرامًا وفسادًا قد سُجلوا على لائحة الأمجاد.
هذه السذاجة المستمرة تنفي الأطروحة، ومعها تزول فكرة الأُنموذج. لا حضارة ممكنة في ظل هذا الفكر. لا بأس أن نزور تلك الأمجاد قليلًا. فسقوط الإمبراطورية الساسانية الفارسية في العصر الأول، والتي كانت بمثابة القطب الثاني للقوى العالمية، لم يكن إلا نتاج انحلال وخواء مزمن ضرب هذه الإمبراطورية. إنّ تحوُّلها إلى لقمة سائغة بيد المسلمين، لا يعني أنّ الفاتحين قد أنجزوا مهمة مستحيلة. فإقبال الفرس على الإسلام بهذه الحمية والسرعة العجيبة يرجع إلى يأسهم المُطبق بعد طول معاناة على يد ملوكهم وأباطرتهم. وهذا ما يُفسر أيضًا تخليهم عن لغتهم القديمة في تلك المدة الوجيزة (أكثر الفارسية أضحت عربية). ولم يمر سوى بضع سنوات حتى أصبح الفرس يشكلون القوة الكبرى في الجيوش المسلمة، ومعها ازداد حجم تأثيرهم في الحياة السياسية. ربما كانت الشعوبية أو العنصرية القومية هي التي حدّت من طموحاتهم أو أدوارهم معظم الأوقات.
سقوط الروم في مشرقنا لا يرجع إلى قوة الفاتحين أيضًا، بل إلى سياسات الاستمالة وتعقيدات العلاقات القبلية في هذه المنطقة. وسقوط القسطنطينية (إسطنبول اليوم) الذي حدث بعد تسعة قرون له قصة مشابهة. لم يكن الصراع حضاريًّا البتة. كان يرتبط إلى حدٍّ كبير بالتعبئة العسكرية، بخلاف عصرنا هذا.
هذا الفهم الساذج للتاريخ المُسلم يرجع إلى اعتبار التوسُّع المرحلة الأخيرة من التاريخ. وبحسب هذا الفهم إذا فرضنا أن الجيوش الإسلامية افتتحت كل الأرض، فسوف نكون على موعد قريب مع الهدف النهائي حيث تتبدل الأرض غير الأرض وتشرق بنور ربها. سقوط الأندلس بعد فتحها وحكمها لمئات السنين ينفي هذه الفرضية بالكامل؛ والشواهد أكثر من أن تُحصى.
هنا ينبغي أن نسجل بأنّ تخلّي قسم كبير من المسلمين عن الاعتقاد بهذه العاقبة يرجع إلى انقلاب الأوضاع بصورة مأساوية من الغزو المغولي والحروب الصليبية وسقوط الخلافة العثمانية وسيطرة الكفار على أرض الحرمين، وما جره كل ذلك من فظائع لم تكن نكبة فلسطين سوى حلقة ممتدة منها.
هكذا تحول الفكر الإسلامي الذي كان يُبشر باليوم الموعود والجنة الأرضية إلى اعتناق عقيدة النهاية الكارثية للعالم التي اشتهرت بين أهل الكتاب؛ وغابت فكرة {وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقين}،[1] وراء مقولة "لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق".[2]
بيئات الفكر الإسلامي كانت تتقلب بين فكرة استعادة الأمجاد وبين النهاية الكارثية للعالم. في كلا الحالين لم تجري عملية البحث في التاريخ بالصورة المطلوبة.
صدمة الاستعمار الحديث والغزو الغربي لبلادنا وما يفعله كل يوم في فلسطين ومختلف أنحاء العالم المسلم تجعل محنة الحروب الصليبية كنزهة. لكنّها في الوقت نفسه تبعث الحياة في الدعوة إلى الماضي المجيد. جماعات وأخويات إسلامية عادت مرة أخرى بأحلام الجهاد والخلافة الإسلامية. أما فشل الحركات القومية والعروبية والأطروحات الاشتراكية في مواجهة عدو الأمة الذي أذلها في فلسطين، فقد كان عاملًا مهمًّا في إمداد الحركات الإسلامية الجهادية بقدرة تعبوية جديدة. ها نحن على موعد مع مقاومة وجهاد سيعيدنا إلى الأمجاد.
وبين التفسير الكارثي لمستقبل العالم وخطاب "المقاومة وحدها كفيلة بعودة الخلافة"، كان هناك تجربة من نوعٍ جديد تسير بصمت وسط عالمٍ مليء بالانقسامات العرقية والحدود المذهبية؛ كانت هذه التجربة الإسلامية تتقدم والأمل يحدوها بإقامة حضارة إسلامية جديدة؛ جديدة لأنّها مغايرة للسابقة في العصر الذهبي، لكنّها غير منقطعة عن نقاط قوتها. لذلك لم تكن دعوة إلى الماضي ولا تغافلًا عنه.
وفي هذه التجربة كانت تتبلور معالم الأُطروحة التي يفترض أن تفسر لنا طبيعة التدخل الإلهي أو دور السماء في أهم شؤون الحياة وأكثرها تعقيدًا كقضية الحكومة ومسؤوليات الشعوب ومنهج الإدارة العامة وكيفية التعامل مع الآخر. هذا في الوقت الذي كان عليها أن تبني نموذجها وسط عالمٍ مليء بالأعداء والذين هيمنوا على عالم الأطروحات واحتكروا وسائل تقديم النماذج.
وهكذا تعود الأطروحة الإسلامية إلى جذورها العقائدية حيث يدور الأمر بين السماء والأرض، أي رب العالم والعالم، أو خليفة الله والشعب. وهكذا يرجع البحث إلى الاستمداد من السماء للنجاح في الأرض.
لكن العقبة الأساسية التي كانت تواجه هذه الأطروحة في تجربتها الثورية المعاصرة هي حاجة النخبة والخواص والمسؤولين والمدراء والقادة فيها إلى فهم عميق لمعنى التدخل الإلهي في الحكم والسياسة والإدارة. الأمر الذي سمح لتسلُّل علمانية دينية أو ازدواجية متذبذبة بين الدين والغرب كانت ذا تأثير كبير في تعطيل تقديم النموذج أو تأخيره إلى يومنا هذا.
يتطلع الشباب الطامحون إلى هذه التجربة في الوقت الذي يئس كبارهم منها. فالذين عايشوا فشل التجارب النضالية التي وعدتهم بالازدهار والتطوُّر والعدالة والحرية، ثمّ شاهدوا انبثاق هذه الحركة الثورية الإسلامية الفتية وسط كل هذا اليأس، لعلهم كانوا أكثر الناس رجاءً وأملًا، لكن عجزهم عن تفسير التاريخ وبُعدهم عن مشهد التحوُّلات الفكرية وعمليات تشكيل وتبلوُر الأُطروحة، سرعان ما ألقى بهم في لجة اليأس مرة أخرى.
هذا ما يصيب كل من يتصور أنه بالتنظير وحده أو بالتطبيق وحده يمكن أن يتحقق التغيير. وهذا ما يصيب من لم يعرف شيئًا عن مخاض التنظير وتحديات التطبيق.
الذين ينظرون إلى العالم من جهة الأفكار فقط، ربما لن يتمكنوا من فهم مدى أهمية التجربة والنموذج. والذين يتحركون في عالم التجربة دون فهم دور الأطروحة، ربما سيكون نصيبهم اليأس. فلا بد من العمل على الأمرين في تناغمٍ كبير انطلاقًا من مبادئ البحث العلمي والاستيعاب التام لدروس التاريخ وتجاربه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]. القصص، 83.
[2]. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج15، ص263.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (فور) في القرآن الكريم
معنى (فور) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 معرفة الإنسان في القرآن (5)
معرفة الإنسان في القرآن (5)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
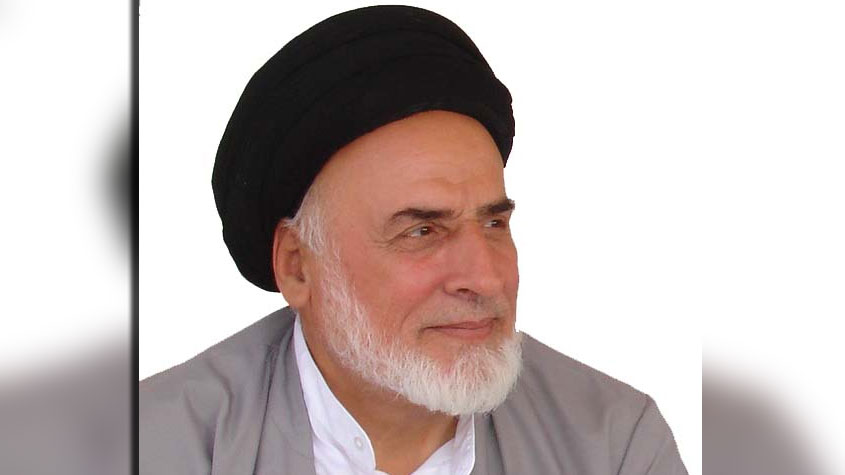 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
الشيخ محمد صنقور
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
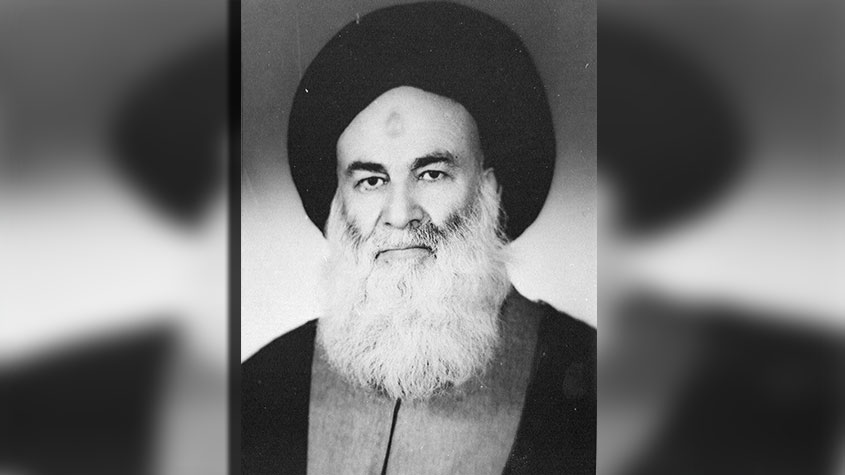 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
-
 صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
السيد عادل العلوي
-
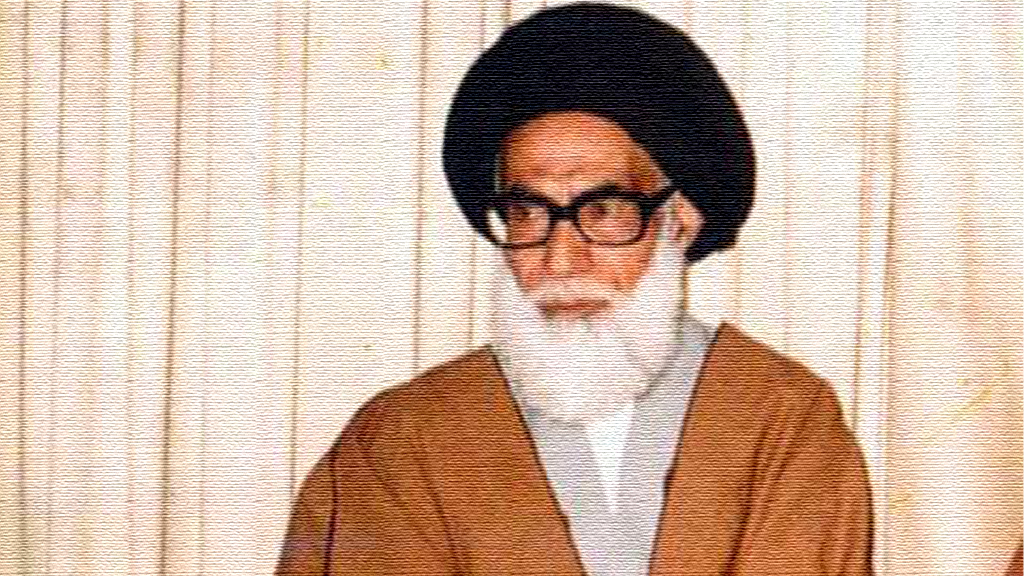 هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
السيد عبد الحسين دستغيب
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
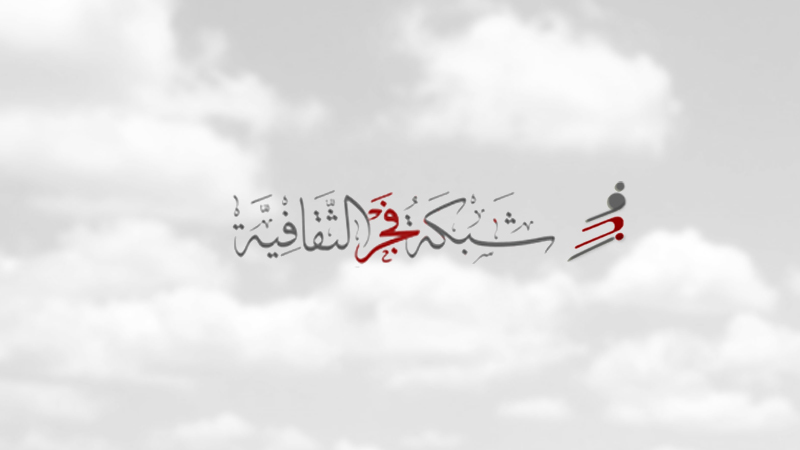 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
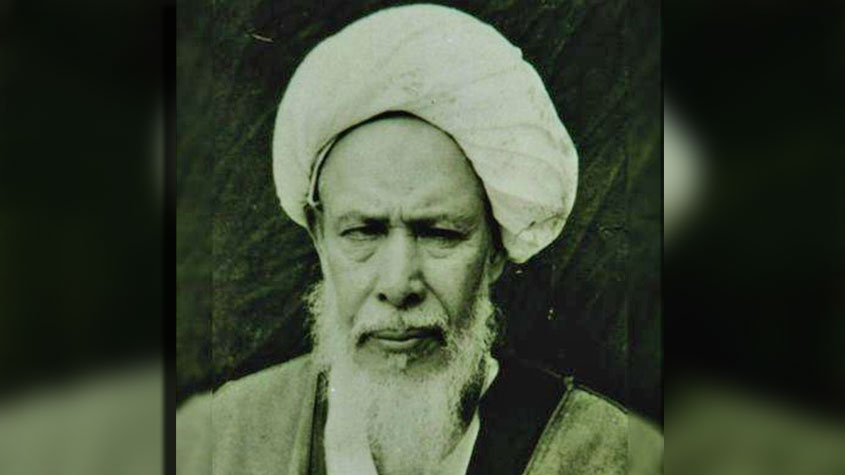 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

لقاء الرحمة والعبادة
-

معنى (فور) في القرآن الكريم
-

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحفز الإبداع إذا سألناه كيف يفكر لا ماذا يفكر
-
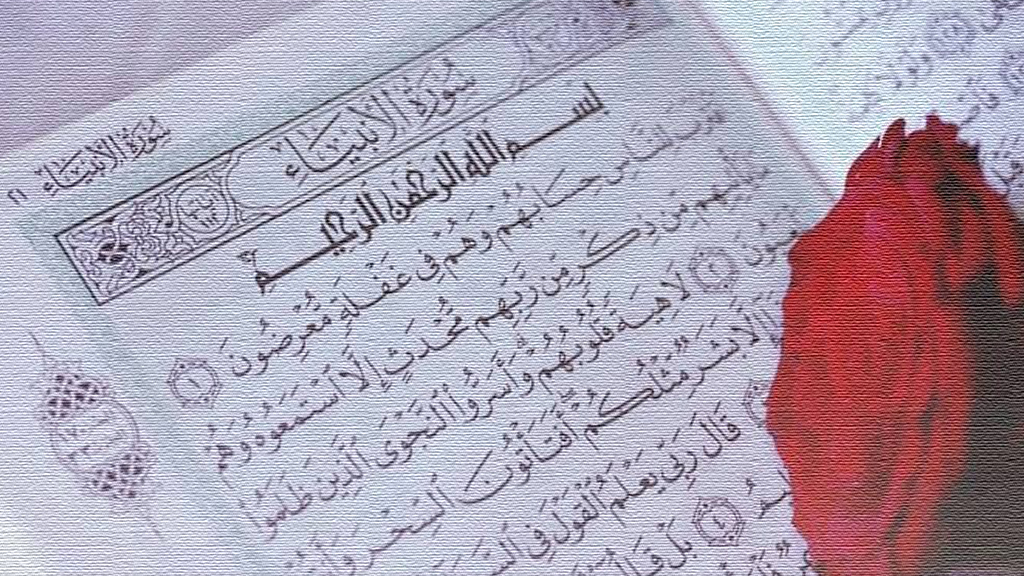
معرفة الإنسان في القرآن (5)
-
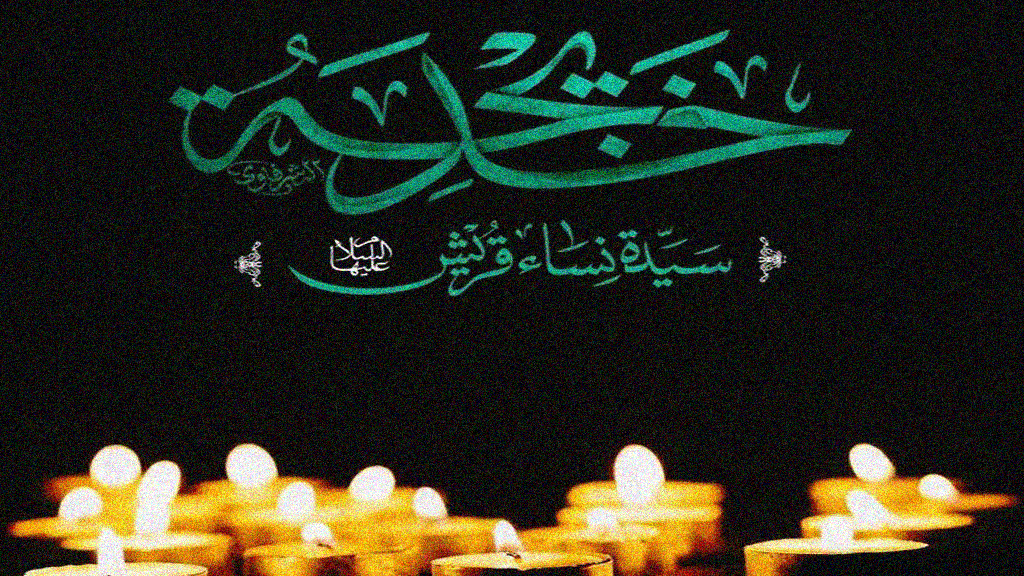
خديجة الكبرى المسلمة الأولى
-
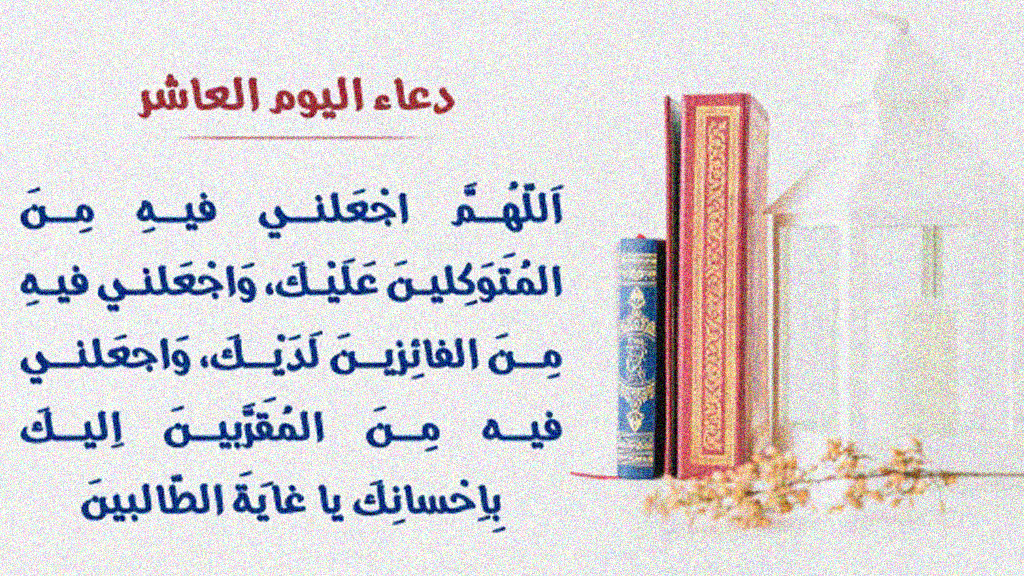
شرح دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك
-
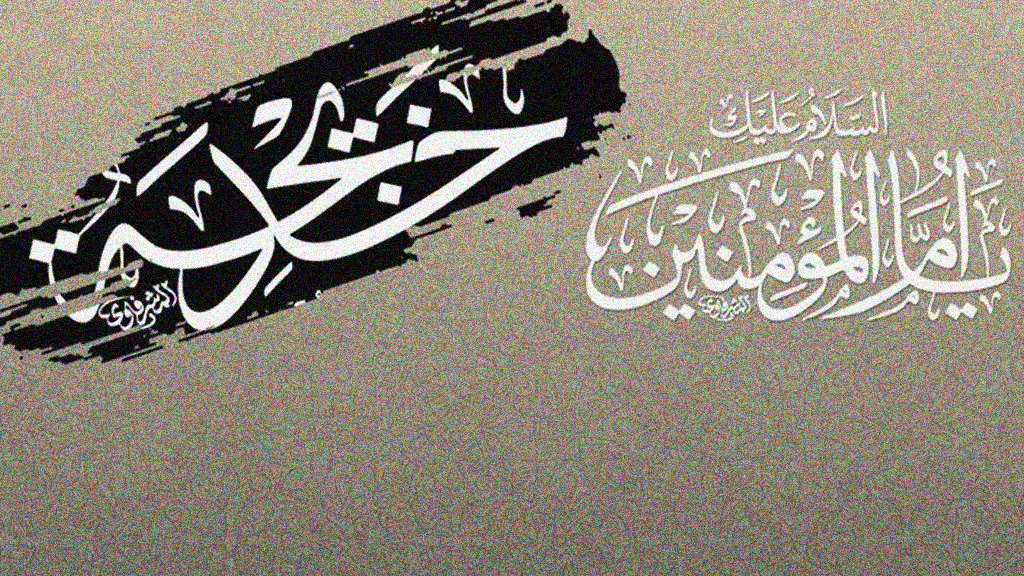
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
-
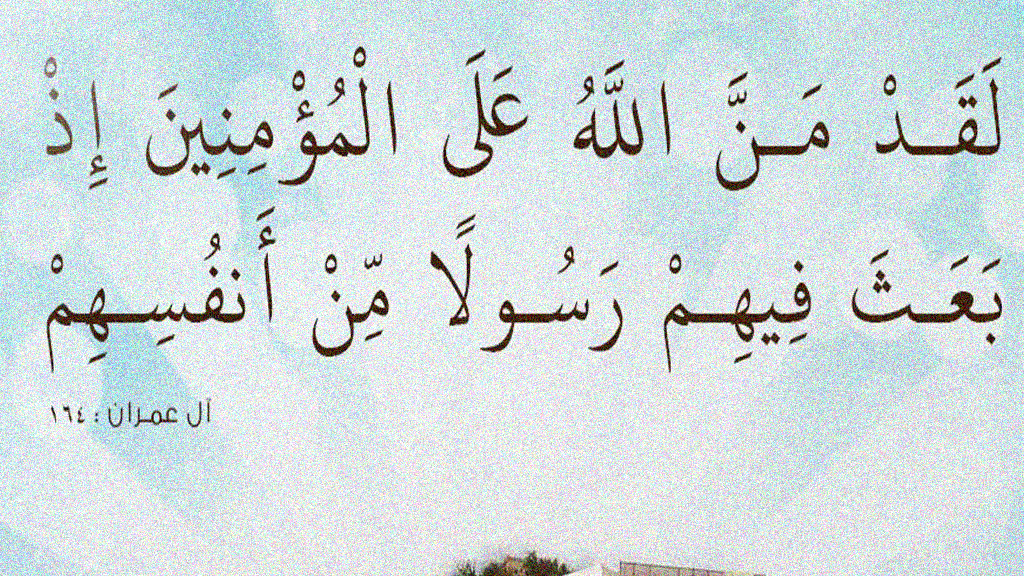
معنى (منّ) في القرآن الكريم
-

أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
-

اختتام حملة التّبرّع بالدّم (النّفس الزّكيّة)










