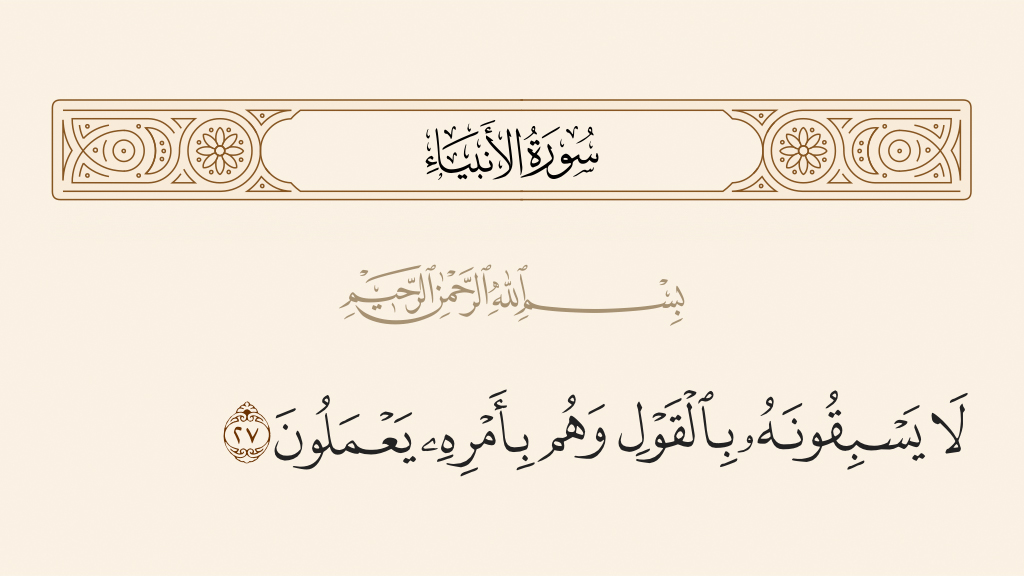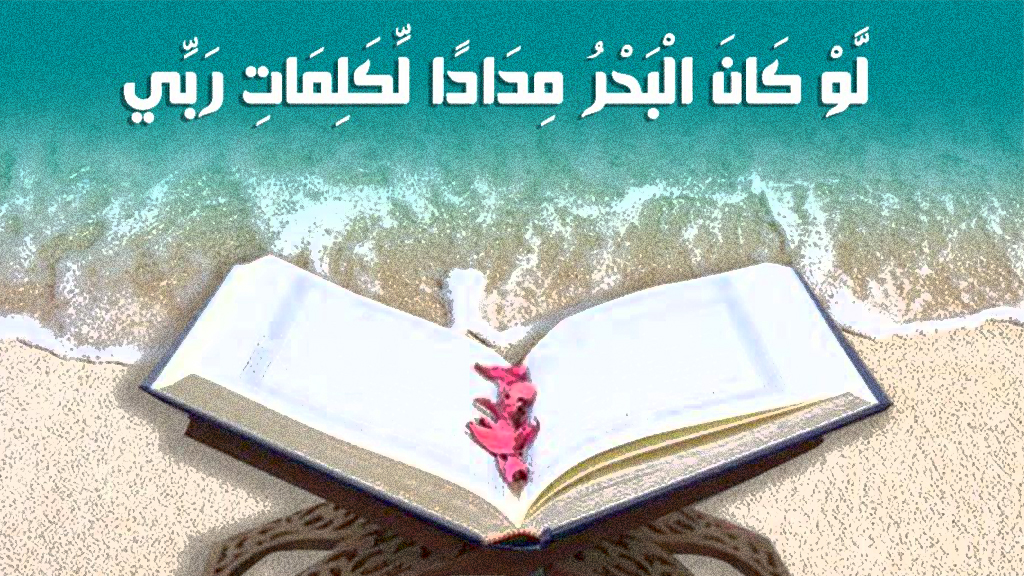علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".العقل بوصفه اسمًا لفعل (2)

مسلَّمات العقل ومعضلة الفهم
مبتدأ اختبار المسلَّمات العقليَّة، جرت كما هو بيِّنٌ، مجرى معرفة التعرُّف على الكون؛ والعلم بالمبدأ الذي منه ظهرت الموجودات. تعود معضلة الإدراك إذن، إلى الَّلحظة التي انعقدت فيها صِلاتُ الوصل بين العقل والسؤال عن مبدأ الوجود ومآلاته. لكن هذه المعضلة التي ركنت إلى علوم الطبيعة وقوانينها سوف تتحوَّل إلى مبادئ ناظمة للعقل الحديث، وحاكمة على وعيِهِ ومنطق تفكيره. حتى لقد بدا كأنَّ ثمَّة خطْبًا جللًا يدعو العقل إلى الوقوف على خللٍ جوهريٍّ في تكوينه. في مرتبته الوضعانيَّة يحسب هذا العقل أنَّه يستطيع بوساطة العلم أن يحيط بكلِّ شيء.
وقد ظهر حينئذٍ، كما لو أنَّه يثلم نفسه بملء مشيئته، من أجل أن يأنس بأمان إلى دنيا الممكنات وسحر ألوانها المبهرة. ربَّما لم يكن يدري أنَّه بفعلته تلك، سوف يدفع نفسَه دفعًا إلى كهف العزلة. ولمَّا حسِبَ أنَّه أفلح بالميثاق الأعظم الذي سيتيح له فكَّ لغز الوجود من خلال ثورته العلميَّة، وقع في تيه الأنانيَّة وجنونها. لقد أخذته العِزَّة بـ “أناه” حتى ظنَّ أنَّه الكائن الفائق الذكاء، الذي لا يدع صغيرة ولا كبيرة إلَّا وقف على سرِّها.. أو أنَّه الجوهر الفريد المكتفي بذاته، وليس له بعدئذٍ من حاجة إلى من يسدُّ نقصه متى استشعر النقص، ولا إلى من يمدُّه بالاغتناء متى استشعر الفقر…
لا يعني الذي مرَّ الكلام في شأنه، إنقاصًا من جلال العقل وجمال ما يختزنه من الحكمة ومحاسن التدبير.. فالمقصود على وجه التحقيق، هو الكيفيَّة التي استُعمِل فيها العقل – بما هو عقل أدنى – لإعمار الحضارة الحديثة.. أمَّا العقل في أصل نشأته وعلَّةِ وجوده، فهو أولُ الموجودات وأشرفُها. وهو الشيء المفارق الذي ينفرد به الكائن الآدميُّ عن سائر الكائنات. بل إنَّه السرُّ الذي لا ينفكُّ مصدر حيَرة الإنسانيَّة منذ بداية وعيه في تعقُّل الأشياء من حوله. لكنَّ الإشكال هو بالتحديد ما أنشأه العقل الوضعانيُّ من تأسيسات دنيويَّة لعلم الوجود ابتدأت مع الإغريق، ثمَّ لتشكِّل الفلسفة الحديثة تتويجًا صارخًا لها. مع المنعطف الأرسطيِّ واستحواذه على نظام التفكير البشريِّ، بلغت الحضارة المعاصرة نقطة النهاية في “ماراثون العقل المنفصل” الذي افتتحه الإغريق، وتابعته الحداثة بأطوارها المختلفة.
وللذكرى، فإنَّ الأرسطيَّة لم تكن كما هي في مشهدها وشهودها سوى تراثٍ مبنيٍّ على المنطق، والتجريبيَّة، والعلوم الطبيعيَّة. والمدرسة التي أسَّسها أرسطو وأدار فيها مناقشاته، عكست هذه التراث فكانت مركزًا للبحوث العلميَّة وتجميع البيِّنات أكثر منها مدرسة فلسفيَّة شبه دينيَّة، كأكاديميَّة أفلاطون. ومع أنَّ الأخير كان يُعدُّ عمومًا في العصور القديمة المعلِّم الأكبر، فإنَّ ذلك الحكم كان سيتعرَّض لاختلال دراميٍّ مثيرٍ في أوج العصور الوسطى، وبدا أنَّ مزاج أرسطو الفلسفيَّ هو الذي سيحدِّد التوجُّه السائد للعقل الغربيّ. فنظامه الموسوعيُّ في الفكر كان بالغ الأهميَّة إلى درجة أنَّ جلَّ النشاط العلميِّ في الغرب، حتى القرن السابع عشر، أخذ بمضامين كتاباته العائدة إلى القرن الرابع قبل الميلاد، بل كان من شأن العلم الحديث، حتى حين راح يتجاوزه، أن يواصل توجُّهه ويستخدم أدواته النظريَّة.
من أظهر الجنايات التي اقترفها العقل الحديث، اختراعُه لمذهبٍ حمَّله اسمه ليكون وليًّا على حياة الإنسانيَّة ومرشدًا لها.. يُقصد بذلك المذهب العقلانيِّ الذي زعم مناصروه امتلاكهم حُزمةً كاملةً من الإجابات الكبرى، على حُزمةٍ كاملةٍ من الأسئلة الكبرى. من السؤال لماذا كان الوجود وليس العدم، إلى الاستفهام عن الكيفيَّات المناسبة لإدارة المجتمع والدولة وحركة التاريخ… وعليه، فقد عُدَّت النزعة العقلانيَّة وفق الصورة التي ظهرت بها خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر في الغرب، نسَقًا ميتافيزيقيًّا ناجزًا.. بل إنَّها عوملت في أكثر المواضع والأحيان، كبديل من الدين… من مفارقات العقلانيَّة أنَّها تعاملت مع العلم كموضوع من مواضيع نشاطها الفكريّ. وضمن هذا المنحى تمَّ الاستيلاء على مقاليد الثورة العلميَّة وتوظيفها لخدمة أيديولوجيَّتها الحاكمة على حضارة الحداثة برُمَّتها.
لقد ظهرت الوضعانيَّة كفجوة تتوسَّع يومًا إثر يوم في بنية العقل الغربيّ. لعلَّ أشدَّها وقعًا دفع العقل إلى مواجهة الإيمان، والتقنيَّة إلى مواجهة البعد الروحيِّ للإنسان. والحاصل، وقوع العقل الحديث في أحاديَّة جائرة أفقدته إمكانات هائلة كانت ضروريَّة لتجديد نفسه وتصويب المجال الحضاريِّ الذي يتسيَّد عليه. أمّا السبب فيعود إلى شغف العقل الحداثيِّ بعقلانيَّة العلم المحض ومنجزاته. وقد دلَّت الاختبارات التاريخيَّة أنَّ الغلوَّ بالعقلنة الحادَّة حين يصل إلى حدِّه الأقصى يُحدثُ مسارًا ارتداديًّا على العقل نفسه، بحيث تظهر علاماته باضطراب السلوك وعدم القدرة على ضبط حركة التقدُّم في الميادين الحضاريَّة كافَّة. من المنطقيِّ القول بإزاء فجوة التناقض بين التقدُّم العلميِّ والإيمان الدينيِّ، أنَّ الأشياء والظواهر لا تتضادّ أو تتصارع إلَّا بين أجناسها. ولكنَّ العقل التقنيَّ لم يدرك – وبسبب من استغراقه في دنيا الرقميَّة الصمَّاء – أنَّ العلم لا يمكن أن يحتدم إلَّا مع العلم، والإيمان يستحيل أن يحتدم إلَّا مع الإيمان. والصراع الشهير بين نظريَّة التطوُّر ولاهوت بعض الطوائف المسيحيَّة – على سبيل المثال – لم يكن صراعًا بين العلم والإيمان، بل بين علم يجرِّد إيمان الإنسان من إنسانيَّته، وإيمان شوَّهَه التأويل الحرفيُّ للكتاب المقدَّس. تأسيسًا على هذه الفرضيَّة لن يكون ثمَّة من صراعٍ بين الإيمان في طبيعته الحقيقيَّة، والعقل في طبيعته الحقيقيَّة. وهذا التأكيد يشمل حقيقة تالية، هي أنَّه لا يوجد صراع جوهريٌّ بين الإيمان والوظيفة الإدراكيَّة للعقل. [بول تيلش – بواعث الإيمان- ص 96].
“الكوجيتو” مُهَيمِنًا في مملكة العقل الأدنى
عند مبتدأ الحداثة، صارت العلاقة بين العقل والدين موضع اهتمام غير عاديٍّ في حقلَيْ الفلسفة والَّلاهوت. تصوَّر آباء الفلسفة الحديثة وفي مقدَّمهم فرانسيس بيكون ورينيه ديكارت، أنَّهم إذا فصلوا مملكة العقل عن مملكة الإيمان أمكنهم تفادي الاصطدام بين المملكتين. فلو تحقَّق ما أرادوا، سينعمون بمواهب التحيُّز للفكر العقلانيِّ من دون الوقوع في أخطار مجابهة الدين. لقد سبق أن قال بيكون في هذا الخصوص: إذا رغبنا في دراسة الَّلاهوت المقدَّس، وَجَب مغادرة زورق العقل البشريِّ الصغير والركوب في سفينة الكنيسة التي تمتلك هي وحدها حقَّ تشخيص المسار الصحيح. أمَّا ديكارت فقد دعا إلى ضرورة التسليم بالوحي الإلهيِّ في الموضوعات المتعلِّقة بالله. فإذا أوحى الله حول نفسه بأشياء فوق طبيعيَّة أي فوق قدرة عقلنا مثل رموز التجسُّد والتثليث، فيجب أن نتقبَّلها من دون تريُّث، حتى ولو لم نستطع إدراكها بوضوح، لأنَّ وجود أشياء فوق حدود إدراكنا فيما يخصُّ عظمة الله ومخلوقاته وَجَبَ ألَّا نعتبرها أمرًا عجيبًا.
في تلك الَّلحظة من تأمُّلاته الفلسفيَّة لم يكن ديكارت قد انعطف بعد إلى محاريب الكوجيتو وضراوة أحكامه. كان الرجل وقتذاك يستعين بأسلوب آخر غير أسلوب الفرز بين مملكتَي العقل والإيمان لحلِّ التعارض بين العقل والدين، وكان يدعو إلى وجوب الاعتماد على يقينيَّة المعارف المستمدَّة من الوحي الإلهيّ. بيد أنَّ هذه الرؤية وإنْ جاءت على صورة لاهوتيَّة، إلَّا أنَّها لم تدم طويلًا، عدا عن أنَّها لم تكن تعني عدم الاكتراث للعقل والتقليل من أهميَّته. هكذا عاد ديكارت ليولي قضيَّة المنهج اهتمامًا خاصًّا، ويشدِّد على قدرة العقل في اكتساب المعرفة اليقينيَّة، ثمَّ ليمهِّد السبيل لنزعة عقلانية سوف تُعرض وتُصاغ في ما بعد على يد جون لوك(1632-1704). ورهطٌ آخرون من بعده.
أمَّا خلاصة النزعة العقلانيَّة المستحدثة التي استظهرها لوك تبعًا لديكارت فهي أن يكون الاعتقاد بوجود الله مقبولًا فقط عندما يؤيّده العقل. غير أنَّ هذه الأطروحة ما لبثت أن شكّلت مفتتحًا جديدًا ستسود فيه العقلانيَّة الصلبة على حساب الإيمان، وضدَّ الاعتقاد بواقعيَّة الاعتناء الإلهيّ بالعالم.
المعضلة التأسيسيَّة التي وقع فيها العقل الحديث، انسحاره بدءًا من ديكارت نفسه، بموازين العقل الرياضيِّ وقدرته على حلِّ أسئلة الوجود حتى من دون الاستعانة بالوحي. قد يكون القَدَرُ هو الذي سيحمل فيلسوف الحداثة على اقتراف دابَّة العقل، ليجعله خطَّ الدِّفاع الأوَّل عن الإيمان المسيحيّ. والذين أدركوا متأخِّرين ما اقترفه الرَّجل، ربَّما كانوا نصحوه ألَّا يفعل. وما هذا إلَّا لأنَّ حصاد الفعليَّة جاء خلاف مقصود النيَّة. لكنّ القَدَرَ سيتمِّمُ رحلته ويستحثُّه ليتّخذ “الشكَّ المنهجيَّ” دربةً لمسعاه. وما كان ذلك إلّا لأجل أن يستدلَّ منطقيًّا على حقيقة الألوهيَّة، ثمَّ ليبلغ من طريق الاستدلال ضالَّة اليقين.
من المبين أن نقول إنَّ ديكارت ما كان ليهتدي إلى “الكوجيتو” لولا أنَّ غَلَبته شَقْوَةُ فَقْدِ الوجود، ثمَّ سعى ليعثر عليه عن طريق “الأنا” المكتفية بذاتها. الخَيارُ سيكون شاقًّا بالنسبة إليه؛ بل ويحتاج من المكابدة أقصاها. لقد وَقَعَ الرجلُ في معثرةِ الجمعِ المستحيلِ بين نقيضين غير قابلين للتواؤم في هندسات العقل الأدنى: الإيقان بالألوهيَّة الذي لزومُهُ التّسليم والإيمان، والأخذ بالعقل البرهانيِّ الذي مقتضاه الجدل والسؤالُ، والسّببيّةُ، والعلَّة المفضيةُ إلى ظهور المعلول. لم يجد ديكارت ما ينفذُ به إلى مجاوزةِ هذه المَعْثَرة الممتدَّةِ جذورُها إلى الميراثين الفلسفيَّيَنْ اليونانيِّ والرومانيِّ، إلَّا أن يلوذَ بـ “الأنا” لكي ينجز مبتغاه. قرَّر الرُّجوع إلى نقطة البداية؛ ليكشف لنا أنَّ الشّيء الوحيد الذي كان واثقًا منه، أنًّه هو نفسه كائن يشكُّ، وجوهرٌ يفكِّر. وها هنا يمكث الظنُّ الذي سيحمله على الاعتقاد بأنَّ الإنسان ذهنٌ محضٌ، وأنَّ معرفتَه بنفسه وبغيره منحصرةٌ بالعقل المحض، هذا الكائن العجيب الذي يسأل عن كلِّ شيء، ويشكِّك بكلِّ شيء.
في سياق دعوته لفكرته الأساسيَّة ولهيكل نظامه الفلسفيِّ، سيعلن ديكارت عبر “الأنا أفكِّر” أنَّه أنشأ أوّل قضيَّة يقينيَّة غير قابلةٍ للشكّ. ولعلَّه أراد في هذه المطارحة أن يظهر كفيلسوف يقين حاول أن يبحر ليجد يقينه عبر سفينة الشكّ. ربّما أخذته أسحار الرياضيَّات التي ظلَّت تلازمه حتى آخر عمره من أجل أن يعْثُرَ على فردوسه الضائع. كان عليه أن يبتدئ من الَّلايقين، لينتهي إلى بداهة المعرفة اليقينيَّة بالوجود. غير أنَّ معثرته الابتدائيَّة هي تلك التي كشفها في “التأمُّلات”. يقول: “أنا موجود.. يعني أنا لي وجود”، أمَّا إلى متى؟ يجيب: طالما أفكِّر.. ومتى ما توقَّف تفكيري عن التفكير، لربَّما توقَّف الوجود ووجودي حينها. إنّ قولًا كهذا، وإن جاء لتوكيد “مشروعيَّة الكوجيتو”، إلَّا أنَّ تداعياته ستطال بالأذى مقاصده الأولى في الدِّفاع عن الألوهيَّة. ربَّما لم يكن ديكارت يدرك، وهو يستظهر هذا التّأمُّل، أنَّه يؤسِّس لعدميَّةٍ صمَّاءَ، تلغي الكون كلَّه حالما تنعدم “الأنا” التي كانت ترى موجودات العالم وتفكِّر فيها…
من بعد مخاض، يأتي دور الشّكِّ المنهجيِّ لكي يتولَّى مهمة الوصول إلى المعرفة الصائبة للوجود. ومنهج الشكِّ – بالنسبة إلى صاحب الكوجيتو-، هو أقرب إلى واسطةٍ لتقطير جميع القضايا التي نشكُّ بها منطقيًّا، وذلك بغية تحصيل المعارف التي لا يرقى إليها الشكّ. فالغاية من “الشكِّ المنهجيِّ” ليست تحديد ما هو معقول أو غير معقولٍ الشكِّ فيه، وإنَّما ما هو ممكن الشكِّ فيه منطقيًّا. في هذا المنهج تُحذف جميع القضايا التي لا تستطيع أن تشكِّل مقدِّماتٍ في نظامٍ فلسفيٍّ استنباطيّ. غير أنَّ الشكَّ المنهجيَّ له افتراضات محدَّدة: أظهرُها ما يفيد بأنَّ الفرد هو الذات المفكِّرة الوحيدة التي تثير الأسئلة. ومنه نستنتج، ومن دون ذهول واستغراب، أنَّ الجواب – أي اليقين الذي يقطع الشكّ – هو عند ديكارت يقين الفرد المفكِّر. والحاصل، أي النهاية الأكيدة للشكِّ هي بطريقة ما متمثِّلة في طريقة إثارته السؤال. وهكذا، يكون معيار الصدق عند ديكارت ما يحدِّده نظام العقل، والعقل الرياضيِّ على وجه الضَّبط. فما يصل إليه هذا العقل ويراه واضحًا ومتميّزًا بعد تفكيرٍ منظّمٍ ومدروسٍ، يمكن قبوله واعتباره صادقًا. واستطرادًا لهذه الفرضيَّة، يوصي ديكارت بوجوب إخضاع الخبرة الحسّيَّة لسلطان العقل ومعاييره؛ لأنَّ خبرة الحواسِّ هذه، هي بصورةٍ فطريَّةٍ أقلّ إيحاءً بالثِّقة من العقل.
حقيقة الأمر، أنَّ ديكارت لم يكن لينأى قيدَ أنملةٍ من شريعة الإغريق وهو يستغرق هموم “الكوجيتو”. ونميل إلى القول أنَّه لم يقطع مع أرسطو، بل جاءت نظريَّته في المعرفة امتدادًا جوهريًّا لمنطِقِه؛ حيث خضعت لوثنيَّة الأنا المفكِّرة. وسيجوز لنا أن نلاحظ، أنَّ الكوجيتو الديكارتيَّ ما هو إلَّا استئناف مستحدث لـ “دنيويَّة المقولات العشر الأرسطيَّة”. وبسببٍ من سطوة النّزعة الدنيويَّة هذه على مجمل حداثة الغرب لم يخرج سوى “الندرة” من المفكِّرين الذين تنبَّهوا إلى معاثر الكوجيتو وأثره الكبير على تشكُّلات وعي الغرب لذاته وللوجود. من هؤلاء – على سبيل المثال لا الحصر- الفيلسوف الألمانيّ فرانز فون بادر الذي قامت أطروحاته على تفكيكٍ جذريٍّ لمباني الميتافيزيقا الحديثة وحكم بتهافتها الأنطولوجيِّ والمعرفيِّ في آن. وإذا كانت فلسفة بادر النقديَّة طاولت الأُسس التي انبنت عليها الميتافيزيقا الأولى، فإنَّ نقده للديكارتيَّة يشكِّل ترجمةً مستحدثةً للميراث الأرسطيِّ بمجمله، حيث يمكن إجماله في النُّقاط الثلاث التالية:
أوّلًا: إنَّ الكوجيتو الديكارتيَّ «مبدأ الأنا أفكِّر» يؤدّي إلى قلب العلاقة التأسيسيَّة للوعي بجناحيه المتناهي والَّلامتناهي. والسّؤال البديهيُّ في هذا المحلِّ هو التالي: «كيف يمكن المرء أن يعرف الله بتفكير لا إلهيٍّ، أو بتفكير لا إلهَ فيه، أو بتفكير مدعوم إلهيًّا، مع أنَّ نفس وجود أو لا وجود اللَّه يُحدَّد فقط من خلال معادلة مختلَّة الأركان قوامها: “اللَّه موجود مجرَّد نتيجة للأنا موجود”».
ثانيًا: ما يريد الشكُّ الديكارتيُّ أن يقوله فعلًا، بوصفه استقلاليَّةً مطلقةً للمعرفة، ليس أقلَّ من أنَّ الإنسان بوصفه مخلوقًا يكوّن معرفته الخاصَّة، ويجعلها تؤسِّس ذاتها من دون مسبقات. الـ “أنا موجود” (ergo sum) التي تلي «الأنا أفكِّر» (co gito) هي – في منطق ديكارت – تعبير عن كيان يريد إظهار نفسه بالتفكير والكينونة، بمعزل عن الله. وبسببٍ من كونه عاجزًا عن فعل هذا، يمنع تجلّي نفسه وتجلّي الله. فالموجود المتناهي – الإنسان – ومن خلال تأسيس يقينه الوجوديِّ والمعرفيِّ في “الأنا الواعي”، يحاول إظهار ذاته كموجودٍ مطلقٍ، ويجعل نفسه إلهًا مؤسِّسًا لذاته”.
ثالثًا: يشكِّل الكوجيتو الديكارتيُّ، بالأساس، انعطافةً أبستمولوجيَّةً نحو الأنا، ما يستلزم انعطافةً أنطولوجيَّةً تليها انعطافةٌ أبستمولوجيَّةٌ منطقيَّةٌ أنطولوجيَّةٌ للعودة إلى ذاتها. وفي أيَّة حال، ستؤدّي الأَنَويَّة الأبستمولوجيَّة والأنانة الأنطولوجيَّة لـ «الأنا أفكِّر أنا موجود» في ميدان تطبيقها الاجتماعيِّ والسياسيِّ والحضاريِّ إلى ولادة أنانيَّة سياسيَّة ليبراليَّة ذات نظامٍ سياسيٍّ واقتصاديٍّ أنانيّ. وهذا هو على نحو البيان والوضوح ما أظهرته قيم الرأسماليَّة من “بربريَّات” صارخة في حقبة التّطاول الكولونياليِّ على الشّعوب الواقعة خارج المركزيَّة الغربيَّة.
على هذا النحو من النَّظر إلى “العقل الأنانيِّ” المستكفي بذاته، سيؤسِّس ديكارت عقلانيَّة العصر الحديث. وجلُّ الفلاسفة الذي خَلَفوا ديكارت، أو تبعوا دربته الاكتفائيَّة، رأوا أنَّ ذات المرء كافيةٌ في تأسيس وجوده وتفكيره، وأنَّ الإنسان بسبب هذا الاكتفاء الذاتي لا يحتاج إلى اللَّه في التأسيس والمساعدة، ولا في وجوده، ولا في معرفته، ولا في وعيه الذاتيّ.
لقد نبَّه التّحليل النّقديُّ لـ «الأنا أفكر إذاً أنا موجود» إلى أنّ الأنا، عندما تتأمّل المكان الذي أتت منه، سوف تدرك أنّها لا تملك “كوجيتو” خاصاً بها، ولا وعياً ذاتياً خاصاً بها، أو منسجماً معه. عندما نفكّر بشكلٍ أعمق في شروط الوعي -كما يبيّن نقّاد الكوجيتو- يصل المرء إلى إدراك أنّ الوعي المتناهي يعرف ذاته على أنّه وعي لشخص لا يُحدِثُ نفسَه، ولا يعرف نفسه بنفسه وحده. وفي الوقت ذاته الذي يعرف الوعي المتناهي «الأنا أفكر» ماهيته، يعرف أنه «مفكَّر فيه». فالوعي المتناهي مؤسَّسٌ في وعي مطلقٍ مستقلٍ بشكلٍ كاملٍ عن الوعي المتناهي. أمّا «مبدأ المفكَّر فيه»، فإنّه يعبّر عن عقيدة حضور كلّ الأشياء في اللَّه على مستوى الوعي، بمعنى أنّ الوعي المتناهي مؤسَّسٌ في اللَّامتناهي، ومن ناحيةٍ أخرى يُبيّن أنّ معرفة الإنسان، بل هي موهبة إلهية.
Franz von Baader Fermenta cognitionis (abbr. FC) in SW Vol. II، p. 178
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 الحجاب بين الحياء والتهتّك
الحجاب بين الحياء والتهتّك
السيد عباس نور الدين
-
 معنى (سقف) في القرآن الكريم
معنى (سقف) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 الملائكة وسائط في التدبير
الملائكة وسائط في التدبير
السيد محمد حسين الطبطبائي
-
 إرادة اللَّه سبحانه
إرادة اللَّه سبحانه
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 ظهور الشعر الأبيض قد يكون وقاية من الإصابة بالسّرطان
ظهور الشعر الأبيض قد يكون وقاية من الإصابة بالسّرطان
عدنان الحاجي
-
 أقسام العلّة
أقسام العلّة
الشيخ محمد جواد مغنية
-
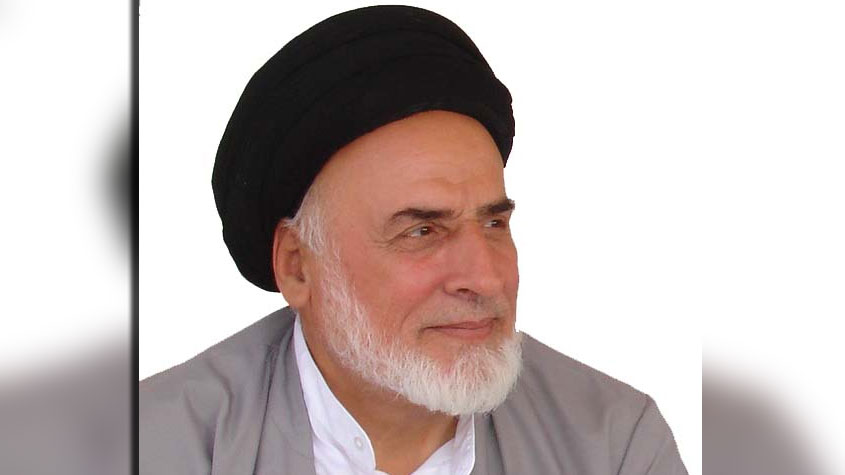 البحث التاريخي
البحث التاريخي
السيد جعفر مرتضى
-
 الكلمات في القرآن الكريم
الكلمات في القرآن الكريم
الشيخ جعفر السبحاني
-
 الصورة والفاعلية التواصلية
الصورة والفاعلية التواصلية
أثير السادة
-
 حياتنـا كما يرسمها الدين
حياتنـا كما يرسمها الدين
السيد علي عباس الموسوي
الشعراء
-
 السيّدة المعصومة: ملتقى الجمال والجلال
السيّدة المعصومة: ملتقى الجمال والجلال
حسين حسن آل جامع
-
 على غالق
على غالق
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر