علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ شفيق جراديعن الكاتب :
خريج حوزة قُمّ المقدّسة وأستاذ بالفلسفة والعلوم العقلية والعرفان في الحوزة العلميّة. - مدير معهد المعارف الحكميّة (للدراسات الدّينيّة والفلسفيّة). - المشرف العام على مجلّة المحجة ومجلة العتبة. - شارك في العديد من المؤتمرات الفكريّة والعلميّة في لبنان والخارج. - بالإضافة إلى اهتمامه بالحوار الإسلامي –المسيحي. - له العديد من المساهمات البحثيّة المكتوبة والدراسات والمقالات في المجلّات الثقافيّة والعلميّة. - له العديد من المؤلّفات: * مقاربات منهجيّة في فلسفة الدين. * رشحات ولائيّة. * الإمام الخميني ونهج الاقتدار. * الشعائر الحسينيّة من المظلوميّة إلى النهوض. * إلهيات المعرفة: القيم التبادلية في معارف الإسلام والمسيحية. * الناحية المقدّسة. * العرفان (ألم استنارة ويقظة موت). * عرش الروح وإنسان الدهر. * مدخل إلى علم الأخلاق. * وعي المقاومة وقيمها. * الإسلام في مواجهة التكفيرية. * ابن الطين ومنافذ المصير. * مقولات في فلسفة الدين على ضوء الهيات المعرفة. * المعاد الجسماني إنسان ما بعد الموت. تُرجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسيّة والفارسيّة، كما شارك في إعداد كتاب الأونيسكو حول الاحتفالات والأعياد الدينيّة في لبنان.انظر.. تبصّر.. هو الله

أنطلق في إثارة موضوع معرفة الله عبر صنائع خلقه وتجلّياته في الوجود والعالم من مجموع أقوال وأحاديث دينية، ثم نشرع بالمعالجة. ومن ذلك:
لما سئل أمير المؤمنين (ع) هل رأيت الله؟ فقال: لم أكن بالذي أعبد ربًّا لم أره. قال: فكيف، صفه لنا؟ قال: ويلك لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان…[1].
“كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، عميت عينٌ لا تراك عليها رقيبًا” (الإمام الحسين (ع)، دعاء عرفه).
“إلهي هبني كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز جنابك” (المناجاة الشعبانية).
تحدثت النصوص هنا، حول حتمية رؤية الله رأي بصيرة لا رأي عين؛ ذلك أن رأي العين إنما ترى الأجسام بأبعادها المتحيّزة، ولا جسمية، ولا تحيّز لبارئ السموات والأرض، والمورد الذي ينص على عميت عين لا تراك عليها رقيبًا، تريد أن تؤكد معنى الرقابة الإلهية في كل موجود وشيء يقع مرمى العين، لينظر من عمق البصيرة أن كل الكون ساحة حضور إلهي. وقد حصر الحديث الأول الرؤية بما أسماه “حقائق الإيمان”، فما معنى حقائق الإيمان؟ وهل المعرفة فيها عقلانية يمكن أن نأخذ بها؟ ثم لو أردنا الإيغال بالسؤال، هل هي قابلةٌ للإثبات؟
هناك موردان حدثتنا بهما النصوص الإسلامية عن معنى حقائق الإيمان:
المورد الأول: عن أبي عبد الله (ع) قال: استقبل رسول الله (ص) حارثة بن مالك بن النعمان الأنصاري فقال له: كيف أنت يا حارثة بن مالك؟ فقال: يا رسول الله! مؤمن حقًّا، فقال له رسول الله (ص): لكل شيء حقيقة فما حقيقة قولك؟ فقال: يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت هواجري وكأني أنظر إلى عرش ربي [و] قد وضع للحساب، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة، وكأني أسمع عواء أهل النار في النار، فقال له رسول الله (ص): عبد نوّر الله قلبه، أبصرت فأثبت، فقال: يا رسول الله ادع الله لي أن يرزقني الشهادة معك، فقال: اللهم ارزق حارثة الشهادة، فلم يلبث إلا أيامًا حتى بعث رسول الله (ص) بسرية فبعثه فيها؟ فقاتل فقتل تسعة أو ثمانية، ثم قتل[2].
المورد الثاني: أما في آليات وديناميات حصول الحقائق الإيمانية فقد أشارت المناجاة الشعبانية بلغة إشارية إلى أن يمر بمراحل أولها الانقطاع إلى الله، ثم ثانيًا أن ينير الله تلك القلوب بأنوار معرفة من ضياء معرفته، ليعلمهم ما لا يمكن لأحد أن يعلّمهم إياه. بعدها تخرق ما أسماه عليه أنوار النور مطلع العظمة، فتصير الذات والروح معلّقة بعزّ جلاله فتضعف.
الإيمان عن حق تمامًا كأن تتحدث في حق اليقين، هو ليس مجرد معرفة تمر أو تستقر في الذهن، بل أمر يصبح ماثلًا فيك، وجزءًا من هويتك تتذوقه وأنت متيقن مما تتذوق، وترى وقائع ما تؤمن به رأي العين كأنها ماثلة بآثارها عندك سواءً منها وقع الموت أو الحشر أو الجنة والنار، وصولًا إلى العزيز الجبار.
فضلًا عن أمور حياتك الدنيا، إن رُزقت هو الذي رزقني، وإن ابتليت هو الذي ابتلاني، وإن انتصرت أو لم تحقق نصرًا إنما النصر من عند الله. عند أهل الإيمان هذه حقائق لا كما تصورت مدارس غربية، كما عند جون راندال، أن المسألة عبارة عن حالة ذهنية تعبّر عنها بهذه الطريقة، أو تلك من خلال لغة دينية خاصة، وأن كل أمر يربط الناس بالله إنما كان لحاجة نفسية عندهم تحقق مصالحهم، فهم يتحدثون مثلًا عن الله الرحيم أو القدير بسبب أنهم يريدون تحقيق القدرة والرحمة فيهم، وبمقدار ما تؤسس هذه اللغة الدينية من غائيات مصلحية لجماعة الناس، بمقدار ما تشيع اللغة الدينية أكثر. ذلك أن لا حقائق دينية بذاتها، بل هي وليدة حاجات مجتمع يؤسسها ويبني عليها بالاهتمام والعناية التي تحقق الغاية. وبغض نظر ما تستوجبه هذه المقولة من مغالطة أو تناقض منطقي فإن المراد لها، كما أشار لذلك جون راندال، إخراج الله كمحور للدين واستبدال الدين به ليصبح الدين هو المحور من فروعه المبحوث فيها لفظ وحقيقة الإله، أو الله مع بدائل جاهزة من مثل المقدس وغيره.
وهناك اتجاه آخر، رأى أن كل عبارة دينية هي إما ميتافيزيقية أو أخلاقية، والأخيرة هي ما يمكن البناء عليها لخدمة نظام أخلاقي له تأثيره العميق في حياة الإيمان والمجتمع، وأن المجتمع غير المؤمن يمكنه الاستفادة منه في ركائز من عيشه، شريطة أن تتبلور القيم الأخلاقية دومًا، وأن تنظم بما يتلاءم مع روح عصر معين، فلا شيء ثابت أو دائم ولا شيء نهائي. وعليه، فإن الدين الذي لا غنى عنه هنا مرة أخرى بسبب قوة واستثنائية تأثيره على الناس من أتباعه على الخصوص يفرض اهتمامًا خاصًّا بما يخدم البعد الأخلاقي الاجتماعي. ومرة أخرى بحث موضوع الله ليس بالأمر الملح بذاته بمقدار ما ضرورة مبحث الدين الأخلاقي وتطويع شعائره وطقوسه بما يتلاءم مع ذلك. فما عند وفق هذه الأنظمة والاتجاهات من أولوية لنقد الأدلة ومناقشتها في المسائل الدينية خاصة منها الله سبحانه، بمقدار ما أن تناولها يعود لمنطق نفعي صرف حاكم في هذا المجال.
وهذه التحولات برغم ما فيها من إحداث بعض الضجيج على مبحث فلسفة خاصة في بيئة غريبة علمانية، إلا أن عودة الدين والحديث عن الإله ظل يتحرك وبقوة. وما زال التيار الذي يتناول العقلانية أو اللاعقلانية هو راسخ بقوة أيضًا.
فهل معرفة الله التي تصل حد الحديث عن رؤيته لدى الواحد من أهل الإيمان والتي قد نلحظ تكررها العريض نسبيًّا عند المسلم وغير المسلم من الأمور العقلانية، أم أنها خارج كل منطق، وهي واحدةٌ من انبثاقات الخيال؟
هنا، أؤكد أن هذه المسألة لنعطيها حقها وباحترام، لا يمكننا الاقتصار على أصحاب النظرة البرّانية للموضوع. نحن نحتاج إلى أن نتروّى جيدًا في مضمون ما يتحدث عنه المؤمن بهذه الرؤية، وأن نسمع منه المسوغات التي دعته للذهاب لاعتبار الأمر حقيقة إيمانية.
ومن المهم أيضًا أن نأخذ بعين الاعتبار انطباعات أصحاب الأديان المختلفة اتجاه بعضهم وبشكل مسبق يعود لكونهم يعتبرون أنهم أصحاب صدق في المعتقد، وغيرهم واهم إذ لا صدق لديه. فمثلًا، مهما سعى المسيحي للحديث عن ظهورات العذراء وعجائب القديسين، فإن غير المسيحي يتعامل معها بأنها لا عقلانية، ومهما سعى المسلم المؤمن بالمهدي من تأكيد وجوده، بل ورؤيته واللقاء به لأفراد من الناس بأمكنة وأزمنة متباعدة، إلا أن الأديان الأخرى تراها لا عقلانية.
ليس هذا ما نبحث عنه، بل نفس نظرة المسيحي لما يعتقد، أو المسلم وما يعتقد وما مضمون إيمانه وعقلانيته.
معنى رأيت الله: لا يختلف اثنان أن الله لا يحدّه مكان ولا زمان ولا شيء، بل هو فوق أن يُتوهم أو أن يعقل، وبالتالي لا تجسيم ولا رؤية.
إذن، ما المقصود من قول الإمام الحسين (ع): “عميت عين لا تراك عليها رقيبًا”، أو قول الإمام علي: “كيف أعبد ربًّا لم أره”، هل هو من باب الكلام الرمزي لأمر يستشعره المؤمن في وجدانه، ولقصور العبارة يرمز إليها، والرمز يحمل خلفه ما يحمل من دلالات؟
لا يظهر من كلامهم أن حديثهم عن الله هو من باب الكلام الترميزي، بل هناك وضوح وصراحة بيّنة في عباراتهم على الكلام المطابق لما يقصدون، بحيث يصح فيه أنه من الجمل الخبرية.
وما يحكيه الرائي هنا ويعبّر عنه، يعتقد أن بصريح قلبه يراه حقائق تضاهي في موثوقيتها رأي العين للأجسام، وهذا الأمر انعكس عند أهل الفلسفة إلى اتجاهات ثلاث:
الاتجاه الأول: قاربها كدرجة من الاطمئنان هي دون ما عليه العقل من يقين حينما يعلم ويعرف حقائق الوجود، ومنها الله، وهؤلاء كتبوا كثيرًا حول عقلانيتها، فضلًا عن إمكانها بالإمكان العام.
الاتجاه الثاني: وهو الاتجاه الإشراقي الذي بنى منهجه على ثنائية التكامل بين البحث الفكري الفلسفي، والعلم اللدني القلبي الذي يشرق على النفس فتشرق عنه أنوار المعارف، وأنه من دون هذا الانبثاق اللدني (من لدن الله) لا إمكان ليقين.
الاتجاه الثالث: فهو الذي اعتبر أن أقدام البرهان خشبية، وأن الدليل هو أن تشهد وترى الحقائق كما هي عليه، وهو وإن اعتبر أن هذه المعرفة خاصة بأهلها وممنوعة عن غيرهم، إلا أن بعض مدارسه يذهب إلى القول: إن أصل خلقة الناس مجعولة بما فطرهم عليه ربهم معرفته ورؤيته وإن بتجلياته.
وإذا كان الجميع يعتقد أنها معرفة قلبية فلأن القلب هو مركز المعرفة عندهم، وهنا يقوم العقل بدور البرهنة على هذه المعاني والحقائق والبناء الفلسفي على وفق ذلك.
هذا لا ينفي أنهم، خاصة الاتجاه الثالث، صرّحوا بأن تعابيرهم وكلامهم إنما يعبّر عن حقيقة يقينية، لكنه قاصر عن التعبير عنها، وذلك لضيق خناق العبارة.
فالعبارة تصرّح بحقيقة أكيدة، لكنها تبقى قابلة للمعالجة في دقة ما تصبو إلى بيانه. ولهذا بعضهم اختار الحكمة للتعبير، وآخر اختار الشعر لذلك، وثالث اختار القصة، كل من تعابيرنا شتى وجمالك واحد. الأمر الذي يسمح الغوص في دراسة اللغة الدينية وأنواعها وبنيتها وتشكّلها باعتبارها الوجه الذي صادق الحق، وتولّد عنه، إلّا أن تعبيره عنه كان من صقع عالم الاعتبار، لا عالم الحقائق، وهنا تكمن المشكلة ويكمن الحل في آن.
إن ضيق العبارة الناتج عن اختلاف صقع وافق الحقيقة والاعتبار القولي ولّد إمكانية هائلة لضخ معطيات ودلالات متكوثرة من حيث المعنى والدلالة والفهم. ومن ذلك عندما تصبح مثل تلك الأقوال موضعًا لمعالجة الفلسفة لها، إن لجهة إثباتها برهانيًّا، أو لجهة اعتبارها واحدة من الحقائق الفلسفية التي بنت عليها مدارس فلسفية وفلاسفة كبار أمثال السهروردي أو الملا صدرا، أو زعيم النزعة الفلسفية في العرفان محيي الدين بن عربي.
إذ إن الفيلسوف في الحضارة الإسلامية وإلى يومنا هذا يتعامل مع الكلام الوحياني، والكلام الشهودي أو ما يسمى بالعرفاني كما يتعامل مع الوجود بدهشة تكسر المألوف وتتحوط الحيرة، وتوغل في السؤال والتنقيب وإعادة النظر والبرهنة عند كل من يقول انظر بقلبك (هو الله).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الشيخ الكليني، الكافي، الجزء 1، الصفحة 138. (مكتبة أهل البيت (ع) الإلكترونية).
[2] مولى محمد صالح المازندراني، شرح أصول الكافي، الجزء8، الصفحة 171، باب حقيقة الإيمان واليقين. (مكتبة أهل البيت (ع) الإلكترونية).
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 ما الذي ينقصنا في عصر المعرفة؟
ما الذي ينقصنا في عصر المعرفة؟
السيد عباس نور الدين
-
 انظر.. تبصّر.. هو الله
انظر.. تبصّر.. هو الله
الشيخ شفيق جرادي
-
 قرية كافرة بأنعم الله
قرية كافرة بأنعم الله
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 التمهيد إلى ميتافيزيقا إسلاميّة بَعديّة (3)
التمهيد إلى ميتافيزيقا إسلاميّة بَعديّة (3)
محمود حيدر
-
 لا مُعين سواه
لا مُعين سواه
السيد محمد حسين الطبطبائي
-
 بيوت تحيا فيها المحبّة (2)
بيوت تحيا فيها المحبّة (2)
الشيخ حسين مظاهري
-
 الأصل اللّغوي لكلمتي يأجوج ومأجوج
الأصل اللّغوي لكلمتي يأجوج ومأجوج
الشيخ محمد صنقور
-
 القضاء في المدينة المهدويّة
القضاء في المدينة المهدويّة
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
-
 معنى (رأس) في القرآن الكريم
معنى (رأس) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 {قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ}
{قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ}
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
الشعراء
-
 السيدة الزهراء: وداع في عتمة الظلمات
السيدة الزهراء: وداع في عتمة الظلمات
حسين حسن آل جامع
-
 واشٍ في صورة حفيد
واشٍ في صورة حفيد
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-

ما الذي ينقصنا في عصر المعرفة؟
-

انظر.. تبصّر.. هو الله
-

أحمد آل سعيد: لكلّ حالة سلوكيّة أسلوب معالجة خاصّ
-
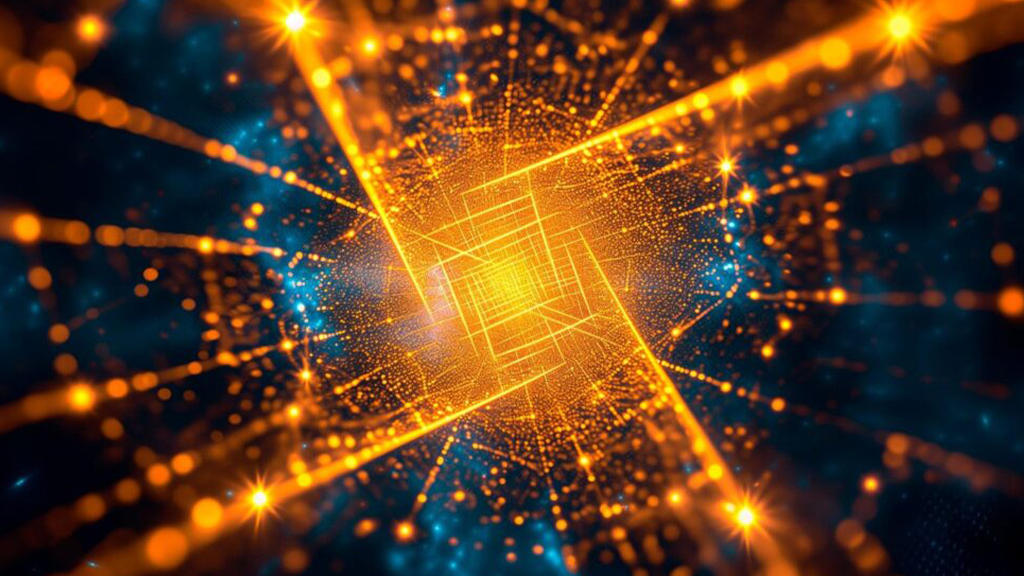
مادة ثورية فائقة التوصيل ذات خصائص حطمت الأرقام القياسية
-

الحرب العالمية في عصر الظهور
-
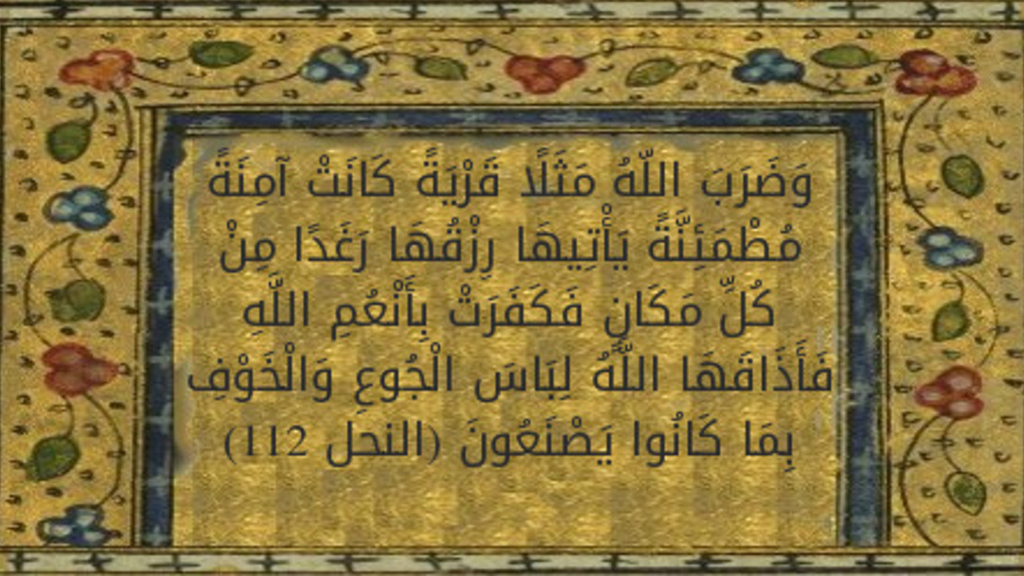
قرية كافرة بأنعم الله
-

التمهيد إلى ميتافيزيقا إسلاميّة بَعديّة (3)
-

لا مُعين سواه
-

بيوت تحيا فيها المحبّة (2)
-

الأصل اللّغوي لكلمتي يأجوج ومأجوج









