علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
حيدر حب اللهعن الكاتب :
ولد عام 1973م في مدينة صور بجنوب لبنان، درس المقدّمات والسطوح على مجموعة من الأساتذة المعروفين في مدينة صور (المدرسة الدينية). ثم سافر إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية لإكمال دراساته الحوزويّة العليا، فحضر أبحاث الخارج في الفقه والأصول عند كبار آيات الله والمرجعيات الدينية. عام 2002م، التحق بقسم دراسات الماجستير في علوم القرآن والحديث في كلّية أصول الدين في إيران، وحصل على درجة الماجستير، ثم أخذ ماجستير في علوم الشريعة (الفقه وأصول الفقه الإسلامي) من جامعة المصطفى العالميّة في إيران (الحوزة العلمية في قم). من مؤلفاته: علم الكلام المعاصر، قراءة تاريخية منهجيّة، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حجية الحديث، إضاءات في الفكر والدين والاجتماع (خمسة أجزاء) ...الأخلاق العلميّة (3)

محاولة لإعادة استحضار القيم الأخلاقيَّة في النَّشاط المعرفي
الشيخ حيدر حبّ الله ..
5 ـ العنف الفكري/ الاعتدال والوسطية
تعاني الكثير من مجتمعات العالم اليوم من ظاهرة العنف، وقد كثرت الأفكار والآراء المتعلِّقة بهذه الظاهرة، ودرسها الباحثون من زوايا متعدّدة، وأحد أنواع العنف هو العنف الفكري.
ليس هناك نظرية، على ما يبدو، قادرة على ادعاء نبذ العنف بشكل مطلق، وليس هناك تيار ينادي بنظرة واحدة إلى العنف، أي عدم تقسيمه إلى عنف مشروع ومقونن وعنف غير مشروع وغير أخلاقي ولا قانوني، والإسلام كان واحداً من هذه التيارات والاتجاهات التي قسمت العنف إلى قسمين، فرفضت بعضه وقبلت بعضه الآخر، وهو أمرٌ لا يعنينا فعلًا.
الأمر الذي يعنينا، هنا، هو مسألة العنف الفكري عند الباحث، فمن ناحية نفسية وسلوكية هناك أشخاص يفكرون بطريقة عنيفة، وهناك بعض آخر يفكر بهدوء وببرودة أعصاب، وهاتان الشخصيتان قد لا نتمكن من توجيه رفض شامل لهما ممتدٍ في الزمان والمكان والظَّرف والحال، لأن التفكير الذي يتَّصف بنوع من الصخب والعنف والانفعال والإثارة نحوٌ من أنحاء التفكير قد يحتاجه أحياناً شاعرٌ أو سياسي أو زعيم أو عارف إلخ... وقد لا يحتاجونه في حالات أخرى، ومن الخطأ ـ في ما يبدو ـ أن يتصور التفكير الممزوج بالإثارة على أنه تفكير خاطى دائماً، وذلك أن له حالات قد لا ينوب عنه فيها أي نمط آخر من التفكير.
وهكذا الحال في الشخصية الثانية، أي الشخصية ذات التفكير الهادى... إن هذه الشخصية ليست أمراً ثابتاً أو من المفترض أن يتحلّى به جميع الناس، إن بعض الحالات تفرض شخصية لا هدوء في تفكيرها وإلّا لضاعت الفرص، و... فيما تتطلب حالات أخرى تفكيراً هادئاً.
ولا يعني التفكير غير الهادىء التفكير الفوضوي، بل يعني التفكير الممزوج بالإثارة والطابع الانفعالي بعيداً عن فوضويته أو انتظامه، فبعض الأبحاث قد تتحلَّى بنظام شديد وترتيب كامل، بيد أن التفكير الذي أنتجها تفكير غير هادىء، والعكس هو الصحيح.
لكن السؤال الذي يبقى مثاراً هو: ما هو الإطار العام الغالب الذي يطالب الباحث أو المفكر، أو التفكير، بصورة عامة، أن يسير ضمنه؟ وما هو الاستثناء على هذا الصعيد؟ كيف يمكن توزيع الأدوار؟
هل أن التوزيع زماني، أي هل نتحدث عن أزمنة، فنقول: إن هذا العصر يتطلب نمطاً من التفكير، أما ذاك فيتطلب نمطاً آخر؟ أو نجعل التوزيع قائماً على أساس تصنيفي بين الناس بحيث نتحدَّث عن شريحة يملكها نمط تفكير أو فئة فيما شريحة أخرى تحكمها طريقة أخرى؟... أنجعل في كل إنسان أكثر من شخصية دفعةً واحدة يستبدل إحداها بالأخرى عندما يتحقق موضوع كل طريقة وظرفها؟... أم نترك الأمور على رسلها تتحكم فيها التنوّعات الطبيعية في شخصيات الناس التي تختلف باختلاف الوراثة والبيئة و...؟
بحسب العرض المتقدّم، ينفتح هذا الموضوع على غير صورة وشكل، لكن من الممكن هنا إثارة نقاط سريعة وموجزة:
أ ـ إن البحث الذي يستهدف الحقيقة يرجح أن يكون هادئاً، لأن الصخب قد يعوِّق تصاعد التفكير وبشكل منتظم وممنهج، فكلما كان التفكير هادئاً وقادراً على أن يحيط بجوانب الموضوع، كان أقدر على قطع منافذ التوتر والإرباك، فالتفكير ممارسة كباقي ممارسات الإنسان التي يطولها الإخفاق والشلل والخلل عند ارتباك صاحبها أو توتّره.
ب ـ البحث العلمي، داخل الدائرة الإسلامية، من المطلوب أن تحكمه حالة الهدوء والتفاهم والاستقرار، انطلاقاً من القاعدة القرآنية القاضية {رحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح/29]، هذه القاعدة، حسبما يفهم من النص القرآني، لا يخرج عنها سوى في حالة الصراع السياسي المتمثل في مفهوم البغي الذي يستدعي إثارة الهيجان في الدائرة الإسلامية كلِّها، وقد يعثر في النصوص على أمور أخرى كحالات البدعة، أو ما شابه ذلك مما يتوقف عليه أحياناً حفظ الدين، وإلا فالأصل في علاقة المسلم بالمسلم هو علاقة الرحمة، وهي علاقة تجعل من أي نشاط فكري داخل هذه الدائرة نشاطاً هادئاً مستقراً.
والمسوِّغ الذي يقدّمه القائلون بضرورة عدم الرحمة إزاء بعض الخلافات الفكرية داخل الساحة الإسلامية يتمثّل في تطبيق مقولات البدعة وهدم الدين والتآمر على الإسلام إلخ...، ومع التقدير المبدئي لهذه المقولات غير أن التباساً، في التطبيق، أو في تحديد الدوائر، لا يزال متحكّماً بالموقف، فتعريف البدعة، وتقديم تصورات واقعية عن المخاطر التي تحفّ بالدين، ومن ثم تحديد الدين والتدين، أو الضرورة الدينية والثابت الديني...، إلى غير ذلك من المفردات، ذلك كله لا تزال تنتابه درجة من الغموض الذي استجلاه بعضهم عن طريق افتراض مركزية قائمة على تفكيره الشخصي، الأمر الذي ولّد ولا يزال إشكاليات حقيقية.
أمّا الاتجاه الذي ينافح عن التغيير، فيحاول فلسفة ثوريته أحياناً عن طريق إغراق الساحة بسيل من الإحباطات التي تؤدِّي بدورها إلى تفضيل المنطق الثوري على المنطق التوفيقي الإيجابي أو التغييري المرحلي، والشيء الذي يضغط لصالح الموقف الداعي إلى ثورة ثقافية ـ بكل ما تحمله كلمة الثورة من معنى ـ هو وجود المنافس الغربي السريع الخطى، والذي يلاحق أي خطوة تطوير في الواقع الثقافي والعام ليدفعها بقوّة نحو الأمام، الأمر الذي قد يؤدي بها إلى تعثّرات هدّامة أحياناً انطلاقاً من اللاإستحكام في الحركة تماماً كمن يسير في الطريق بخطى تعتمد على دفع غيره باستمرار، وهذه المعضلة، أي معضلة الحركة المبرمجة من جهة وفقدان عامل الزمن من جهة أخرى، لم تحسمها آلية الثورة، لأن تجربة القرن العشرين أكّدت في مجتمعاتنا الإسلامية على السرعة الهائلة واختزال المراحل، ما دفع المنافس الآخر الداخلي (التقليدي) إلى النكوص، وفصل هذا الوضع المثقف المتنور عن واقعه ومجتمعه، الأمر الذي أحال أي عملية تغيير شاملة ربما حتى على الطريقة الغربية، لأن الثورات الفكرية في الغرب تصاحبت وتعاطفٍ جماهيري كبير جداً، ولم يكن الناقدون غرباء في مجتمعاتهم إلى الحد الموجود في بعض مجتمعاتنا الإسلامية.
ج ـ من الضَّروري معرفة أن التحرّق على الدين من الهجمات الثقافية التي يتعرّض لها اليوم، لا يسوِّغ استخدام أساليب العنف الفكري في مقام إنتاج الأفكار أو في مقام عرضها، لأن التجارب الواقعية باتت تؤكد ـ وبتواصل ـ أن هذه الأساليب غالباً ما جرّت في الآونة الأخيرة، أي في القرن العشرين، سلبيات على المدافعين عن الدين، لا أقل من أنَّها صنعت شخصيات في الطرف الآخر أثارت تعاطف الشارع عموماً، بدءاً من طه حسين وعلي عبد الرازق، وصولًا حتى نصر حامد أبو زيد وعلي الوردي وعبد الكريم سروش وعلي شريعتي ونوال السعداوي وغيرهم.. وقد أكدت غير تجربة أن العقبة الأساس التي كان يواجهها بعض هذه الشخصيات كانت اللغة العلمية الهادئة التي استخدمها بعض خصومهم ضدهم، كما يقال عن «مطارحات» الشيخ محمد مهدي شمس الدين المخصَّصة للرد على كتاب «نقد الفكر الديني» للدكتور صادق جلال العظم، فقد شكلت هذه اللغة إحراجاً لهذه الشخصيات حتى لو تعرّض أصحاب هذه اللغة أنفسهم أحياناً لغضب التيار التقليدي.
إن هذا الموضوع دخل عملياً دائرة التجاذب حول ما هي الوسيلة الأنجع اليوم في بدايات الألفية الثالثة للدفاع عن الدين؟ هل خلق الإرباك والمنطق الثوري في ردع الآخر أو تهدئة الأمور واستخدام منطق هادى؟ وفي تقدير كاتب هذه السطور أن المنطق الهادى يمكن اعتباره اليوم في الإطار العام ـ وكل شيء له استثناءاته ـ الوسيلة الأنجع في الدفاع عن الدين، فنحن نعيش في عالم بدأ لا يرفض منطق الصخب في المعرفة فحسب، بل أخذ يشعر بحالة من التقزّز إزاءه، وهو ما يؤدي إذا لم نعد إنتاج خطابنا الفكري وفاقاً لضرورات المرحلة إلى المزيد من التراجع على الصعيد الثقافي والفكري عموماً.
إن طفو مظاهر التطرُّف الفكري، على مختلف اتجاهات الثقافة بلا استثناء، وتربُّع المتطرّفين من جميع الاتجاهات على كراسي المعرفة وإدارة الأمور، وانزواء المعتدلين واتهامهم بالجبن أو المهادنة أو المداراة أو الرياء سيكرّس ثقافة العنف في عالم المعرفة، وسيعمد في نهاية المطاف إلى إغراق الساحة الثقافية في عواصف من الإرباك، والتوتر واللاإستقرار، وهي عواصف تعوِّق ـ بالتأكيد ـ عملية التنمية المنشودة.
6 ـ النَّظر بعين ناقدة إلى النِّتاج الشخصي/ التَّواضع العلمي
ثمة قصص ومقولات مسجلة أو تتناقل شفاهاً أن بعض العلماء السابقين، أو بعض المعاصرين، يحجم عادةً عن نشر كتبه ومؤلفاته، ويسوِّغ هذا الصنف من العلماء، أو من يؤيد توجههم، هذا التصرّف بتسويغات كثيرة يرجع بعضها إلى القول: إنَّ الإنسان كلما نظر في ما كتبه بعد مدَّةٍ شعر بالنقص فيه.
ولسنا في صدد محاكمة هذا السلوك، لكن أساسه صحيح ودقيق، فكلما تقدّم الإنسان الباحث في العلم وصارت لديه خبرة أكبر في هذا المجال، شعر بالنقص في ما قدّمه سلفاً من نتاجات، وهذا أمرٌ ـ كما أُلمح ـ إن دلّ فإنما يدل على تقدّم الإنسان نفسه، وإلّا لشعر بعظمة ما كتبه ولو بعد حين.
إن الشعور الدائم بالنقد الذاتي ـ وكذلك تقبُّل النقد الموضوعي من طرف الآخرين ـ يشكل ضمانةً مهمَّة لديمومة الرقي والارتفاع المعرفي، إن الباحث الذي يعيد قراءة ما أنتجه أو التفكير فيه، وبصورة متواصلة، هو باحث متواضع وليس متكبراً، وهو باحث يهدف إلى الحق والحقيقة لا إلى الأنا والذات، كما أنّ الشعور بنقص ما قدّمه الإنسان شعورٌ أخلاقي ينمّ في ساحة التديُّن عن تقوى وتواضع، أما التكبُّر في الحياة العلمية فلا معنى له في ظل وسائل الإدراك المحدودة للإنسان، وهذا التكبر هو اليوم ـ وربما قبل اليوم ـ إحدى آفات الباحثين والبحث العلمي، إن الكثير من مقدّمات الكتب أو في مطاويها لا تزول منها عبارات أن ما أتيت به لم أجده عند أحد قبلي، أو لم يسبقني إليه أحد، أو هو فتح عظيم، أو هو تغيير سيقلب معادلات المعرفة والتفكير، أو هو حل لمعضلات دامت قروناً متمادية... إن هذه الكلمات عندما تصدر، في عصرنا الحديث، عصر التواضع المعرفي، والاعتقاد بضعف قدرة العقل أمام كشف الحقائق إنما تعبر عن دوغمائية وجزم لا موضوعي، فيما المطلوب تقديم نمط تفكير أكثر تواضعاً، أو إذا أردنا أن نعبر بطريقة براغماتية نفعية نقول: نمط تفكير أكثر براعةً وقدرةً على امتصاص أي خطأ في المستقبل.
إن نقد الذات القائم على اعتقاد حقيقي مسبق بمكانتها الواقعية المحدودة في المعرفة، وترويض النفس على تحمل هذا النقد وتقبل اكتشاف الخطأ... ليس أمراً سهلًا أو مجرَّد شعار نطلقه وننضوي تحته، وإنما تربية للنفس صعبة كل الصعوبة تحتاج إلى سلسلة من الأخلاقيات تتضافر لصنع شخصية علمية متواضعة، من جهة، ومتفهمة من جهة ثانية، ومسرورة باكتشاف الخطأ من جهة ثالثة، أما الاعتقاد بالخطأ في الذات وممارسة العصمة فيها فهو مفارقة تجرّ الكثير من السلبيات.
وهذه المشكلة (التكبّر والخوف من النَّقد وإعادة النظر) تظهر في كلمات الباحثين كثيراً وبأساليب متعدّدة، أحدها تعقيد العبارات اللفظية ومحاولة إبهام الأفكار على الآخرين (طبعاً ليس الأمر على نحو إطلاقي بالتأكيد)، إن الحملة العنيفة التي شنَّها التيار الجديد ضد الكتب الدينية ـ والحوزوية بالخصوص ـ في تعقيداتها وأساليب بيانها المبهم وإن كانت صائبة من وجهة نظر، لكن البديل الذي قدّمته النتاجات الجديدة لم يكن دائماً أسهل، فالكتب الجديدة التي تصدر عادت إليها الظاهرة نفسها مع اختلاف الشكل والقالب، وصارت هناك حالة شبه سائدة اليوم مفادها أن الباحث كلما مارس تعقيداً أكبر وإبهاماً أعمق في كلماته وعباراته نمّ ذلك عن عمق معرفي ومستوى علمي أكبر عنده، وكلما بسّط الأفكار ـ لا إلى حد الابتذال ـ كشف ذلك عن نقص علمي عنده، بل يرى بعضهم ـ كما كانت ترى التيارات المدرسية الدينية ـ أنَّك إذا لم تستعمل المصطلحات الخاصة، فإنَّك لم تدخل في المناخ العلمي المطلوب، فسابقاً كان شعار العلمية أن تستخدم تعابير الفلسفة وأصول الفقه، أما اليوم فتعابير جديدة، مشكلةُ بعضِها أنها لم تدخل في صورة رسميّة المعاجم الجديدة إلى حد بلغت فيه الحال أن كل كاتب صارت له مصطلحات خاصة.
إن تطوّر المصطلح أمرٌ في غاية الضرورة، ولا مجال لتجاوزه، ولا نقاش هنا في هذا الأمر، إنما الحديث عما يمكن تسميته بحالة اللاإستقرار في إنتاج المصطلح واستخدامه إلى حد النظر (إضافة إلى من قال...) إلى كيف قال، لا إلى ما قال، وهو أمرٌ يعكس في ما يعكس ـ من وجهة نظر شخصية ـ إشكالية تعود في بعض امتداداتها إلى الجانب الأخلاقي بالمعنى الذي ذكرناه للأخلاقي.
وهذا التعقيد يعبّر، في بعض الأحيان الأخرى، عن محاولة من الباحث لسدّ الطريق على النقد المركّز والواضح، وهي نقطة جديرة بالتركيز عليها والتأمل فيها.
إذن الإحساس بثقل النَّقد الذاتي، ومن ثم النقد الموجّه من الآخر، يعبّر عن رغبة في الاستقرار في نقطة محدَّدة علمياً وعدم تخطيها نحو الأمام.
والأمر الذي قد يُجبر الباحث على اتخاذ مواقف متصلّبة أحياناً هو الثقافة والتربية العامة اللتان تنظران إلى من يعترف بخطئه، أو يعدل عن رأيه، بمثابة الضعيف علمياً، صحيح أن المفكّر الناضج أو المجتهد في العلوم الدينية مطالبٌ بالدفاع عن أفكاره لا التخلّي عنها وكأنه لم يتعمَّق فيها، لكن هذا لا يعني خلق مناخ لا يسمح بالتراجع أو التبديل، بل المطلوب عدّ ذلك كرامة ومفخرة تمنح صاحبها وساماً في الأوساط العلمية، فأكثر العلماء عبر التاريخ تغيرت آراؤهم عدّة مرات في حياتهم، فقد عرف ذلك من فلاسفة كبار كابن سينا والملَّا صدرا، كما عرف عن فقهاء أجلَّاء كالعلَّامة الحلّي والإمام الغزالي وغيرهما، بل إن ذلك سنّة الله في خلقه إلَّا من عصم، وهذا ما يجعلنا نضع بعض علامات الاستفهام على المحاولات التي ترمي إلى تصوير بعض المفكرين ـ كالشهيد محمّد باقر الصدر (م 1400هـ) ـ وكأنهم لم تتبدّل أفكارهم منذ نعومة أظفارهم، وعدّ ذلك شاهداً على عبقريَّتهم.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (فور) في القرآن الكريم
معنى (فور) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 معرفة الإنسان في القرآن (5)
معرفة الإنسان في القرآن (5)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
الشيخ محمد صنقور
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
-
 صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
السيد عادل العلوي
-
 هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
السيد عبد الحسين دستغيب
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

لقاء الرحمة والعبادة
-

معنى (فور) في القرآن الكريم
-

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحفز الإبداع إذا سألناه كيف يفكر لا ماذا يفكر
-
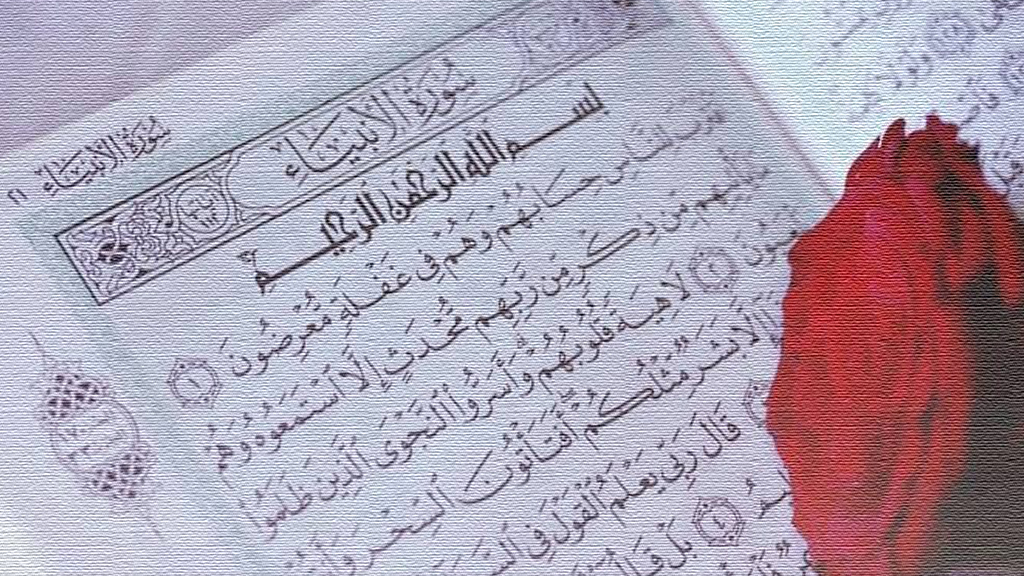
معرفة الإنسان في القرآن (5)
-

خديجة الكبرى المسلمة الأولى
-

شرح دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك
-

السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
-
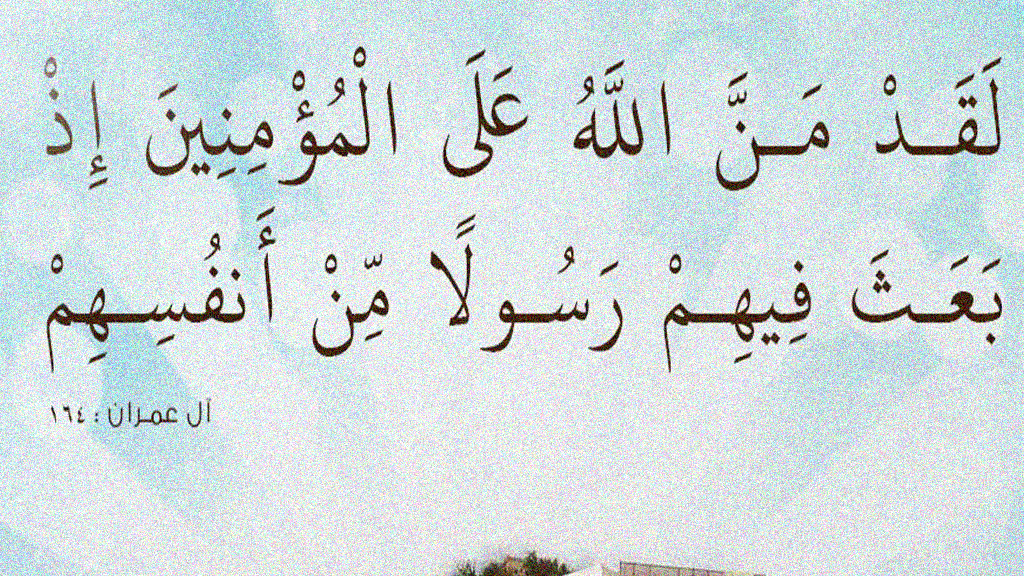
معنى (منّ) في القرآن الكريم
-

أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
-

اختتام حملة التّبرّع بالدّم (النّفس الزّكيّة)










