علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".مقاصدُ الاستشراق

محمود حيدر
لو أنّ لنا من توصيفٍ يوَحِّد معنى الاستشراق بعد ارتحالٍ مديدٍ من الإجراءات التفسيريّة، لقلنا إنّه فهمُ الغرب للشرق، من دون أن يكون للشرق حريّة التّعريف بنفسه كما هي في الواقع.
كان للغرب شغَفٌ إلى التعرّف على شرقٍ لم يعد عند غروب القرن الثّامن عشر مجرّد نظيرٍ جَهوي له.. بل كان بالنسبة إليه، جغرافيا مسكونة بالأسرار. ثمّ وجدَ أن لا مناصَ له من تحرّي ما تثيرُه الدّهشة التي ينطوي عليها. فأنَّى ذهبتِ التّفسيرات لجلاء الأسباب المعرفيّة التي دفعت النُّخب الغربيّة إلى مثل هذا التحرِّي، فليس من العقلانيّة في أمر، أن تُحمل الظّاهرة على محمَل البراءة. ذاك أنّنا لسنا بازاء إجراءٍ معرفيٍّ منقطع الصّلة عن تحوّلات الحداثة، وتدفّقها إلى خارج فضائها القومي.
بهذا المعنى لا يعود الاستشراق مجرّد حقبة تاريخيّة ولدت كفائض قيمة للحداثة الإمبرياليّة، وإنّما هو ظاهرة مركّبة من المعرفة والهيمنة؛ وقد صُبَّتا في وعاءٍ واحد...
ما تصحّ الإشارة إليه، أنّ الغرب استطاع أن يتجاوز أزماته الحضاريّة من خلال إعلائه من شأن النّقد. فلقد نقدَ كلَّ عيبٍ يولد في حقلٍ من حقول المعرفة ومنظوماتِ القِيم، من أجل أن يرمِّم ما فَسد في تاريخه. لكنّ الاستشراق لم يكن في حاجةٍ على ما يبدو إلى مثل هذا النّقد، إلّا إذا تعلّق الأمر بتصحيح المهمّات التي أوكلَها إلى نفسه. ولذا، فعلى الرّغم ممّا ظهر به عملُه، وكأنّه نسَقٌ مستقلٌّ بذاته، إلّا أنّه لم يكن بمنأى من الإستراتيجيات العليا لموطنه الأصلي. فإنّه في أطوار زمنيّة ومكانيّة مختلفة سيُفارق مدَّعاه الاستقلالي، ليؤدّي مهمّة أيديولوجيّة من وجهَين:
1- تظهير العقلانيّة بما هي شأن ذاتي لماهيّة الغرب.
2- رؤية الشرق تبعاً لعقل الغرب ومعاييره الصّارمة، وإعادة توليد صورة المشرق على نحو يجعل نُخبَه ومثقّفيه غافلين عمّا هم عليه في واقع الأمر.
هذا ما يشير إليه إدوارد سعيد، حين يرى أنّ انعدام الوعي النّقدي الضّدّي في الاستشراق، هو حصيلة كونه توثيقاً إحاليّاً، يُعيد فيه النّصُّ الجديد -أي المنتَج الاستشراقي- توثيقَ سلطةِ النّصّ القديم.
ففي مقدّمة كتابه (الاستشراق)، يقول سعيد: «إذا اتّخذنا من أواخر القرن الثامن عشر نقطةً للانطلاق؛ محدّدة تحديداً تقريبيّاً، فإنّ الاستشراق يُمكن أن يناقَش ويحلَّل بوصفه المؤسّسة المشتركة للتّعامل مع الشرق. أي التّعامل معه بإصدار تقريراتٍ حولَه، وإجازة الآراء فيه وإقرارها، وتدريسه، والاستقرار فيه، وحكمه.. الاستشراق كأسلوب غربي للسّيطرة على الشرق، واستبنائه، وامتلاك السّيادة عليه..».
وأمّا مؤدّى الأطروحة التي يمضي إلى إنجازها، فيُوجزها قولُه: «إنّنا لم نكتَنه الاستشراق بوصفه إنشاءً، فلن يكون بوسعنا أبداً أن نفهم الفرع المنظّم تنظيماً عالياً، والذي استطاعت الثقافة الغربيّة عن طريقه أن تتدبّر الشرق -بل حتّى أن تنتجَه- سياسيّاً، واجتماعيّاً، وعسكريّاً، وعقائديّاً، وعلميّاً، وتخيّليّاً..».
يضيف: «لقد احتلّ الاستشراق مركزاً هو من السّيادة بحيث أنّني أؤمن بأنّه ليس في وسع إنسان يكتب عن الشرق، أو يفكّر فيه، أو يمارس فعلاً متعلّقاً به، من دون أن يأخذ بعين الاعتبار الحدود المعوّقة التي فرضَها الاستشراق على الفكر والفعل. وبكلماتٍ أخرى، فإنّ الشرق، بسببِ الاستشراق، لم يكن (وليس) موضوعاً حرّاً للفكر أو الفعل.. لا يعني هذا أنّ الاستشراق، بمفرده، يقرِّر ويحتِّم ما يُمكن أن يقال عن الشرق، بل إنّه يشكّل شبكة المصالح الكليّة التي يُستَحضَر تأثيرُها بصورة لا مفرّ منها في كلّ مناسبة... بحيث يكون فيها ذلك الكيان العجيب -الشرق- موضعاً للنّقاش».
أما كيف يحدث ذلك، فقد جاء -حسب سعيد- عبر تقريره أنّ الثقافة الغربيّة اكتسبت المزيد من القوّة والهويّة بوضع نفسها موضع التّضادّ مع الشرق؛ باعتباره ذاتاً بديلة أو حتّى سريّة: «تحت -أرضِيِّة».
ديالكتيك التّثمير والتّفكيك
لو قصرنا وجهة الاستشراق على كونها وظيفة أيديولوجية للسلطة الإمبريالية، فلربّما سهَونا عن الكثير من مواطن الخَلل. فالمسألة تتعدّى السياسي المباشر لتصلَ إلى طبقاتٍ أعمق غوراً، وهي في الوقت عينه، متّصلة اتّصالاً موثوقاً بالغاية العليا لتوجّهات الحداثة، ورحلتها الكولونياليّة نحو الشرق.
وعلى هذا النحو سنرى كيف انعقد السجالُ حول الاستشراق على سياقٍ مركّب، قوامُه التّلازم الدّيالكتيكي بين التّثمير المعرفي لمنجزات الشرق، وإعادة إنتاجها كسلطة معرفيّة للسيطرة عليه.
ثمّة مَن يبيّن أنّ الاستشراق -الذي كثيراً ما أسهب المعنيّون في توصيفه وتعريفه- لا يعدو كونه علماً طالَ الإسلامَ عقيدةً وثقافة، واجتماعاً سياسيّاً، وبنْيةً حضاريّة. فلا عجب إذاً، أن تنشأ مدارسُ للدّراسات العربيّة والإسلاميّة، أبرزها تلك التي تزعّمها المستشرق «بورجشتال». ولا غرابةَ أيضاً حين تتبوّأ إحداها -تحت إدارة المستشرق «سنوك هرخرونيه»- مكانةً مرموقةً وُضعت في خدمة المستعمرات الهولنديّة في جنوب شرق آسيا. أمّا الألمان الذين حُرموا من وليمة المستعمرات، فلم يَنههم ذلك عن الضرب بسهمٍ وافرٍ في هذا العلم. ومن بابٍ أولى -ونحن نستجمع أسباب اللّهفة الأوروبيّة على الثقافة العربيّة- أن نعود بذاكرتنا لنرى إلى الدافع الذي آل بالإسبان إلى العدول عن السيف نحو الكلمة، من أجل درْء الخطر الذي شكّله الفتحُ الإسلامي بدايةً، ومن بعده الموحّدون الذين أثاروا بانتصاراتهم المتكرّرة حفيظةَ الكنيسة.
أمّا النتيجة فكانت ولادةُ فكرة ترجمة القرآن الكريم للتعرّف على الطبيعة الروحيّة والفكريّة للخصم. ولقد أصاب المستشرق الألماني «يوهان فوك» حين شبّه حال الكنيسة وهي تتبنّى الفكرة وتنفّذها، بحالة الدول النّامية في وقتنا الرّاهن، إذ بات لزاماً عليها، أن تخطو الخطوة الأولى، فتنفتحَ معرفيّاً على ثقافات وأيديولوجيات الدول المصنّعة والمتقدّمة...
يظهر لنا هنا إلى أيّ مدى كان للعامل الدّيني عناية خاصّة في اشتغالات الاستشراق. ولَسوف يلاحظ المحقّقون، كيف لعب الدّين دوراً رئيسيّاً في ولادة الحركة الاستشراقيّة. ففي وقتٍ مبكّر سيجري التعامل مع الشرق بوصفه جغرافيا دينيّة، ومع لغة القرآن الكريم بما هي الفضاء المعنوي والمعرفي الحاضن لتلك الجغرافيا.
ولو تحرَّينا الدراسات والتحقيقات التي أنجزها المستشرقون في لغة الدّين وفلسفته، لَتبيّنَ لنا عمق التلازم بين الدّين واللّغة لاستكشاف البناءات المعرفيّة لمجتمعات الشرق العربي والإسلامي.
فلَئن عُرِّف الاستشراق لدى جلِّ المستشرقين، على أنّه فقه اللّغة (الفيلولوجيا)، كما حرص المستشرق «باريت» على تسميته، فلن يكون ذلك مجانبةً لحقيقة التعريف. فاللّغة العربية، بحكم تحدُّرها من أسرةٍ ساميّةٍ واحدة، إلى جانب الآراميّة والسريانيّة والعبريّة، راحت تستأثرُ باهتمام الكنيسة لشرح ما أبهمَ عليها من نصوص الكتاب المقدّس.
من أجل ذلك شاع القول إنّ الإقبال على تعلّم العربية لم يكن بحافزٍ أحادي، ولا بطفرة دينيّة فحسب، بل لأسبابٍ معرفيّة أيضاً. فمن المعروف أنّ العصر الوسيط شهد للعرب أنّهم ورَثةُ العلوم القديمة، وهو ما كان يطلَق على الطبّ والفلك والفلسفة والرياضيات. كانت العربيّة وقتها كالانجليزية اليوم، لغة الرُّقيّ والمدنيّة، وبوّابة الخلاص من الجهل والتخلّف. وكان الشعار المرفوع دوماً -وحتّى وقتٍ متأخّرٍ من القرن الثامن عشر- هو تخليص الاستشراق من قبضة اللّاهوت ((AUTORITAT. سوى أنّ هذه المحاولة لم تجد سبيلاً لها لتصير نهجاً راسخاً في الممارسة الاستشراقية. وسيأتي من الحوادث ما يدلّ على أن المنحى الغالب في الاستشراق هو تحوّله إلى ضربٍ من ميتافيزيقا سياسيّة، بما لهذا الاصطلاح من معنى. ولنا على سبيل التحقيق أن نحيل القارئ إلى الحادثة التالية:
عام 1888 أقدم «غوغوير» على ترجمة «ألفيّة» ابن مالك المشهورة، وهي -كما يُعرف- أرجوزة في النحو العربي لا مكانَ فيها للجدل الديني أو العقائدي أو السياسي، لكنّه افتتحَ الترجمة بهذه الكلمات: «لقد حان الوقتُ لإتقان هذة اللّغة الساميّة (العربية)؛ ذات الطابع الشعائري أساساً والمنتشرة في مستعمراتنا».
والدافع إلى هذا العمل -على ما يوضح صاحب الترجمة- هو: «أن نتعرّف على الاتّجاهات الخبيثة لكُتّابها وأن نشهِّر بهم. إنّ بحثي قد يكون مفيداً على المستوى العلمي البَحت، لكنّ هدفَه الأكبر عملي؛ إنّه من نوع الطموح الذي يحملُه المهندس العسكري عندما يدرس مراجعَ عدوّه حول الدفاع والهجوم؛ إنّ هدفي هو التدمير..».
بوجهٍ عام، لا يوضَع الكلام -الذي مرّ معنا- خارج الحفر المعرفي المتعدّد الأنساق. وهو هنا يعبِّر عن نفسه في استكشاف الشرق بما هو جغرافيّة الإسلام المترامية الأطراف، وإعادة تشكيله وتأليفه على قاعدة ما ذهبنا إلى تسميته بـ «ديالكتيك التّثمير والتّفكيك». فلو عدنا إلى المشهد العالمي المعاصر، لوجَدنا أنّه كلّما انعقد كلامٌ حول ثنائيّة الإسلام والغرب، عاد ما بينهما من وصلٍ وفصلٍ إلى سيرته الأولى. فما من شيءٍ للإسلام على الغرب، أو للغرب على الإسلام، إلّا رُدَّ إلى مستهلّ الإشكال؛ إلى تلك اللّحظة التي أدرك فيها الغرب، بما هو غرب، أنّ استئنافَ التاريخ، وإعادةَ ترتيبه، لا يتحصّلُ إلّا بآخر يواجهه، ليُحاوره أو يجادلُه، أو لِيُهيمنَ عليه. إنّها أيضاً اللّحظة نفسها، التي يُدرك فيها المسلمون أنّهم، على وجه القصد، هم ذلك الآخر.
أما السؤال المفترَض عن موقعيّة الاستشراق ضمن جدلية «الذات والآخر»، فقد نجد جوابه في التوظيف الأيديولوجي للفكر الاستشراقي سحابة قرون الحداثة الفائتة..
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (فور) في القرآن الكريم
معنى (فور) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 معرفة الإنسان في القرآن (5)
معرفة الإنسان في القرآن (5)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
الشيخ محمد صنقور
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
-
 صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
السيد عادل العلوي
-
 هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
السيد عبد الحسين دستغيب
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

شرح دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان
-

لقاء الرحمة والعبادة
-

معنى (فور) في القرآن الكريم
-

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحفز الإبداع إذا سألناه كيف يفكر لا ماذا يفكر
-
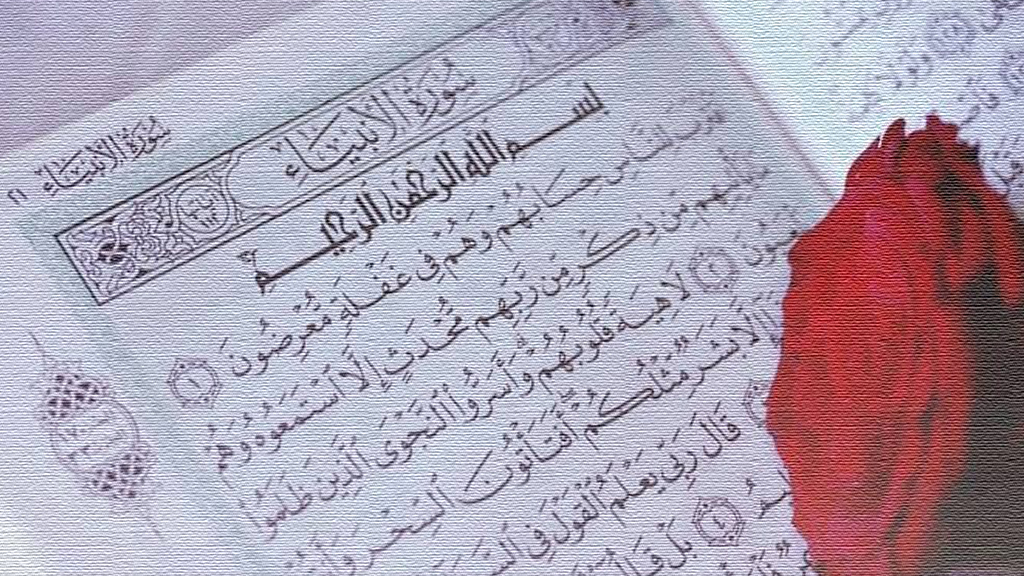
معرفة الإنسان في القرآن (5)
-

خديجة الكبرى المسلمة الأولى
-

شرح دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك
-

السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
-
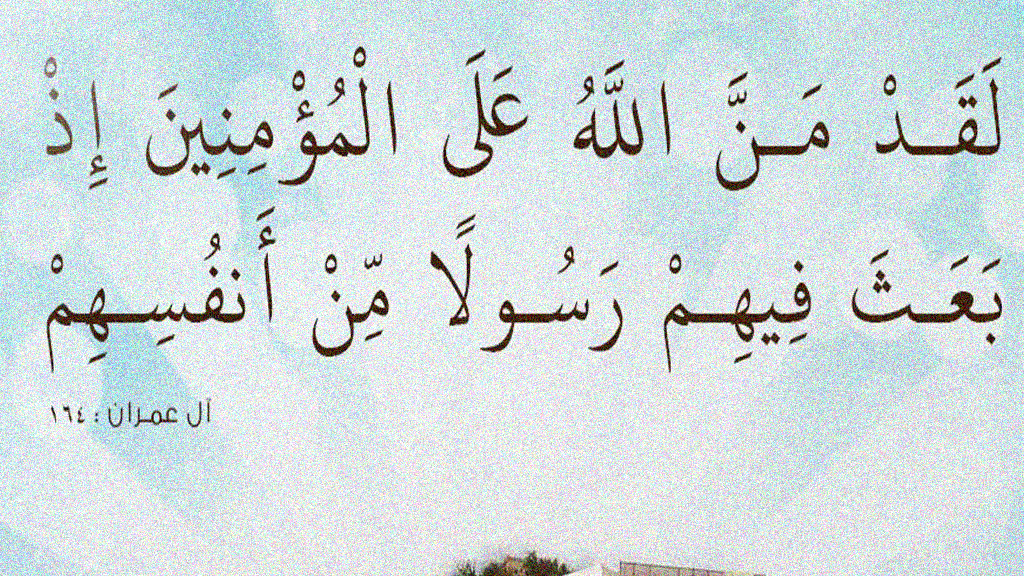
معنى (منّ) في القرآن الكريم
-

أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين










