علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".الغرب العائد إلى سؤال الإيمان

كان فيلسوف الدين الروسي نيقولا برديائيف يرى أن لليقظات الفلسفية دائماً مصدراً دينياً، ولقد نال من كلامه هذا الكثير من النعوت المذمومة، من جانب علماء التاريخ الماركسيين من مجايلييه. لكنه رغم سير الانتقادات التي انهمرت عليه، والتي استؤنفت بعد وفاته من جانب المؤسسة الستالينية، ظل على قناعته بأن جهلاً مطبقاً ضرب العقل الأوروبي حيال الدين.
وكان يدعو على الدوام إلى التبصر في هذه الظاهرة التي لا يستطيع العقل العلماني أن يقاربها بيسر. بل إنه سيمضي في مطارح كثيرة من مساجلاته، إلى ما هو أبعد من ذلك. فقد أعرب عن اعتقاده بأن الفلسفة الحديثة عموماً، والألمانية خصوصاً، هي أشد مسيحية في جوهرها من فلسفة العصر الوسيط، حيث نفذت المسيحية برأيه إلى ماهية الفكر نفسه ابتداءً من فجر عصور الحداثة.
ذلك يدل على وجود منفسحات معرفية ذات وزن داخل البيئة الفلسفية الغربية، كانت ولا تزال ترى بهدوء إلى موقعية الإيمان الديني الحاسمة في وجدان الأفراد والحضارات. ومؤدى ما كان يصدر عنها، أن ليس ثمة صراعاً بين الإيمان في طبيعته الحقيقية والعقل في طبيعته الحقيقية.
ويشمل مثل هذا التأكيد أطروحة تقول بعدم وجود صراع جوهري بين الإيمان والوظيفة الإدراكية للعقل. وإذا فُهِمَ ذلك، ظهرت الصراعات السابقة بين الإيمان والعلم في ضوء مختلف تماماً. فالصراع في الحقيقة لم يكن بين الإيمان والعلم، بل بين إيمان وعلم لا يعي كلاهما بعده الصحيح.
فلم يكن الصراع الشهير بين نظرية التطور ولاهوت بعض الطوائف المسيحية، صراعاً بين العلم والإيمان، بل صراعاً بين علم يجرد إيمان الإنسان من إنسانيته، وإيمان شوه التأويلُ الحرفي للكتاب المقدس تعبيراته. ويفضي هذا التمييز بين حقيقة الإيمان وحقيقة العلم، إلى تحذير لا بد من توجيهه للاهوتيين وعلماء الدين في ألا يستخدموا المكتشفات العلمية الحديثة لتأكيد حقيقة الإيمان.
وسرعان ما صار الكتاب الدينيون يوظفون هذه المكتشفات لتأكيد أفكارهم عن الحرية الإنسانية، والإبداع الإلهي، والمعجزات. ولكن لا مسوغ لمثل هذا الإجراء، لا من وجهة نظر الفيزياء ولا من وجهة نظر الدين، فالنظريات الفيزيائية المشار إليها لا علاقة لها مباشرة بالظاهرة المعقدة تعقيـداً لا نهائياً عن الحرية الإنسانية.
إذا اتفقنا على المبدأ الأخلاقي كمعيار تأسيسي لإجراء المصالحة بين الإيمان الديني والعلمنة، نكون قد وضعنا الفرضية الأولى لأطروحتنا. فإذا كانت غاية الدين ومقاصد الشريعة قائمة على الخير والعدل والحب والجمال، وإذا كانت غاية العلمنة هي الوصول بالإنسان ليكون سيد نفسه وسيداً على الكون.. فإن الغايتين سوف تلتقيان بالضرورة على الجوهر الواحد وهو الخيرية. وهنا يمكن القول إن الإيمان الديني المتجرد من الأغراض، يتضمن في منطقه الداخلي كل ما له صلة بخير الإنسان، وبهذه الرابطة الجدلية لن يُرى الإنسان ومن موقعية الإيمان الأعلى إلا ككائن نبيل ومكرّم، يستحيل فصل علمانيته عن روحانيته.
لا شيء يحول دون هذا التوحّد الضروري، سوى تحويل الإيمان إلى رأي والعلمنة إلى إيديولوجيا، ومثل هذا التحويل هو من طبيعة السلطة كل سلطة، سواء كانت دينية أو علمانية. والسلطة الدينية بسبب غرضيتها وتحيّزها واستئثارها بما لها وما لغيرها، تروح توظف مبادئ الخير والجمال لأغراضها وأهوائها وديمومتها، كذلك تفعل السلطة العلمانية لما يأخذها الغرور لتنتزع من الإنسان عالمه المعنوي، وتلقي به في عوالمها الأرضية الصمّاء. وفي اختباراتها السياسية والثقافية والأمنية على مدى قرون الحداثة، ما يستظهر مشاهد مدوية في ميادين القهر والإقصاء والنفي.
الإيمان بوجود قانون أخلاقي مطلق، لا يتناقض مع القول بأن الأفكار الأخلاقية تختلف باختلاف البلدان والعصور والحضارات. والقول بأن الشيء نفسه يكون خيراً في ثقافة معينة، وشراً في ثقافة أخرى، لا يعني أن الأخلاق نسبية، بمعنى أن الشيء نفسه هو خير في ثقافة، وشر في أخرى، والذين يؤمنون بذلك ربما جهلوا القانون الأخلاقي الحقيقي.
والدليل العقلي أنه إذا كانت السرقة خطأ فهي في كل مكان وعلى الدوام، وكذلك الظلم والقتل وسائر صنوف الشر. تلك رؤية الأديان على الجملة، فكل إنسان يؤمن بأن العالم يمثل نظاماً أخلاقياً، لا بد له بالضرورة من أن يعتنقها لكي يكون إنساناً سوياً، ولو كانت القيم الأخلاقية موضوعية، فهي مستقلة عن معتقدات الناس وآرائهم. فلا يكون الشيء خيراً لأن بعض الثقافات يعتقد أنه خير، فما هو صواب سوف يكون ما هو عليه في انسجام مع النظام الكوني.
ومعنى ذلك، على الجملة، أن أي نوع من الموضوعية الأخلاقية ينطوي على القول بوجود أخلاق كلية واحدة. يستطيع الإيمان الأعلى، وهو إيمان الصفوة من القديسين والأولياء والحكماء والفلاسفة وعلماء الأخلاق، أن يحتوي بحكمته ورحمانيته وعقلانيته الفكر السلطوي.
ولأن القرن الواحد والعشرين هو القرن الفاصل بين عصرين، فإنه في مرحلة انتقالية، يلتبس فيها القديم المتداعي بالجديد الواعد، أي أنه قرن الاحتمالات المفتوحة في ساحة الأفكار والنظريات والمفاهيم. ولأنه كذلك، فهو يحتاج إلى جهد تنظيري، ليملأ الفراغات التي عصفت بعالم المفاهيم.
لم يعد العقل الذي ابتنت عليه الحداثة منجزاتها العظمى على امتداد خمسة قرون متواصلة، قادراً وبأدواته المعرفية المألوفة على مواجهة عالم ممتلئ بالمفارقات والتناقضات. لم تعد العلمنة التي تقدست مسالكها ونعوتها وأسماؤها، مؤهلة لمواصلة حروبها مع من يخالفها ثقتها المفرطة في بناء مدينتها الفاضلة، ولا الدين الذي صنعته الجماعات الحضارية على قياسها، قادراً على نيل رضا الله في خلقه. هذا ضرب من الادعاء، قد تقولون. لكن لا بد من الادعاء بعدما استغرق الإنسان شرقاً وغرباً في فوضاه وقلقه وحيرته. حين انتهى ما بعد الحداثة إلى الحديث عن الإنسان الأخير وعن موته، فبديهي أن ينصب الحديث الذي سيلي، على الحاجة إلى إنسان مستأنف، يجمع ولا يفرق، ويجتمع حيث ينبغي الاجتماع.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 خصائص الصيام (1)
خصائص الصيام (1)
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الشيخ محمد صنقور
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 معرفة الإنسان في القرآن (6)
معرفة الإنسان في القرآن (6)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (فور) في القرآن الكريم
معنى (فور) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

خصائص الصيام (1)
-

الموانع من حضور الضيافة الإلهية
-

البعث والإحياء بعد الموت
-

حديث للاختصاصيّ النّفسيّ أسعد النمر حول توظيف التّقنية في العلاج النّفسيّ
-

التقوى، العطاء، الإيثار في شهر رمضان
-

شرح دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان
-
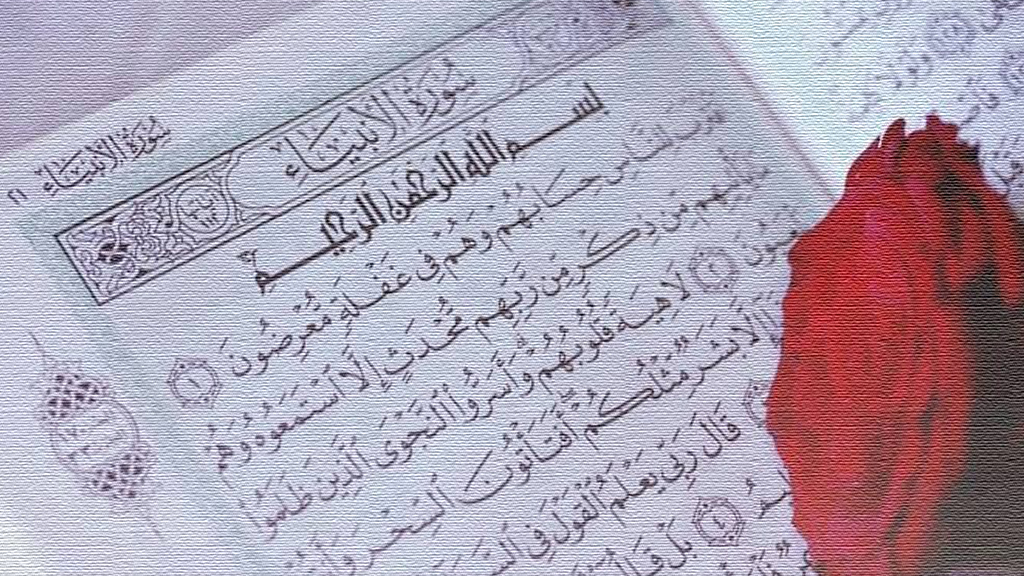
معرفة الإنسان في القرآن (6)
-

شرح دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان
-

لقاء الرحمة والعبادة
-

معنى (فور) في القرآن الكريم










