علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".تنظير الآخر الغربي (3)
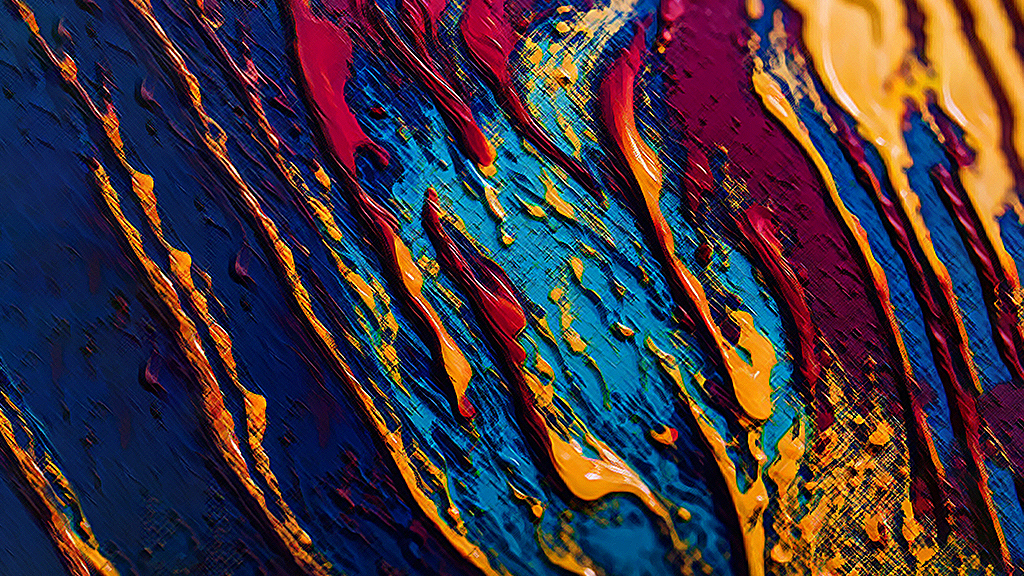
هيغل ذروة اضطراب الميتافيزيقا المعاصرة
أخذ هيغل عن الأسلاف معثرته الكبرى. فكان بذلك أرسطياً بقدر ما كان ديكارتياً وكانطياً في تمارينه الفلسفيَّة. من بعدِ ما أضناه مبحثُ الوجود بذاته سيعرض هيغل عن ورطته اللاهوتيَّة ليحكم على الوجود بالخلاء المشوب بالعدم. فلا وجود عنده إلا ما هو ظاهرٌ وواقعٌ تحت مرمى الأعين. وفي هذا لم يأتِ بجديد يَفْرُق بينه وبين السلف. ليس ثمة على ما يبدو من مائز جوهري بينه وبينهم. أخذ عنهم دربتهم ثم عكف على مجاوزتهم حتّى اختلط الأمر عليه حدّ الشبهة.
آمن هيغل بالوجود ثم أخضعه للديالكتيك وذلك على خلاف ما استلهمه من جوهر الإيمان المسيحي. لم يفعل ذلك من أجل توكيد كفايَّة الوجود لذاته بذاته، بل للتقرير أنه متناقض في ذاته. ومعنى هذا –كما يبيِّن في مدّعاه- أن وجود المجرّد – قبل وجود الطبيعة – يحتمل ألا يكون موجوداً وموجوداً في الآن عينه. أي أنّه ينطوي هو نفسه على الوجود واللاوجود في الآن عينه. والحال فقد اصطدم كل من هذين النقيضين في نظامه الفلسفي لينجم من ذلك أن تحوَّلَ فكرُه بكامله إلى ظواهر الموجودات، ثم ليسري مذهبه التناقضي إلى كل موجود، سواء كان طبيعة أم إنساناً أم مجتمعاً.
من المفيد للذكر.. أن إحدى أبرز النظريّات التي طرحها هيغل هي نفي (الوجود المحض) جملةً وتفصيلاً. ذلك لاعتقاده أن كلّ وجودٍ إنّما ينشأ إثر تركيبه مع العدم. بمعنى أنّ الوجود والعدم يجتمعان مع بعضهما ليتمخّض عنهما الوجود الطبيعي. ولقد سعى الرجل إلى توليفٍ ملتبسٍ يجتمع فيه الضدان والنقيضان، ثم ليكون هذا التوليف مؤسَّساً على فرضيتين أساسيتين:
الأولى: أن كل شيء يكون موجوداً ومعدوماً في آن واحد.
والثانية: أن التناقض في الموجودات هو أساس حركتها وتكاملها.
المعترضون على هذا التنظير يقولون: ليس من شأن العدم أن يتّصف بالوجود على أرض الواقع باعتباره نقيضاً له، لذا لا يمكن تصوّر حدوث انسجامٍ واتّحادٍ بينهما. بناءً على ذلك، سيخطئ هيغل ومن تَبِعُه لمَّا قالوا إنّ اتّحاد الوجود والعدم في (الصيرورة) يدخل في أصل اجتماع النقيضين واتّحادهما مع بعضهما. فهذه الصيرورة تنقض مبدأ امتناع اجتماعهما.
هايدغر كمنعطف ميتافيزيقي
بدت مساعي هايدغر على خلاف ما اقترفه السابقون عليه. قد يكون سؤاله الأثير عن السبب الذي أفضى إلى وجود الوجودات بدلاً من العدم؟ دليلاً على ذهابه إلى السؤال المؤسِّس. الإجابة كانت بديهيَّة من طرف هايدغر: إن الشيء الذي يناقض نفسه لا يمكن أن يكون أو يوجد. لكأنما يرد على هيغل من دون أن يسمّيه؛ ثم يضيف متعجِّباً: كيف يكون هناك وجود محدّد وغير محدّد في آن واحد. ومن جهتنا نضيف: كيف لهيغل أن يرتضي لنفسه السؤال عن شيء ليس موجوداً؟
استعاد هايدغر ما سبق وما لَحِق من أسئلة الميتافيزيقا، ثم استودعها «حاضرته» الفائضة بالإبهام. فليس من غرابةٍ إذاً، أن نرى إلى مختبر أفكاره كمستودع يحوي العناوين الكبرى التي أنجزتها الفلسفة، على تعاقب أطوارها، وتنوّع مدارسها وتياراتها.
شُغلُه باستعادة الأسئلة الماضيَّة الحاضرة، لم يكن لأجل تفكيكها أو انتقادها تمهيداً للتبرُّؤ منها، وإنما لتكون له ممراً إجبارياً لمجاوزتها، وإعادة تظهيرها وفقَ ما يختزنه مشروعه من إنشاء فلسفي متجدد. أفصح هايدغر عن ذلك لـمَّا أشار إلى صعوبة الكتابة من خارج أفق الميتافيزيقا. وحجَّتُه أن الاعتناء بالسؤال المؤسس – أي ذاك الذي يستفهم حقيقة الوجود – يستحيل أن يُنجز بمعزلٍ عن عالم الواقع، الذي يشكل برأيه أفق الدلالة الشاملة للذّات الحيَّة، والذي في مجاله تتحقَّق الخبرة الإنسانيَّة.
لم يقطع هايدغر مع الميتافيزيقا الكلاسيكيَّة التي اكتفت بالاعتناء بالموجود، بل دعا إلى اجتيازها من خلال العودة إلى السؤال الأصيل عن وجودٍ لفَّهُ النسيانُ. لأجل ذلك راحت منظومته تنمو وتتكامل على امتداد انعطافات أربعة:
الأول: حين توقف مليّاً عند معنى واجب الوجود.
الثاني: لـمَّا سعى إلى تجاوز وهن الميتافيزيقا وفقرها الوجودي. كانت دعوته حالذاك متّجهة إلى نقل الهمّ الميتافيزيقي من حيِّز الاعتناء بالماهيّات نحو فضاءِ العناية بالوجودِ وأصالتهِ.
الثالث: لـمَّا استدرجه السؤال عن حقيقة الوجود إلى قلق طاول قاع النفس والفكر، وبسببه طفق يبحث عن مَلَكَاتٍ أخرى غير مرئيَّة في الروح الإنسانيَّة لتكون البديل من العقلانيَّة المتشيّئة لميتافيزيقا الحداثة.
الرابع: حَيْرتُه في الإشراقات التي وجد أن الكينونة تَهَبُها للإنسان لكي يهتدي بها إلى صواب الضمير.
إذا كانت مهمة هايدغر الأولى مجاوزة الميتافيزيقا بداعي انئخاذها بالموجود، وغفلتها عن الحقيقة الأصليَّة للوجود، فمثل هذه المهمة لا تلبث حتى تتضاعف تحيُّراً حين تعلم أن تلك “الغافلة عن أصلها” لـمَّا تزل تحتل مساحة العالم وتقرر مصائر أهله. ذاك أن عصر الانتقال من الميتافيزيقا المكتفيَّة بعالم الحواس إلى ما فوقها، يتم بصوت خفيض أمام ضوضاء التقنيَّة وسيطرتها المطلقة. في هذه الحقبة من تطوّر الميتافيزيقا يصبح الكائن الإنساني في وضعيَّة حدِّيَّة وحرجة: من ناحية تجعله يستسلم لجنون الهيمنة، ومن ناحية أخرى يتنبَّه إلى وجوب أن يأخذ قسطه من مسؤوليَّة كشف الواقع الذي هو فيه. والكشف هنا هو إزاحة السِّتر عما يمارسه العقل التقني، إلى الحدّ الذي يجعل انتماء الإنسان للوجود يعلن عن نفسه عبر استشعاره للخطر. وهذا الإنسان هو نفسه الذي سيطلق عليه هايدغر اسم “الدازاين” أو “الكائن الإنساني الباحث عن سر حضوره في العالم”. وهو ما حاول هايدغر التفكير فيه تفكيراً خاصاً عبر ما سمَّاه (الإيرأيغنيس Ereignis). أو “الانبثاق الكبير”…
لم يفارق هايدغر أسئلة الميتافيزيقا الصمّاء. لكنه لم يسكن إليها، وإنما ساكَنَهَا على سبيل المجاراة والوفاء لقربى قديمة. أما ما ستؤول إليه رغائبه فذلك ما ستفي به إلقاءات السنين الأخيرة من عمره. لقد أوشك وهو يجوب ساحل الحضرة الحائرة، أن يتعرض إلى الحادث العرفاني، بعدما أرهقته مشقة السؤال حول حقيقة الكينونة. بدا كما لو أنه يستعد لسفر تعرُّفي لم يألفه من قبل. سفر هو أقرب إلى هجرة لا تقبل العودة إلى الوراء، وغايتها الوصول إلى فكر يتعدى الفقر الموصول بالماهيات الفانيَّة. هو ـ على الأصح ـ فكر الفكر الذي جعله أرسطو فكراً خاصاً بالله. فكر يقود إلى الأصل.. إلى الشيء الذي هو محطُّ السؤال. ربما هذا الذي حدا به أن يعلن عام 1973 أنه مستمر في تعريف فكره بأنه “فينومينولوجيا ما لا يظهر بعد”. أي الفكر الذي يحيل دائماً إلى عمليَّة الظهور، وإلى الإنوِهاب التي يتلقاها الإنسان في الحضرة الإلهيَّة.
لن نقول إن هايدغر بلغ المكان الآمن في الحضرة. لقد مضى بالبذل طلباً لهذا المبتغى. لكنه اتجه شطر الألوهي بشقّ النفس.. إلى ان وجدناه بعد طوافه الأخير في صحراء الميتافيزيقا الظمأى يعلن ان بإمكان: “الله وحده أن يمنحنا النجاة”… وما كنا لنستحضر التنظير الهايدغري هذا، إلا باعتبار ما “اقترفه من شَغَبٍ فريد” في تاريخ الميتافيزيقا الغربيَّة. فالمحصول الذي زوَّدنا به كان أدنى إلى «جيولوجيا فلسفيَّة» لم تُخرج كل نباتها بعد..
كل ما جاء به العقل الغربي من محاجَّات، فإنما من تضخم الذات التي أسلمت نفسها لمسلمتين سحابة أربعة قرون خلت:
1 – مسلَّمة العلم التي تقرر أن العلم والتفكير العلمي قادران لوحدهما أن يحدِّدا كل ما علينا أن نتقبله على أنه حقيقي. وأن كل شيء يجب أن يخضع لقوانين الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، أو أي فرع آخر من فروع العلم، أما الروحانيات وحتى الشعور بالجمال والحدس والعاطفة والأخلاقيات، فقد اختزلتها النظرة العقلانيَّة إلى مجرد متغيرات في كيمياء الدماغ تتفاعل مع مجموعة من القوانين الميكرو ـ بيولوجيَّة المرتبطة بتطوّر الإنسان.
2 – مسلَّمة الهيمنة والاستحواذ، لـمَّا رأت أن الهدف من العلم – كما يقول فرانسيس بيكون – هو التحكم بالعالم الخارجي واستغلال الطبيعة، والسعي الحثيث إلى جلب المنافع أنَّى وُجِدَت.
من أجل ذلك سيكشف مسار الحداثة الفائضة عن خراب مبين في اليقين الجمعي سيُعرِّفُهُ عالم الاجتماع الألماني دوركهايم بـ “هيكل الشرك الحديث”. وهذا هو في الواقع، ما تستجليه عقيدة الفرد وشخصانيته المطلقة. فالشكل العبادي للشرك الحديث ـ كما ألمحَ دوركهايم ـ ليس الوثنيَّة بل النرجسيَّة البشريَّة، حيث بلغ تضخم الذات لديها منزلة الذروة في زمن الليبراليَّة المطلقة..
لقد ظهر في اختبارات الحداثة وامتداداتها المعاصرة أن ليس للمقدس لدى “العِلْمويَّة” بصيغتها الإلحاديَّة من محل. وهنا على وجه الضبط تكمن إحدى أهم خاصِّيات التهافت في الفكرة الإلحاديَّة. نعني بذلك نظرها إلى الانسان كشيء زائل ككل الموجودات الزائلة، حيث لا يعود المتعالي الإلهي بالنسبة إليها غير وهم محض.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (منى) في القرآن الكريم
معنى (منى) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 ثلاث خصال حمدية وثلاث قبيحة
ثلاث خصال حمدية وثلاث قبيحة
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 النسيان من منظور الفلسفة الدينية (2)
النسيان من منظور الفلسفة الدينية (2)
الشيخ شفيق جرادي
-
 معـاني الحرّيّة (3)
معـاني الحرّيّة (3)
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 (مفارقة تربية الأطفال): حياة الزّوجين بحلوها ومرّها بعد إنجابهما طفلًا من منظور علم الأعصاب الوجداني
(مفارقة تربية الأطفال): حياة الزّوجين بحلوها ومرّها بعد إنجابهما طفلًا من منظور علم الأعصاب الوجداني
عدنان الحاجي
-
 المدينة الفاضلة المهدويّة
المدينة الفاضلة المهدويّة
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
-
 يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ!
يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ!
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 إلقاء موسى موسى (ع) الألواح، ومشاجرته أخاه هارون (ع)
إلقاء موسى موسى (ع) الألواح، ومشاجرته أخاه هارون (ع)
الشيخ جعفر السبحاني
-
 أدر مواقفك بحكمة
أدر مواقفك بحكمة
عبدالعزيز آل زايد
-
 ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقا بَعدية (5)
ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقا بَعدية (5)
محمود حيدر
الشعراء
-
 السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات
السيدة الزهراء: حزن بامتداد النّبوّات
حسين حسن آل جامع
-
 اطمئنان
اطمئنان
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-
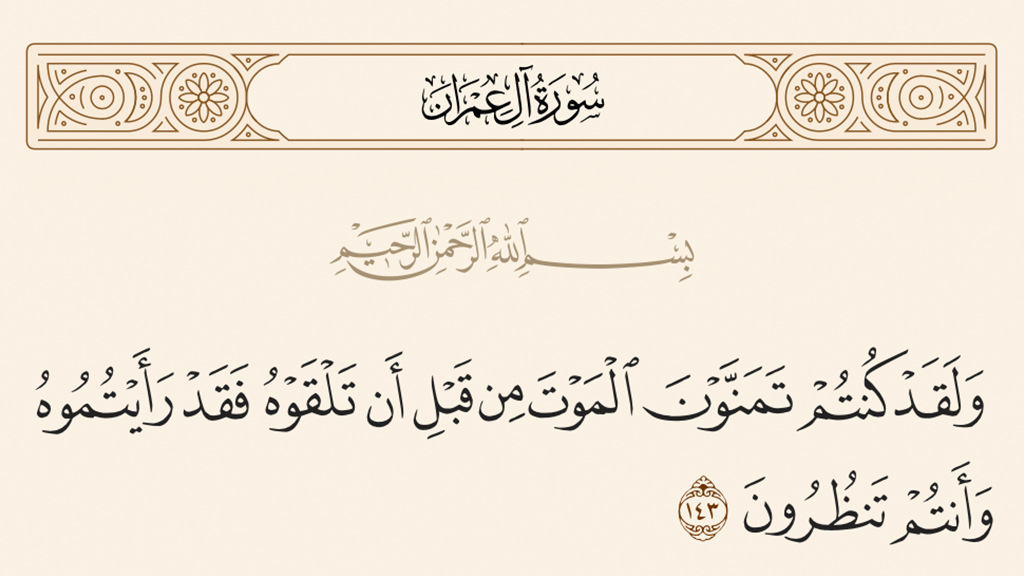
معنى (منى) في القرآن الكريم
-

ثلاث خصال حمدية وثلاث قبيحة
-

النسيان من منظور الفلسفة الدينية (2)
-

معـاني الحرّيّة (3)
-

(مفارقة تربية الأطفال): حياة الزّوجين بحلوها ومرّها بعد إنجابهما طفلًا من منظور علم الأعصاب الوجداني
-

نادي قوافي الأدبيّ بالأحساء يكرّم رئيسه الوسميّ على ما قدّمه خلال تولّيه إدراته لعشر سنوات
-

المدينة الفاضلة المهدويّة
-

معـاني الحرّيّة (2)
-

إيران: إطلاق موقع المحادثة مع تفاسیر القرآن الكريم بالذّكاء الاصطناعيّ
-

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ!









