مقالات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد عباس نور الدينعن الكاتب :
كاتب وباحث إسلامي.. مؤلف كتاب "معادلة التكامل الكبرى" الحائز على المرتبة الأولى عن قسم الأبحاث العلميّة في المؤتمر والمعرض الدولي الأول الذي أقيم في طهران: الفكر الراقي، وكتاب "الخامنئي القائد" الحائز على المرتبة الأولى عن أفضل كتاب في المؤتمر نفسه.لماذا يحزن المؤمن؟

السيد عباس نورالدين
كما أنّ المؤمن يفرح بنعمة الله ويحدّث بها ويظهرها، وهو يرى حياته كلها نعمة إلهية كبرى، فإنّه يشارك في مطالعة هموم العالم ومشاكله، ويتعرّف إلى آلام البشرية ومعاناتها، مع كل ما يجلبه له ذلك من حزن وغم. فأكبر خصائص المسلم الواقعي اهتمامه الكبير بما يجري في العالم وسعيه لإصلاحه، بدءًا من مجتمعه ومرورًا بمجتمعات المسلمين وانتهاءً بشعوب الأرض قاطبة. ولا يمكن لهذا المسلم أن يكون غير مبال بأيّ جماعة بشرية مهما كانت نائية وبعيدة. فالخلق بالنسبة له عيال الله، كما أخبره رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكل من آمن بالله أحب متعلقاته وكل ما ينتمي إليه، والبشر هم أهم مظاهر خلق الله.. إنّها علاقة تفوق الأخوّة الإنسانية والتشابه البشري، لأنّها تنبع من ارتباطنا بالله وانتمائنا إليه.
ويقف على رأس سلسلة العائلة البشرية ويتصدّر مشهدها رسول الرحمة والهدى محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله) الذي يمثّل لنا الفارق الجوهري بين الجنة والنار، أي بين النعيم المقيم وعذاب الجحيم، وبين كل مراتب السعادة وأشد أنواع الشقاء والمعاناة؛ فلولاه لكنّا في قعر حفر النار، كما قال تعالى: {وَكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها}.[1] ولذلك فإنّ حبّنا له يفوق الوصف، ولا يمكن أن يضاهيه أيّ حب مهما كان، سوى ما كان مثلًا له ونابعًا منه. ولهذا أحببنا الإمام عليًّا، لأنّه كان حبيب رسول الله، وأحببنا فاطمة الزهراء بنت المصطفى وبنيها الأطهار؛ وأضحى هذا الحب والود تذكارًا لكل الطيّبات والخيرات والفضائل والسعادات التي ننالها بفضل اتباعنا للنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله). فلا يمكن أن نتصوّر أيّ خير في عالم الوجود بمعزل عنهم.. هكذا كانت مشيئة الله تعالى: أن يفيض علينا بالهداية والنور والحبور والكمال والسرور بواسطتهم؛ ولهذا قصة عميقة ذات تفاصيل مذهلة.
يتصدّر مشهد حب آل البيت كل مشاهد الإسلام ومعانيه ومبادئه؛ وكيف لا يكون كذلك وقد جعله الله تعالى أجرًا ومقابلًا للرسالة التي هي وسيلتنا للنجاة: {قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى}.[2] ولأنّهم ثمرة الدين ومظهر تحقّق كل قيمه وأهدافه؛ وبفضل هذه المودة والتقرّب استطعنا أن نميّز الخطّين الرئيسيين اللذين تشعبا داخل التجربة الإسلامية منذ بداياتها؛ خط الإسلام الأصيل الصافي النقي، وخط حكام الجور وسلاطين البغي والفساد العابثين بالدين والمستغلين لمقدساته.
ومع مرور الزمان تجلّى هذان الخطان بصورة ديانتين مستقلتين وصراطين منفصلين. وبفضل تلك المودة وما نبع منها من موالاة وتبعية وتقدير تعرّفنا على الديانة الحقيقية، وعلّمنا الله معالم ديننا، وأصلح ما كان فسد من دنيانا. فتعمّق هذا الحب وصار عنوان الدين الأكبر. كما قال الإمام الصادق عليه السلام "وهل الدّينُ إلّا الحبُّ".[3]
مهما تحدّثنا عن علاقة المسلم الواقعي بأهل البيت الأطهار، فإنّ كلامنا يقصر عن إيصال المعنى في بضع كلمات ومقالة وجيزة. وكيف يمكن أن نؤدّي حق تراث عظيم امتد على مدى القرون، وهو يحوم حول مركز الطهر والفضيلة ويرتع قرب مقام العبودية الخالصة. فارتباطنا بهؤلاء المعصومين الأطهار أصبح مظهرًا أساسيًّا لارتباطنا بالله وأمرًا لا يمكن أن ينفك عنه؛ "وَمَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ وَمَنْ أَبْغَضَكُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ".[4] ومع كل خطوة نخطوها نحوهم، نقترب من معرفة خطة الله ومشروع رسالته، ونفهم هذا العالم وما يجري فيه ونتعرّف إلى حقائق التاريخ ونشرف على المستقبل. فهو الحب الذي أوقد فينا كل مصابيح الوعي والبصيرة.
لكن ما جرى عليهم من ظلم وعدوان كشف عن أسوأ ما يمكن أن يصل إليه البشر في انحطاطهم، وأبان الوقائع الكبرى التي فسّرت لنا مسيرة الإسلام وكشفت عن عوامل التراجع الحضاري، وأدركنا أنّ كل ما حلَّ بالبشرية من ظلم و مآسٍ وفجائع وفظائع على مدار الأعوام إنما تفرع ونشأ من ظلمهم ومنعهم من القيام بدورهم الذي عيّنه الله لهم. ولهذا نقول بأنّه لو قدر لأمير المؤمنين (عليه السلام) أن يحكم ويثبت قدميه، لتغيّر وجه العالم بأسره، ولما حدث كل ما حدث من فجائع الدهر في مجتمعات المسلمين وغيرهم من أهل الأرض.
ولهذا، فحين نستحضر مصائبهم، فإنّنا نستحضر مصائب العالم. ولو ذكرتَ لي قصة طفل يتيم تُرك وحيدًا في غابة من الوحوش في بلد ناءٍ كالأرجنتين، لما ترددت لحظة واحدة في نسبة هذا الظلم إلى مصيبة أهل البيت عليهم السلام. فنحن نتصوّر المشهد الكامل من حكومة الإمام علي وهو ينشر العدل في كل العالم، ويقطع دابر المجرمين ويقيم دولة القسط على كامل البسيطة. ولم يكن لينقص هذا الإمام، ولا مَن جاء بعده من أولاده المعصومين، أيّ كفاءة أو مهارة لتحقيق هذا الهدف المقدس، سوى رفض الناس له وإعراضهم عنه وكلبهم على دنيا زائلة ومتاعها الفاني، واتّباعهم لعصبية عمياء، ما زلنا نقاسي أهوالها إلى يومنا هذا.
من الجميل أن تتوقّف أيها القارئ ـ إن لم تكن ممن يفهم التاريخ على هذا النحو ـ وتستمع إلى العرض الدقيق الذي يقدّمه لك المنتمون الواعون لأهل البيت حول التاريخ ومسار العالم. ولن يطول الأمر حتى تعلم أنّ الحروب العالمية الطاحنة واغتصاب فلسطين ونهب ثروات المسلمين وكل فجائع الأرض، إنما كانت بسبب منع هؤلاء الأطهار عن القيام بدورهم الهادي.
ولا شيء يمكن أن يزيل ألم المؤمن هنا أو يخفف من حزنه على هذه المصائب المفجعة سوى الوعد الإلهي الكبير بالمستقبل المزدهر لهذه الأرض التي ستشرق بنور ربّها تحت ظل حكومة أهل البيت (عليهم السلام)، بدءًا من قائمهم بالحق وهو الإمام المهدي (عجل الله فرجه).
المسلم الواقعي شديد الاتصال بأوضاع العالم وكثير الاهتمام بمستقبله ومصيره، ولهذا فإنّه يرجع إلى التاريخ ليفهم ما يجري باعتبار أنّ التاريخ ليس سوى مجموع الأسباب والعلل التي أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، ونحن مسؤولون عن التعامل معها بحكمة ووعي ومعرفة ودراية. وليس هذا من باب التفاخر بالأمجاد ولا حقن الذات بمخدر الماضي. ففهم الماضي واستحضار وقائعه والسعي لفهمه لم يكن يومًا سببًا للضياع والحيرة وفقدان النظرة المستقبلية. وإنّما يضل ويضيع من انقطع عن التاريخ أو تصوّره بشكل خاطئ. وإنّما يصرّ المغفّلون على قطع ارتباطنا بالتاريخ حين يعجزون عن الاتصال بوقائعه وفهم حقيقة ما جرى فيه. وحينها يقول قائلهم كلمة الحق التي يراد بها الباطل: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُم}.[5] رغم أنّنا كنا وما زلنا أمة مسلمة واحدة منذ أن أنشأها رسول الله (صلى الله عليه وآله).
وبالنسبة لمن فهم التاريخ، فإنّ واقعة عاشوراء التي قتل فيها سبط النبي الأكرم وأحب الناس إليه الذي هو بمنزلة نفسه وبمثابة الروح من الروح حيث قال عنه "حسينٌ مني وأنا من حسين"،[6] تعدّ اختصارًا جليًّا لكل المشهد التاريخي الذي نتحدث عنه. ففيها أظهر أعداء رسول الله كل مكنونات نفوسهم وأغراضهم وحقدهم ورفضهم لمشروعه وكفرانًا بنعمته، وتكشّفت في فعلتهم الشنيعة تلك التيارات الأساسية والتوجهات والتفسيرات المتعددة داخل المجتمع المسلم. وباتت هذه الواقعة التاريخية ميزانًا لتقييم الناس بحسب انتمائهم لرسول الله ولدينه ومعيارًا لتحديد الشخصية الإسلامية الأصيلة التي تتفاعل مع قيم الدين وتنسجم معه.
فحزن المؤمن في كربلاء لا يُختصر بالتفجّع على هول المصاب وكبر الجرم، بل يتفاقم بحسب ما يراه من تشوّه بنيوي في شخصية عدد كبير من المسلمين الذين لا يقدرون على التفاعل مع رسول الله الذي يفترض أنه يمثّل لهم كل شيء. فكيف تحبون هذا النبي العظيم ولا تحزنون على قتل حفيده وسبي ذريته بتلك الطريقة التي يندى لها جبين التاريخ؛ وإن لم تقدروا على التفاعل مع مثل هذا المصاب الجلل، فمع أي شيء تتفاعلون؟! وأين هي النفس الإنسانية والطبيعة البشرية الأولية التي تحزن على موت حيوان أليف يعيش معنا داخل المنزل، ولا تحزن على قتل أعظم الناس والتنكيل بأهله؟!
حزن المؤمن حين يستحضر هذه الواقعة هو حزن على الجهل الذي يعمّ المجتمعات المسلمة التي لا تقدر على استبصار نور الهداية لفهم التاريخ وإدراك حقائق الحاضر. فهي عالقة وسط مآسيها التي لا تنتهي وهوانها الذي جعلها أذلّ الأمم.
ــــــــــــ
[1]. سورة آل عمران، الآية 103.
[2]. سورة الشورى، الآية 23.
[3]. الكافي، ج8، ص 80.
[4]. الزيارة الجامعة.
[5]. سورة البقرة، الآية 134.
[6]. بحار الأنوار، ج43، ص 261.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (فور) في القرآن الكريم
معنى (فور) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 معرفة الإنسان في القرآن (5)
معرفة الإنسان في القرآن (5)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
الشيخ محمد صنقور
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
-
 صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
السيد عادل العلوي
-
 هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
السيد عبد الحسين دستغيب
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

لقاء الرحمة والعبادة
-

معنى (فور) في القرآن الكريم
-

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحفز الإبداع إذا سألناه كيف يفكر لا ماذا يفكر
-
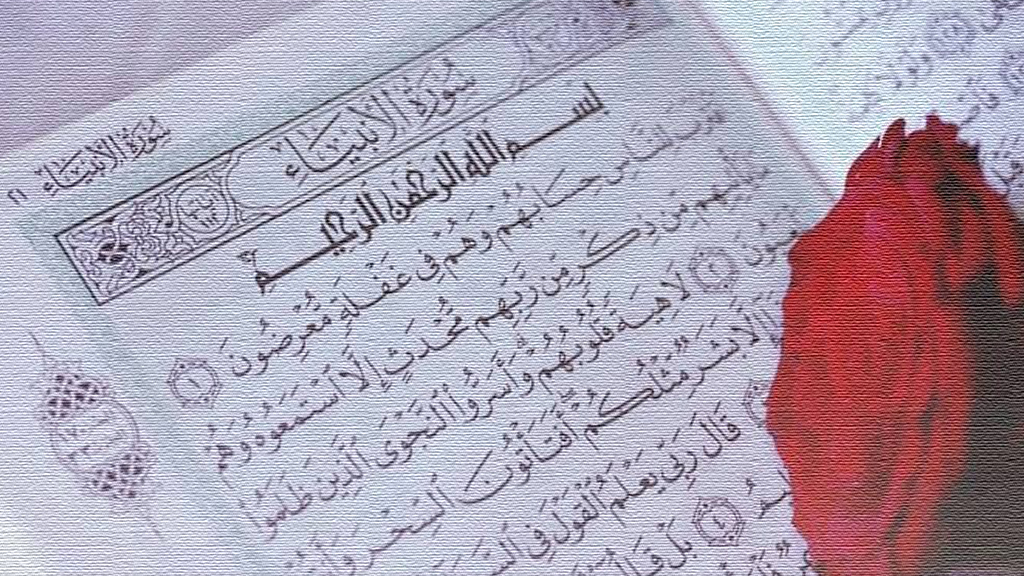
معرفة الإنسان في القرآن (5)
-

خديجة الكبرى المسلمة الأولى
-

شرح دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك
-

السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
-
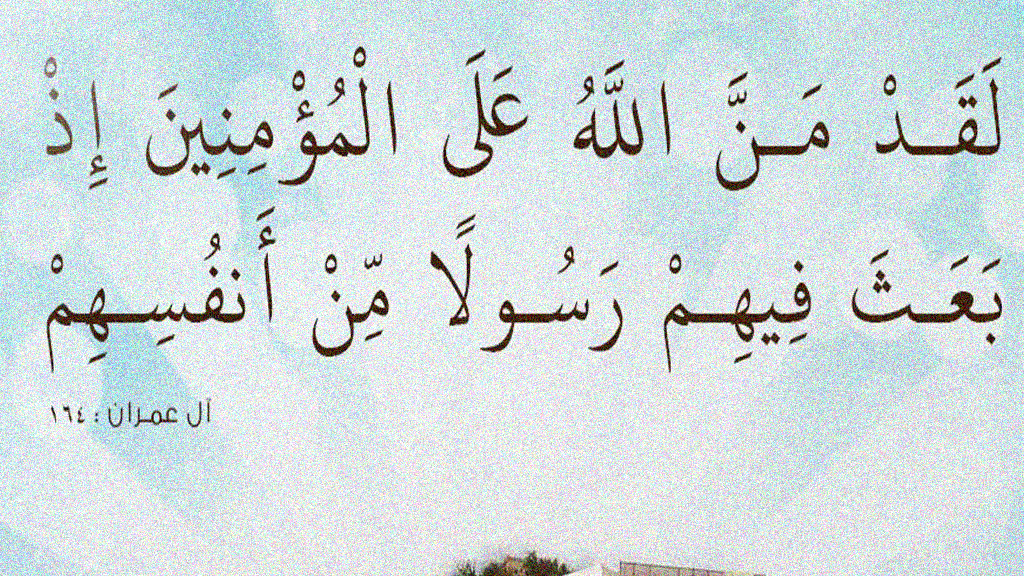
معنى (منّ) في القرآن الكريم
-

أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
-

اختتام حملة التّبرّع بالدّم (النّفس الزّكيّة)










