مقالات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد عباس نور الدينعن الكاتب :
كاتب وباحث إسلامي.. مؤلف كتاب "معادلة التكامل الكبرى" الحائز على المرتبة الأولى عن قسم الأبحاث العلميّة في المؤتمر والمعرض الدولي الأول الذي أقيم في طهران: الفكر الراقي، وكتاب "الخامنئي القائد" الحائز على المرتبة الأولى عن أفضل كتاب في المؤتمر نفسه.بين العقلانيّة وخوارق العادات، كيف نحبّ أن يعاملنا اللّه؟

ما يرتكبه العدو من فظائع يحفر فينا أسئلة لا بد من الإجابة عنها.
العقلانية تعني ملاحظة الأسباب المعروفة والتصرف وفقها. وخرق العادة عبارة عن إجراء الأمور دون معرفة أسبابها. أكثر المؤمنين يحبون أن يعاملهم الله بخرق العادة لأنّهم سيشعرون بقربه وعنايته أكثر. يسمون ذلك "التدخل الإلهي"، رغم أنّه ما من شيء يجري في هذا العالم إلا على أساس التدخل الإلهي. فإذا حصل انتصار على عدو يفوقنا عدة وعددًا سنعتبر هذا نصرًا إلهيًّا، أما اذا جرى وفق حسابات القوى الظاهرة فربما نخجل أو نحجم عن اعتباره كذلك.
ما من شيء أحب إلى المؤمن من أن يشعر بأنّ الله معه ومؤيده وناصره. يبذل المؤمنون جهدًا كبيرًا وجهادًا عظيمًا عسى أن ينالوا مثل هذا الشعور. إنّه الباعث الأوحد على الطمأنينة؛ وليس ببعيد أن يكون قوله تعالى {أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ}،[1] شاملًا لذكرنا له وذكره لنا. ربما لن تطمئن قلوبنا إلا إذا ذكرَنا اللهُ عز وجل. وبالتأكيد، إنّ الله يذكرنا عند كل ذكر له، كما قال سبحانه {فَاذْكُرُوني أَذْكُرْكُم}،[2] لكن المطلوب هو أن نشعر بهذا الذكر الإلهي ونُدركه. إنّه المقام الأعلى الذي ربما ليس فوقه مقام.
نُريد أن نشعر بأنّ الله حاضرٌ وناظرٌ في صراعنا ضد الباطل، ولذلك نتمنى من أعماق قلوبنا لو أنّ الله تعالى يدمّر أعداءنا بخسف أو زلزال أو أي شيء فوق هذه الأسباب والوسائل التي نستعملها، خصوصًا أنّنا أضعف بكثير من هذا العدو على الصعيد المادي. ضربة واحدة منك يا رب تجعلنا نشعر بأنّنا على الطريق الصحيح وأنّنا نفعل ما تريد.
رغم كل اليقين بأنّ هذا العدو ظالمٌ وباغٍ وطاغٍ وشرير ومُفسد، لكنّنا مع ذلك لا نستبعد أن نكون مستحقين لظلمه وعدوانه وبطشه بنا. هذا ما يجري في أعماق قلب كل مؤمن عرف ربّه وعرف نفسه. ما ينقلنا إلى الطمأنينة التي هي فوق البراهين العقلية والإيمان الاستدلالي هو أن نشاهد يد الغيب وقد امتدت من السماء لتبطش بعدونا بطريقة لا نتوقّعها أبدًا. هذا ما يُسمّى بخرق العادة.
لكن لخرق العوائد محاذير وسلبيات ربما لا نلتفت إليها، كما إنّ للعقلانية ونفوذ الأسباب العادية إيجابيات وفوائد قد لا تخطر على بالنا. وربما لو تأمّلنا جيدًا لعرفنا أنّ الأفضل لنا هو أن يتم النصر ـ إن أراده الله لنا ـ عبر الأسباب العادية من الإعداد والعدة والتخطيط والحيلة والتدبير والمكر والحذر والإتقان والمثابرة وبذل المهج والتضحيات الجسام.
في ظل هذا الفارق النوعي بالقدرات، من المتوقع أن يتحمل الأضعف الخسائر الأكثر ويدفع الأثمان الأبهظ. في غير هذه الصورة سيكون العامل هو خوارق العادات. أن نتوقع من العدو الذي يمتلك مئات الطائرات الحربية النفاثة عدم استخدامها ضدنا بطريقة وحشية تدميرية شاملة فهذا خلاف العقلانية. أن نتوقع انفجار مخازن الأسلحة الاستراتيجية للعدو بطريقة غير محسوبة فهذا خلاف العقلانية. أن نتوقع أن يقصفنا العدو ولا يُقتل منّا أو يستشهد نساء حوامل وأطفال صغار، هذا خلاف العقلانية. أن نتوقع أن لا يستخدم العدو كل قدراته وإمكاناته التي راكمها على مدى العقود، هذا خلاف العقلانية. أن نتوقع أن لا تدعم ألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا واليابان والهند وأستراليا هذا العدو بكل ما لديها من معلومات وتقنيات ومخابرات، هذا خلاف العقلانية.
الأشرار وُجدوا في هذا العالم لكي يستعملوا شرّهم ويظهروه إلى أقصى حد ممكن. كبت هذه القدرات هو خلاف العقلانية. هل هو ممكن؟ بالتأكيد.. لكنّه خلاف جريان الأسباب التي أقام الله عالمنا عليها.
رغم ظهور الخوارق في الحياة البشرية، إلا أنّها لم تكن يومًا العامل المسيّر للعالم. الخوارق التي تكون عند الأنبياء بمثابة المعجزات، هي أمور طارئة ومحدودة. والأصل هو أن يجري هذا العالم على أساس أسباب يمكن لأي إنسان أن يكتشفها ويصل إليها ويستخدمها.
العقلانية تعني وضوح الطريق الموصل إلى القدرة والأسباب. والعقلانية تعني أنّ هذا الطريق ممكن وميسر لأي شخص أو جماعة تسلكه. وبسبب هذا الوضوح تتجه الهمم البشرية وتنبعث الطاقات الكامنة فيها؛ وفي ظل هذه الانبعاث يكتشف الإنسان حقائق الوجود التي تكون مظهرًا لعظمة الله وأسمائه وصفاته.
التفاعل مع العالم على أساس الاستخدام والاستفادة والوسيلة هو الذي يفعّل الطاقات الكامنة لتكون محلًّا لشهود الحق ومعرفته والشعور به.
إنّ ضياء الأعين لن ينبعث إلا إذا أبصرت الأشياء. ولو فرضنا أنّ الإنسان عاش في مكان لا شيء فيه، فلن تتفتح قواه الباصرة والسامعة حتى لو كانت سليمة معافاة. وإن إدراك عظمة الله لن يتم إلا إذا شاهدنا آثار صنعه وتفاعلنا معها. ولذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون للإنسان كدح في هذا العالم لتحقيق مآربه.
عالمنا هذا بمثابة المهد الذي تنبعث فيه القوى الإنسانية وتتكامل، حتى جاء قوله تعالى: {وَمَنْ كانَ في هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبيلًا}،[3] وليس قتالنا لأعداء الله سوى فرصة لبعث الكثير من الطاقات والمعارف والقوى والمشاعر التي ما كنّا لنصل إليها إلا بواسطة هذه القتال. ولعله لا يوجد ولن يوجد مثل هذه الفرصة من حيث تأثيرها على طاقاتنا الكامنة في نظام العالم الحالي.
أجل، إنّ الله لا يحب لنا أن نبقى في حالة من الصراع والقتال والخوف والحزن، وقد فسح المجال لنوعٍ آخر من النظام الذي يمكن للبشر أن يفعّلوا فيه طاقاتهم الكامنة، وهو النظام الذي نؤمن بأنّه سيتحقق على يد مخلّص البشرية ومنقذ العالم المهدي المنتظر عجل الله فرجه. هناك، حيث سيتضاعف السعي الإنساني بدرجة تصبح الجهود التي نبذلها في الحروب والمعارك والمواجهات بمثابة الاستراحة مقارنةً بالجهود التي ستبذلها البشرية لإصلاح الأرض وفتح أبواب السماوات. لكن إن لم ننهض في ظل هذا النظام الحالي ونجاهد بكل ما أوتينا من قوى مادية وذهنية ومعنوية، فإنّنا لن نتمكن من الانتقال إلى ذلك النظام الأعلى. وما يعيقنا عن ذلك ويؤخر حركتنا أو يبطئها هذه هو أن نزيد من توقعاتنا لخرق العوائد، فنعجز عن إدراك أسرار هذا النظام وقواعده.
ولأنّ الله تعالى شاء أن يكون عالمنا مهد تكاملنا ومحل تفعيل طاقاتنا، فإنّ كل هذه التوقعات والأماني لن تؤدي إلى نتيجة. وسيكون عائد ذلك أن نسيء الظن بالله أو نسخط ونتألم أو نأسى على قضائه. وبدل أن نزداد إيمانًا في ظل هذا الصراع، ستضعف علاقتنا بالله ونظن أنّ الله تعالى قد وكلنا إلى أنفسنا.
على مؤمني الطبقة الأولى أن يتبحروا في فهم كل الأسباب التي تنفذ في هذا الصراع. وجزء كبير من هذه الأسباب لا يُفهم إلا بمعرفة التاريخ وقراءته قراءة واعية؛ لأنّ مراكمة القوة عند عدونا إلى هذا الحد لم تكن من صدف الأمور وخوارق العادات. كما إنّ مراكمة الضعف والهشاشة في معسكرنا لم تكن كذلك.
لم يصل عدونا إلى ما وصل إليه إلا بفعل الأخذ ببعض الأسباب، ولم نصل إلى ما وصلنا إليه إلا بسبب جريان بعض الأسباب علينا. وحين نريد أن نردم الهوة الواسعة ونقلل من فارق القوة، يجب علينا أن نسلك سبيل الأسباب. وأثناء سلوكنا العقلاني هذا سنشاهد الكثير من الألطاف الإلهية التي ما كنّا لنراها لو أجرى الله خوارق العادات علينا.
حين نشاهد بعض الفظائع، نتساءل في أعماقنا: لماذا يسمح الله بها؟ لنفترض أنّ الله تعالى تدخل (كما يُقال) وحال دون موت الأمهات الحوامل والأطفال الرضّع في الحروب. هذا ممكن على سبيل الفرض، لكن ذلك سيعني تداعي كل هذا النظام، وحينها لن يبقى أي شيء عقلانيًّا أو قابلًا للفهم والتفسير.
كل هذه الشرور التي تفوق قدرتنا على التحمّل أحيانًا، ليست سوى جزء من سلسلة علل النظام الحالي وأسبابه. هذا النظام الذي يُفترض أن نسعى لتغييره عبر الأخذ بالأسباب. إنّ وجود مرضٍ خبيث كالسرطان ليس خارجًا عن هذا النظام، وإن كان الباحثون عاجزين لحد الآن عن اكتشافه. وإنّ سعي البشرية للقضاء على السرطان أو معالجته لا يمكن أن يصل إلى النجاح ما لم تُفهم أسبابه وعلله. فهو مرض يتحدانا لكي نتعمق في فهم كيفية جريان العالم ومعرفة العلاقة بين الأفعال البشرية ونتائجها.
وفي سعينا للقضاء على هذا المرض الخبيث سنتمكن من إصلاح عالمنا أيضًا. ولأجل ذلك قد يُقال بأنّ كل هذه الجهود التي تُبذل في هذا المجال لن تزيد إلا من المعاناة البشرية لأنّها تصر على التعامل مع النتائج دون معرفة أسبابها. إنّ ما يقوم به الباحثون في هذا المجال أشبه بطلب الخوارق، وإن كانوا أكثر من يستبعد ذلك. إنِ اختار الله لنا العقلانية سبيلًا للنصر، فعلينا أن نشكره، لأنّنا أصبحنا مورد عنايته الخاصة، رغم كل المعاناة!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]. سورة الرعد، الآية 28.
[2]. سورة البقرة، الآية 152.
[3]. سورة الإسراء، الآية 72.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (فور) في القرآن الكريم
معنى (فور) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 معرفة الإنسان في القرآن (5)
معرفة الإنسان في القرآن (5)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
الشيخ محمد صنقور
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
-
 صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
السيد عادل العلوي
-
 هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
السيد عبد الحسين دستغيب
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

لقاء الرحمة والعبادة
-

معنى (فور) في القرآن الكريم
-

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحفز الإبداع إذا سألناه كيف يفكر لا ماذا يفكر
-
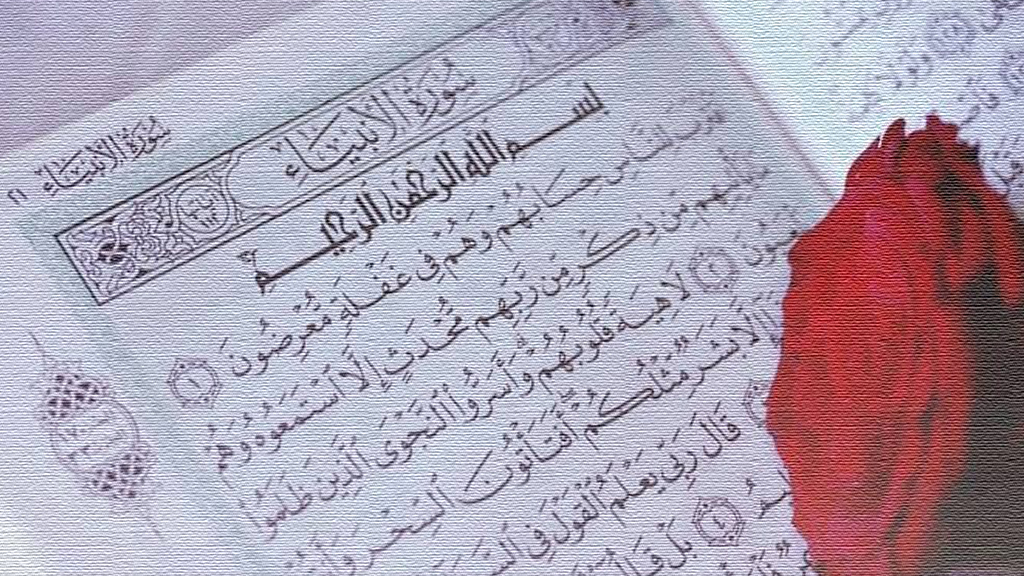
معرفة الإنسان في القرآن (5)
-

خديجة الكبرى المسلمة الأولى
-

شرح دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك
-

السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
-
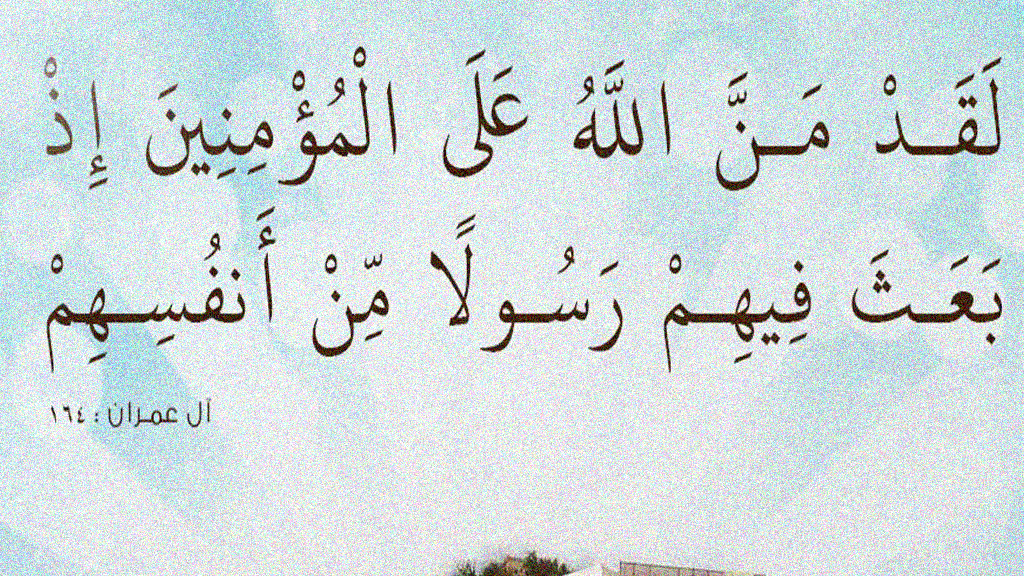
معنى (منّ) في القرآن الكريم
-

أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
-

اختتام حملة التّبرّع بالدّم (النّفس الزّكيّة)










