مقالات
معلومات الكاتب :
الاسم :
السيد عباس نور الدينعن الكاتب :
كاتب وباحث إسلامي.. مؤلف كتاب "معادلة التكامل الكبرى" الحائز على المرتبة الأولى عن قسم الأبحاث العلميّة في المؤتمر والمعرض الدولي الأول الذي أقيم في طهران: الفكر الراقي، وكتاب "الخامنئي القائد" الحائز على المرتبة الأولى عن أفضل كتاب في المؤتمر نفسه.القدرة العجيبة المنسيّة لصناعة الإنسان

هناك شبه إجماع بين التربويين على أن العلم وحده ليس كافيًا.. فالمطلوب هو السلوك؛ ولا يبدو أن مجرد العلم يحقق العلة التامة للسلوك. ما يبتغيه التربويون، بل كل عقلاء العالم، هو الفعل الصحيح، وإن اختلفوا في تحديده.
ما نؤمن به هو أن الإسلام في شريعته قد حدد جميع الأفعال التي تؤدي إلى سعادة الفرد والمجتمع، وإن اختلفنا في استنباط هذه الأفعال من نبع الإسلام ومصادره.
أجل؛ فما فائدة وجودنا على هذه الأرض إن لم تكن لنا أفعال تؤثر في حياتنا؛ فمهما بلغت أفكارنا من العظمة والدقة، ما يفيدنا وينفعنا في النهاية هو تلك الأفعال التي تجلب لنا الخير وتدفع عنا الشر.
والكلام كله في العلة التامة وراء السلوك الإنساني الصحيح النافع.
غالبًا ما نجد نحن البشر أنّ علمنا سابق على عملنا، أو أنه أوسع من أفعالنا (نعلم أكثر مما نعمل). وقد تكون أفعالنا مخالفة لما نعلم. هذا ما يٌقال. ولكن، هل يمكن أن تتشكل أو تنبثق الأفعال السليمة المبتغاة عن غير العلم المصيب للواقع؟ (إلا في الحالات النادرة التي لا يُعتد بها)..
لا شك بأنّ العلم الصحيح أو العلم الكاشف والمصيب للواقع هو أحد أجزاء العلة التامة للفعل السليم. وكل الكلام في حصة هذا الجزء مقارنةً بغيره من أجزاء هذه العلة؛ فإذا كان العلم يمثل النسبة الكبرى، وجب على البرامج التربوية أن تأخذ بعين الاعتبار نسبة هذه الحصة فيها. لأن الإخفاق في التعليم يرجع بالدرجة الأولى إلى التقصير بحق أجزاء العلة التامة؛ مع اعترافنا المسبق بأهمية السلوك وموقعيته.
ماذا لو كان هناك علم يمكن أن يكون بذاته العلة التامة للسلوك والفعل الاختياري، بحيث لو امتلكه الإنسان لتحقق كل ما هو مُبتغى من التربية ومن صناعة الإنسان وإعداده!
أسوأ ما تعاني منه الرؤى التربوية في عالمنا اليوم هو تقسيم أهدافها ما بين علم وقيمة ومهارة، حيث تساوي بين العلم والعمل؛ في حين أننا نؤمن بأن العلم هو المصدر الأول للقيم والمهارات. لكننا نمتلك تصورًا مختلفًا عن هذا العلم، ونفضل أن نطلق عليه عنوان العلم الأعلى. إنه العلم الذي لا مجال له في المذاهب المادية وأمثالها.
إنّ اعتبار وجود مناشئ للقيم والمهارات غير العلم والمعرفة يمثل وقيعة بالإنسان، فوفق هذا التصور سيكون للسلوك الإنساني في العديد من الحالات أسباب لا علاقة لها بفهمه وإدراكه للعلاقة بين الفعل والمصير. وفي ظل هذا الانفصام يصبح الفعل تحت سيطرة قوى أخرى غير صاحبه.
كلما كان الفعل صادرًا عن الوعي كان صاحبه أكثر تحررًا وانعتاقًا. الوعي هنا ليس سوى قوة حضور العلم في العمل والسلوك. وفي ظل الوعي ينفذ الإنسان مهمة التفسير العلمي لما يقوم به، تفسير ما يقوم به على ضوء ما يؤمن به من حقائق. ولذلك احتاج الوعي إلى العلم حتمًا.
أجل، قد تتشكل بعض المهارات بعيدًا عن هذا الوعي، لكن يمكننا في مثل هذه الحالات أن نطلق عليها مهارات الدب الراقص، الدب الذي يتعلم بواسطة عصا التهديد.
يوجد مع الإنسان شيء آخر غير العصا وهي الجزرة. الجزرة هي تلك الأعراف والموضة والتيارات والثقافات الاجتماعية التي تحدد قيم الأفعال وجوائزها.. يعمل الكثير من الناس على اكتساب مهارات معينة لا لشيء سوى لأن وراءها جوائز اجتماعية مختلفة، وهكذا يدخل عنصر التأثير والتحريك الاجتماعي بعيدًا عن الوعي. إنه أشبه بالتنويم المغناطيسي الذي لا يدري صاحبه ما يفعل به!
للأسف، مع انحطاط مستوى الفلسفة في الفكر التربوي بات الكثير من التربويين لا يناقشون مدى فائدة أو ضرورة هذه المهارة أو تلك طالما أنها مطلوبة أو ممدوحة في العرف والتقنين الاجتماعي الحاكم.. هنا يصبح امتهان هذه المهارة هدفًا إذا كانت ضرورات الاقتصاد تتطلبها، على سبيل المثال. إنها العبودية الجديدة التي تقوم مناهجنا التعليمية فيها بتطويع العبيد وإعدادهم ليكونوا خدامًا جديرين لهذا النظام الدنيوي الوضعي. إنها الغايشا العالمية التي لا يناقشها أحد.
في المقابل، العلم الذي نتصوره هو علم يبين العلاقة الوطيدة بين الحقائق والوقائع وبين الأفعال. الأفعال هنا لن تكون سوى تجلّ وظهور للعلم بتلك الحقائق. إنّ النفس البشرية مخلوقة على أساس أن العلم الذي لا يخالجه الشك سيكون علة تامة للفعل المتناسب معه. المعصومون الذين لا يخالفون الشريعة ولا يقصرون في واجباتها كانوا كذلك لأنهم كانوا مبرئين من الشك، هذه هي ميزتهم الأولى. كما جاء في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام في وصف أهل بيت العصمة والطهارة حيث قال: "وَإنّا لا نوصَفُ، وَكَيْفَ يوصَفُ قَوْمٌ رَفَعَ اللهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وهُوَ الشَّكُّ". وكونهم لا يشكون أبدًا، لا يعني أن من سواهم ـ من ليس معصومًا بحسب التعريف الكلامي ـ يشك في كل شيء.
إنّ لكل الناس نسب وحظوظ من اليقين، وعلى أساس ما يمتلكون منه تصدر أفعالهم السليمة.. ما نحتاج إليه هنا هو توسعة دائرة هذا اليقين ليشتمل على القضايا التي نؤمن أنها ضرورية ومهمة في هذه الحياة. وهذا ممكن جدًّا. نحن نخالف علمنا أحيانًا لا لأننا بشر نتبع الأهواء والميول الغريزية، بل لأن علمنا أحيانا كثيرة لا يكون قد ارتقى إلى درجة اليقين في هذه القضية التي خالفنا فيها أو تصرفنا عكس ما تقتضيه وتستلزمه.
اليقين هو بكل بساطة انتفاء احتمال الخلاف. لكن الخلاف المطروح هنا ليس في دائرة التصور المفهومي لهذه القضية ولا حتى في التصديق الفلسفي المؤطر، فنحن لا نتحدث عن قضية محددة في إطار الفلسفة المتعارفة، وإن كان للفلسفة هنا دورٌ لا يُستهان به؛ بل القضية التي نتحدث عنها والتي تُعتبر منشأً للفعل والسلوك هي شيء أوسع بكثير، إنها تلك التي تشتمل على عواقب الفعل والترك.
حين نطرح قضية نبتغي من خلال طرحها حث الآخر على التصرف المتناسب معها، لا ينبغي أن ننسى أنّ خلوّ هذا الطرح أو تلك القضية من تفسير وتوضيح عواقب الفعل يعني أنّ قضيتنا ناقصة.. أن نقول "إنّ الله موجود" قضية، لكن وجود الله لا ينحصر وفق هذا التصور بالمعنى المفهومي المقابل لعدم وجوده، فالوجود الإلهي يشتمل على معان كثيرة، وإلا لما كان وجودًا لله تعالى بالمعنى الحقيقي. وبتعبيرٍ آخر، إنّ تصور الموضوع في هذه القضية أمر أهم بكثير من الحكم عليه. يُفترض في هذه القضية أن نعلم بأنّ الله المستحق للعبادة والمحبة والطاعة والخشية هو الموجود الحاضر المهيمن، لا الله الذي ينفي وجوده الملحدون. في مثل هذه الحالة، لا يمكن أن يتخلف الفعل المتناسب مع هذه القضية عن العلم اليقيني بها.
أكثر الذين طرحوا ازدواجية العلم والسلوك، كانوا يشيرون إلى ذلك العلم المفهومي الفلسفي، وهو العلم الناقص الذي نريد تكميله حتى يصبح يقينًا يصدر منه الفعل حتمًا. حتى الغفلة والنسيان وأمثالها ترجع إلى درجاتٍ من الشك. الموقنون تصدر أفعالهم من علمهم صدورًا علّيًّا. وإذا أردنا أن نكون واقعيين ينبغي ألّا ننسى بأنّ ما نصبو إليه في صناعة الإنسان هو هذا المستوى من السلوك الذي يحفظنا على الصراط المستقيم، وإن زلت أقدامنا أحيانًا أو تباطأنا أو غفلنا. على هذا الأساس، ستتشكل القيم التي هي التجسيد الشعوري للحقائق في عالم الاعتبار الاجتماعي والنفسي، أو فقل إنّ القيم ليست سوى تشكل الحقيقة في الإطار المحرك للسلوك. على هذا الأساس أيضًا، يندفع الإنسان نحو الأعمال التي يؤمن بضرورة القيام بها ويكتسب بفضل هذا الاندفاع والتوق تلك المهارات والإتقان، وما أقرب الإتقان إلى الإيقان.
الإنسان الموقن هو الذي يدرك بوعيٍ تام أهمية وضرورة السعي الحثيث لإتقان ما يقوم به، وهو ما يشكل أرضية المهارات المختلفة. حين يصل الإنسان إلى اليقين لا يبقى بينه وبين إطاعة جسده وأعضائه وجوارحه لقلبه وعقله المؤمن سوى وقت قصير، وهو أقصر بكثير من أي وقت يستغرقه المتدرب الجاد المثابر! لو اكتشفنا هذا العلم وعلّمناه لأبنائنا الذين يحملون الكثير من الخصائص النفسية الملائمة لقبول الحقيقة والإيمان بها، لتشكل ذلك الجيل الذي لا نحتاج معه إلى كثير جهد في التزكية والتربية والتدريب.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 معنى (فور) في القرآن الكريم
معنى (فور) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 معرفة الإنسان في القرآن (5)
معرفة الإنسان في القرآن (5)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا..} (البرّ) بين الرّفع والنّصب
الشيخ محمد صنقور
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
-
 صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
صفات الله سبحانه وتعالى الجماليّة والجلاليّة
السيد عادل العلوي
-
 هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصّلاة؟
السيد عبد الحسين دستغيب
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

لقاء الرحمة والعبادة
-

معنى (فور) في القرآن الكريم
-

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحفز الإبداع إذا سألناه كيف يفكر لا ماذا يفكر
-
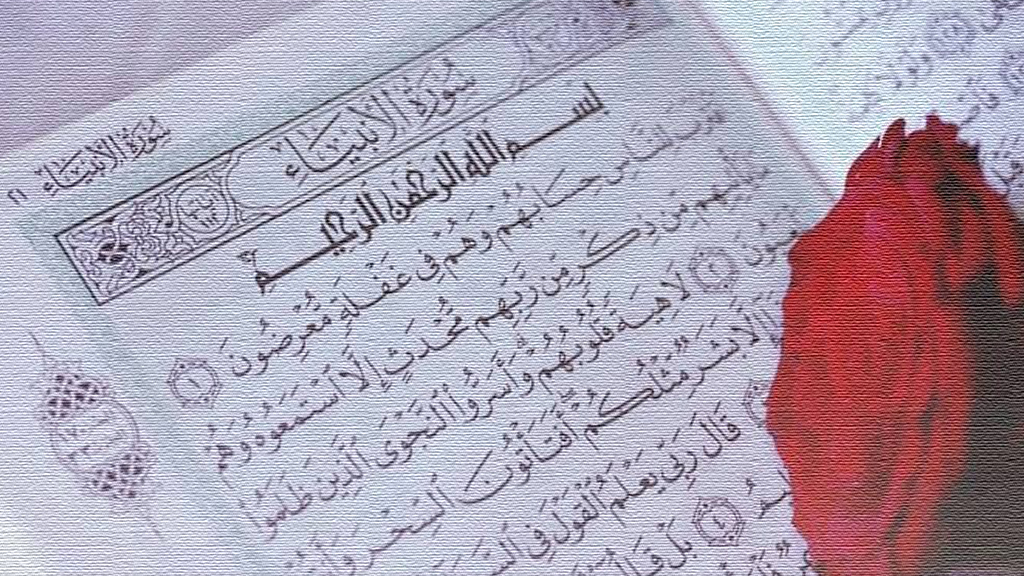
معرفة الإنسان في القرآن (5)
-

خديجة الكبرى المسلمة الأولى
-

شرح دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك
-

السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
-
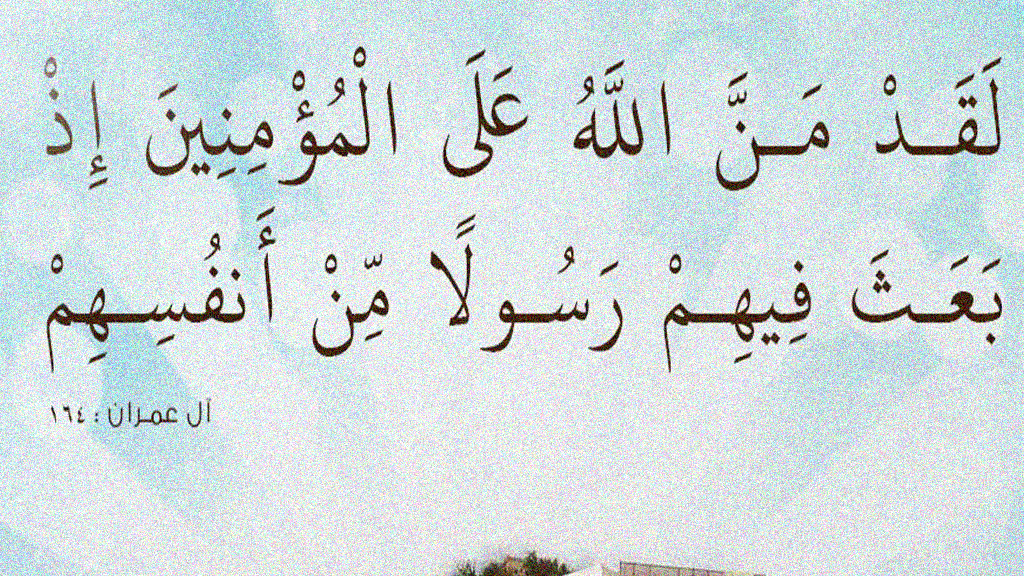
معنى (منّ) في القرآن الكريم
-

أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
-

اختتام حملة التّبرّع بالدّم (النّفس الزّكيّة)










