علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
الشيخ عبدالهادي الفضليعن الكاتب :
الشيخ الدكتور عبدالهادي الفضلي، من مواليد العام 1935م بقرية (صبخة العرب) إحدى القرى القريبة من البصرة بالعراق، جمع بين الدراسة التقليدية الحوزوية والدراسة الأكاديمية، فنال البكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية ثم درجة الدكتوراه في اللغة العربية في النحو والصرف والعروض بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، له العديد من المؤلفات والمساهمات على الصعيدين الحوزوي والأكاديمي.rnتوفي في العام 2013 بعد صراع طويل مع المرض.أسلوب البحث (5)

غلو الطوفي في المصالح المرسلة:
وكان من مظاهر غلو الطوفي فيها تقديمه رعاية المصلحة على النصوص والإجماع، واستدل على ذلك بوجوه: "أحدها أن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح، فهو إذن محل وفاق، والإجماع محل خلاف، والتمسك بما اتفق عليه أولى من التمسك بما اختلف فيه" (1).
ويرد على هذا الاستدلال عدم التفرقة بين رعاية المصلحة وبين الاستصلاح كدليل فالأمة، وإن اتفقت على أن أحكام الشريعة مما تراعى فيها المصالح، ولكن دليل الاستصلاح موضع خلاف كبير لعدم إيمان الكثير منهم بإمكان إدراك هذه المصالح مجتمعة من غير طرق الشرع.... فدليل الاستصلاح إذن ليس موضع وفاق ليقدم على الإجماع.
"الوجه الثاني: أن النصوص مختلفة متعارضة فهي سبب الخلاف في الأحكام المذموم شرعًا، ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيه، فهو سبب الاتفاق المطلوب شرطًا فكان اتباعه أولى، وقد قال عز وجل: (واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا) (2)، (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء) (3)، وقال عليه السلام: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم"، وقد قال عز وجل في مدح الاجتماع: (وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم) (4)، وقال عليه السلام: "كونوا عباد الله إخوانًا".
ومن تأمل ما حدث بين أئمة المذاهب من التشاجر والتنافر، علم صحة ما قلنا، حتى أن المالكية استقلوا بالمغرب، والحنفية بالمشرق، فلا يقارن أحد المذهبين أحدًا من غيره في بلاده إلا على وجه ما، وحتى بلغنا أن أهل جيلان من الحنابلة إذا دخل إليهم حنفي قتلوه، وجعلوا ماله فيئًا حكمهم في الكافر، وحتى بلغنا أن بعض بلاد ما وراء النهر من بلاد الحنفية، كان فيه مسجد واحد للشافعية وكان والي الإبل يخرج كل يوم لصلاة الصبح فيرى ذلك المسجد فيقول: أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق؟ فلم يزل كذلك، حتى أصبح يومًا وقد سد باب ذلك المسجد بالطين واللبن فأعجب الوالي ذلك".
"ثم إن كلًّا من أتباع الأئمة، يفضل إمامه على غيره في تصانيفهم ومحاوراتهم حتى رأيت حنفيًّا صفف مناقب أبي حنيفة، فافتخر فيها بأتباعه، كأبي يوسف ومحمد وابن المبارك ونحوهم، ثم قال: يعرض بباقي المذاهب:
أولئك آبائي فجئني بمثلهم
إذا جمعتنا يا جرير المجامع
وهذا شبيه بدعوى الجاهلية وغيره كثير، وحتى أن المالكية يقولون: الشافعي غلام مالك، والشافعية يقولون: أحمد بن حنبل غلام الشافعي، والحنابلة يقولون: الشافعي غلام أحمد بن حنبل. "وقد ذكره أبو الحسن القرافي في الطبقات من أتباع أحمد". "والحنفية يقولون: إن الشافعي غلام أبي حنيفة لأنه غلام محمد بن الحسن، ومحمد غلام أبي حنيفة"، قالوا لولا أن الشافعي من أتباع أبي حنيفة لما رضينا أن ننصب معه الخلاف. وحتى أن الشافعية يطعنون بأن أبا حنيفة من الموالي، وأنه ليس من أئمة الحديث، وأحوج ذلك الحنفية إلى الطعن في نسب الشافعي وأنه ليس قرشيًّا بل من موالي قريش، ولا إمامًا في الحديث لأن البخاري ومسلمًا أدركاه ولم يرويا عنه، مع أنهما لم يدركا إمامًا إلا رويا عنه، حتى احتاج الإمام فخر الدين والتميمي في تصنيفيهما مناقب الشافعي إلى الاستدلال على هاشميته، وحتى جعل كل فريق يروي السنة في تفضيل إمامه، فالمالكية رووا: "يوشك أن تضرب أكباد الإبل ولا يوجد أعلم من عالم المدينة". قالوا: وهو مالك، والشافعية رووا: "الأئمة من قريش، تعلموا من قريش ولا تعالموها"، أو "عالم قريش ملأ الأرض علمًا"، قالوا: ولم يظهر من قريش بهذه الصفة إلا الشافعي والحنفية، رووا: "يكون في أمتي رجل يقال له النعمان هو سراج أمتي، ويكون فيهم رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس".
والحنابلة رووا: "يكون في أمتي رجل يقال له أحمد بن حنبل يسير على سنتي سير الأنبياء" أو كما قال فقد ذهب عني لفظه". "وقد ذكر أبو الفرج الشيرازي في أول كتابه المنهاج" واعلم أن هذه الأحاديث ما بين صحيح لا يدل، ودال لا يصح. أما الرواية في مالك والشافعي فجيدة لكنها لا تدل على مقصودهم لأن عالم المدينة إن كان اسم جنس فعلماء المدينة كثير ولا اختصاص لمالك دونهم، وإن كان اسم شخص فمن علماء المدينة الفقهاء السبعة وغيرهم من مشايخ مالك الذين أخذ عنهم وكانوا حينئذ أشهر منه، فلا وجه لتخصيصه بذلك وإنما حمل أصحابه على حمل الحديث عليه كثرة أتباعه وانتشار مذهبه في الأقطار، وذلك إمارة على ما قالوا، وكذلك الأئمة من قريش لا اختصاص للشافعي به، ثم هو محمول على الخلفاء في ذلك، وقد احتج به أبو بكر يوم السقيفة، وكذلك تعلموا من قريش لا اختصاص لأحد به".
"أما قوله: "عالم قريش يملأ الأرض علمًا" فابن عباس يزاحم الشافعي فيه، فهو أحق به لسبقه وصحبته ودعاء النبي (صلى الله عليه وسلم) في قوله: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" فكان يسمى بحر العلم وحبر العرب، وإنما حمل الشافعية الحديث على الشافعي لاشتهار مذهبه وكثرة أتباعه، على أن مذهب ابن عباس مشهور بين العلماء لا ينكر".
"وأما الرواية في أبي حنيفة وأحمد بن حنبل فموضوعة باطلة لا أصل لها، أما حديث" هو سراج أمتي "فأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وذكر أن مذهب الشافعي لما اشتهر أراد الحنفية إخماله، فتحدثوا مع مأمون بن أحمد السلمي وأحمد بن عبد الله الخوشاري وكانا كذابين وضاعين، فوضعا هذا الحديث في مدح أبي حنيفة وذم الشافعي، ويأبى الله إلا أن يتم نوره".
"وأما الرواية في أحمد بن حنبل فموضوعة قطعا لأنّا قدمنا أن أحمد كان أحفظ الناس للسنة وأشدهم بها إحاطة حتى ثبت أنه كان يذاكر تأليف ألف حديث وأنه قال: خرجت مسندي من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألف حديث، وجعلته حجة بيني وبين الله عز وجل، فما لم تجدوه فيه فليس بشيء".
"ثم إن هذا الحديث الذي أورده الشيرازي في مناقب أحمد ليس في مسنده، فلو كان صحيحًا لكان هو أولى الناس بإخراجه والاحتجاج به في محنته التي ضيق الأرض ذكرها".
فانظر بالله أمرًا يحمل الأتباع على وضع الأحاديث في تفضيل أئمتهم وذم بعضهم، وما مبعثه إلا تنافس المذاهب في تفضيل الظواهر ونحوها على رعاية المصالح الواضح بيانها الساطع برهانها، فلو اتفقت كلمتهم بطريق ما لما كان شيء مما ذكرنا عنهم".
"واعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء تعارض الروايات والنصوص، وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك عمر بن الخطاب، وذلك أن أصحابه استأذنوه في تدوين السنة في ذلك الزمان فمنعهم من ذلك وقال: (لا أكتب من القرآن غيره) مع علمه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "اكتبوا لأبي شاه خطبة الوداع" وقال: "قيدوا العلم بالكتابة" قالوا: فلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، لانضبطت السنة، ولم يبق بين أحد من الأمة وبين النبي (صلى الله عليه وسلم)، في كل حديث إلا الصحابي الذي دون روايته، لأن تلك الدواوين تتواتر إلينا كما تواتر البخاري ومسلم ونحوهما" (5).
ثم أورد بعد ذلك على نفسه بقوله: "فإن قيل خلاف الأمة في مسائل الأحكام رحمة وسعة، فلا يحويه حصرهم من جهة واحدة لئلا يضيق مجال الاتساع، قلنا هذا الكلام ليس منصوصًا عليه من جهة الشرع حتى يمتثل، ولو كان لكان مصلحة الوفاق أرجح من مصلحة الخلاف فتقدم". "ثم ما ذكرتموه من مصلحة الخلاف بالتوسعة على المكلفين معارض بمفسدة تعرض منه، وهو أن الآراء إذا اختلفت وتعددت اتبع بعض رخص بعض المذاهب فأفضى إلى الانحلال والفجور كما قال بعضهم:
فاشرب ولط وازن وقامر واحتج
في كل مسألة بقول إمام
يعني بذلك شرب النبيذ وعدم الحد في اللواط على رأي أبي حنيفة، والوطأ في الدبر على ما يعزى إلى مالك، ولعب الشطرنج على رأي الشافعي". "وأيضًا فإن بعض أهل الذمة ربما أراد الإسلام فيمنعه كثرة الخلاف وتعدد الآراء ظنًّا منه أنهم يخطئون، لأن الخلاف مبعود عنه بالطبع، ولهذا قال الله تعالى: (الله نزل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا ) (6) أي يشبه بعضه بعضًا ويصدق بعضه بعضًا، لا يختلف إلا بما فيه من المتشابهات وهي ترجع إلى المحكمات بطريقها، ولو اعتمدت رعاية المصالح المستفادة من قوله (ع): "لا ضرر ولا ضرار" على ما تقرر، لاتحد طريق الحكم وانتهى الخلا ، فلم يكن ذلك شبهة في امتناع من أراد الإسلام من أهل الذمة وغيرهم" (7).
ومع الغض عما في نصه هذا من خطابية وتطويل قد لا تكون له حاجة، إن الاختلاف ضرورة لا يمكن دفعها عن البشر، وهو لا يستدعي الصراع والخصام المذهبي ما دام أصحابه يسيرون ضمن نطاق الاجتهاد بموضوعية تامة، وما دامت الأهواء السياسية وغيرها بعيدة عنه.
وهذا النوع من الصراع بين أتباع المذاهب كانت من ورائه دائمًا عوامل لا ترتبط بالدين. وكانت السياسية من وراء أكثرها وكثير من هؤلاء المصطرعين لم يكونوا من العلماء المجتهدين، وإنما كانوا مرتزقة باسم الدين لانسداد أبواب الاجتهاد في هذه الفترات التي أرخ لها، وحيث يوجد الغرض والهوى والجهل، ومحاولات الاستغلال من تجار الضمائر والمبادئ توجد التفرقة والصراع، وأمثال هؤلاء المفرقين من العلماء إنما هم دمى بيد السلطة تحركها كيفما تشاء.
وإلا فإن العالم الصحيح لا يضره الاختلاف معه في مجالات استنباطه وربما سر لعلمه بقيمة ما يأتي به الصراع من تلاقح فكري، وإنماء وتطور للأفكار التي يؤمن بها. والعلماء في مختلف المجالات العلمية يختلفون، وما سمعنا خلافًا أوجب الصراع فيما بينهم باسم العلم فضلًا عن أن يدب الصراع إلى أبناء شعوبهم فيقتتلون، اللهم إلا إذا كانت السلطات من ورائه كما هو الشأن في موقف سلطة الكنيسة من بعض العلماء المكتشفين أمثال غاليلو.
والشيعة أنفسهم رأوا طوائف من علمائهم وهم بحكم فتح أبواب الاجتهاد على أنفسهم كانوا يختلفون، وينقد بعضهم آراء البعض الآخر، ومع ذلك كله نرى تقديسهم لعلمائهم يكاد يكون منقطع النظير. وما استشهد به من الآيات والروايات على المنع من الاختلاف أجنبي عن هذا النوع من الاختلاف الذي يقتضيه البحث الموضوعي، لأن المنع عن هذا النوع منه تعبير آخر عن الدعوة إلى الجمود وإماتة الفكر والنظر في شؤون الدين، وهو ما ينافي الدعوة إلى تدبر ما في القرآن والنظر إلى آياته، بل ينافي الدعوة إلى تدبر ما في الكون والحث على استعمال العقل، وهو ما طفحت به كثير من الآيات والأحاديث، لأن طبيعة التدبر واستعمال الفكر تدعو إلى اختلاف الرأي.
فالاختلاف المنهي عنه هو الاختلاف الذي يدعو إلى التفرقة وتشتيت كلمة الأمة، أي الاختلاف الذي يستغل عاطفيًّا لتفرقة الشعوب لا الاختلاف الذي يدعو إليه البحث الموضوعي وهو من أسباب الألفة والتعاطف بين أربابه، ففي الاستدلال خلط بين نوعي الاختلاف.
ومع التغافل عن هذه الناحية فإن دعواه بأن رعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيه فهو سبب الاتفاق - لا أعرف لها وجها، لأن المصالح الحقيقية التي يتطابق عليها العقلاء محدودة جدًّا، وما عداها كلها موضع خلاف بل هي نفسها موضع لخلاف كبير في مواقع تطبيقها كما سبق بيانه في مبحث العقل فكيف يكون النظر فيها موضعًا لاتفاق الكلمة وبخاصة إذا وسعنا الأمر إلى عوالم الظنون بها والأوهام، وهل تكفي مواضع الاتفاق منها لإقامة شريعة إذا تجردنا عن النصوص.
وبهذا يتضح الجواب على ما أورده على نفسه من إشكال وأجاب عليه، فكون الاختلاف رحمة وسعة مما لا إشكال فيه أصلًا إذا كان في حدود البحث الموضوعي، والذي يدل عليه كل ما يدل على وجوب المعرفة المستلزمة حتمًا للاختلاف من آيات وأحاديث، ومعارضتها بمفسدة الأخذ بالرخص لا تعتمد على أساس.
فالآخذون بالرخص إما أن يكونوا معتمدين على حجية كأن يكون هناك مرجع مستوف لشرائط التقليد يسيغ لهم ذلك، فالأخذ بها لا يشكل مفسدة وأصحابها معذورون، وإما أن لا يكونوا على حجة، وهؤلاء لا حساب لنا معهم لتمردهم على أصل الشريعة في عدم الركون في تصرفاتهم على أساس، وكونهم يستغلون الرخص لتبرير أعمالهم أمام الرأي العام فإنما هو من قبيل الخداع والتمويه، ولو لم تكن هناك رخص لارتكبوا هذه الأعمال والتمسوا لها مبررات غير هذه.
وكون الاختلاف مانعًا من دخول أهل الذمة إلى الإسلام هو الآخر لا يخلو من غرابة، فإن هؤلاء إن كانوا على درجة من الثقافة عرفوا أن هذا المقدار من الاختلاف مبرر في جميع الشرائع، بل هو مما تقتضيه الطبيعة البشرية لاستحالة اتفاق الناس في فهم جميع ما يتصل بشؤون شرائعهم، بل جميع ما يتصل بشؤونهم الحياتية وغيرها، ومتى منع الاختلاف أحدًا من الدخول في الإسلام؟! فغلو الطوفي في استعمال المصالح المرسلة وتقديمها على النصوص والإجماع لا يستقيم أمره بحال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رسالة الطوفي، ص 109.
(2) آل عمران / 103.
(3) الأنعام / 159.
(4) الأنفال / 63.
(5) رسالة الطوفي، ص 109 إلى ص 113.
(6) الزمر / 23.
(7) رسالة الطوفي، ص 116.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 خصائص الصيام (1)
خصائص الصيام (1)
الأستاذ عبد الوهاب حسين
-
 الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الموانع من حضور الضيافة الإلهية
الشيخ محمد صنقور
-
 البعث والإحياء بعد الموت
البعث والإحياء بعد الموت
الشيخ محمد جواد مغنية
-
 معرفة الإنسان في القرآن (6)
معرفة الإنسان في القرآن (6)
الشيخ مرتضى الباشا
-
 معنى (فور) في القرآن الكريم
معنى (فور) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
أهميّة قوة العضلات في خفض معدّل الوفيات للنّساء فوق الستين
عدنان الحاجي
-
 البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
البعض لا يتغيّر حتّى في شهر رمضان المبارك، فماذا عنك أنت؟!
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
أبو طالب عليه السلام المظلوم المفترى عليه (3)
السيد جعفر مرتضى
-
 شروط استجابة الدعاء
شروط استجابة الدعاء
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
اللهمّ إني أفتتح الثّناء بحمدك
السيد محمد حسين الطهراني
الشعراء
-
 السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
السيّدة خديجة: سيّدة بيت النّبوّة
حسين حسن آل جامع
-
 مشكاة اللّيل
مشكاة اللّيل
فريد عبد الله النمر
-
 كالبرق الخاطف في الظّلمة
كالبرق الخاطف في الظّلمة
أحمد الرويعي
-
 يا جمعه تظهر سيدي
يا جمعه تظهر سيدي
علي الخويلدي
-
 شربة من كوز اليقين
شربة من كوز اليقين
أسمهان آل تراب
-
 ما حدّثته أعشاش اليمامات
ما حدّثته أعشاش اليمامات
حبيب المعاتيق
-
 في حنينٍ وفي وجد
في حنينٍ وفي وجد
الشيخ علي الجشي
-
 وجهة
وجهة
ناجي حرابة
-
 أفق من الأنوار
أفق من الأنوار
زكي السالم
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
آخر المواضيع
-

خصائص الصيام (1)
-

الموانع من حضور الضيافة الإلهية
-

البعث والإحياء بعد الموت
-

حديث للاختصاصيّ النّفسيّ أسعد النمر حول توظيف التّقنية في العلاج النّفسيّ
-

التقوى، العطاء، الإيثار في شهر رمضان
-

شرح دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان
-
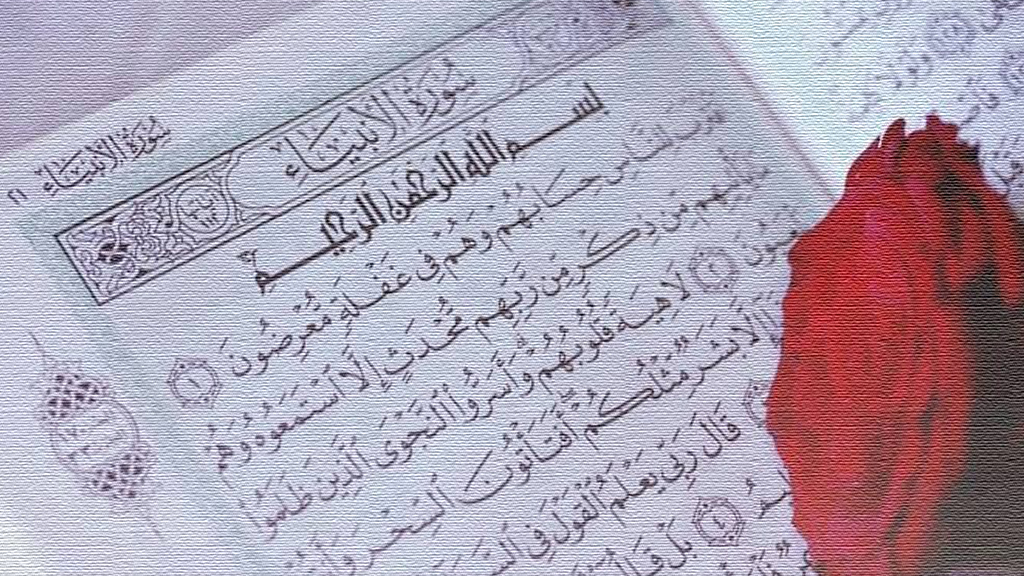
معرفة الإنسان في القرآن (6)
-

شرح دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان
-

لقاء الرحمة والعبادة
-

معنى (فور) في القرآن الكريم










